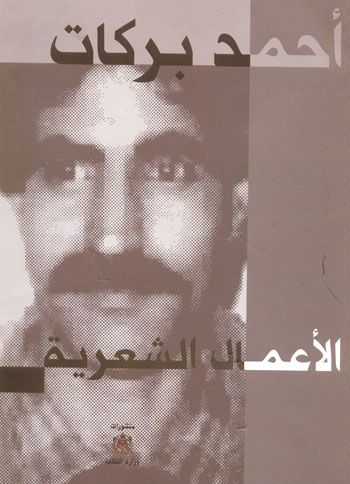شاعر الزلزال يعود: 20 عاما على رحيل أحمد بركات

في التاسع من سبتمبر من سنة 1994، رحل الشاعر المغربي أحمد بركات وهو لم يتجاوز 34 عاماً. لم تكن وفاته المبكرة هي التي صنعت نجوميته وتألقه الشعريين، ولكن شعره تألق وهو على قيد الحياة، حين توج بأول جائزة لاتحاد كتاب المغرب سنة 1990، عن ديوانه الشهير “أبدا لن أساعد الزلزال”، والذي أحدث، بحق، زلزالا في الأرض الشعرية في أواخر الثمانينات وبداية التسعينات.
وهكذا، خلد بركات اسمه ضمن قائمة الشعراء الذين رحلوا باكرا، ولكنهم ظلوا مقيمين في ديوان الإنسانية الكبير، من طرفة بن العبد إلى بايرون إلى شيليب إلى رامبو إلى بوشكين وماياكوفسكي ولوركا، ومن فروغ فرخزاد إلى سيلفيا بلاث، هذه الأخيرة التي كادت تكمل الثلاثين من العمر دون أن تموت، فقررت الانتحار، وماتت لتكون من الخالدات.
هذا ما فعله بركات، ربما، فقد مات ليبقى على قيد الحياة. أليس أحمد هو الذي كان معجبا بعبارة نحتها المفكر المغربي الراحل عبد الكبير الخطيبي عن نيتشه، تقول: “إن جدارة الإنسان هي أن يستحق موته بين الموتى”.
عبر فرنسا
كرمت جمعية “إنسانية وثقافة” الشاعر بركات مؤخراً في مدينة فرونتينيون، وقدمت مختارات من أعماله الشعرية إلى الثقافة الفرنسية والفرنكوفونية، في لقاء حافل بالمدينة المتوسطية، جنوب فرنسا، ضمن حلقة جديدة من سلسلة “لقاءات الجنوب”.
وقد اختارت الجمعية الفرنسية، التي تترأسها الشاعرة الفرنسية الشهيرة نيكول درانو وزوجها الشاعر جورج درانو، تكريم الشاعر المغربي الراحل، من خلال تقديم وعرض تجربته، وترجمة مختارات من أعماله إلى الفرنسية، وطبعها مرفقة بلغتها الأصلية. وقد قام بترجمة نصوص الشاعر محمد ميلود غرافي، والذي عرض لتجربة بركات في المشهد الشعري المغربي في ثمانينات القرن الماضي. وتمت ترجمة أشهر نصوصه، وفي مقدمتها “أبدا لن أساعد الزلزال” و”بائعة الخبز” و”هذا هو الكرسي” و”انتهى الطريق” و”مجاز للأصفر”…
وبهذا تكون ترجمة أشعار بركات إلى الفرنسية بمثابة ترجمة لحلم راود الشاعر، الذي كان يتمنى قراءة أشعاره بالفرنسية، مثلما سعى في حياته إلى ترجمة قصائد لشعراء فرنسيين أثّروا في تجربته الشعرية، وفي مقدمتهم الشاعر كلود روي، الذي افتتن بشعره، وظل، طوال حياته، حريصا على ترديد صورة شعرية يقول فيها “لا تطرق الباب قبل أن تدخل، فأنت هنا منذ البداية”. كما ظل بركات يعرِّف الشاعر بلسان هذا الفرنسي: “الشاعر من يؤلمه القلب، تؤلمه الأرض، تؤلمه اللحظة. الشاعر من يقول: أنا ورأسي للآخرين”.
على أن افتتان بركات بديوان “الشعر والشعراء الفرنسيين” لم يتوقف عند هذا الحد، بل امتد إلى عشق فرنسا بأشعارها وأنوارها، فقرر منتصف ثمانينات القرن الماضي الهجرة إلى فرنسا، حيث قضّى هناك نحو سنة يحاول أن يكتشف نفسه في مكان آخر، كما جاء في إحدى رسائله التي بعث بها من باريس. واليوم، ها هو الشاعر المغربي يظهر في فرنسا من جديد، وفي ضاحيتها الجنوبية، مؤكدا أن الشاعر كائن أبدي.
شخصية إبداعية
من ناحية أخرى، أصدرت وزارة الثقافة المغربية، مؤخرا، الأعمال الشعرية الكاملة للراحل. وإلى جانب ديوانيه المعروفين واليتيمين “أبدا لن أساعد الزلزال” و”دفاتر الخسران”، ضمت الأعمال الكاملة، وعلى امتداد نصف المجلد، قصائد لم تنشر تعود إلى بداياته وبواكيره.
وبصدور أعماله الكاملة، يكون أحمد بركات أصغر شاعر يحظى بهذا التقدير، من جيل الثمانينات، بعدما توقفت الأعمال الكاملة على شعراء الخمسينات والستينات والسبعينات، من محمد الصباغ إلى محمد السرغيني، ومن عبدالكريم الطبال إلى محمد الميموني، ومن مليكة العاصمي إلى إدريس الملياني، فالمهدي أخريف.
وهي الأعمال الوحيدة التي تم تصديرها بمقدمة خاصة. وما يضفي عليها أهمية أكبر، وحميمية أشد، أن كاتب المقدمة ليس سوى شقيق الراحل الكاتب والصحفي عبدالعالي بركات.
|
يكشف لنا عبدالعالي أن أحمد، وقبل أن يكون شاعرا، تردد على الكثير من الفنون والرياضات، فقد كان يحمل، بقامته الفارعة، حلم حارس مرمى لكرة القدم، وكان بصوته الجهوري وجسده المتوثب مشروع ممثل مسرحي، أدّى أدوارا معبرة ومؤثرة مع فرقة “حوري الحسين” متنقلا ومترجلا على قدميه من حي عين الشق إلى دار الشباب بوشنتوف، على بعد المسافة.
كما كان الشاعر، منبهرا، على غرار أبناء جيله، بالأغاني الثورية والاستثنائية لـ”أغاني الجيل”، من مجموعة “ناس الغيوان” إلى مجموعة “لمشاهب” إلى مجموعة “جيل جيلالة”. وكان يعزف على آلة “الطمطام” التي اشتهرت لدى هذه الفرق، وتأثره بشعرية “كلام الغيوان” واضح في الكثير من قصائده. بل ويحكي لنا أخوه عبدالعالي بركات كيف أن أحمد كان يتمنى لو غنت مجموعة “لمشاهب” قصيدة من قصائده، على ما فيها من غنائية وثورية معا.
الرحلة الناقصة
لم يكمل بركات تعليمه الجامعي، غادر الجامعة في السنة الثالثة وقبل الأخيرة. ويحكي الشاعر السبعيني محمد الشيخي، أنه عندما كان أستاذا بكلية عين الشق بالبيضاء، نهاية الثمانينات، أن بركات عرض عليه الإشراف على رسالته الجامعية، للموسم المقبل، وكانت الفكرة عن موسيقى الشعر المغربي المعاصر، غير أن الشاعر سوف يتخلى عن الفكرة، ولن يعود إلى الجامعة، بعدها. وقد كانت الحاجة إلى كسب “الخبز اليومي”، في “الفرن اليومي” لمهنة المتاعب، هي التي عطلت الكثير من أحلامه ومشاريعه المشروعة.
لكن أحمد هو الذي مات. فبعد زواجه بالسيدة سعاد شرفي، وإقامته في بيتها في حي “الصخور السوداء” بمدينة الدار البيضاء، سوف تتصل الزوجة بأسرة بركات لتخبرهم بأن المرض اشتد على أحمد. ظهر الخبر يومها في إحدى الجرائد الوطنية “الشاعر أحمد بركات بين الحياة والموت”. وهنا، تحرك اتحاد كتاب المغرب، على عهد محمد الأشعري، وتقرر نقله إلى مصحة “الحكيم”، بجوار مستشفى 20 آب، حيث ظروف أفضل للعلاج، غير أن الأوان كان قد فات، ولم يلبث بعدها أن لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.
سيرة شعرية
شكل ظهور ديوان “دفاتر الخسران” بعد رحيل أحمد بركات فرصة لاستكمال النظر إلى تجربته الشعرية وامتداداتها، وإلى تطور التجربة، وتحولاتها، خاصة وأن تجاوز ديوان ناجح، بحجم “أبدا لن أساعد الزلزال” كان مهمة صعبة.
وقد تم جمع قصائد “البدايات”، وتشمل الفترة من 1979 إلى 1983. هي قصائد صارخة، وإن لم تكن حماسية، تحمل وهج التجارب والصيحات الشعرية الأولى، وتنطق باسم “الصوت المتمرد”، كما هو عنوان أول قصيدة للشاعر، وهي “قصة العجلة والصوت المتمرد”. ومنذ أول كلمة في العنوان، يتأكد الالتباس، ما بين القصة والشعر. على أن بركات هو شاعر قصيدة النثر الخالصة في المنجز الشعري المغربي.
في هذه القصيدة تمرد صريح على ما يسميه الشاعر “قانون الصمت الصارم” و”قانون الصمت المحكم”. وفي قصيدة أخرى من هذه المرحلة، وهي قصيدة “هجرة الألم إلى عينيك الرافضتين” يخاطبها الشاعر، هي المرأة أو القصيدة أو الريح أو الثورة منشدا: “أيتها الثائرة ضد معالم الصمت الرافضة”. ويعود الشاعر ليُصَدِّرَ قصيدة “الناقوس” بعبارة حاسمة “الخروج من دائرة الصمت، أو تحطيم هذا الجدار الذي يقسمني نصفين ويفصلني عن الفرح”.
وكان ناقد عراقي هو عبدالقادر جبار قد انتبه إلى ما يسميه “شعرية الرفض” عند بركات، وهو يتناول تجربة بركات الشعرية في كتابه النقدي “غربة النص”. بل يمكن القول إن بركات إنما كان يكتب قصيدة الرفض، وهو يعلن في إحدى قصائده الجميلات، والمهداة إلى جميلة: “هذه فاتحة الرفض أكبتها!”.