أرستيبوس القوريني فيلسوف مذهب اللذة المقموع لم يتردد في ارتداء ملابس امرأة
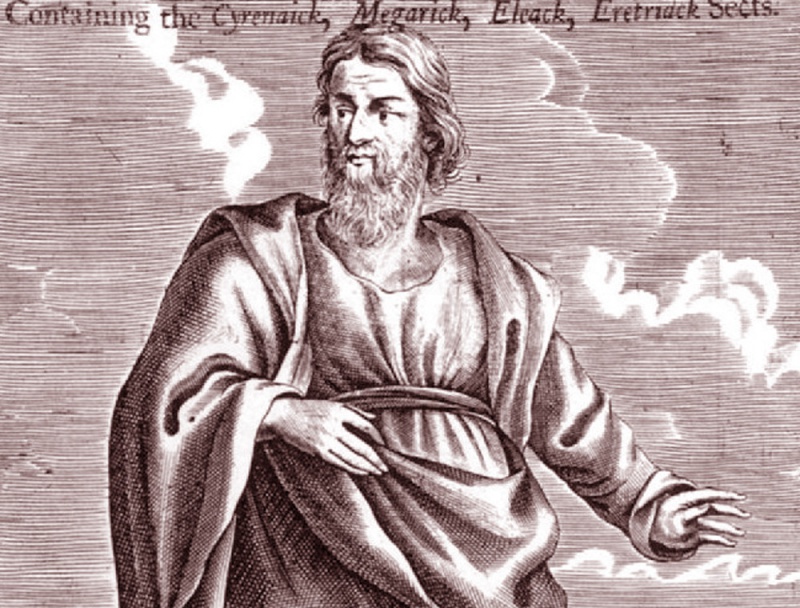
في عالم الأفكار اخترع اليونانيون كل شيء. ومن بين اختراعاتهم المنسية هناك تيار المتعة الذي يطرح تحقيق اللذة كهدف أساسي للحكمة ويسمى “قورينا” لأنه تطور في “قورينة”، مدينة تقع شمال أفريقيا (الآن شحات في ليبيا)، حيث كانت ليبيا مستعمرة يونانية. وهناك اجتمع فلاسفة قورينا حول أرستيبوس القوريني فيلسوف مذهب اللذة وأحد المعاصرين الناقدين لأفلاطون الذي تعرض للنبذ.
عاش فيلسوف مذهب اللذة أرستيبوس القيرويني، في القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد، وهو رجل خيالي لم يتردد في ارتداء ملابس امرأة، واللجوء إلى النكات لجعل جمهوره يفكر ويتفلسف بشكل أفضل. وقد تعرض لانتقادات واسعة النطاق، حتى مصداقيته من قبل جميع الفلاسفة الرسميين، منذ بداياته وحتى يومنا هذا، لكن مع ذلك سمح لبعض المفكرين بتطوير مذهبهم الخاص.
وفي هذا الكتاب “اكتشاف اللذة.. شذرات قورينية” للفيلسوف الفرنسي ميشل أونفري يقدم رؤيته للمدرسة الفلسفية القورينية وتطورها حول فن المتعة والهجوم والتعتيم الذي طال مؤسسها، ثم يترجم جانبا مما بقي من شذراتها. ومن هنا يمكننا أن نكتشف نظريات هؤلاء الفلاسفة حول المال، والحب، والسلطة، والعلاقات مع الآخرين، مع الذات، مع الآلهة، مع النساء، إلخ. وتتيح رؤية/ مقدمة ميشل أونفري كشف وضع هؤلاء المفكرين وأطروحاتهم في السياق الفلسفي والتاريخي والأيديولوجي وقتئذ، حيث يعيد أونفري عبر هذا العمل إحياء قارة مغمورة من الفكر اليوناني.
الفلسفة المقموعة
الحضارة الغربية وكياناتها القلقة قمعت الفلسفة القورينية، فرقدت تلك الفلسفة في قاع أطلانطس الذي يصعب استكشافه
يقول أونفري في كتابه، الذي صدر أخيرا عن دار نينوي بترجمة العراقي كامل العامري، “بعد 25 قرنا من الاختفاء الجسدي لأرستيبوس القوريني، ظلت الببليوغرافيا الفرنسية صامتة على نحو غير طبيعي عن هذا الشكل الأساسي من الفلسفة القديمة. لا شيء يذكر عن هذه الشخصية أو عن عقيدته، ولا شيء عن أتباعه أو المدارس التي تشير إليه. عندما يظهر اسمه، فإنه يستخدم كأنموذج للمتعة السهلة، وبقليل من البذاءة، والابتذال على نحو غامض. إنه يبدو نوعا من الأشخاص الغلاظ إلى درجة أن هذه النزوة أو تلك من الرقص المتنكر في زي امرأة يفوح منها العطر، من شأنها أن تمنع من حسبانه فيلسوفا جديرا بهذا الاسم. ليس في وسع المتنكر بزي امرأة وهو يتمايل في سحابة من الروائح أن يحتل مكانة بارزة في مجمع المفكرين الذين تعتمدهم الجامعة أو المؤسسات التي تقلدها”.
ويضيف “كان القورينيون نشطين بين القرنين الخامس والثالث قبل الميلاد، وأنتجوا شخصيات من أمثال أنيقريس، هيجيسياس، تيودوروس، وأنتيباتروس.. وتيارات من الفكر، كان لها تأثيرها في الأفراد لما تتسم به من طابع تشاؤمي بقدر تأثيرها في مذهب المتعة القوريني؛ يحفظ ديون المتحول، وبيون بوريستينيس، وأبيقور وأسرته بعلاقات وثيقة معهم. على الرغم من حيوية هذه الحساسية، لا يوجد شيء في المجال الببليوغرافي لإثبات ذلك”.
ويشير إلى أن قلة المطبوعات التي تجمع المقتطفات والشهادات تسهم في تكثيف الصمت والجهل، ثم نسيان القارة المغمورة. ويؤدي الغياب في المكتبات العامة إلى عدم وجود أي مكان آخر حيث يجب إجراء أعمال التنقيب: الجامعات والمدارس ومراكز البحث والأماكن الأخرى المصرح لها بممارسة علماء الآثار في هذه المدن المشعة والمختفية. لا توجد حلقات درس أو ندوات أو أطروحات أو كتب أو دراسات معتبرة. ظروف البقاء مفقودة، فكيف يمكن للحياة أن تجد طريقها؟
ويؤكد أونفري “لن نجد في السديم القوريني عقيدة متامسكة مبنية بطريقة حصن منيع، لذلك من العبث البحث عن مفاهيم لافتة للنظر، مطلية بالذهب الخالص، مثيرة للإعجاب أو مثيرة للخوف، وعن رهانات ذات عمق واضح، سوف نبحث من دون جدوى عن تطورات مستعصية ومرهقة، وغير قابلة للهضم، وعن خطاب خادع ومراوغ، ومنطق عرض مدرسي وقوطي، ولن نكشف عن شخصية مفاهيمية قادرة على ضمان الطابع المعاصر. تلك هي خيبة الأمل لدى أنصار التقليد والانتماء النقابي”.
القورينيون يريدون الاستقلالية وحاولوا سن قوانينهم الخاصة، من دون الاهتامم بالقواعد الجماعية التي تنظم العلاقة بين الآخرين
ويثبت أنه على نقيض طريقة التفكير القديمة، يجسد أرستيبوس القوريني تقليدا يشهد على طريقة وجود وفعل وتفكير قادرة على تقديم أنموذج، يدل ولا يهتم بالبرهان، يجسد ويضيف إليه في التجسد، لأنه لا يكترث للابتعاد عن الواقع الحي، ويمارس تجريد الجوهر، ليمنح نفسه جوا مهما لمعالجة الكلمات أو بهلوانية الفعل، يتحرك، يأتي ويذهب، يتكلم، يتساءل، يختار الساحة العامة، والهواء الطلق. يفتح الفلسفة على العالم الخارجي، ولا يحتفظ بها للاختصاصيين والأطباء والعلماء الآخرين في مكاتبهم، إنه يلتمس بائع الخضراوات والإسكافي والمحظية والبحار، والأمير أيضا، ويسخر من محادثة تدور بين الفلاسفة. يمنعه الكثير من الغطرسة وما هو غير مناسب لأوانه من المشاركة في مجمع الآلهة الذي فيه يسترخي أفلاطون وأرسطو.
ويلفت إلى أنه من الغريب أن أرستيبوس (نحو 435 – نحو 350 قبل الميلاد) يظهر كفيلسوف من القرن السادس قبل الميلاد، ومن الواضح أن صورته تترك الكثير مما هو مرغوب فيه. كان أرستيبوس قد استجاب لأدنى نزوات ديونيسيوس عندما كان في سرياكيوز. لكن، يجب على المرء أن يكون على استعداد فردي لرسم الصورة التي تتوافق مع الفكرة التي يمتلكها عن فيلسوف مذهب اللذة ليحافظ على واقعه في مثل هذا الاحترام المتدني له. ولأن أيقونة الإنسان الشره ليست أكثر إثارة للاهتمام من أيقونة مدعي الجمال، كما أن أيقونة الشخصية الفظة ليست أكثر من صورة الرجل ذي الأخلاق الرفيعة، فالخنزير ليس أفضل من الساحر، ولا ذو الثياب المعطرة أفضل من ذي الطبع الباحث عن الملذات.
يمكن أن تنبه الكراهية لا الانبهار، المحاباة لا الاستياء، ولاسيما أن هؤلاء المثقفين والأيديولوجيين يستغنون مسبقا عن الانتقال إلى النص الوحيد الموثوق: أين، وفي أي نبذة يمكن لأرستيبوس أن يشبه حيوانا متوحشا، وهو يؤكد على ضرورة الاعتدال في الشهوانية، ووجوب القياس في الملذات؟ في ضوء أي شهادة يمكننا تحويله إلى فاسق وفاسد وشره، عندما يظهره النص يحتفل بالزهد، والسيطرة على النفس، والاستقلال، والهيمنة الدائمة للذات على الذات؟
ويوضح أونفري أن نسيان وفقدان الثقة، وهستيرية أرستيبوس والقورينيين تكشف عن أعراض القمع في تاريخ الفلسفة الغربية، من قمع وعصابية. في هذه الحالة، فإن رفض الجسد، الذي يفهم دائما بأنه عدو الروح، يعوق متعة الاتحاد المحتمل مع المبدأ السماوي، سواء كان ذلك في شكل فكرة، أم في صيغة الرجل الصالح، أم في صيغة إله الموحدين.
ويتابع “لقد أنتج الجسد المكبوت حضارتنا في شكل عصاب متسامح تاريخيا، أي أن كراهية الجسد الأفلاطونية، والعبادة التي يؤديها المسيحيون إلى حافز الموت والاستخفاف الشامل بالدنيا، ثم اللعن الذي أطلق على الرغبات البشرية، كل ذلك أدى إلى تحول قسطنطين، وإلى تحول الإمبراطورية بأكملها إلى مباهج المسيحية، وهذا كاف لإبقاء مذهب المتعة تحت السياط. تلك هي عدالة المنتصرين. لقد قمعت الحضارة الغربية وكياناتها القلقة الفلسفة القورينية، فرقدت تلك الفلسفة في قاع أطلانطس الذي يصعب استكشافه. إن الدوكسوغرافي (وجهات نظر الفلاسفة والعلماء السابقين) يتعامل في المقام الأول مع الأفكار الأقل خطورة، أو الأقل حسما وراديكالية وتخريبية. ليس من المستغرب إذا أن نرى ميتافيزيقيا ما قبل سقراط تفتح الأقفال البيبليوغرافية وتغلقها اللامبالاة الساخرة ـ قبل أن نعد أرستيبوس الشهواني عضوا شرعيا في صفوف الفلاسفة اليونانيين الذين يستحقون هذا الاسم”.
خصوصية فكرية

يرى أونفري أنه في الضد من أفلاطون وزملائه من الأكاديمية، افتتح أرستيبوس وأنتيستنيس (فيلسوف إغريقي وتلميذ سقراط) وحلفاؤهم طريقة تعتمد على مسرح الشارع أكثر من الاعتماد على مدرج الجامعة. وهنا الساحة العامة المفتوحة بدلا من المساحة المغلقة، والظاهرة المرحة بدلا من التقشف الباطني، والكرم المبهج مقابل التلقن النخبوي، والضحك والفكاهة لتحل محل الأسلوب المدرسي، فهي تفترض مسبقا توسيع خشبة المسرح إلى الحياة وتحويل الواقع إلى كوميديا ارتجالية.
ويضيف “إن الفيلسوف الفنان مقابل الفيلسوف الشرير، والبهلواني والمهرج مقابل الكاهن والأستاذ، والسيرك مقابل الجامعة.. يا لها من ريح منعشة ومنشطة تهب على الساحة العامة المفتوحة. إن أرستيبوس قد شن حربا على أفلاطون من خلال تركيز اهتمامه الفلسفي على الواقع المحسوس وحده: الحياة، الجسد، اللذة، الرغبة، الجسد، التجسد، والحياة اليومية. على عكس أفلاطون الذي حول العالم المادي إلى نقطة انطلاق للوصول إلى الأفكار. فعنده، مثلا، يكون الجسد ذا قيمة فقط بقدر ما يتلاشى ويتحول بعد استخدامه كنقطة انطلاق نحو الجميل في ذاته. إن إدعاء أرستيبوس هنا، والآن، بالآنية الملموسة، وإرادة الاستمتاع التي تحولت إلى توتر أساسي يضعه في مواجهة أفلاطون. كان ديوجينيس يقول عنه: ‘كلب ملكي’، كلب مزيف في هذه الحال، في مواجهة عدوه وخصمه مدى الحياة”.
ويقول “لا يحب القورينيون سوى الأخلاق. من وجهة نظرهم، لا تمثل الفيزياء والرياضيات وجميع العلوم أي أهمية بالنسبة إليهم، الشيء الوحيد المهم هو الحياة الناجحة. ومن هنا جاءت العدمية المعرفية المؤكدة بوضوح، يليها تركيز كل الجهود الفلسفية على مسألة الحكمة العملية والأخلاق القادرة على توفير قواعد للحياة، ومؤشرات وجودية، وأسباب واضحة للسلوك السليم. فالفيلسوف لم يعد يهتم بالأفكار المحض أكثر من اهتمامه بالأرقام. إنه لم يعبأ بخرخشات طفل تثير فيثاغورس، أو الأفلاطونيين وورثتهم حول هذا الموضوع، كما تثير كثيرين غيرهم”.
ويتساءل “ما هدف الفلسفة؟ أن تعيش عيشة ملائمة. كما هي الحال في كل ما يسمى بالمدارس الهلنستية – الرواقية، والأبيقورية، والكلبية ـ لا نفكر لأجل التفكير، لا نتفلسف لأجل المتعة النرجسية المتمثلة في التلاعب بالمفاهيم التي لا يمكن فهمها أو الكلمات الفظة أو المفاهيم المشوشة، لكن لأجل تحويل وجودنا، لجعل حيواتنا عملا متماسكا، لإنتاج أسلوب وجودي، لتجسيد تفكيرنا في الحياة اليومية، وتاليا الوصول إلى أدق التفاصيل: في الملبس والجاذبية، والمظهر لكن أيضا في الحركات والكلمات والأفعال والصمت والانسحاب والامتناع”.

ويشدد أونفري على أن الفلسفة يجب أن تصيب أدنى فجوة في السيرة الذاتية، فهي تبعث روحا وشفيعا وثنيا يمكن التعرف إليه في دقائقه الصغيرة، وتتجلى في متناهية الصغر. وأرستيبوس يشهد على ذلك. يريد القورينيون الاستقلالية، بالمعنى الاشتقاقي: القدرة على سن قوانينهم الخاصة، من دون الاهتامم بالقواعد الجماعية التي تنظم العلاقة بين الآخرين. فالرجل الحكيم يتمتع بالاكتفاء الذاتي فهو لا يعيش بالوكالة، ويتشبث مثل الطفيلي بتخيلات المجتمع، وهو يمتص اللب من الأساطير المجتمعية ليمنح نفسه تناسقا وهميا، فهو لا يحتاج إلى أمر متسام خارجي بالنسبة إليه، إذ سبق له أن أطاع أمرا جوهريا خاصا به، أخلاقيا ومستوجبا. يريد أرستيبوس أن يكون حرا ومستقلا عن كل شيء: بما في ذلك المتعة، على عكس ما تعكسه الرسوم الكاريكاتورية المعتادة عنه – عبدا لجسده وعواطفه ورغباته ودوافعه.
ويتابع “لا يريد أرستيبوس أن يتألم، أو بالأحرى يريد أن يستمتع. يكمن تفرده في هذه الخصوصية: فهو يتخطى اتباع نهج الازدهار والرفاهية Eudémonistes الذي يكتفي بالمتعة السلبية (تجنب الألم، المعاناة، وبناء حياة المرء لتجاوز ما بين أدنى حاجاتها) أو متعة باهتة للغاية، بل لا لون لها، لاستعادة المتعة والشهوة والمرح. لهذه الغاية، وعلى النقيض من حسيته النظرية، يعيد الجسد إلى كرامته الكاملة: الجسد الذي يأكل ويشرب ويتعطر ويلبس ويفكر، ويتدلل ويتأمل، جسد يتجاوز أي تسلسل هرمي بين الملذات المواتية والسيئة، ويريد أيضا طاولة ممتازة عليها زجاجات رائعة ومحادثة فلسفية على ساحة أغورا: هي ساحة دائرية كان المزارعون في أثينا يلتقون فيها منذ عام 406 ق.م، لكنها لم تكن حكرا عليهم بل كانت موضع التقاء الفلاسفة تليها كتابة كتاب. كي لا يعاني، وكي يبني استقلاليته الذاتية، لا يوجد شيء مثل التحرر من السلاسل المعتادة: العمل والأسرة والوطن. لقد أوضح أريستيبوس أن معارضيه لم يكونوا ليهتموا به قدر الإمكان، ولم يكن لديهم حب العامل، مثلهم مثل جميع اليونانيين، يفضلون الأوتوم ـ مصطلح لاتيني يغطي مجموعة متنوعة من الأشكال والمعاني في مجال وقت الفراغ ولم يشعروا بأنهم ينتمون إلى هنا أو هناك، ولا يعتمدون على شيء أو على أي شخص: هذا كله ما كان يدور حول مذهب اللذة. لذلك نظرا لأنه لا يضع شيئا في الحسبان فوق حريته، فإن القوريني لا يجد نفسه مطلقا منغمسا في الولاءات الدينية والسياسية والاجتماعية والمجتمعية. إنه يصنع شخصيته الفردية مثل نحات حريص على استخراج شكل جديد من كتلة من الرخام الخام.
ويوضح “كي لا يكون عبدا وشيئا من الملذات يحول أرستيبوس اللحظة إلى نقطة مفعمة بالمتعة وشبيهة بالماس ليعيش في جوهرها، وإلى تجربة على نحو مطلق. لا يلوث اللحظة بذكرى الماضي أو بمخاوف من مخاطر المستقبل. في الكثير من الأحيان يفسد الحاضر بسبب دخول الطاقات السيئة فيه، القادمة في خط مباشر من الماضي أو المستقبل: ذكريات سيئة، آثار باقية من الأمس أو اليوم السابق. حتى القلق بشأن الغد وما سيأتي بالتأكيد. إن الزمن الحاضر وهو عالق ما بين الزمن المنقضي والزمن غير الموجود، يستطاب مثل خمرة فاخرة وثمينة. من خلال الظهور بمظهر تجبره فيه نزوات التمثيل وحدها على ابتكار خيال مضى ووقت ينقضي، يكتفي الرجل الحكيم بإعطاء، هنا والآن، قوة سحرية رائعة؛ فبعد تحرر الفيلسوف من واجباته في ما يتعلق بالزمن السابق والزمن الذي يليه، وكلاهما غارق في المادة التي تصنع منها الأحلام، يكتسب إمكانية الوصول إلى بعد غالبا ما ينسى، ويهمل في معظم الأوقات: أن يستوطن اللحظة، ويستقر في الآنية، ولا يقلق بشأن الماضي والمستقبل اللذين يستمدان وجودهما واتساقهما من المعرفة الوحيدة التي تزود العقل بالحواس أو بالذاكرة والإبداعات العقلية الخطرة. إن العمل على هذه التخيلات يفتح مجالا من الاحتمالات ويترك الطريق مفتوحا لأهواء المتعة. سيتذكر أبيقور ذلك، ويخلق علاجه الرباعي بدءا من هذه البديهيات القورينية: لا تخف الآلهة، لا تخش الموت، وتعلم أن من الممكن الوصول إلى السعادة وتسكين الآلام. لا يمكن النظر في دستور الأدوية هذا القادر على علاج آلام الحياة إلا من منظور النظرية الآنية الأريستبيوسية المحدثة: في اللحظة عينها، ليس للآلهة مكان في هذه اللحظة حيث هم، إذا كانوا – خارج الزمن – ليس لديهم اهتمام بالبشرية كن مطمئنا، الخلود والحاضر لا يحافظان على علاقة حسن الجوار. والشيء نفسه مع الموت، الذي لا يمكن لنا أن نخافه، فطالما أننا موجودون فهو غير موجود، ولم القلق بشأنه إن لم نكن نتطلع إلى المستقبل؟ وحينما يحدث ذلك، لن نعود في وضع يسمح لنا بتجربة أي ألم افتراضي”.






















