القصة القصيرة أكثر قدرة على العبور من الرواية وقصيدة النثر والمقالة
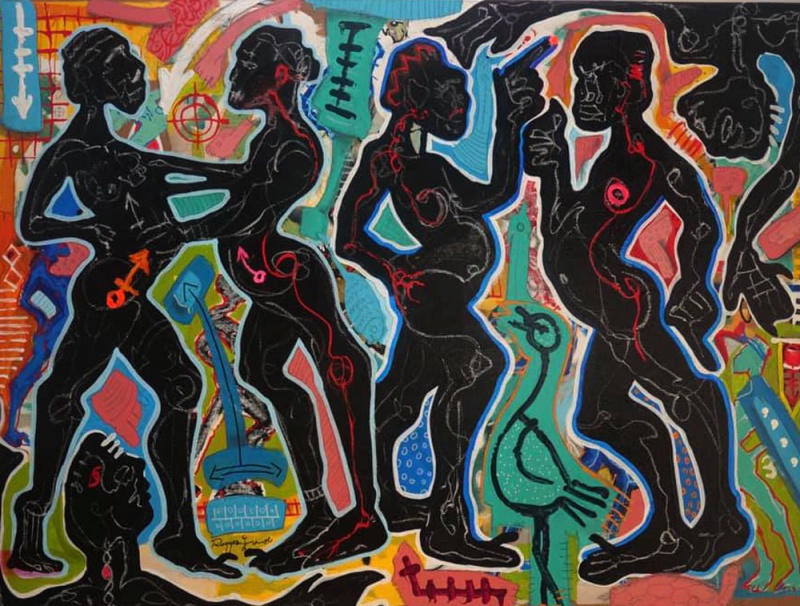
يعدد ويكرر العديد من النقاد مسألة انتهاء الأجناس الأدبية أو اندماجها وتداخلها وتجاوزها للتصنيفات التاريخية والنقدية والفكرية الصارمة التي حكمتها، متناسين أن هذه التصنيفات لم تمنع من ولادة أجناس جديدة، كما لم تسمح بانتشار الفوضى الكتابية وحافظت على كل جنس دون أن تعيق انفتاحه على مناطق من أجناس أخرى. وهنا نحلل نظريات العبور الأجناسي وحدود التصنيفات التي حافظت على قوتها رغم الزمن.
تعد دراسة الأجناس الأدبية عملا تصنيفيا بينما دراسة الجنس العابر هي تحليل لعملية التصنيف نفسها كشفا عما في الجنس العابر من أنظمة وعلاقات، تعمل بكفاءة فيه، لا في غيره من الأجناس والأنواع والأشكال الأخرى. وصحيح أن التصنيف ثابت كإطار وحدود، بيد أن أركانه ستتقوى وتزداد تماسكا بالعبور. ولقد تساءل أوستن وارين: هل تبقى الأجناس ثابتة؟ وأجاب ربما لا، لأن بإضافة أعمال جديدة تنزلق مقولاتنا.
وعلى الرغم من حديثه عن رواية “يوليسس” بأنها تجمع الملحمة الشفهية والأدبية بالإلياذة والإنياذة وما حدده في “أوبرا الشحاذ” و”أليس في بلاد العجائب” من وجود نوع سماه الأدب الرعوي، فإنه وجد نفسه مضطرا إلى أن يعود مجددا إلى أرسطو، المرجع الكلاسيكي لنظرية الأجناس، مؤكدا أن المأساة شيء والملحمة شيء آخر؛ وأنهما متميزتان ورئيستان لكن النظريات الأدبية الحديثة هي التي تريد طمس التمييز بين الشعر والنثر.
التصنيف يفرض نفسه
معايير التجنيس الأدبي ليست فرضية قابلة للدحض بل حقيقة يؤكدها الاختبار ويدلل عليها نقاء الجنس واختلافه النوعي
إذن فالتصنيف أمر حتمي وأي محاولة لتناسيه أو إلغائه ستؤدي إلى الاضطراب بين اكتشاف ورصد أنواع كتابية شعرية وسردية جديدة وبين الرضوخ لمقاييس التصنيف الأجناسي. وهو أمر لم يقع فيه أوستن وحده، بل معه العشرات من الدارسين لقضية الأجناس الذين تباينت مقترحاتهم وتعددت مصطلحاتهم ومقولاتهم في سبيل وضع نظرية نهائية لعملية التصنيف الأجناسي.
افترض ناقدان مهمان هما هوبزارسكين وجاكوبسون وجود علاقة في تصنيف الأجناس بين مورفولوجيا اللغة والموقف من الكون كحضور وغياب وتكلم، ولو كأجزاء مكونة ترتبط ربطا متنوعا، وافترض غيرهما وجود اختلاط بين الأجناس ومن ثم لا حدود نهائية يمكن القول بها، فالرواية مختلطة لأن فيها الحوار الخارجي والمشاهد الدرامية كما أن المسرحية مختلطة، فيها مخرج وصانع ديكور ومهندس إضاءة.
ولعل آخر الافتراضات وأكثرها تداولا اليوم هو أن لا نقاء في الأجناس الشعرية والسردية عملا بمبدأ الانفتاح الذي وضعه نقاد ما بعد البنيوية منطلقين من أن التهجين والتداخل والتناص أمر واقع لا محالة، نافين وجود غلبة أو تفرد لجنس على جنس. وهو ما فتح المجال أمام كثيرين كي يفكروا في ابتكار أجناس جديدة كما أتاح لآخرين التحرر من ثوابت التصنيف الأجناسي ومفاهيمه الجمالية.
التصنيف أمر حتمي وأي محاولة لتناسيه أو إلغائه ستؤدي إلى الاضطراب في اكتشاف ورصد أنواع كتابية جديدة
ومهما يكن أمر تناسي الصنفية أو الانفلات من التجنيس، فإن التصنيف يظل يفرض نفسه. ليس لأن أرسطو وضع أساسات لا مجال للقفز عليها فحسب، بل لأن مرحلة الانفتاح النصي انتهت ومعها انتهى الانبهار بأمر التناص والتعالق النصي، فدخل النقد الأدبي في مرحلة جديدة ما بعد كلاسيكية تستند في مرجعياتها إلى الرعيل الأول من النقاد الجدد الذين تمسكوا بالنظرية الأرسطية ورفضوا فكرة عدم النقاء تهجينا وخلطا وتداخلا.
وإذا كانت نظرية الأجناس قد نالت اهتماما جديا من لدن نقاد القرنين التاسع عشر والعشرين، فإن نقاد القرن الحادي والعشرين أعادوا إلى هذه النظرية أهميتها، وطرحوا رؤى تعطي الاعتبار لتصنيفية القوالب ونقائها. وعلى الرغم من ذلك فإن هناك مآخذ على عملهم، منها: أولا أنهم لم يضيفوا إلى نظرية الأجناس ما يعزز موقفهم في رفض التهجين والتداخل بين الأجناس. ثانيا أنهم لم يوضحوا كيف يمكن لقصيدة مرثية أو قصة تاريخية أو مسرحية شعرية أن تكون مصنفة أجناسيا بقالب محدد.
ثالث مأخذ هو أن بعضا منهم تجاهل المعطى التاريخي والبناء العقلاني لجنس القصة القصيرة وراح يقول بولادة جنس جديد سماه حلقة القصة القصيرة أو الكتاب المفتوح. أما المأخذ الرابع فيكمن في أنهم لم يوضحوا مدى تأثير الموضوع وأسلوب التكنيك في طريقة بناء القالب وتقويته أو بالعكس إضعافه وتفتيته.
معايير التجنيس الأدبي

لا مراء في أن نظرية جوليا كريسطيفا في التعالق النصي التي هي استكمال لنظرية باختين في الكرنفالية والحوارية كانت تصب في باب التنظير للنص وليس الأجناس، غير أن تركيزها على فاعلية تعالق النص بغيره من النصوص هو الذي عده بعض النقاد مسوغا للقول باللا تجنيس أو عدم نقاء الأجناس مفندين بذلك الصنفية والنظامية معا. وقد تلاقت توجهات كريسطيفا مع توجهات تودوروف وبارت في الميل إلى اللا تجنيس مع أنهم لم يقولوا صراحة بذلك لأسباب جمالية وتاريخية.
ولا يزال التضارب ما بين القول بتصنيف الأجناس من جانب وتداخلها من جانب آخر مستمرا، ومعه تكثر الابتداعات بلا معاينة نسقية ولا اكتراث منهجي، فنجد نقادا يتحدثون عن الرواية التاريخية والتخييل التاريخي والتخييل الذاتي وقصة الأطفال بوصفها أجناسا أدبية، ونقادا آخرين يعدون تقانات وأنماطا من قبيل المتوالية والحوارية والنص الموجز أو القصة القصيرة جدا أنواعا مستقلة.. وهلم جرا.
وما من نظرية تشرح حقيقة ما يجري في عالم الأدب من ابتداعات أو تضبط المسافات الحدية ما بين الأشكال والتكنيكات والصيغ والأنماط كما لا فرضية ناجزة تدافع عن الصنفية ونقاء الجنس الأدبي وتراتبية الأجناس نفسها ودوامها وما يجري داخلها من تطوير وإضافات.
وعلى الرغم من كل ما تقدم، فإن للأجناس سلطة تفرض نفسها على من يتمعن في عقلانية ابتداعها ومنطقية نموها وقوة قالبها. ومن تبعات هذه السلطة النظر إلى العبور قوة صنفية تملي على دارس الأجناس أن ينظر إلى تاريخ التنظير بدءا من أرسطو وهوراس ومرورا بنقاد العصر الحديث. وبغيته الوقوف على أسباب عدم تمكن أشكال ذات تاريخ قديم أن تثبت صنفيتها الأجناسية مثل المونودراما أو المشجاة أو الحوارية أو القناع التي بقيت أنماطا داخل جنس قار هو المسرحية وكيف أن تعدد الأشكال التي بها يكتب الشعر الغنائي كالسوناتا والأدعية والأناشيد أو الأهزوجة لم يلغ أجناسية هذا الشعر.
التضارب ما بين القول بتصنيف الأجناس من جانب وتداخلها من جانب آخر مستمر ومعه تكثر الابتداعات
معايير التجنيس الأدبي ليست فرضية قابلة للدحض، بل هي حقيقة يؤكدها الاختبار الكمي ويدلل عليها نقاء الجنس واختلافه النوعي. وما عملية العبور الأجناسي سوى أمر حاصل بمعايير التصنيف أولا وجدوى فاعليتها آخرا. ومن ثم لا تخلخل أو تقلقل أو تداخل وإنما هي غلبة جنس يحافظ على حدود قالبه ويزداد قوة بما يحققه من عبور على غيره من الأجناس الأدبية.
فالرواية جنس عابر بقوة الامتداد التاريخي الذي ورثته من جنس الشعر الملحمي الذي بدوره ورثه من الحكاية الخرافية. وقصيدة النثر جنس عابر لقوة الأصول فضلا عن الارتكاز على القاعدة التي منها نشأت كل الأنواع والفنون أعني السرد الذي هو فن شأنه شـأن الشعر. وأي نوع أو أسلوب أو موضوع شعري هو منصهر في قالب قصيدة النثر، هجائيا كان أم غزليا، قصيرا كان أو مطولا، رباعي التفعيلات أو بلا تفعيلات، على طريقة الرومان والإغريق أو على طريقة اليابانيين والإيطاليين.
وقد يذهب الظن إلى أن الاستمرار في النظم على وفق أشكال وأنواع يمنحها شرعية أن تكون أجناسا أو يؤهلها لأن تكون عابرة، وذلك ممكن في حالة أنها أثبتت تاريخيا قدرتها على الاستمرار في موازاة الجنس راسخة كرسوخه، وعندها ستتأكد قابلية الشكل على أن يكون نوعا ثم قابلية النوع لأن يكون جنسا.
والقصة القصيرة أطول الأجناس تاريخا مما يعطيها قوة وقابلية فنية على العبور حتى على الأجناس العابرة كالرواية وقصيدة النثر والمقالة. فالبعد التاريخي عادة ما يكون في صالح المستوى الفني للانعطاف النوعي الذي يعطي الفن وجوده ويجعله مستمرا. وما من استمرار لفن من دون أن يشهد تحولات وتتشكل فيه انعطافات.
العبور الأجناسي

إذا كانت عصور الأدب قد شهدت شتى الأنواع الإبداعية الشفاهية والكتابية، فإن الدفاع عن واحد منها إنما هو دفاع عن خصائصه على وفق معايير جمالية حددها منظرو الأجناس وغايتهم البحث عن نظام في الكتابة وفيه نتعرف على الأصل ونميزه عن التقليد وندرك فاعلية الراسخ عن الآخر غير الراسخ.
وليس العبور سوى نظام من تلك الأنظمة التي تطورت مع الزمان وغدت حقيقة لا مجال لدحضها إلا عند من فرضت عليه فكرة اللا تجنيس نفسها أو كان تابعا يردد وجهة النظر الغربية في أن لا نقاء في الأجناس الأدبية.
إن العبور فاعلية وصفية لآلية إجرائية تجري على وفق قواعد وبمعايير معلومة فيها العابر محدد بينما المعبور عليه متعدد الأنماط والأشكال والأنواع حتى لا مجال لأي تهجين أو مزج أو تعالق أو تنافذ أو تداخل بين اثنين هما نوع وجنس أو جنس وجنس لأن ذلك ببساطة ينتفي، كما وضحناه آنفا، مع سمتين مهمتين في الأجناس هما النظام والصنفية.
وما من سبيل لإنتاج جنس جديد إلا على أساس هاتين السمتين اللتين بهما يكتسب النوع الشمول ويكون له غنى تاريخي يؤهله لامتلاك قالب خاص به. ولأن الفروع ليست كالأصول يبقى التقولب مسألة بعيدة الحصول إلا لماما ولا مشاعة بالعموم، وإلا ما كنا لنتحدث عن تميز واختلاف وتخصص وتصنيف. ذلك أن الجنس هو حصيلة اشتغال ابتكاري وإصرار به تتأكد عبقرية وأصالة تميزه قالبا بمميزات لا يشاركه فيها أي قالب آخر، أي تنتفى معه أي قواسم مشتركة في الحدود الأدبية. إذ لا وجود في معجم نظرية الأجناس لما هو مشترك أو تأليفي أو ما هو متقارب وبيني، فكل مسمى وموصوف هو مصنف بشكل نهائي وانغلاقي وحتمي وراسخ وشامل ومستمر.
للأجناس سلطة تفرض نفسها على من يتمعن في عقلانية ابتداعها ومنطقية نموها وقوة قالبها
أما العبور فخطوة إجرائية متممة للصنفية وبها يتم التجسير ثم الانتقال غير القابل للتملص من حتمية حصوله. فالعبور يمثل ـ بكل وضوح ـ جملة من العمليات الصياغية/ الأسلوبية والبنائية/ الهيكلية المفروغ من حصولها داخل قالب له من الثبوت والاستمرار ما يعزز قواعد تجنيسه الأدبي فيكون القول بعبوره حتميا ومنطقيا.
ويبقى الشكل الفني لأي جنس أدبي اشتغالا داخليا ويكون الإطار الخارجي صنفيّا تماما، به تترسخ قوة ذاك الاشتغال؛ فقالب القصيدة العمودية لا يستطيع الصمود أمام قالب قصيدة النثر بسبب ما لهذه القصيدة من سمات وخصائص تجعلها متمكنة من العبور. ولا تؤثر طبيعة الموضوعات وصيغ الكتابة والنظم في صنفية الجنس العابر؛ فبوشكين طوّر قصيدة التفعيلة بتناوله موضوعات هزلية، وأضاف مظفر النواب للقصيدة العمودية أوزانا وأطوارا شعبية لكن ذلك كله لم يؤثر في القيم المستخلصة والنظام النهائي لعبور قصيدة النثر كحاصل ناجز سواء على مستوى الابتكار الشكلي أو على مستوى التحديث الإطاري. فالعبور عملية تبدأ كتجريب غير مقصود وبمرور الزمن تصبح معقدة وحقيقية.
ولا خلاف في أن الرواية جنس نشأ من تطور حصل في نوعية كتابة القصة التي هي بدورها نشأت من تطور مجموعة أنواع كالمقامة والرسالة والمنامة والسيرة والرحلة والخبر والمفكرة اليومية والحكايات الخيالية والأنشودة والأغنية والمأساة والملهاة وغيرها.
بمرور الزمن ترسخ قالب الرواية حتى صار جنسا بينما عبورها كان مؤكدا بفاعلية استمرار إطارها قويا من الخارج وسائلا من الداخل مما أتاح له أن يهضم ويجسر ويحتوي ويعبر على القصة الرومانسية والرواية التاريخية والنفسية والبوليسية ويقيم صلات مع أشكال وأنماط فيصبغها بالصبغة الروائية.
من هنا يكون للعبور وجوب نظري في أن نقر به فاعلية واشتغالا يحصل على مستوى الإنتاج النصي السائل ويحصل أيضا على مستوى الرسوخ الإطاري الصارم. فالعبور عملية تحديث ميكانيزما التصنيف الأجناسي بدلالته النوعية وقطعيتها التي عرفت منذ القرن التاسع عشر. وفي هذا جواب على سؤال: كيف أمكن للأجناس أن تظل في هذا التحديد القسري بلا تكاثر أو تعدد مع أن الأنواع والأشكال تتناسل باستمرار؟
وليس مثل تاريخ الأجناس دليلا به تتوكد حتمية العبور على أساس أن الأدب ليس كتابة سائبة وأن التجنيس تشكله جملة معايير، تفترض لكتابة ما أن تكون في قالب خاص ومختلف. ومع القالب ينتفي الانفلات والتسيب والاشتراك والتقاسم وإلا ما كنا عرفنا الأجناس، ولا أعطيناها قيمة، ولا عددناها قضية من قضايا النقد الأدبي. وكيف تكون هناك قواسم والبعد التاريخي لا يقبل القسمة أو الاقتسام أو التشارك؛ أولا لأن التاريخ يكشف عن سلسلة تطورية فيها يبرز قالب موضوعي فتتحقق نوعيته بأبعاد معلومة، وثانيا لأن تاريخ الأجناس ليس بمفصول عن حركة المجتمعات والأفراد.






















