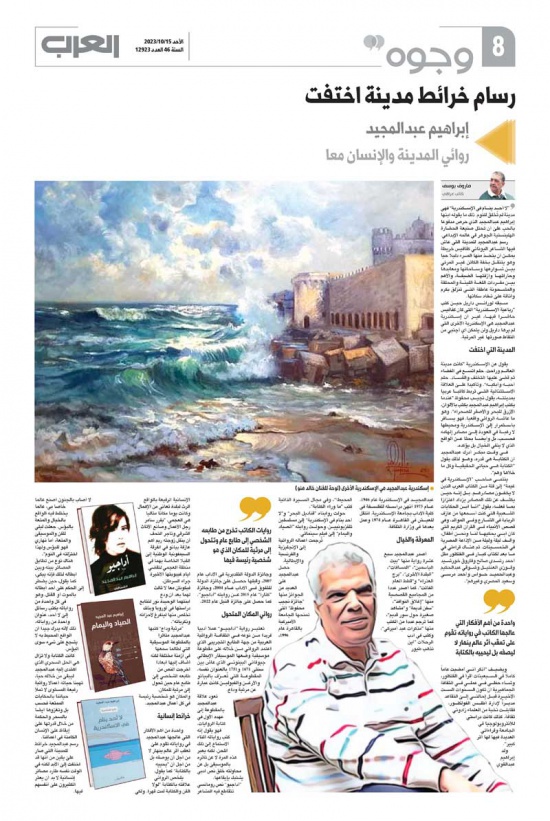روايات القرن الحادي والعشرين أمام مفترق طرق

السرد له تقاليده الفنية وأصوله الكتابية بدليل وجود أجناس منه بقوالب خاصة ومعلومة على مدى عصور من التدوين الأدبي، ولكن تبقى الرواية أهمها وأبرزها، بينما واجهت الأخيرة الكثير من المفاهيم المغلوطة، خاصة في ما يتعلق بعلاقتها بالخيال واللاواقع. كثيرون يردون الأصل في السرد إلى الواقع بينما ما هو غير واقعي يأتي لاحقا تاريخيا أو في التجربة الكتابية. ولكن ماذا عن انطلاقة السرد المبكرة في مجال الخيال واللاواقع من أساطير وخرافات وغيرها. ومن ثم إن دراسة قوالب الرواية اليوم تتطلب وعيا بمسارها.
ليس غريبا أن يكتب المبدع نصاً به يختزل العالم كله، ولكن الغرابة في أن يتمكن هذا المبدع من اعتماد نهج يسير عليه اللاحقون من بعده مقتفين أثره، فيترسخ النهج من خلالهم ويسود. ولا يتحقق مثل هذا النهج إلا بأمرين: الأول هو الخصوصية الذاتية كموهبة، والآخر هو الكلية الإبداعية كممارسة.
والجمع بين التحرر المتمثل في الخصوصية والاتباع المتمثل في الكلية هو الذي يمنح الأديب الحرية وفي الآن نفسه الهوية، فيكون في الأولى تابعا لإحساسه ويكون في الثانية تابعا لنظام جماعي ذي تراكمات خاصة ومحددة. ولا وجود لنظام ما لم يكن مستقرا، ولا استقرار إلا بوجود أساس متين وصلب يمنح النظام ثبوتا وقوة. فتكون القاعدة سابقة للنظام ويكون النظام حصيلة ممارسة ما انبنى على القاعدة من تقاليد بوصفها ممارسات وتجارب.
بناء قالب الرواية
الرواية فن قبل أن تكون جنسا أدبيا وهي في أصلها موجهة نحو فهم الواقع على حقيقته وليس الإيهام به
عمل النظام ليس كعمل القاعدة، لأنه لا يولد ممارسات قد تتخلق منها تقاليد، بل بالعكس هو يوجب الالتزام بما يتولد من ممارسة تلك التقاليد. وبهذا يكون الكاتب ملتزما بتمثل النظام في حين هو متحرر في تمثل القاعدة. وبهذا تظل القاعدة (اللاواقعية) هي ذاتها واحدة لا يؤثر فيها تغير الأنظمة السردية.
ولقد تشكلت القاعدة اللاواقعية للسرد العربي القديم من تراث زاخر سبقه، يعود إلى أمم غابرة، به تأثر العرب وعليه بنوا حكاياتهم وقصصهم بكل ما فيها من أشكال وثيمات وموضوعات. ومن خلال هذه القاعدة تراكمت ممارسات السرد عبر العصور حتى صارت من كثرة المداومة عليها “تقاليد”. فكان النظام السردي فعالا إلى درجة أن توضح قالب القصة العربية في مراحل متأخرة من الحضارة العربية وظلت اللاواقعية قاعدة هذا القالب حتى نهاية القرن التاسع عشر تقريبا. ولم يكن للقصة الأوروبية أن تتطور وتصير رواية إلا وهي تتخذ من اللاواقعية قاعدة متمثلة تقاليد السرد العربي. ولقد تطور النظام المتبع في هذا التمثل مع بناء قالب الرواية الذي ما كان ليغير القاعدة اللاواقعية وإنما هو خلخلها فبدا النظام الروائي واقعيا.
استمر القصاصون في أوروبا يطورون تقاليد السرد القديم لوعيهم بأهمية التجريب في الجذر الذي هو اللاواقعية. ولقد أثر ذلك في طريقة تعبيرهم عن العالم. فكان أن وقعوا على كتابة الرواية، ثم مال كتاب الرواية نحو نهج واقعي هو في الحقيقة ابتداع لنظام سردي يقوم على التقاليد القديمة وتطويرها وليس تغيير القاعدة الأصلية. ولا يكون السير على نظام مقعد الأسس ومحدد الخطوات مستمرا دوما، فقد يتحرر الكاتب منه باستلهام نظام غيره. ولا فرق في هذا، لأن التأسيس القاعدي يظل واحدا، أي لاواقعيا، سواء تنوع النظام أو لم يتنوع.
وعادة ما تجري المراهنة على التقاليد وليس القاعدة، فتكون الخلاصة تغيرا في النظام كممارسات فيها يتأثر المبدع ــ وهو يتمثل التقاليد ــ ببيئته وخصوصياته الجينيالوجية. ومن العناصر التي تأسست على اللاواقعية وانتقلت بالسرد إلى الواقعية مستلهمة تقاليد السرد العربي القديم “الخيالية” التي هي أكثر تقاليد السرد العربي أهمية، وقد ثبتت أوزار تمثلاتها منذ أن عرف الإنسان السرد، وبسبب ذلك امتلك السرد قاعدة صلبة تستوعب كل الأنظمة ومنها تخرج مختلف التقاليد.
اللاواقعية رهان إبداعي
من الغريب حقا أن ينظر النقاد إلى السرد الواقعي على أنه هو الأصل الذي منه انبثق السرد غير الواقعي
ليس الواقع سوى قشرة لا مجال لمعرفة ما بداخلها إلا بمحاكاتها بخيال يحطم المعتاد والمعقول من خلال تخليق ما هو غير معقول ومستحيل. فلا تطويق ولا انحباس في المخيلة الروائية التي تسعى إلى هدفها بمجازية شعرية. ومعروف أن اجتماع الواقعي بالخيالي يفضي إلى الإيهام الواقعي لكن انفراد الخيال لوحده يفضي إلى اللاواقعية التي هي واضحة لأن المؤلف لا يريد منها إيهاما أو خداعا أو تمويها، بل يريد ابتكارا تخييليا. وبهذا يتقارب السرد والشعر فما من تشكيك أو تفنيد، بل هي مجازية التعبير والتصوير.
ومعلوم أن أنظمة السرد يفرضها الإبداع وما يجري فيه من تجريب وتقليد، ولا يفرضها النقاد أو المنظرون وإنما تقع على عاتقهم مهمة التفكير في ميكانيزمية الإبداع ووصف عمليات التجريب فيها. ولقد كان الفلاسفة الإغريق أول نقاد الإبداع وهم بمقاييسهم المنطقية وضعوا نظريات في الإبداع وعناصره ومنها التخييل فحددوا له مواضعات جمالية وتفاوتوا في النظر إليه بمثالية أو قيمية أو أخلاقية. وقنن بعض المفكرين الفاعلية التخييلية من ناحية التسامي المثالي والغايات الأخلاقية وعدها بعضهم الآخر حرة كالسحر أو وسيلة في الفهم والإصلاح.
وعلى الرغم من ذلك، فإن واقعية السرد ظلت تفرض ضوابطها على الكتاب الأوروبيين في أن ما يبرمجونه أو يقننونه سيصب في باب وعيهم الذاتي بالأشكال حتى وقعوا في أزمة الكتابة الروائية. ولم ينج من الأزمة سوى الكتاب الذين عادوا بالسرد إلى قاعدته اللاواقعية، نافرين من نمطية الضوابط ومتمردين على علاقة السرد بالواقع فرفضوا الرضوخ لمواضعات التخييل واستعاضوا عن الإيهام الواقعي بالخيالية كتقليد سردي كان سائدا في روايات القرنين السابع عشر والثامن عشر، وفيها انصب الاهتمام على التخييل وتشكيل الكلمة المنطوقة مع اختلاف الضمير المرتبط بها.

بيد أن الاكتراث ببناء الشخصية والاهتمام بملفوظاتها وأن تكون مجتزأة من محاكاة واقع ما، جعل للشخصية مركزية في البناء السردي فتغلبت النزعة الواقعية على السمة التخييلية. وبسبب هذه النزعة تمتعت الشخصية بالاستقلال الصوتي في الرواية متعددة الأصوات وبدت هي صانعة العمل الروائي، أي تصنع مصيرها بنفسها، ولا دور للسارد يمارسه عليها. فصارت الشخصيات كيانات لفظية وأصبحت الأشكال والأساليب هي موضع المعالجة، ففقد المؤلف حريته وتنازل عنها كي يضمن لشخصياته واقعية وبأبعاد سيكولوجية فيها خضوع تام للزمان والمكان، يجرد الرواية من فاعليتها في فهم الواقع على حقيقته بعيدا عن الإيهام والمحاكاة.
ولكن ذلك لا يعني انعدام عنصر التخييل، بل هو حاضر لكن تحت ضغط الواقع الموضوعي، ومثلما أن المؤلف لا يستطيع أن يتحاشى النظر الخيالي إلى هذا الواقع فكذلك لا يمكنه أن يتحاشى السير على تقليد الخيالية واستمداد أبعادها من إرث سردي بكل ما فيه من شخصيات خرافية وأحداث أسطورية. وهو أمر ينطبق على الشعر أيضا فالقصيدة الكلاسيكية لها خياليتها كتقليد يرتكن إلى نزوع مجازي في التعامل مع الواقع؛ فالخيالية في قصيدة مثل “الأرض اليباب” لإليوت هي تقليد شعري له أصوله التاريخية التي فيها وجد الشاعر تحررا في التعبير عن المدنية الحديثة من خلال شخصية برفروك الذي سيطر عليه شعور بدائي طقسي لا واقعي، فكان التطهر والبراءة من حاضر مشوه ورأسمالي هو الخلاصة التي انتهت إليها القصيدة التي بدت في نهايتها واقعية وبدت في بناء قالبها ورسم بطلها خيالية.
ولا يعني هذا التحرر أن الخيالية عدوة النظام، بل هي التي تعود بالنظام إلى الأصل الذي صير منه نظاما وهو اللاواقعية كرهان إبداعي لا مناص من تجريبه. فالخيالية بمثابة حدس شعوري يوجب التجريب في النظام مثلما يفترض الانتظام في التجريب. وتختلف الوسائل الخيالية في محاكاة الحياة الواقعية وقد تستبدل معها درجات المحاكاة. ولقد ظل تقليد الخيالية فاعلا ما استمرت فاعلية التجريب في النظام السردي الذي هو واقعي بقصد التحرر منه والعودة إلى الأصل أي القاعدة اللاواقعية.
الهدف من التخييل
الخيالية ليست عدوة النظام وللقاص والروائي دور تاريخي في بناء الأنظمة السردية وتمثل واقعياته أو التحرر منها
لا مجال لأي نمو أو تطور أن يحصل في النظام من دون أن يكون هناك جذر، ولا غرابة في أن تكون قصيدة النثر نظاما جديدا تبلور من أصل لاواقعي. والمؤلف ــ شاعرا كان أم حكاء ــ هو الداينمو المولد للخيالية أي العقل الذي به ترتبط التقاليد بعضها مع البعض الآخر. وليس مجرد حلقة ينبغي نسيانها كما ذهب منظرو السرد البنيوي أو هو حلقة لا بد من ربطها بحلقات أخر تعضدها وتقوي فاعليتها كما ذهب منظرو السرد ما بعد البنيوي أو حلقة مبتدؤها في النص وختامها في القارئ ولا معنى لها من دونهما كما يذهب منظرو السرد ما بعد الكلاسيكي، بل المؤلف هو صانع الحلقات ومنظم ترابطها وهو الذي يعطيها معناها.
وإذا كانت الخيالية بهذه الأهمية، فإن للقاص والروائي دورا تاريخيا في بناء الأنظمة السردية وتمثل واقعياته أو التحرر منها، وباعتبار التخييل هو الطريق إلى فهم الواقع يغدو ممكنا للكاتب والقاص أن ينتهج مسارات في التخييل غير معتادة فيغدو سرده غير واقعي وبخيالية محضة.
ومن الغريب حقا أن ينظر النقاد إلى السرد الواقعي على أنه هو الأصل الذي منه انبثق السرد غير الواقعي معتبرين الرواية جنسا واقعيا، ومن هذه الواقعية تفرعت أنواع غير واقعية كالرواية الفنتازية والغرائبية والسحرية وغيرها.
تبقى التجربة الإنسانية هي التي تولد السرد وليس العكس ويبقى التخييل هو الوسيلة الأهم في هذا التوليد تعبيرا عن تجربة ما
وعلى الرغم من أن التنظيرات البنيوية وما بعد البنيوية مخصوصة في السرد الواقعي والتنظيرات ما بعد الكلاسيكية وجهت عنايتها إلى السرد غير الواقعي، فإن أمر المخاطرة والتحرر من الأنظمة يبقى طبيعيا بصلابة اللاواقعية كقاعدة عليها يقوم السرد كله ومنذ الأزل، فهي صانعة التقاليد التي منها تشتق أنظمة السرد قديما وحديثا.
ولقد استوعبت الرواية ميكانيزما التخييل في أبعادها وتنوعاتها كافة متبعة نظاما من الأساليب والتقانات، مما أعطاها سمتها الأجناسية كقالب محدد بإطار منضبط، بيد أن المنظرين حرفوا إبداعية هذا الجنس من كونه صناعة تخييلية إلى أن يكون صنعة واقعية. فكأن اكتساب الرواية التجنيس جعل التخييل مقننا شكليا وجماليا بالواقع الذي يطغى عليه.
وأدى النقد بنوعيه الكلاسيكي والحديث دورا مهما في موضعة التجنيس في هذا الإطار من خلال اهتمامهم بالسارد والصوت السردي ووجهة النظر والمحاكاة والانعكاس إلى غير ذلك من المسائل التي ظلت تبعاتها تفعل فعلها السلبي في تحجيم الخيال.
وإذا كان الهدف من التخييل موجها نحو الشكل، فإن وظيفة الكاتب الفنية تحددت في ابتكاره والتجريب فيه. حتى إذا وصلت الرواية إلى منتصف القرن العشرين كانت أزمتها قد هددت وجودها، فحاول روائيون مثل جون بارت وآلان روب غرييه وموريل سبارك وغونتر غراس وغيرهم حل الأزمة من خلال العودة إلى الحكاية والأسطورة واستلهام التراث السردي وإعادة صياغته مع تجريب طرائق جديدة كالشيئية والحوارية والميتاسردية والخيال العلمي وغيرها.
مفترق طرق

من المؤكد أن تحجيم الطاقة التخييلية كان قد ساعد في رسوخ تقاليد الرواية لكن هذا الترسيخ لم يمنع الخيال من أن يستمر في تقاليده السابقة المتمثلة في اللاواقعية التي اتضحت أبعاد تقاليدها عند الكتاب الأوروبيين في القرن الثامن عشر، فأثروا في السرد الأوروبي الحديث تأثيرا كبيرا، لافتين الأنظار إلى خياليتهم حتى تحدد قالب الرواية الأجناسي كنوع من الكتابة جديد.
والرواية فن قبل أن تكون جنسا أدبيا، هي في أصل نشأتها موجهة نحو فهم الواقع على حقيقته وليس الإيهام به. وتبقى التجربة الإنسانية هي التي تولد السرد وليس العكس ويبقى التخييل هو الوسيلة الأهم في هذا التوليد تعبيرا عن تجربة ما. وهو ما كان ملموسا سابقا في الرواية الكلاسيكية ونلمسه اليوم في روايات الرعب والسحر التي صارت تجذب القراء وتسترعي انتباه صناع الأفلام بشكل ملحوظ.
وهذا ما يضع رواية القرن الحادي والعشرين أمام مفترق طرق، وعليها أن تختار ما بين أن تكون فنا يحاكي الواقع الخارجي أو فنا يحاكي الداخل النفسي أو فنا خياليا لا يحاكي واقعا لكن عناصره السردية مترابطة ترابطا منطقيا. ومعلوم أنه كلما اقتربت الرواية من الحقيقة، تضاءلت أزمة الشكل في التعبير عن رؤيا العالم عبر إعادة التفكير في واقعية الرواية وأهمية استعادة خياليتها من خلال اللغة.