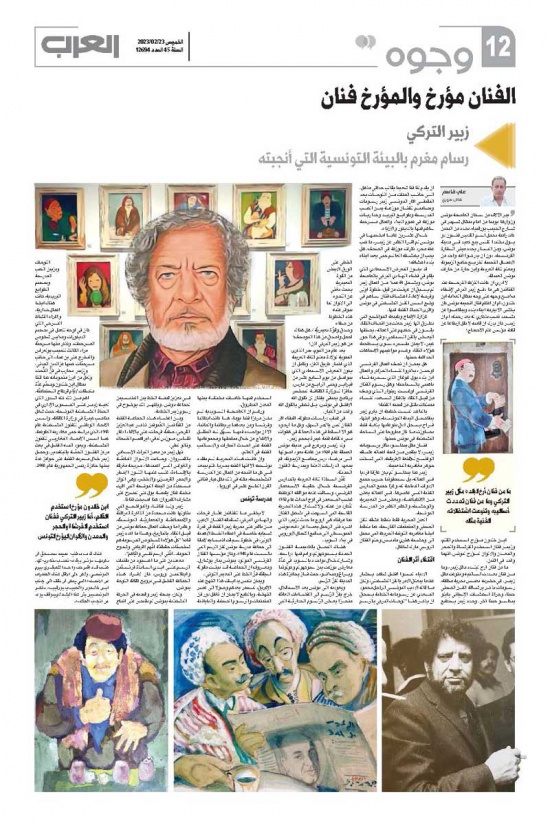نقاد ومسرحيون خليجيون وعرب يواجهون تساؤلات راهن المسرح الخليجي ومستقبله

اهتم ملتقى الشارقة للمسرح الخليجي في دورته الرابعة بمناقشة راهن المسرح الخليجي ومستقبله، حيث عرض مداخلات لباحثين وفنانين، بعضها بحثي وأكاديمي وبعضها الآخر يختزل نظرة مهنية تطبيقية، تقدم لمحة شاملة لواقع المسرح بنواقصه والتحديات التي يواجهها وكذلك أهم إنجازاته، لكنها تستشرف المستقبل وتقدم توصيات لتطوير المشهد المسرحي في الخليج ودعم حضوره محليا وعربيا ودوليا.
حقق المسرح الخليجي جملة من المنجزات والنجاحات في العقود الأخيرة، بفضل الدعم الرسمي ونتيجة لجهود الرواد، فزادت معاهده التعليمية، وتعمق حضور ممارسيه وموضوعاته وجمالياته، على مستوى أبحاث كليات الدراسات العليا “الدكتوراه والماجستير”، وتضاعفت أنشطته (المهرجانات، الورش التدريبية، المؤتمرات الفكرية، المسابقات..) وتكاثرت فرقه وجمعياته ووسائطه الإعلامية المرئية والمقروءة والمسموعة، وتوسعت مساحاته في الفضاءات المغلقة والمفتوحة، وامتدت تنقلاته محليا وعربيا.
رافق كل ذلك تطور ملحوظ في شكل هذا المسرح وتقنياته، وخبرات وطموحات صناعه، ما مكنه من إحراز المزيد من الجوائز والأصداء في كل مكان. هذه الرؤية التي طرحها الملتقى الفكري لمهرجان الشارقة للمسرح الخليجي في دورته الرابعة، والذي جاء في جلستين شارك فيهما مسرحيون ونقاد خليجيون وعرب، طرحت العديد من التساؤلات من بينها: كيف يمكن لهذا المسرح أن يصنع مستقبله؟ أي موقع يمكن أن يشغله في الغد؟ وأي اتجاهات يمكن أن تسلكها تجاربه؟ وما الذي يتطلع هذا المسرح إلى طرحه أو معالجته أو تجاوزه أو تحقيقه، في ما يتصل بهويته الإبداعية، وفي صلته بجمهوره، وفي نظمه الإدارية والمؤسساتية؟ ما التحديات التي يجب على المشتغلين بهذا المسرح الاستعداد لها في ما هو آت؟
بداية أكد الكويتي د. عبدالله العابر أن دول مجلس التعاون الخليجي تشهد تطورا ملحوظا على الصعيد الثقافي وذلك منذ بدايات القرن الماضي ساعية إلى النهوض بالمجتمع الخليجي بصفة خاصة والانفتاح العربي والعالمي بصفة عامة. وحرصا منها على إبراز الدور الثقافي في نمو وتطور المجتمعات الحضارية قامت دول المجلس بالتركيز على جانب التعليم وإنشاء مراكز ثقافية وفنية وإقامة الندوات الفكرية والثقافية والاهتمام بالمجلات وإصدار الكتب والبحث العلمي.

ولم تقف دول الخليج عند هذا الحد؛ فقد ركزت على أهمية الجانب الأكاديمي ودوره في صقل المواهب، لهذا عملت على إنشاء المعاهد الفنية، التي تعنى بتدريس الفنون مثل المسرح والموسيقى، والاهتمام بالفرق المسرحية وإقامة المهرجانات والمسابقات والورش سعيا منها لكسب المهارات والخبرات من خلال احتكاكها بالفرق المحلية والعربية وخلق روح المنافسة بينها. لقد شهد المسرح الخليجي عدة عوامل ساهمت في نموه وازدهاره عن طريق مؤسسات الدولة والشركات الخاصة أو عن طريق الأفراد.
تطور ملحوظ
وتطرق العابر إلى بعض التجارب والنقاط المشتركة بين التجارب المسرحية الخليجية، واستعرض تجربة المسرح الكويتي، ما له وما عليه، من ناحية الطاقة البشرية والبنية التحتية والقرار الإداري، وقال “لدينا طاقات بشرية لافتة، لكن البنية التحتية للمسرح الكويتي تعاني مشكلات كبيرة، من أبرزها عدم امتلاك مسرح حقيقي، فكل المسارح مؤجرة وليست ملكا للفرق القائمة، كما أن الدعم المالي ضعيف جدا، وأي نشاط مسرحي لفرقة لا يستطيع هذا الدعم تغطية نفقاته، الدعم من الدولة قليل جدا نتيجة ضعف قناعة المسؤول بالثقافة عامة والمسرح خاصة”.
وتناول المؤرخ والناقد المسرحي التونسي د. محمود الماجري الحركة المسرحية في الإمارات وتطوراتها، كاشفا عن تفاصيل مشاركته في مشروع وضع مناهج المسرح المدرسي، وقال “أفرز العمل في المشروع بعد ثلاثة عشر شهرا من العمل الدؤوب إنجاز أول إستراتيجية عربية في هذا الجانب الحيوي من النشاط المسرحي الذي يغطي كل المراحل التعليمية من الروضة حتى نهاية الدراسة الثانوية. ويمكن أن أقول للتاريخ إنها كانت وثيقة تأسيس عسيرة الصياغة لكن ما أنجزته كان عظيما للمسرح الإماراتي خاصة والمسرح العربي عامة”.
وكانت للماجري عدة مطالب منها: ابتعاث المواهب المسرحية إلى البلدان التي تتمتع بتجربة مسرحية مميزة وذلك بتوفير منح للمبدعين ـ الاهتمام بالنقد المسرحي ـ حثّ الفرق على وضع خطة سنوية وبرامج عمل ـ وضع برامج إعلامية وثقافية للنهوض بالوعي الثقافي بما يعزز علاقة الجمهور بالمسرح ـ تعزيز الإمكانات المالية للفرق المسرحية ـ لا ينبغي لحيز الخصوصية وأمر الهوية أن يشكلا ابتعادا عن العولمة بتقنياتها وانفتاحها ـ مراجعة نظام أيام الشارقة المسرحية بلوائحها الضابطة ـ العمل على إنشاء مسرح قومي تكون نواته فرقة مسرحية قومية ـ بناء دور مسرحية في مدن الإمارات ومناطقها تعزيزا للامركزية المسرح – الاهتمام بجائزة الشارقة للكتابة المسرحية “النصوص” وتحفيز المواهب على خوضها أملا في بروز كتابات جديدة ومواهب محلية ـ الاهتمام بالوجه الاجتماعي للمسرح لمعالجة القضايا التي تهم الشباب والمجتمع المتحول.
وقال إن “هذه المطالب تمثل تعبيرا عن تحديات المستقبل كونها تنطلق في تقديري من وعي تاريخي حاد بالذات في علاقتها بمحيطها العربي والعالمي، مع فهم واستيعاب دقيقين لخصوصيات ومتطلبات المهمة المسرحية ضمن شروطها الاقتصادية والثقافية في مجتمع متغير يريد المحافظة على هويته من التصدع دون خوف من الانفتاح أو دعوة إلى الانغلاق”.
وفي مداخلته التي حلل فيها الناقد والمسرحي إبراهيم الحسيني عددا كبيرا من العروض الخليجية لفت إلى ثلاثة اتجاهات متجاورة قائلا “ثمة مجموعة من التحديات تواجه المشهد المسرحي في الخليج العربي، بعضها يتعلق بطبيعة العملية الإنتاجية للمسرح وعلاقتها بالجمهور، والبعض الآخر يتعلق بإشكاليات بنية العملية الفنية نفسها، وفي ظل حالة الحراك المسرحي المستمرة يتأكد وجود مثل هذه التحديات، خاصة وأن اللحظة الحضارية المعيشة سريعة التطوّر على المستوى التكنولوجي، وأيضا على مستوى إنتاج الأفكار الفنية”.
وتابع “نحن كعرب لم ننتج الظاهرة المسرحية كما هي بشكلها المتعارف عليه بل استوردناها وعرّبناها وزرعناها في التربة العربية، لا ننكر أنه كانت لدينا بالفعل قديما مجموعة كبيرة من الظواهر المسرحية تختلف في نضجها من منطقة عربية إلى أخرى لكن ما ثبت حتى الآن أننا مازلنا نلاحق تطورات المسرح في الغرب ونضيف إليه، وهو ما يشكل تحديا دائما لاستمرارية العملية المسرحية بمواصفاتها العربية الباحثة عن هوية عربية خالصة بعيدا عن المواصفات الغربية، ومن داخل هذا السبب ظهرت ومازالت تظهر الكثير من دعاوى التأصيل لمسرح عربي خالص كنص مسرحي وكعرض أيضا”.
◙ ثمة مجموعة من التحديات تواجه المشهد المسرحي في الخليج العربي بعضها يتعلق بطبيعة العملية الإنتاجية للمسرح وعلاقتها بالجمهور
وأضاف “لعل أول ظهور حقيقي لمفردة ‘الهوية’ ظهر مع دعوات العولمة، تلك الدعوات التي تحاول صياغة ثقافة عالمية موحدة وهو ما سيطغى بشكل ما على هوية الشعوب وخصوصيتها الثقافية والحضارية، لذا ظهرت الكلمة مقرونة بأشكال مختلفة للدفاع عن هويتنا العربية، الدفاع عن التاريخ والتراث والحكايات الشعبية والأشكال الملحمية وأشكال الأداء الشعبية، وظهرت بالتالي محاولات كثيرة حول ذلك الأمر. ولمنطقة الخليج العربي مواصفات خاصة حيث تجمعها اللغة الواحدة، والمكان الواحد، والتاريخ المشترك، والتراث الشعبي المتشابه، وبالتالي يمكن التعرّف على الكثير من الصفات المشتركة على مستوى الشكل وأيضا على مستوى المضمون داخل الفنون الخليجية”.
وأكمل "وإذا تحدثنا عن فكرة الهوية هنا داخل مسار وحركة المسرح الخليجي وكيفية ترسيخها داخله فسنجد أن مفردات التاريخ والمكان وحكايات الصيادين والعلاقة بالبحر، وكذلك المفردات المعجمية الخاصة به: أغاني الصيد، أنساق الأعراف والتقاليد والأخلاقيات الحاكمة لهذه البيئة، كل ذلك يمثل فكرة الهوية بالنسبة إلى المجتمع الخليجي، وتضمين تلك المفردات وما شابهها داخل الحراك المسرحي الخليجي يعني فيما يعني التمسك بالهوية، والبعد عنها يعني الانفصال عن الهوية والانخراط في المعاصرة، وعليه ستجد الكثير من العروض المسرحية الخليجية تتشبث بالحفاظ على مسار الهوية وتتمسك به. هذا في حين أن هناك تجارب أخرى داخل المسرح الخليجي تغرّد خارج سرب الهوية وتحاول تقديم مواصفات مسرحية عصرية تستفيد من شكل وفكر واتجاهات المسرح الغربي، حيث يرى أصحاب هذا الاتجاه أن التوقف لدى استلهام التاريخ والتراث وحكايات الصيد والصيادين سيكرر العملية المسرحية ويجعلها متشابهة في الشخصيات الدرامية والأفكار والمضامين".
وتابع “هذا في حين أن هناك اتجاها ثالثا تمثله بعض التجارب الأخرى ويدمج ما بين الأمرين، ما بين العودة إلى الجذور التاريخية والتراثية وما بين الشكل العصري الراهن للمسرح الذي يستفيد من كل حضارة اللحظة الراهنة للمسرح من تكنولوجيا وأفكار إخراجية، ولا يوجد بين الأشكال الثلاثة المتجاورة / المتصارعة أي إقصاء يمارسه طرف تجاه الطرفين الآخرين، هذا مسرح يراه البعض يرسخ للهوية، وهذا مسرح يجاوره ويستخدم مهارات اللعبة المسرحية الحديثة من حيث: مسرح الجسد، الصور، التكنولوجيا، ما بعد الحداثة،.. وهذه نوعية ثالثة ترى أن الحل التوافقي هو الأنسب وهو القادر على جمع الحاضر بالماضي في جملة مفيدة. لكن إذا ما استثنينا الحل التوافقي الذي يدمج ما بين الصيغة الباحثة عن الهوية والمتمسكة بها من ناحية وما بين الصيغة المعاصرة للمسرح، تلك المنقطعة الصلة بأي جذور عربية إلا فيما ندر، سنجد أن الصراع الأساسي يكمن بين مسارين كبيرين: أولهما العروض التراثية والتاريخية التي تشكل نسبة كبيرة مما ينتجه المسرح الخليجي. وثانيهما عروض المسرح الحديث المتماشية مع بعض ما يطرحه مسار العولمة من أفكار وما يعتمده المسرح التكنولوجي من تقنيات حديثة.
تخطيط للمستقبل

في الجلسة الثانية من الملتقى قال الناقد المسرحي البحريني د. يوسف الحمدان إن “الدعم وارد وسخي والمستقبل لدى أغلب مسرحيينا في خليجنا العربي، إذ ليس من السهل تشكيل اتجاه مسرحي خلاق ومؤثر ما دمنا في وارد التجربة العابرة التي قد تترك أحيانا أثرا جميلا في حينه على المتلقي ولكنها لا تسعى لتشكيل وهج فكري ومؤسس يدعونا إلى متابعته وقراءته واكتشاف مناطق تحولاته الخفية حتى في أقرب راهنيته، لذا أجدني في ورقتي هذه منحازا إلى الحديث عن الداعم لهذا المسرح، أقصد الشيخ الدكتور سلطان القاسمي بوصفه مشروعا أو اتجاها مسرحيا مؤسسيا مستقبليا، ينبغي علينا استثماره على المدى المتواصل والأبعد وليس المؤقت والراهن، كما هي في بعض المناسبات المسرحية”.
وتحدث الحمدان عن منجزات الشارقة للمسرح الإماراتي خاصة والمسرح العربي عامة التي تحققت انطلاقا من رؤى وأفكار الشيخ الدكتور سلطان القاسمي، وأكد أن الشارقة هي أكثر العواصم العربية التي لا يكف المسرح فيها عن العمل في مختلف حقوله وأنواعه، كما أنها العاصمة المسرحية العربية الوحيدة التي يرعى ويدعم ويحضر حاكمها كل الفعاليات والمهرجانات المسرحية، وهي العاصمة المسرحية الوحيدة في وطننا العربي التي يعلن فيها راعي فعالياتها بشارات مسرحية جديدة تراكم على ما سبق من إعلانات وأحلام تحولت على أرض الواقع اليوم إلى حقيقة”.
ورأى الممثل والكاتب المسرحي الإماراتي عبدالله مسعود أن المسرحيين أمام تحد كبير في البحث عن طرق بديلة ووسائل مختلفة تواكب ما آلت إليه صورة الحياة الزاخرة بالوسائل العبثية والترفيهية والتي تحاول تحجيم أدوار الوسائل القديمة ومنها المسرح بلا شك.

وتطرق إلى واقع المسرح الإماراتي ومستقبله وأهم التحديات التي يجب أن يخوضها ويتجاوزها، وبطبيعة الحال هو أيضا انعكاس على المسرح الخليجي، وقال “لن أتحدث عما قبل جائحة كورونا ولا خلالها بل بعدها. كنت أشاهد المحاولات الحثيثة من قبل المؤسسات المعنية بدعم وإنتاج وتكوين العملية المسرحية، حيث كانت كلها تسعى لإعادة المسرح إلى ما كان عليه حتى لو كان تقليدا أو مصابا بالخوف، كانوا يبحثون بشكل سريع وآمن، وقد نجح الجميع في مساعيهم”.
وشرح مسعود كيف “بدأ المسرح بالعودة من جحيم كورونا وما خلفته فينا، وأخذ بالنهوض محليا على أقل تقدير، بدأ بخطى بطيئة إلى أن استقر، وعاد بهيا كما نريد له أن يكون، كان ثمة تعطش كبير للاشتغال وملء الفراغ، اتفقت غيابيا كل الفرق على أن تبذل جهودها لتقديم أعمال مسرحية تحاكي الطموحات والرؤى المستقبلية، بعض الفرق وصل إلى ما أراد وبعضها الآخر وقفت العوائق في وجهه ومنها بكل تأكيد الغلاء الفاحش في أسعار المواد والمحروقات وهذا ليس بخاف على أحد، لكن في النهاية تبقى الفكرة الرئيسية وهي المضي قدما لخلق أعمال وحركة مسرحية كي تعود العجلة إلى الدوران”.
وأضاف “تحركت منذ فترة ليست بالطويلة وزارة الثقافة والشباب في الإمارات وشعرت بأهمية دعم الأعمال المسرحية خصوصا في تمثيلها الخارجي، وأثمر هذا الدعم الذي جاء في وقته عن تميز الأعمال الإماراتية بشكل خاص في المحافل والمهرجانات الخارجية، حيث فازت بعض الفرق بجوائز عديدة وكبيرة كما حظيت بعض العروض بتقييمات مميزة إذ قدمت عروضها شكل رائع. لكن ماذا بعدها؟ مع الدعم السخي للشيخ الدكتور سلطان القاسمي والمؤسسات المعنية والأرباح المعنوية والمادية التي حصل عليها المسرح الإماراتي مازال لم يحقق المراد وما نطمح إليه”.
وشرح “أنا أتحدث هنا عن وجود الصحيح في المجتمع، في وسطه، بين أهله وناسه في الأزقة والأروقة والقاعات حتى التي لم تكن مهيأة له، لا ينبغي أن يكون بعيدا بل عليه أن يكون لصيقا يطرق الناس أبوابه في كل حين. أعتقد أن الجهود يجب أن تنصب حول البحث عن آليات جديدة وعصف ذهني مغاير للنهوض به وإيصال الفكر. هناك عوائق أرى أنه في التخلص منها سيكون المسرح وغيره من الفنون بألف خير وهي: ألا يقف كل فن على حدة وكأنه في مواجهة مع الفنون الأخرى، يجب أن نقترب من بعضنا البعض، وأن تقترب الفنون الجمالية وتشترك حتى تكتمل الصورة فتتوهج الساحات جمالا ومتعة”.
◙ المسرحيون أمام تحد كبير في البحث عن طرق بديلة ووسائل مختلفة تواكب ما آلت إليه صورة الحياة الزاخرة بالوسائل العبثية والترفيهية
أما أستاذ المسرح المساعد بجامعة السلطان قابوس د. سعيد محمد السيابي فسعى لطرح بعض الأسئلة من واقع المجتمعات الخليجية التي مرت ومازالت تمر بتحولات كثيرة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والفكري والثقافي وتأثير ذلك على المسرح، وحاول الإجابة عنها، مثل: هل استطاع كتاب المسرح الخليجي مواكبة هذه التحولات من خلال نوعية القضايا التي طرحوها؟ وهل استطاعوا التنبؤ بقضايا المستقبل أو ببعضها؟ وما هي الموضوعات المستقبلية التي لم يطرحوها؟
وخلص إلى مجموعة من النتائج والتوصيات نذكر منها: أولا، التنبيه إلى عدم الاستغراق في الماضي والعيش المطلق على أمجاده واستحضاره، رغم أهميته، ولكن لا ينبغي أن ينسينا ذلك التفكير في المستقبل والتزود له بالعلوم والمعارف، ونطرح ذلك في موضوعاتنا المسرحية. ثانيا، إن الدراسات المستقبلية عن المسرح الخليجي ستظل في حدود ضيقة إن لم يتم طرح مثل هذا الموضوع وتكتيب باحثين مجيدين يتناولون بالدراسة العلمية التطورات في الموضوعات المسرحية المستقبلية والتنبيه إلى الموضوعات غير المطروقة.
ثالثا، لوضع رؤى مستقبلية أو دراسات استشرافية خليجية علينا أن نؤسس لقيام أكاديمية أو معهد فني للدراسات المستقبلية يروّج لتخصصاتها البينية مع الفنون الأخرى. رابعا، إن المعالجة الدرامية للقضايا المستقبلية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وقضايا الطفل في النصوص المسرحية محل الدراسة كشفت عن وجود نصوص مهمة لدراسة موضوعات المستقبل. خامسا، هناك العديد من الموضوعات المستقبلية المقترحة وتساهم في تحرير المستقبل من الخلاص الغيبي، نذكر منها: موضوع قرصنة الأجهزة الذكية أو عالم الأشياء المتصلة بالإنترنت، ومخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي ضمن الحروب البيولوجية، والحروب الذكية والجندي الخارق وحروب المستقبل، ومذيع المستقبل، وتكنولوجيا توظيف التراث في عصر الثورة الصناعية الرابعة في المتاحف والمعارض وغيرها.