يُمنى العيد.. مديرة مدرسة البنات التي غيرت وجه النقد العربي

اختارت هيئة الشّارقة للكتاب الناقدة والأدبية اللبنانية يمنى العيد، أو حكمت صبّاغ الحكيم، كما هو اسمها الحقيقي، شخصية العام الثقافية لفعاليات الدورة الـ38 من معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي أختتم في نوفمبر 2019، تحت شعار «افتح كتابًا.. تفتح أذهانًا»، احتفاءً باختيار الإمارة العاصمة العالمية للكتاب.
وقد جاء اختيار صاحبة “النص المفتوح” وفقًا للبيان الذي أعلنته هيئة الشارقة “تقديراً لجهودها المعرفية خلال أكثر من أربعة عقود ماضية من الكتابة والتأليف في النص الأدبي العربي، حيث قدمت عشرات الدراسات والبحوث المتخصصة في النقد الأدبي، والنقد المقارن، والتوثيق الأدبي، والمقاربات التاريخية، وغيرها من المؤلفات”.
لم يكن هذا الاعتراف هو الأوّل، أو الوحيد، بمكانة يمنى العيد النقدية، فلقد سبقته اعترافات وتكريمات كثيرة من أهمها حصولها على جائزة السلطان قابوس في دورتها الثالثة، فرع الدراسات الأدبية والنقدية. حيث جاء حينها في حيثيات الفوز أن “أعمال يمنى العيد في مجملها تُفصح عن وعي متميّز لمناهج النقد الحديثة، وحرص واضح على الملاءمة بين النظرية والنص العربي”.
رؤية أخرى للعالم
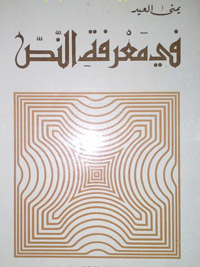
لا خلاف على مكانة يمنى العيد النقدية في عالمنا العربي، حيث تعدُّ تجربتها النقدية واحدة من أهم التجارب النقدية في العقود الأخيرة، إلى جوار أسماء نسوية لا تقل عنها أهمية مثل سيزا قاسم وفريال غزول وسلمى الخضراء الجيوسي، تشكّل جميعها توازنًا مّا مع الطرف النقيض “الرجل”، الذي يُتهم بأنه يحتكر النقد وَيُمارس سلطويته.
تمتلك مشروعًا في النقد الروائي متراكمًا على مستوى الإنتاج، ومتطوّرًا على صعيد الرؤية والممارسة النقدية؛ وهو ما يدفع بها لتنتمي إلى مدرسة نقدية يخوَّلُ لها البحثُ في النصوص، استنتاجَ النظري أو معرفته. كما تتسم تجربتها التي امتدت قرابة أربعة عقود، بعد أن بدأت من السبعينات، بميلها إلى المشروع العلميّ الخلّاق، والذي تسعى من خلاله إلى تكوين “وعي معرفي لا بالنّص الأدبي، أو بما نقرأ بل بذواتنا وواقعنا”، وهو في مجمله وعي معرفي ضدَّ الجهل الذي كان ثمنه مع الأسف مريعًا.
ويستمر هذا الهاجس “الوعي المعرفي” أثناء
ممارستها الكتابة النقديّة للنصوص الأدبيّة. ففي مقدمة الطبعة الثانية من كتابها “في معرفة النص” تقدّم لنا يُمنى العيد رؤيتها المبكّرة جدَّا، والتي ستصير منهجها في الممارسة النقدية، التي تراها “نشاطًا فكريًّا يشتغل على الموضوع” دون أن ينعزل عن حقوله المادية، فلا حدود صارمة بين نشاطات الفكر الذهنيّة أو المادية، فقط “ثمة معارف تُفتح الأبواب بينها أكثر فأكثر”.
وفي المحصلة أن الممارسة التي تأمل أن تكون بداية طريق في حقل النقد؛ لها هدف إنتاج معرفة بموضوعها. وبناءً على هذا “فالنقد الأدبي” تُعرِّفه بأنه “شغل على النصوص”، أي هو ممارسة وليس تنظيرًا على التنظير يكرّر المفاهيم، أو يضيف إليها. بمعنى أكثر وضوحًا هو “قراءة تنتج معرفة بالنص”.
أما التنظير الذي تبغيه للنقد، فيتمثل “في معرفة النص بدواخله، في نسيجه، في مادته التي هي اللغة”. كما تؤكد على أهمية أن تصير القراءة “نقدًا”، وتعوّل كثيرًا على القارئ في أن يصبح قادرًا على كشف دواخل النصوص “عن طريق المحاورة لا أن يقع أسيرًا لها”. فكما تقول “بالقراءة نُبدع النصوص، بل إن القراءة هي التي تقيم حياة للنصوص، وأيضًا تشهد على موتها”.
ترفض يمنى العيد بشدة اعتبار أن هدف النقد هو “إنتاج نص أدبي”، فتقول إن النقد يواجه مأساته حين يطمح إلى “أن يكون نصًّا أدبيًّا”، وتقع مأساته في أحد أمرين: إما أنه نص يكرّر النص الأدبي وصفًا وشرحًا وتقييمًا، وهو في هذه الحالة دونَ النص الذي هو موضوعه؛ لأنه تقليد أو موازنة أو رهينة، فالأصل هو دائمًا أفضل. وإما أنه نص أدبي متميز، وفي هذه الحالة يخون النص الأدبي، موضوع نقده، وبالتالي لا يعود نقدًا، إنه نص آخر. والنص موضوع المقاربة لديها ليس معزولاً عن خارج هو مرجعه، الذي هو “كل مخزون الذاكرة التاريخية واللحظوية” والذاكرة هنا لا بمعنى فعل التذكّر، بل كمستوى للمتخيّل. فتهتم بمتن النص الأدبي، وبنسيج هذا المتن وبالعلاقات فيه.
وبذلك يكون مفهوم النقد وَفقًا لما جاء في كتابها “تقنيات السّرد الرّوائي في ضوء المنهج البنيوي” أشبه بـ”حوار يبلور رؤية أخرى للعالم، ويؤهّل الوعي لاستقبال التنوّع والاختلاف، مزوِّدًا بذلك ثقافة الإنسان بما يثريها ويمدّها بالحياة” دون أن يعني هذا أن نتخلّى عن موقعٍ لنا في هذا العالم يخوّل لنا الحفاظ على هوية شخصيتنا. وهو ما أَهّلَها لأن تشخّص أزمة النقد المعاصر بقولها إنه “تعوزه المفاهيم النقدية، كي يخرج على وضعيته الوصفية، والرؤيوية، أو كي يتغلب عليها ويتجاوزها إلى ما هو بحث علمي، وشغل ينتج معرفة بالنص”.
عقلية يمنى العيد عقلية لا تقبل الارتكان إلى التقليد، بل النبش في الجديد وتطويعه لما يخدم منتجنا المحلي، وتقديم المغاير دومًا، حتى لو كان مصيره الاصطدام بواقعها، وهو ما سيقودها، وهي مديرة لمدرسة صيدا للبنات، إلى أن تخوض نضالاً من نوع آخر
أما الكتابة فهي ترى أنها تنهض على مستوى المتخيّل، فالكاتب من وجهة نظرها عندما يكتب لا يتعامل مباشرة مع الواقع، بل ما يرتسم في ذهنه أو في مخيلته من صور تخصّ هذا الواقع، أو تمثّله وتعنيه. وهذه الصورة المرتسمة في الأخير هي صور مفهوميّة تُعادل بعض المعاني أو تشكّل البعض الآخر منها، لأنها صورة مرتسمة من موقع رؤية الكاتب لها. وبذلك تكون عملية الكتابة عملية صياغة هذا المفهوم غير الجاهز، الذي يرتسم أوليًّا في الذهن بفعل ممارسة النشاط التعبيري.
تقطع يمني العيد بيقين لا ينازعه شك أو تزعزعه محاولات بعض النقاد لردِّ الرواية إلى جذور عربية، تتصل أوّل ما تتصل بالمقامات، وترى بأن الرواية العربية فنّ حديث لا تقاليد له سابقة أو موروثة في تراثنا العربي، حيث مالت الرواية العربية في مراحلها الأولى إلى محاكاة الرواية الغربية أسلوبًا وقواعدَ بناءٍ، حتى بدت الرواية قاصرة عن بناء عالم متخيّل قادر فنيًّا على قول حكايتها التي تنهض وتتشكّل من المعيش الذي هو الحافز على كتابتها. وفي ذات الوقت هي لا تُنكر أنّ الرواية واجهت قلقًا والتباسًا لا على مستوى المسرود أو الحكاية، بل أيضًا على مستوى المتخيّل الذي عانى فنيًّا قلقَ المُتغيّر والمُختلِف، قلق الإفادة من تجربة الآخر دون السقوط في التقليد والمحاكاة والعجز عن قول ما تودّ الكتابة قوله. لذا نراها تولي اهتمامًا بالأثر، أثر الواقع المعيش، وبصفته المرجعية في تشكّل بنية عالم الرواية.
ضد التبعية الذهنية

في كتاباتها النقدية، على تعددها، تؤكد على أهمية المنهج، وأيضًا ثمة التزام بمنهج صارم ألزمت به نفسها، حتى لو تغيّر وتبدّل مع تطوّر الوعي المعرفي، وهو يتصل بمفاهيم النظرية الغربيّة ومرجعيات نقدية تطوّرت عبر حقول نقدية عديدة، لكن جميعها لا تخرج عن إطار منهج، حتى لو كانت الدراسة كلاسيكيّة، على نحو دراستها المبكّرة عن “أمين الريحاني رحّالة العرب” و”قاسم أمين إصلاح قوامة المرأة” و”ممارسات في النقد الأدبي”.
ومع اعتدادها بالمنهج إلّا أنّها تتجنب جاهزية المنهج وإطلاقيته النظرية والإجرائية، على عكس ما تشير عناوين كتبها، التي تطرد فيها مفاهيم ومصطلحات غريبة توهم قارئها بأنها إزاء ممارسة إجرائية لهذا المنهج، على نحو عناوين “في معرفة النص” و”الكتابة، تحوّل في التحوّل مقاربة للكتابة الأدبية في زمن الحرب اللبنانية” و”في مفاهيم النقد وحركة الثقافة” و”حول نظرية الرواية: الراوي، الموقع والشكل، بحث في السرد الروائي” و”تقنيات السرد
الروائي في ضوء المنهج البنيوي” و”فن الرواية العربية بين خصوصية الحكاية وتميز الخطاب” و«الرواية العربية: التخيّل وبنيته الفنيّة”.
فهي في المقام الأول حريصة على ألّا تقع في التبعيّة الذهنيّة بأن تتماهى مع النموذج الغربي، بل على العكس تمامًا، تحرص على تنسيبه من خلال استحضار السّياق الاجتماعي والثقافي الذي يحفّ بعملية استقباله، وتمييزه من خلال إعادة إنتاجه في الممارسة النقدية وفق ما تلتحف به النصوص الروائيّة العربيّة من مرجع خاص يُساهم في تفرّد بنيتها الفنية، وتخليق نسيجها التعبيري، متجنِّبَة السُّقوط في فخ التقليد وترديد مقولات غربيّة في سياقات غير سياقاتها.
ومن نتاج عدم السقوط في التبعية تقبّلت بيُسر نكوص الرواية العربية، مؤخرًا، عن التجريب، وإعادة الاعتبار إلى الكلاسيكية السردية التي مال بعض الروائيين العرب الجُدد إلى توسّلها بغية حَدْثَنتها بما يتلاءم ومنظورهم لرواية عربية لا تغرق في السرد الـ”مابعد حداثي”. إضافة إلى التوثيق الذي أدخلته بعض الروايات العربية في سردها، كرد على هذا الجنوح الـ”ما بعد حداثي”، الذي رهن الحقيقي بالدال السردي على حساب المدلول، ناشدًا لتدشين خطاب يؤكد ويُكرّس اعتبار اللغة مجرد لعب مبتور الصلة بمرجعيات خارجيّة قائمة في الواقع.
ذات ممزّقة

تنفتح سيرتها الذاتية “أرق الروح” بسؤال وجودي “من أنا؟ هل أنا حكمت أم يمنى؟” هذا السؤال في حقيقة الأمر يكشف أولاً عن معاناة كانت تُثقل صدرها وهي تتخفى تحت الاسم الذكوري الذي فرضه الأب بعد وفاة شقيقها، كي تكون تعويضًا عن عبدالحليم أخيها الأكبر المتوفّى، وهو الاسم الذي كرهته؛ لأنه “يحمل وهمًا بالذكورة” في حين جاء اسم يمنى،
وهو الاسم الأنثوي الذي اختارته ووقّعت به أوّل مقالاتها وصدّرته على أغلفة كتبها، جاء كنوع من استعادة حقّ الامتلاك الذي سلبته إرادة الأب، وقبلها استعادة أنوثتها الموؤودة تحت الاسم الذكوري، وفي الوقت ذاته تكشف عن رغبة صادقة لأن تتحرّر من هذا التمزُّق الذي صنعه التراوح بين الاسميْن؛ حكمت التي بقيت أسيرة “زمن مضى” وظلت “راكدةً تحت جلد يمنى”، وتسعى لهذا التصالح مع اسمها القديم الذي أخفته، وتمنحه فرصة جديدة كي يعيش حياةً كاملة في كتاب مطبوع.
ومع استعادة الاسم الذي هو استعادة لماضٍ تليد، تستعيد حياتها. فتخبرنا أن يمنى أو حكمت، ولدت في صيدا في لبنان عام 1935 وقد أتمت دراستها الثانوية والجامعية فيها، إلى أن انتقلت إلى بيروت، ثم تخرجت من الجامعة اللبنانية، ثم عادت مجددًا إلى صيدا لتعمل في سلك التعليم، حتى وصلت إلى مديرة لثانوية البنات. وتقديرًا لدورها كرمتها وزيرة التربية السابقة بهية الحريري وأطلقت اسم “ثانوية يمنى العيد” على ثانوية صيدا الرسمية.
تجربتها النقدية تعدُّ واحدة من أهم التجارب النقدية في العقود الأخيرة، إلى جوار أسماء نسوية لا تقل عنها أهمية، مثل سيزا قاسم وفريال غزول وسلمى الخضراء الجيوسي، لتشكّل جميعها توازنًا ما مع الطرف النقيض "الرجل"، الذي يُتهم بأنه يحتكر النقد
وتبرز جانبًا من نضالها، حيث أوشكتْ على الموت مرتين، وأنها أصيبت في قدمها برَصاص الجنود الفرنسيين أثناء تظاهرة مدرسية تُطالب بإطلاق سراح رجال الاستقلال سنة 1943. كما تشير إلى أنها عاشت في بيئة ذكورية، وإن كانت لم تؤثر ولم تكن حجرَ عثرة في تعليمها الذي استكملته، حتى نالت شهادة الدكتوراه من جامعة السوربون في الأدب العربي، وانتقلت بذلك إلى الجامعة اللبنانية، التي ما زالت تعمل فيها، وقد عملت في جامعة صنعاء باليمن لاحقاً.
الحقيقة أن هذه العقلية هي إفرازات نقاشات ثرية مع أعلام ينتمون إلى تيارات مختلفة، مثل حسين مروة ومهدي عامل، والأخير التقته عندما جاء للعمل كمدرِّس للفلسفة في المدرسة التي كانت تعمل مديرة لها. وأيضًا ثمّة لقاءات نادرة مع عبدالله العلايلي وسعيد عقل وعبدالوهاب البياتي وفيروز وصادق جلال العظم ويعقوب الشدراوي وكاتب ياسين.
عقلية يمنى العيد عقلية لا تقبل الارتكان إلى التقليد، بل النبش في الجديد وتطويعه لما يخدم منتجنا المحلي، وتقديم المغاير دومًا، حتى لو كان مصيره الاصطدام بواقعها، وهو ما سيقودها، وهي مديرة لمدرسة صيدا للبنات، إلى أن تخوض نضالاً من نوع آخر في التعليم والأفكار اليسارية والتقدمية وصولاً إلى تغيير شكل النقد العربي المعاصر ومضمونه.




























