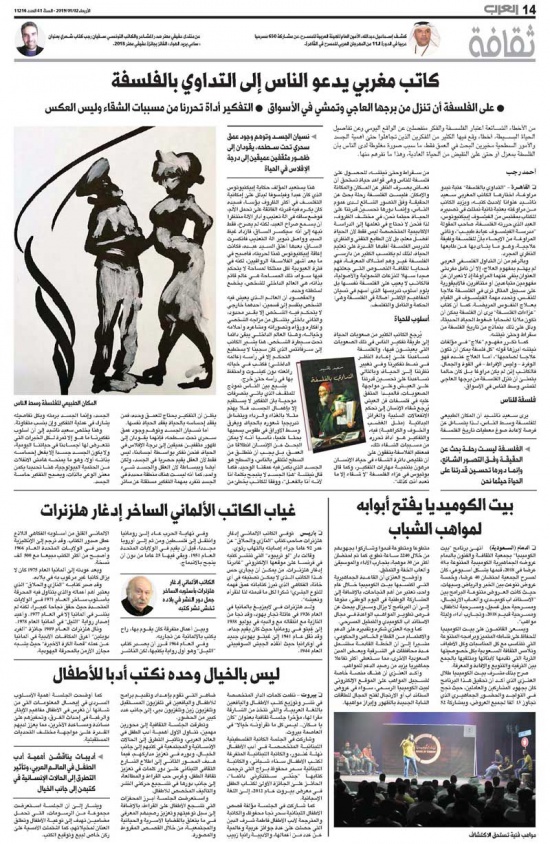المسرح ليس اختراع حكايات جديدة.. إنه أصوات المجتمع

إن الكتابة المسرحية أمر بالغ الأهمية في عملية الإبداع المسرحي، لا تقل أهميتها عن الإخراج والتمثيل والسينوغرافيا وغيرها، بل إنها العمود الفقري لأي عرض مسرحي. ولكنها عربيا تعاني من التغييب والتناسي، حيث أغلب الأعمال يكتبها المخرجون بأنفسهم.
يتمتع المؤلف المسرحي والدراماتورج والسيناريست والقاص التونسي يوسف البحري، بحضور بارز في المشهد التونسي خاصة والعربي عامة، كونه يتابع عن كثب المشهد المسرحي العربي نتيجة مشاركاته سواء بالأعمال المسرحية أو كعضو في العديد من لجان تحكيم المهرجانات المسرحية العربية أو كناقد وأستاذ جامعي بجامعة سوسة له دراسات كثيرة في المسرح والسينما والأدب.
المسرح والأدب
بداية وانطلاقا من لجوء المسرحيين لمسرحة الرواية أو اقتباسها أو إعدادها يقول البحري “لا يوجد مسرح صاف مطلق منغلق عمّا حوله في السياق الثقافي العام. الحكايات التي يوظفها المسرح تأتي من الأساطير ومن أحداث التاريخ ومن أحداث المجتمع والأفراد ومن الأخبار المتفرقة في الصحافة والإعلام على مدى تاريخ المسرح. وتتميز عناصر الحكاية المسرحية في النص الدّرامي وعناصر النص الحيّ (على الخشبة) فنّيا وتقنيا بالتفاعل الدائم مع الفنون الأخرى والظواهر المحيطة بالفن المسرحي. المسرح ليس اختراع حكايات جديدة بالضرورة بل هو بناء مسرحيات لها كيان فنّي وثقافي أصيل أي لها فرادة تحقق الإمتاع الفنّي والعمق الفكري. شكسبير مثلا فعل ذلك ولا أحد يصف أعماله بكونها اقتباسا وإعدادا. وقبل ذلك كانت التراجيديات الإغريقية مستمدة من الأساطير ومن أحداث التاريخ ولم يذكر أرسطو أنها اقتباس بمعنى أنها ليست إبداعا أصيلا. ما يربط بين فن الرواية وفن المسرح من اقتباس أو إعداد هو شكل من أشكال انتقال الحكايات بين الفنون أو انتقال تقنيات أو عناصر فنّية أيضا. لا توجد حدود صارمة بين الفنون وإنما توجد تفاعلات واختيارات تعود إلى ثقافة الفنان المسرحي واطلاعه ومرونته الفكريّة وروح الابتكار لديه وذكائه وشجاعته في تخطي أوهام الأحكام الفنّية المنتهية والنمطية”.
ويرى البحري أنه لا توجد عقبات تواجه الكاتب المسرحي أو المخرج عند تحويل الرّواية إلى نصّ مسرحي. ففي حال وجود عقبات فهي موجودة في شخص الكاتب المسرحي أو في شخص المخرج. الفرق الجوهري بين فن الرّواية وفن المسرح هو أن الرواية تقوم على شخصيات يقدّمها سارد يسمح أحيانا بنوافذ حوار بين الشخصيات، وأن المسرح يقوم على شخصيات تقدّم نفسها مباشرة بلا وسيط على الخشبة التي تتحاور فيها وفي ما بينها ولا أحد ينقل للمتفرّج ذلك الحوار. وإذا كان الكاتب المسرحي أو المخرج كسولا في عمليّة التحويل فيمكن أن يكتفي باقتطاع الأجزاء المتعلّقة بالحوار في الرّواية دون الانتباه إلى أن روح المسرح ليس في الحوار في حدّ ذاته بل في الصّراع الذي هو جوهر الدّراما. وإذا كان الكاتب المسرحي أو المخرج متحايلا وعاجزا عن التعاطي مع النص الروائي قراءة وتحليلا وتحويلا فقد يعمد إلى القفز على النص الروائي والاكتفاء بإشارات سطحيّة تربط الرواية بالمسرح، ويذهب إلى الزخرفة الفنّية والإبهار التقني للتغطية على غياب عمليّة التحويل التي تحتاج إلى الدّراية بفن الرّواية وفن المسرح معا وإلى الهدوء والصبر وإلى شجاعة الإنجاز ومراجعة الإنجاز دون توقّف حتى الوصول إلى درجة من الجودة.
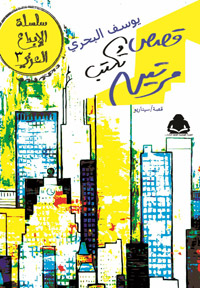
إشكاليات المسرح
من جهة أخرى يؤكد البحري أن دور المسرح لا يقتصر على “التحريض” على الوعي والتنوير فقط. فمنذ نشأة ممارسة المسرح عند الإغريق إلى اليوم ومنذ بداية فهمه نظريا عند أرسطو في كتاب الشعر تغيّرت أدوار المسرح وتنوّعت واتّسعت وضاقت. ويمكن القول إن “الوعي والتنوير” ليس لهما طريقة واحدة في المسرح هي “التحريض” عليهما بواسطة مسرحيات تصنعها نخبة وجمهور الناس “ينتقلون” إلى الوعي والتنوير بواسطة تلك المسرحيّات. هناك وسيلة أخرى هي نشر المسرح بين الفئات الاجتماعيّة والعمريّة وبين جهات البلاد. ففي تونس مثلا تخلو أغلب المدن والقرى والتجمعات السكانيّة من وجود المسارح المجهّزة اللائقة بالممارسة المسرحيّة وبالعروض أو تخلو من وجود المسارح أصلا. والأمر نفسه بالنسبة إلى المؤسسات التعليميّة من مدارس وجامعات. لا توجد فرصة التعرّف على المسرح أصلا أو التمرّس بصنعه وفهمه في أغلب البلاد فكيف الحديث عن دوره في التحريض على “الوعي والتنوير”؟
ويشير البحري إلى أن المسرح في تونس يكاد ينحصر في قاعات موجودة بشارعين بالعاصمة و”غيتو” مغلق اسمه “مدينة الثقافة” وبدل أن تبنى المسارح في شتى جهات البلاد وقع بناء قاعة “بمدينة الثقافة” وضع لها اسم “مسرح الجهات” كأنك تقول بدلا عن أن تسافر إلى اليونان تقوم بجلب اليونان إلى بيتك. أغلب البلاد التونسية تعيش في مرحلة ما قبل 1909 أي في مرحلة ما قبل أول مسرحيّة صنعها التونسيون “صدق الإخاء”.
ويلفت البحري إلى أن الفنان المسرحي في شتّى وظائفه كاتبا أو مخرجا أو ممثلا أو سينوغرافا أو دراماتورجا أو مصمم شريط صوتي أو مؤلفا موسيقيا أو سواه، ينبغي أن يكون حرفيا وفنانا في نفس الوقت أي يتمتع بالمهارة في الصناعة المسرحيّة من ناحية، ويتمتع برؤية جماليّة وفكريّة وثقافية من ناحيّة أخرى. مضيفا أن هذا الأمر يطرح مسألة “التكوين” أي ما الذي يوفّره التكوين الأكاديمي أو غير الأكاديمي للمسرحيّين؟ وما الفائدة من التكوين إذا كان مجرّد تلقين لمعارف ومهارات دون العمل على “شخصيّة” المسرحي؟
وحول ما إذا كانت لديه مقترحات للخروج بالمسرح مما هو فيه، يقول البحري “ليس لي مقترحات جاهزة لإخراج ‘المسرح العربي’ برمته مما هو فيه. ففي كل بلاد توجد مشاكل في المسرح تحتاج إلى معاينتها بحد ذاتها وتحتاج إلى حلول خاصّة بها. وفي كلّ بلد توجد مشاكل في التكوين المسرحي وفي الإنتاج المسرحي وفي سبل تمويل الإنتاج وفي توزيع العروض وفي التشريعات والنظم المتعلّقة بالمسرح وفي نمط المخرجات المسرحيّة وسواها، لا تشبه المشاكل في بلاد أخرى. المسرح يحتاج إلى تشريعات وإلى كوادر وإلى تمويلات وإلى بنى تحتية وإلى منصات توزيع وتثمين للمنتوج وفي أغلب البلاد العربيّة لا نعرف هل توجد سياسات مسرحيّة أم مجرّد توجهات أم مجرّد وجود لنشاط مسرحي هكذا بدون تخطيط ورؤية”.
ويؤكد البحري أنه يتابع المسرح الخليجي عامّة لكن علاقته بالمسرح في الإمارات أقوى قائلا “لأن إحاطتي به أوسع من غيره ولأنّني جزء من زخمه. إنّه يتميّز بكونه ليس مجرّد أنشطة تقام ومسرحيات يتم صنعها. وإنّما توجد رؤية وآليات تخطيط وكفاءة في التنفيذ ومصداقيّة في النتائج والمخرجات. يتجلّى ذلك في الشارقة تحديدا حيث يتم العمل بمفاهيم جديدة في تنظيم وهيكلة المسرح. فالمنصات المهرجانيّة مثلا بلغت درجة عاليّة من الجودة. وتترابط في ما بينها بحيث تمتد من الصحراء إلى المدينة ومن مسرح الطفل إلى أيام الشارقة وغيرها.