هل يمكن للأدب أن يستقل عن الواقع

تُعدُّ تجربة الاستعمار أو الإمبريالية، بما تحمله من انخلاعٍ ونفي وإقصاء، واحدة من التجارب المهمة والملهمة -على الرغم من قسوتها على الطرف المستعمَر- في تاريخ الشعوب المستعمَرة، فأنتجت خطابات كانت بمثابة كشف هذه الإمبريالية التي تجاوزت الاستغلال إلى الإقصاء والسعي إلى محو تراث وهوية الطرف الأضعف. وقد توقف عندها باحثون من الشرق والغرب أمثال إدوارد سعيد وإقبال أحمد وهومي بابا، وغيرهم.
ينتمي كتاب طوني موريسون “اللعب في الظلام: البياض والخيال الأدبي” الذي اضطلع بترجمته الدكتور محمد مشبال، وصدر بعنوان “صورة الآخر في الخيال الأدبي”، والصادر حديثًا عن دار كنوز المعرفة بعمان 2018، إلى الكتابة التي عنيت بتفكيك الاستعمار عن طريق الرد بالكتابة وفقًا لمقولة بيال أشكروفت. يصدّر مشبال للكتاب بمقدمة غاية في الأهمية بعنوان “في بلاغة النص الأدبي”، يستقصي فيها غايات النقد الأدبي الذي تحوّل على يد الشكلانيين وغيرهم إلى علم ذي موضوع مستقل، بحيث يجب على الناقد وهو يبحث عن القوانين والبنيات أن يتخلى عن ذاته الوجدانية والتاريخية.
بلاغة النص الأدبي
يتطرق محمد مشبال إلى شيوع وهم الدعوات التي طالبت باستقلال النص الأدبي عن ظروفه التاريخية والاجتماعية والسياسية، ثم استقلاله عن صاحبه في حقل وتصورات النظرية الأدبية الحديثة، والاكتفاء بدراسة أدبية النص الأدبي. وهي الدعوات التي بدأت منذ صعود الرومانسيين إلى تنامي حركات وتيارات ترفع شعار الفن للفن، ويعزو إليها أنها كانت السبب الرئيسي وراء تقلُّص البلاغة بمفهومها الشّامل للخطاب، وتحويلها إلى مجال ضيق خاص بدراسة الأسلوب. ولم تَسْتَعِد البلاغة حيوتها وقدرتها على دراسة النص بوصفه خطابًا تواصليا فعالاً إلّا مع إنجازات النظريات اللسانية التداولية ونظريات الحجاج المختلفة، وكذلك إلى تراجع البنوية أمام صعود ما بعد البنيوية التي استفاد منها نقاد ما بعد الاستعمار في صياغة أفكارهم عن النص الأدبي.
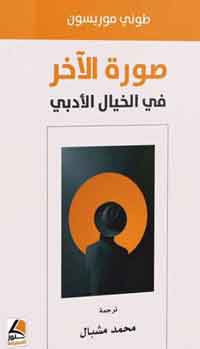
فقد صارت البلاغة -كما يشير مشبال- تمتلك اليوم كل الظروف الملائمة للإسهام في بناء تصوُّر عن النص الأدبي ينسجم مع التصورات والاتجاهات النقدية التي نادت بإرجاع النص إلى سياقه الذي انبثق عنه، والنظر إليه بوصفه خطابًا لا يكتفي بوصف العالم وتصويره، إنما يروم أيضًا تغييره بإحداث تأثير عملي في المتلَقِي. ومن ثمّ يُقدّم تصورًا لهذه الرؤية البلاغية للنص الأدبي، حيث تنظر إلى النص الأدبي بوصفه تمثيلاً ثقافيًّا. كما أن النص الأدبي يحيل إلى الواقع وإلى العالم، ولا يمكن تصوره بوصفه مكتفيا بذاته.
ويرى مشبال أن وظيفة الناقد هي وضع النص في خطابه الدنيوي، الذي صدر عنه وتشكَّل فيه، بدلاً من الاكتفاء بعزل النص بدعوى البحث عن أدبيته؛ أي أن النقد مُطالبٌ بالكشف عن الوظيفة الثقافية والأيديولوجية للنصوص، بدل العكوف على فحص قيمه الجمالية.
يتخذ مشبال من الدراسات التي اعتمدت على التجربة التاريخية للنص مجالاً لترويج المقاربة البلاغية التي يرمي إليها في دراسته؛ فدراسات إدوارد سعيد -خاصة “الإمبريالية والثقافة”- كانت رفضًا كاملاً للمقاربات التي سعت إلى عزل النص الأدبي عن سياقاته التي تشكّل فيها وكذلك عن منتجه. ومن ثم يتبنى أفكار إدوارد سعيد التي بثّها في كتاباته خاصة في كتاب “الإمبريالية والثقافة” حيث يقر بتورط الثقافة في الجانب الدنيوي، إذ الثقافة كما يقول “مجال متواشج مع مجالات القوى السياسية والعنصرية والاضطهاد والاستيلاء وفي كل المجالات التي درج النقاد على تجاوزها في قراءاتهم للأعمال الأدبية العظيمة”.
يتوقف مشبال في مقدمته عند هذه الأعمال التي تناولت الآخر، ويحلل ما جاء فيها، وإن كان يؤاخذ محمد أنقار على أنه لم يطالب الرواية الإسبانية بإنصاف المغاربة والسُّمو بهم، إنما طالبها بالامتثال لأصول الرواية في تصوير النماذج الإنسانية والفضاءات المغربية بدل الامتثال للأيديولوجيا الاستعمارية العرقية. فكان تركيز أنقار على علاقتها بأصول الفن الروائي، ومن ثمّ فليس أمام الرواية الاستعمارية الجيّدة والمقنعة سوى الانخراط في جدل حقيقي بين الأيديولوجيا وبين مستلزمات الفن.
الخيال الأميركي

تسعى المؤلفة طوني موريسون إلى الإجابة عن تساؤلات من قبيل: ما هي علاقة الأفريقانية بالخيال الأدبي؟ وكيف أدّت عملها؟ وتخلص إلى أن ندرة الأبحاث حول هذا الموضوع الواسع، ترجع إلى أن الخطاب الأدبي اتسم تاريخيًّا في القضايا العرقية بسيادة الصمت والعزوف. اللافت أنها لم تنشغل بالبحث عن الصورة السّلبية للشخصية السوداء، ولا بتورط الكتّاب الأميركيين في الأيديولوجيا العرقية، وإنما طمحت إلى الإجابة عن سؤال: كيف يتصرف التخييل الأدبي عندما يتخيّل الآخر الأفريقاني أو عندما يصطدم بالأيديولوجيا العرقية؟ كما أن الأفريقانية وفقًا لمفهوم موريسون ظلت حقلًا مهمَّشًا وغائبًا في الخطاب النقدي؛ فهناك ما يشبه العمى النقدي المقصود لأسباب مختلفة يحيط بحضور السُّود ودورهم في الأدب الأميركي. فالاهتمام بالسَّواد والعرق في الرواية الأميركية يمثّل إعادة اكتشاف للأدب الأميركي، وإعادة تأويله في سياق جديد.
وقد انتهت الباحثة في تأمُّلِها السّواد والظلمة والشخصيات السوداء في الرواية الأميركية إلى إعادة اكتشاف هذه الرواية، ورؤية ما تنطوي عليه من تمثيل مجازي واستعاري للحضور الأفريقاني، الذي شكّل وسيلة لتحديد هوية الذات الأميركية باعتبارها ذاتًا حرة ومحبوبة وقوية وتاريخية وبريئة، كما شكّل أداة وفق قول مشبال لتحديد أهم سمات الأدب الأميركي، وهي الفردية والذكورية والالتزام الاجتماعي، مقابل العزلة التاريخية، والإشكالات الأخلاقية الحادة والغامضة. ومن هنا تجاوزت الباحثة فحص الحضور الثانوي للسود والسواد في الرواية الأميركية عرقيًّا وثقافيا ووجوديًا، إلى استجلاء تأثيره وأهميته الجوهرية بالنسبة إلى أولوية الرجل الأميركي الأبيض الجديد.
قامت الباحثة بتحليل أعمال إدغار آلان بو، ومارك توين وكذلك إرنست همينغواي وقد أقرت بأن مفهوم الذات الأميركية عند الأخير وثيق الصّلة بالأفريقانية. وكشفت لها رواية مارك توين “هاكليري فين” عن مركزية الحضور الأفريقي؛ فالحرية البيضاء ذات طبيعة طفيلية، لا معنى لها دون شبح الاسترقاق ودواء النزعة الفردية، ومن دون عصا القوة المطلقة المسلَّطة على حياة شخص مُختلف. وفي أعمال همينغواي ذكرت أن الكاتب سعى إلى رسم تحوّل الأفريقانية الأميركية من أغراضها التبسيطية والخطيرة في إقامة الاختلاف التراتبي نحو خصائصها البديلة، كتأملات مستبطنة لفقدان الاختلاف.
لا تتميز مقاربة طوني موريسون بأنّها بَعُدَتْ عن الخطاب الأيديولوجي المباشر وتحاشت الخوض في قضايا من قبيل الأدب العنصري أو اللاعنصري، أو مواقف الكتاب من العرق، فحسب بل اتسعت رؤيتها لتشمل الاهتمام برؤية ما تحدثه الأيديولوجيا العرقية في ذهن الأسياد وخيالهم وسلوكهم، وذلك بتأمُّلها في صيغ هذا الحضور المقهور ودلالاته التخييلة والأيديولوجية. وهو ما قادها في النهاية إلى تأمُّل الشخصية الأميركية في ذاتها. باختصار إن مفهوم الذات الأميركية وخصائصها مرتبطان بالأفريقانية.
توصلت طوني في مقاربتها النقدية إلى أن الأعمال الأدبيّة مجال للتواصل الإنسانيّ بأوسع معانيه وأغناها. كما أنّ النصَّ الرّوائي ليس نصًّا مُنغلقًا، أو بناءً جماليًّا يمكن توصيفه في عالمه الداخليّ، إنما هو خطاب الإنسان في فضاء جغرافي معين ومرحلة تاريخية.




