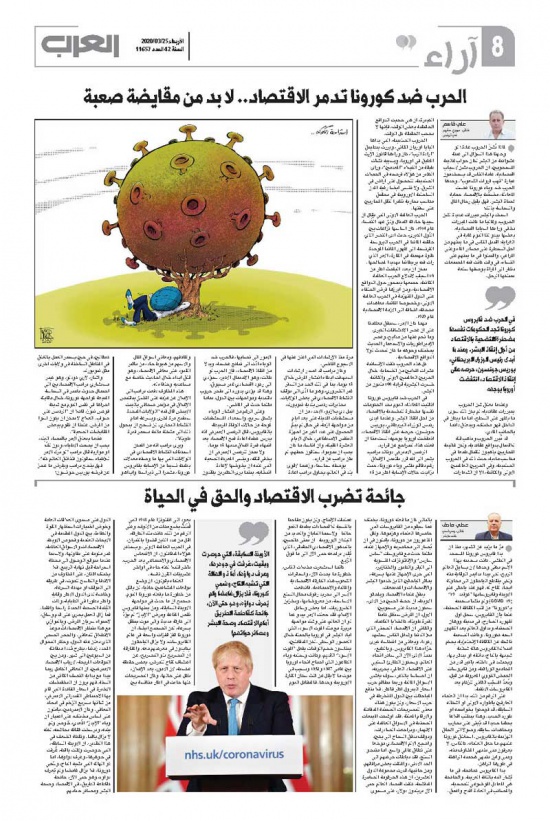هل يكون المنفى حافزا إبداعيا؟

يحتلّ المنفى سواء كان قسريا أو اختياريا مكانة بارزة في آداب العالم القديمة، والحديثة على حد السواء.
وفي البعض من الحالات قد يكون المنفى مُهْلكا ومُدمّرا. ورامبو قد يكون أبرز مثال على ذلك. فقد ظل لسنوات طويلة يتذمر من “مسيحيته المتعفنة”، ومن الثقافة الأوروبية التي كانت تبدو له شبيهة ببيت العنكبوت، متمنيا أن يطير بعيدا بحثا عن الخلاص. وذات يوم، طلّق الشعر، وانطلق إلى أفريقيا ساعيا للعثور على النار التي “تدفّئ عظامه الباردة”. إلاّ أنه عاد من هناك وهو يحتضر ليموت في بلاده ميتة شنيعة.
لكن في حالات عديدة، يمكن أ ن يكون المنفى حافزا إبداعيا. وتشهد على ذلك القصائد العظيمة التي كتبها أوفيد في منفاه القاسي على البحر الأسود بعيدا عن أهله، وعن موطنه. ويزخر العصر الحديث بالعديد من المبدعين الكبار الذين اختاروا أو أجبروا على العيش في المنفى.
ولعل الكتّاب والشعراء البريطانيين هم أبرز من خيّرُوا العيش في المنفى على العيش في بلادهم، مبدعين أعمالا هامة بعيدا عنها، لكن من دون إهمالها أو نسيانها. ومن أشهر هؤلاء يمكن أن نذكر دي. هايتش لورنس، ومالكوم لاوري صاحب رائعة “فوق البركان”.
وفي سنوات شبابه، ترك جيمس جويس موطنه أيرلندا التي كان ينعتها بـ”التروتة المتعصبة التي تلتهم أبناءها” ليمضي بقية حياته متنقلا بين ترياست الإيطالية، وزيوريخ السوسرية، وباريس الفرنسية.
وفي منافيه الثلاثة، أبدع جويس أعماله الأساسية “صورة الفنان في شبابه” و”أوليسيس” و”يقظة فينيغن”. وفي جميع هذه الأعمال ظلت أيرلندا رغم كرهه لها، حاضرة ومتوقدة حتى أنه قال ذات مرة إنه لو دمرت دبلن العاصمة لأعيد بناؤها بحسب الجغرافيا التي رسمها لها في “أوليسيس” التي يروي فيها يوما واحدا من حياتها عبر شخصيات متعددة ومختلفة في التفكير وفي الطباع.
ونفى صاموئيل بيكت نفسه بنفسه منذ سنوات الشباب لينهي حياته في مأوى للشيوخ في باريس التي أقام فيها الشطر الأكبر من حياته. ويعجّ تاريخ الأدب الأميركي الحديث بأسماء كتاب وشعراء بارزين اختاروا هم أيضا العيش في المنفى مثل إزرا باوند، وهنري ميللر، وهمنغواي، وبول بولز الذي أقام في طنجة منذ الخمسينات من القرن الماضي وحتى وفاته في الثامن عشر من شهر نوفمبر 1999. وكان السويسري بليز ساندرار الذي أمضى الشطر الأكبر من حياته متنقلا بين القارات الخمس قد كتب ذات مرة يقول إنه “لا ينتسب إلى أي بلد”، لأن “الشعر هو موطنه الأصلي والنهائي”.
ونحن نعلم أن ما سمّاه النقاد “الأدب المهجري” كان له تأثير على مسار الثقافة العربية، مُحدثا تحوّلا هائلا في النثر والشعر. كما أن جميع المنتسبين لهذا الأدب هم لبنانيون أجبرتهم ظروف العيش، والمظالم المسلطة على مجتمعهم من قبل السلطات العثمانية على الفرار إلى المنافي ليعيشوا في أميركا الجنوبية، وأميركا الشمالية.
وقد ساعدهم إتقانهم للغة الإنجليزية على الاطلاع على التيارات الجديدة في النثر كما في الشعر ليبدعوا أعمالا مهمة كان لها تأثير على أجيال من الأدباء والشعراء مشرقا ومغربا.
ولعل الإقامة الطويلة في فرنسا بهدف الدراسة هي التي سمحت لطه حسين بأن يزرع في الثقافة العربية بذور الحداثة والتنوير. وفي حين خيّر نجيب محفوظ البقاء في بلاده ليبدع أعماله التي خوّلت له الحصول على جائزة نوبل للآداب، خيّر توفيق الحكيم أن يسافر إلى باريس بهدف استكمال دراسته، لكنه تخلّى عن ذلك ليمضي سنوات هناك متسكعا بين المكتبات والنوادي والمتاحف والمسارح.
وفي ما بعد سوف تسمح له تلك التجربة بكتابة العديد من الأعمال الروائية والمسرحية ليكون واحدا من أعمدة الأدب العربي الحديث. وأما الطيب صالح فقد أتحف المكتبة العربية برائعته “موسم الهجرة إلى الشمال” التي تصوّر بطريقة آسرة ضياع مثقف سوداني في منفاه في لندن… أن نجد فنانين وكتابا وشعراء وروائيين.
والآن تعددت المنافي العربية بسبب الأزمات السياسية والاجتماعية والثقافية التي تتخبّط فيها البلدان العربية. وفي مدن وعواصم القارات الخمس يقيم كتاب وشعراء وفنانون من مختلف البلدان العربية. وجميع هؤلاء أنتجوا أعمالا مهمة سواء في مجال الشعر أو النثر أو الفكر أو الفن بجميع أشكاله من مسرح وسينما وموسيقى وفنون تشكيلية.
وباستثناء قلّة قليلة اختارت الكتابة بلغة البلد المُسْتَضيف، حافظ أغلبيتهم على لغتهم الأم. وظلت أعمالهم، مفتوحة على هموم أوطانهم، وعلى أزماتها ومشاكلها.
لكن خلافا للأدب المهجري الذي حظي بمتابعة هامة وعميقة من جانب النقاد ومؤرخي الأدب، ظلت أعمال المهاجرين العرب الجدد، وهم بأعداد وفيرة، مُهملة إلى حد كبير. وصحيح أن هناك متابعات صحافية لها، لكن المتابعات النقدية الجادة التي تبرز مختلف جوانبها لا تزال غائبة.