هل يقتل الأدباء آباءهم لأسباب جنسية

تبدو العلاقة بين الآباء والأبناء في ظاهرها علاقة مبنية على مشاعر متباينة تجمع بين الحب والاحتواء من طرف الأول (الأب) للثاني (الابن)، والاحترام والطاعة من جانب الثاني للأول، إلا أنها في باطنها قائمة على صراع متبادل بين طرفين؛ فالأول يريد احتواء الثاني بعدم الخروج عن طوعه وإرادته، في حين يسعى الثاني إلى التمرّد على الأول. وهذه العلاقة بين الآباء والأبناء نجدها تتجسّد بشكل كبير في عالم الأدب والأدباء.
عبّر الكاتب المصري نجيب محفوظ (1911 – 2006) في مشهد رائع في رواية “قلب الليل” (1975) عن الصراع بين الأب والابن على لسان محمد شكرون لجعفر الراوي عندما سأله عن موقف جده من أبيه، فقال “علاقة الأب بابنه علاقة غامضة على الرغم من وضوحها السطحيّ، أحيانا يتدفق منها الحنان وأحيانا تتجمد بالقسوة، عَرَجي هذا الذي تراه ما هو إلا عاهة صنعها أبي في ساعة غضب، أما أخلاق الرجل الحقيقية فتُقيَّم على ضوء علاقته بالآخرين..”.
والجدير بالذكر أن هذا الصراع، صراع أزلي، قديم لم (ولن) يُحسم لصالح أحدهما على الإطلاق على حساب الآخر الشريك في علاقة معقدة ومتشابكة في آن معا؛ لأن المتحكم في هذه العلاقة على تعدُّد أسبابها هو العاطفة فحسب، والعاطفة لا أحد يستطيع التحكم فيها، وتوجيهها حيثما يريد أحد الأطراف من الطرف الآخر.
ومن ثمّ شاب هذه العلاقة الغموض تارة والصّراع في مرات عديدة؛ لذا تشتمل هذه العلاقة على شعوري الحب والكـراهية المتزامنين نحـو الأب، وهذا يرمز إلى الصّراع الأبدي القائم بين كراهية الأب وحبه؛ أي بين الخوف منه كمصدر للخطر والشعور به كمصدر للأمن في وقت واحد. وقد صاغ سيجموند فرويد (1856 – 1939) من هذه الجدليّة نظريته عن العقدة الأوديبيّة التي هي “مجموعة من الأفكار والتصـوُّرات اللاشعوريّة، المثقلة بشحنة وجـدانيّة قويّة متناقضة في مضمونها الانفعالي تجاه الأب”.
الأب البديل
يشير فرويد في كتابه “الغريزة والثقافة” (1930) إلى أن هناك أحداثا صغيرة مرّ بها الأبناء في حياة الطفولة تتسبّب في نشوء مزاج عَكِر، يدفعهم في مرحلة لاحقة إلى انتقاد الآباء، أو ما يوازي الرمز الأبوي في مخيلتهم في مراحل لاحقة، كالرؤساء والمديرين والقادة..إلخ.
اللافت أن الانفعالات العدوانيّة التي يصيغها الأبناء في صورة انتقادات تكون موجّهة إلى الأب وليس إلى الأم، ومن ثمّ يكون الميل إلى التحرّر من الأب وليس من الأم.
وفي مرحلة البلوغ يعتقد الأبناء أن تحقيق الأماني، على حد نظرية فرويد، يمثّل تصحيحا للحياة نفسها، وفي ذلك يتبع هدفين بالدرجة الأولى وهما: الشهوة الجنسيّة والطموح، وفي نفس الوقت تنشغل فانتازيا الطفل في هذه المرحلة بمهمة محددة ألا وهي “التخلّص من الأبوين المستهينين به وتعويضهما عادة بمن هم أرفع منزلة اجتماعية”.
محاولات وتمثيلات قتل الأب في الأدب ما هي إلا تجسيد فعلي لصراع واقعي بين الآباء والأبناء الأدباء وآبائهم الحقيقيين
اللافت أن فرويد يعود ويقول إن مراجعة الخيالات الروائيّة، أي تصورات الأبناء للآباء في مخيلتهم، تأتي عوضا عن الآباء الحقيقيين، أي فكرة تعويض الأبوين، أو إبدال الأب بمن هو أفضل منه شأنا، فبعد المراجعة ستكشف أن الأبوين الجديدين والنبيلين يحملان عموما ملامح الأبوين الحقيقيين ذوي الأصل المتواضع.
وهو ما يعنى أن محاولة رفع الابن الأب، لأب أعلى منه منزلة، لا يعني إلغاء الأب على الإطلاق، وإنما هي مجرد “تعبير عن حنين الطفل إلى الزمن السعيد المفقود الذي بدا فيه أبوه من أشد الرجال نُبلا وقوة، وكانت فيه أمه من أطيب النساء وأجملهن على الإطلاق”، وهو ما عبّر عنه أورهان باموق تعبيرا جيدا في ترسيم علاقته بأبيه بقوله “إننا لا نريد آباءنا أن يكونوا أفرادا، إنما نريدهم أن يكونوا متوافقين مع المثال الذي نرسمه لهم”.
وإن كان بول ريكور في صراع التأويلات يتخذ من تحليلات فرويد عن العقد الأوديبية ذريعة ليقول إن “نقطة النقد في الأوديب تكمن في البحث في التأسيس البدئي للرغبة، أي في جنون العظمة الذي ألمّ بها، وفي كل القدرة الطفولية. إذ أن منها يصدر استيهام أب يُمسك بامتيازات يجب على الابن أن يستولي عليها لكي يستطيع أن يكون هو ذاته”.
قتل الأب أدبيّا
جسّدت الأعمال الأدبيّة نظرية قتل الأب، التي ردّها فرويد إلى اعتبارات جنسيّة بحتة، خير تجسيد، وقد قدّمت مرويات عديدة نماذج صارخة لحالات/ شخصيات تسعى إلى التحرّر من هذه العلاقة بالتخلّص من الأبوة.
وفي رأيي إنّ هذه المحاولات والتمثيلات ما هي إلا تجسيد فعليّ لصراع واقعي بين الآباء والأبناء (الأدباء وآبائهم الحقيقيين) حيث تَعرَّض قطاع كبير من الأدباء في حياتهم العائلية لطفولة خشنة، عانوا فيها من فرط قسوة الأب وإهماله، وهو ما انعكس على إبداعهم في ما بعد، فحفلت سيرهم الشخصيّة وكتاباتهم الروائية بتمثيلات لصورة الأب القاسي، والمهمِل، وما تبعها من محاولات دؤوبة لقتله ولو مجازيّا على الورق، وإن كان بعضهم جنح خياله لمحاولة قتله فعليًّا.
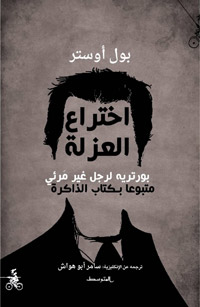
وقد تراوحت صيغ التعبير عن صراعية العلاقة بين إنكار تام لنسبه كما فعلت الكاتبة التركية أليف شفق التي تنازلت طواعية عن حمل لقب عائلة أبيها لصالح اسم أمها، كفعل رمزي وصريح لحالة الرفض/ القطيعة لشخص لم تره أبدا، ومن ثمّ قررت ألا تحمل لقب عائلته، فهو لم يقم بما يجب (طبيعيّا) ناحيتها، كي ينال شرف الأبوة.
وبالمثل أحال فرانز كافكا (1883 – 1924) كل التعاسة التي كان يعيش فيها لمعاملة والده له، فجاءت رسالته إليه (رسالة إلى والدي) بمثابة إعلان تمرد صريح على هذه الأبوة بل ومحاكمتها على الورق، فيقول “أنت خلقت كل كتاباتي، لقد قلت فيها ما لا أستطيع قوله، وأنا على صدرك” وتارة ثانية يقول لميلينا في إحدى رسائله “إن والده الذي كان يعمل بتجارة الخردوات كان جزءا من التعاسات وهو سبب كل معضلة تصيبه”، وعندما كان يعجز عن مواجهته كان يلجأ إلى الكتابة. أما دوستويفسكي، فقد كان يكره ويمقت والده مقتا شديدا، نظير ما عاناه منه وكان يتمنى أن يقتله، مع أن الرسائل المتبادلة بينهما كانت تشي بعكس ما كان يضمره تجاهه.
وجاءت كتابات ديفيد هربت لورانس (1885 – 1935) صاحب رواية “عشيق الليدي تشاترلي” (1928) تجسيدا لهذه العلاقة المتأزمة بينه وبين أبيه، وهو ما صوّره بصورة تفصيليّة في روايته “أبناء وعشاق” (1913) حيث عكست الرواية أزمته العائليّة، فحسب فلسفته أن الأسرة التي لا يأخذ فيها الأب دوره الرئيسي تُعدُّ، بمقاييسه، “أسرة مفكّكة وهشة وهي عُرضة للدمار تدمرها العُقد النفسيّة التي تظهر نتيجة العلاقات الأسرية المريضة”، وهو ما برع في تصويره عبر شخصية الابن (بول)، الذي نراه يعجز عجزا تاما عن منح حبه لـ”ميريام” الفتاة التي أحبها، فعجزه هو نتيجة لأثر علاقته المتأزمة بأبيه.
ومع هذه الإشارات المتناثرة هنا وهناك، إلا أن ثمة أدباء أوقفوا جزءا من أعمالهم للتعبير عن هذه العلاقة الإشكالية، على نحو ما فعل الأميركي بول أوستر، وكافكا، ومحمد شكري، وغيرهم. وفي المقابل هناك مَن أَجَلَّ الأب وأعطى له مكانة متميزة، على نحو ما فعل التركي أورهان باموق، فخص الأب بنصين أدبيين كشف من خلالهما تأثير والده الفكري عليه، وأنه نتاج هذه المعرفة التي غرسها الأب، وهو ما كافأه عليه في خطاب نوبل، وردَّ له جُزءًا من الأمانة.
في هذه المقالة سأتوقف عند تمثيلات لعلاقة الصراع هذه بين الآباء والأبناء من خلال السير الذاتية والمذكرات الشخصية، والمراثي وأيضا الرسائل التي كتبها أدباء من الغرب والشرق، وكيف تجسدت صورة الأب في المخيال الأدبي من خلال لحظات البوح والاعتراف التي تتيحها كتابات الذات. فالصورة، كما تبدو، أكبر من مجرد قتل للأب على الورق، بقدر ما هي مصالحة وتكفير عن خطيئة فكرة القتل، نفسها، الماثلة في «الجزء الملوّث من القلب» على حد تعبير ويليام بتلر ييتس في إشارته إلى أنّ للفن جذورًا غير محبّبة تكمن في هذا الجزء الملوّث.
بقلب بارد
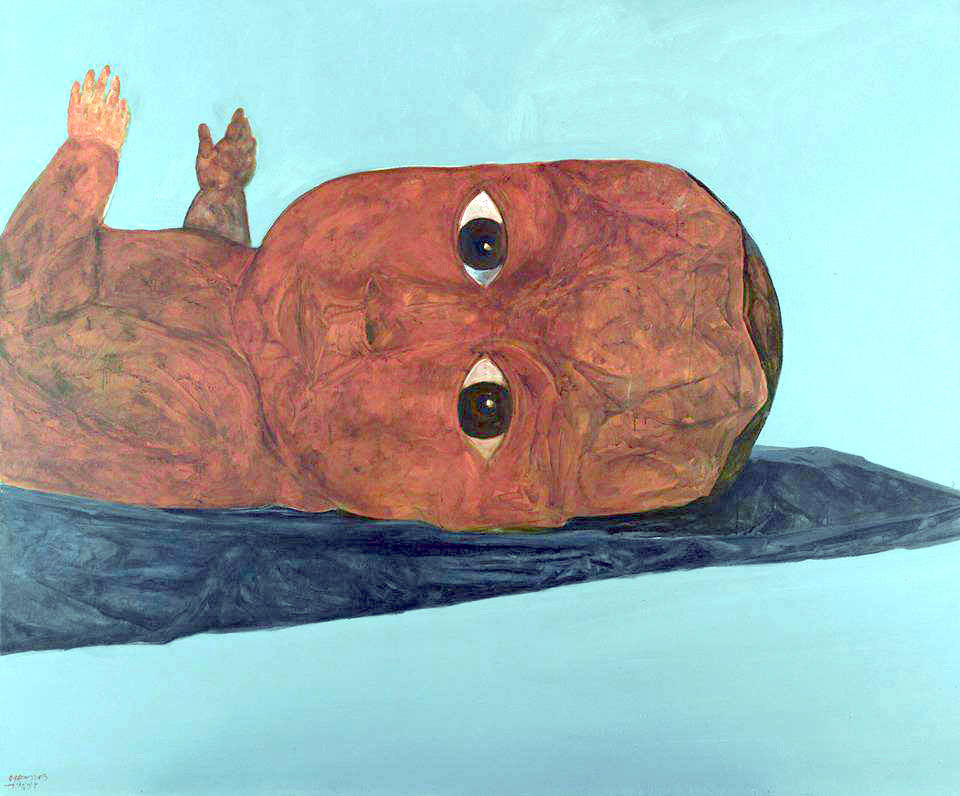
من أكثر الأدباء الذين عبّروا عن حالة من الحنق والغضب إزاء الأب الكاتب الأميركي بول أوستر (1947). ففي كتابه “اختراع العزلة” (1982) يُجرِّد الأب من كل صورة إيجابيّة، بل نراه يتجرأ عليه في مواضع عدة، فالأب عنده “شخصية خيالية، رجل ذو ماضٍ مُظلم، أما حياته الحاضرة فلم تكن سوى محطة وقوف
فقط”، لذا نراه يسعى إلى قتل الأب بالمعنى المجازي، على الورق، باستدعاء مواقف تخاذّله في حقهم، فيجرده من صفات الأبوة وأيضا من الصّفات الإنسانيّة بصفة عامة.
وهو ما ينعكس عليه عندما يأتي له خبر وفاته نراه يعترف “إنني لم أذرف دمعا، ولم أشعر بالعالم يتهاوى من حولي،
ويا للغرابة، لقد كنت مُستعِدّا بشكل لافت لتقبّل هذا الموت على الرغم من بغتته. إن الذي شوّشني حقًّا كان أمرا آخر، أمرا لا علاقة له بالموت أو ردّة فعلي نحوه: اكتشفتُ أنّ أبي لم يترك وراءه أيّ أثر”.
كما يصف الأب بالبخل، فيحكي عن مساومته للباعة، وعدم ذهابه إلى السينما بسبب أن الأفلام ستُعرض في التلفزيون بعد عام أو عامين، وكذلك ذوقه في الملابس كان متأخّرا
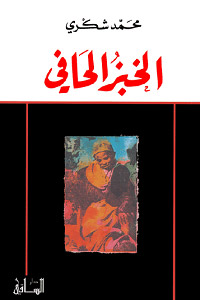
عشرين سنة، واعتزاله الناس واحتفاظه بأشياء في منزله تَنمُّ عن إنسانٍ حريص إلى حدّ البخل والتقتير الشّديدين. كما يتهمه بأنه كان السبب في ما خلقه في نفس أبنائه من خذلان وكسر لهمّة الابن، لدرجة عدم الوثوق في إنبائه بخبر سعيد، وهذه الحالة دفعت الابن للتشبُّث بالأمّ، التي دائما ما يَصفها الأب بأنها ستفسد الابن، لكن المساحة الفارغة التي تركها الأب جعلت الابن يبحث عن بديل يعوِّضها ويملأ فراغ الأب، ولم تكن سوى الأم التي استغلت حالة المرض التي أُصيب بها الطفل كمبرِّر للدفاع عن هذا الالتصاق بينهما.
وقد كان مرض أخته عاملا مهمّا كي يرى الابن الأبَ في صورة المتخاذل الذي لم يقم بدوره إزاء أخته ومرضها، فالابن يتهم الأب بأنه لم يقم بواجبه في انتزاع أخته مما أصابها، بل كان مكابرا ورافضا فكرة ذهابها لطبيب نفسي من الأساس. وكأنّ الابن يشير بأصابع الاتهام إلى أَبيه في ما أصاب أخته مِن مرض انتهى بها لأن تكون أسيرة علاج كيميائي لم يكن ناجعا وقتها.
ويرسم نيكوس كازنتزاكس (1883 – 1957) في “تقرير إلى غريكو” (1956) صورة للأب نقيضة لصورة أمه التي اعتبرها قديسة، فكما وصفها “لها صبر الأرض واحتمالها وعذوبتها”، في حين الأب يأتي في صورة زنديق لا يحب القساوسة ولا يؤدي طقوسا دينيّة البتة.
فنراه يستعرض علاقته بوالديه، في فصل خاص بالأب يشير إلى حالة من السلبيّة كان عليها؛ فلم يكن مشاركا له في أي شيء، وليس لديه أيّ ردة فعل إزاء ما يتعرض له، بل هو عاجز حتى عن الدفاع عن نفسه. وفي علاقته به لم يكن ودودا، فلم يسمع منه كلمة تنمُّ عن مشاعر حبّ أو دعم باستثناء مرة واحدة يذكرها على استحياء، وكأن إظهار العواطف، في نظره، خيانة للنفس. ومن شدة نفوره يصفه هكذا “كان كالحا لا يحتمل”، كما أنه منطوٍ لا يودُّ المشاركة في الفعالية أو الزيارات الاجتماعية، دائما ينزوي في ركنه الخاص، يكون منشغلا بكيس تبغه.
لم يقتل أحد الأب بقلب بارد مثلما فعل الكاتب المغربي محمد شكري (1935 – 2003) في سيرته “الخبز الحافي” (1972)، فهو لم يترك نقيصة إلا وألصقها به، دون تقوّل أو تحيّز ضده، فالأب عند شكري هو رديف للتسلُّط والاستبداد والقهر، حتى بدت صورته “مثل عملاق يتحكم في الأقزام. نحن كنا أغنامه. يستطيع أن يبدأ بذبح من يشاء. أختي ارحيمو منكمشة على نفسها وأمي تبكي”.
إضافة إلى أنّه متهاون في مسؤولياته وعاجز عن واجباته، ومدمن للمخدرات، ويتحول في عنفه إلى وحش كاسر في هجومه على أمه المستكينة، وقد انتهى به الحال في إحدى نوبات هيجانه إلى قتل أحد أبنائه. وإزاء هذه المواقف كان يتمنى شكري قتله فعليّا ليخلّص أمه وأخته من هذا الأب المتسلّط، فكما كان يقول في استيهاماته “في الخيال لا أذكر كم مرة قتلته. لم يبق لي إلا أن أقتله في الواقع”.




























