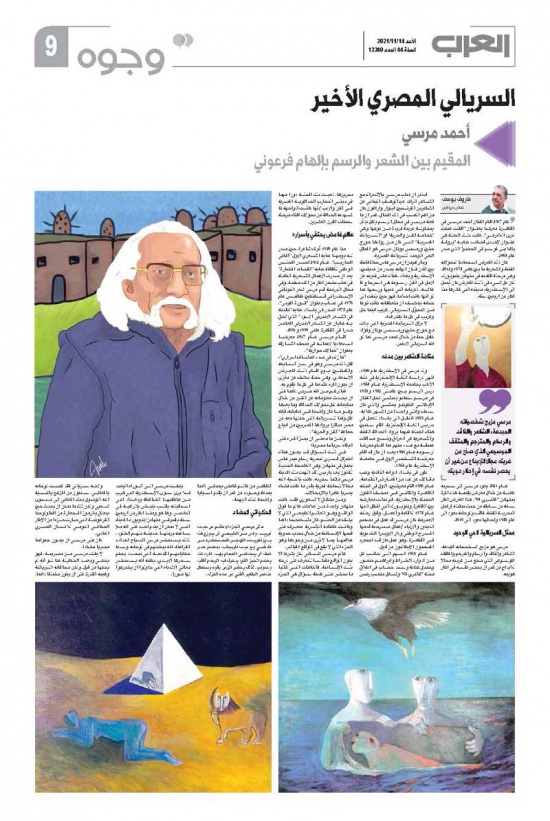هل صمتت الرواية العربية حقا عما جرى من مآس للمجتمع العربي؟

شهدت السنوات العشرون من القرن الماضي حروبا ونزاعات في العديد من الدول العربية مثل العراق، اليمن، لبنان، سوريا وليبيا، نتجت عنها إصابة المجتمعات بمآس جراء الاقتتال الأهلي وخروج جماعات الإرهاب وما ارتكبته من جرائم وحشية، فضلا عن ترد في الأحوال المعيشية والهجرات الجماعية شرقا وغربا وما جرى للمهاجرين من اضطهاد، كل ذلك وأكثر شهدته العديد من المجتمعات العربية ومع كل ذلك لم تقدم الرواية العربية معالجات كاشفة بحجم وعمق تلك المآسي. وهو ما نسأل عن سببه مجموعة من الأدباء والنقاد العرب.
بلغت وحشية الواقع الذي عاشته وتعيشه كثير من المجتمعات العربية حدا مرعبا ومهددا للوجود الإنساني في الحاضر والمستقبل، فيما لم يستثمر الأدب الروائي ما يحدث بشكل جيد.
وهذا التحقيق الذي اختلفت رؤى المشاركين فيه جاء انطلاقا من الرأي الذي كتبه الدكتور هيثم الزبيدي في مقاله في “العرب” بعنوان “كثير من التجارب وكثير من الصمت”، حيث رأى أننا لم نر في الرواية العربية “تجربة الحرب. تجربة التهجير. تجربة الجوع. تجربة اضطهاد اللاجئ من قبل أفراد في بلد اللجوء. تجربة احتيال اللاجئ. تجربة الهجرة إلى أوروبا. تجربة الحرب بعين الضحية. تجربة الحرب بعين القاتل. تجربة الجندي المجبور على القتل. تجربة الطائفي المتفاني في القتل. تجربة نساء دواعش. تجربة العيش في مدينة تسهر لوجه الصبح في حانات وهي محاطة بسلفيين ينتظرون الفرصة للانقضاض عليها. تجربة أئمة كذب ونفاق. تجربة وهم بالقادة”.
تساءلت “العرب” عن أسباب هذا التجاهل وتلك الغفلة وهذا الصمت من جانب الروائيين والقاصين؟ هل وراءه انكفاء على الذات وانشغال بها وبعد عن الهم القومي سواء كان عربيا أو محليا؟ وقد اختلفت الآراء واتفقت كما سيتضح في السطور القادمة.
الروائيون عاجزون
بداية يقول الروائي شريف العصفوري إن هناك أعمالا كثيرة لروائيين وقصاصين من العراق وسوريا ولبنان، تتحدث عن الهجرة والحروب الطائفية والاحتراب الأهلي، لكن هناك جهات تأبى الالتفات للأعمال والمخاطرة بمواجهة ردات الأفعال.
ويضيف “أعمال كثيرة مصرية تناولت الأصول الفكرية للسلفية الثقافية أو السلفية الجهادية، هناك رواية ‘مولانا‘ مثلا لإبراهيم عيسى التي تتصدى لعلاقة السلطة بالسلفية الثقافية، وإشكاليات الثقافة السلفية السائدة. المواجهة المباشرة لكل القضايا التي ذكرتها ستجعل من الكثيرين أعداء أيديولوجيين، وتذكي الاستقطاب الحاصل فعلا، بالتالي عدم النجاح التجاري في المبيعات”.
ويتابع “السلطة الثقافية العربية انتقلت قيادتها للجوائز الكبرى (الشيخ زايد، كتارا، الشارقة، بوكر العربية) وكلها جوائز في دول محافظة ولها أجندات محافظة، والدولة المصرية بمؤسساتها الثقافية بين نارين، التنوير ‘فعل ثوري‘ و‘تثبيت الواقع‘”.
ويؤكد الروائي العراقي شاكر نوري أن الرواية العربية العظيمة لم تولد بعد، إذا ما استثنينا عبدالرحمن منيف الذي قارب تحولات العصر، فلا تزال الرواية العربية غير قادرة على التعبير عن تحولات المجتمع الكبيرة. فليست لدينا رواية حرب كما في رواية “الحرب والسلام” لتولستوي أو رواية “الأمل” لأندريه مالرو ولا توجد لدينا رواية تأمل مثل رواية “البحث عن الزمن الضائع” لمارسيل بروست أو رواية “يوليسيس” لجيمس جويس.
ويرى أنه على الروائي أن يكشف القصص العظيمة في واقعنا لكن القصور لا يأتي من الواقع العربي الملتهب بل من الروائيين العاجزين عن مقاربة الموضوعات الكبيرة. ولا تقتصر الرواية على كتابة الموضوعات بل يجب أن تقدم كل ما هو جديد في عالم التقنيات السردية التي وصلت إلى أوجها. ولا يوجد إبداع دون الإبداع في اللغة وإيجاد التقنيات السردية الجديدة.
ويضيف “أستطيع القول بكل ثقة إن الواقع العربي يتجاوز مخيلة الروائيين العرب. أما عن موضوع الهم الجماعي فلا أعتقد أنه يمكن الفصل بين الذاتي والجماعي لأنهما مقترنان ببعضهما البعض في التعبير الأدبي. في الموضوعي توجد الذات وفي الذات يوجد الموضوعي. للأسف الشديد توجهت أنظار الرواية العربية إلى الجوائز الأدبية. ونحن بحاجة إلى كتابة سردية ملحمية تسبر أغوار الإنسان العربي بكل ما يحمل من أساطير وخرافات”.
ويتابع نوري “يجب على الروائي أن يستكشف آفاق المستقبل. فالرواية فن صعب بحاجة إلى كل الطاقة البشرية بكل ما فيها من ألغاز وأسرار لكي تعانق الأرواح التي شاءت ظروف العالم العربي بكل آلات السلطة والقوة لجعل الإنسان العربي ذلك الكائن الهش والضعيف الذي لا يقوى على مجابهة الواقع، لذا فإنه ضائع بين الهجرة والمنفى وقوى الظلام والإرهاب. لكن الرواية تنتصر في نهاية المطاف لأنها قادرة على رؤية الحقيقة. فالمبدعون لا يخافون من طرح الحقيقة وكما يقول جورج أورويل: الروايات العظيمة لا يكتبها أناس خائفون“.
ويرى نوري أن الحرب إعلان بربري لقوى الظلام على الإنسانية. إنها ثيمة كبرى للرواية، ولكن الرواية العربية لم تقدم لنا نماذج فنية راقية وظلت حبيسة الأنماط الجاهزة، بينما كان من الممكن أن يكون ميدانا إبداعيا كبيرا وساحة فنية وصندوقا للأرواح والنفوس والألغاز. ذلك الفن الذي أبدع فيه الروس حتى راح المؤرخون يستقون من هذه الروايات الحقائق والشواهد.
وفي رأيه إن ما يقال في الرواية لا يمكن أن يقال في أي فن آخر لا في البحث ولا في المقالة ولا في كتب التاريخ. ومن هنا تنبع أهمية الرواية كفن ابتكاري في استقصاء الحقائق الإنسانية التي لا يمكن التعبير عنها إلا من خلال هذا الفن، ولذلك ظلت روايات تولستوي ودوستويفسكي منارات مضيئة في أرواح البشر تقبل على قراءتها جميع الشعوب كأنها ترتدي جلود الروس وأرواحهم. ويتساءل لماذا نكصت الرواية العربية عن مثيلاتها من الروايات الإنسانية رغم واقعنا الغني؟
اصبروا ستأتي الروايات

يقول الناقد والروائي المغربي عبدالرحيم جيران إنه ينبغي عدم الخلط بين الزمان الأدبي والزمان الواقعي، فهما ليسا متساويين. الأول بطيء في التشكل بينما الثاني فوري الوقوع، ومعنى هذا أن الأدب لا يستجيب بسرعة للحدث التاريخي، بل يحتاج إلى وقت أطول ليفعل ذلك؛ فلكي يستطيع أن يعبر عن الموضوع التاريخي يحتاج إلى مسافة زمانية تجاهه، حتى يتوافر له الفهم الجيد. ولنا في الكتابات التي واكبت الربيع العربي خير مثال، فالتسرع وإرادة السبق أديا إلى إنتاج نصوص سيئة نتيجة عدم فهمها لما كان يحدث، وقد نجم هذا الإنتاح السيء عن عاملين: أولا لم يكن الحدث قد استكمل تشكله على نحو متكامل؛ وثانيا عدم اتخاذ مسافة زمانية تجاه ما حدث لكي يتوافر الفهم الجيد له.
ويضيف أنه ونظرا إلى هذه القيود التي تلزم الكتابة فإن التعبير عما يجري الآن في العالم العربي لم يسفر بعد عن الكل الذي يسمح بتفسيره وفهمه. ومن ثمة يحتاج الأديب إلى وقت كاف لفعل ذلك. هذا فضلا عن معايشة الحدث في جريانه الواقعي لم تتوافر أجل المبدعين العرب الذين واكبوه، إما عبر القراءة، وإما عن طريق السماع، وإما بوساطة الميديا البصرية. ولهذا لا يحق معاتبتهم عن شيء لم يعايشوه، ولا بد لهم لكي يفعلوا ذلك من فهم جيد، ولا يتحقق هذا الأخير إلا بالبحث الرصين المنزه عن الأهواء والانفعالات الظرفية، وتصنيع من هذا القبيل يحتاج إلى المسافة الزمانية التي أشرت إليها في ما سبق.
ويشير المفكر والروائي عمار علي حسن إلى أن الرواية العربية لم تهمل الكثير من القضايا الراهنة التي تفرض نفسها على الساحة من المحيط إلى الخليج، لكنها بالطبع لم تجار اللحظة، معبرة عنها كاملة، وهذا أمر لا يمكن أن يُتهم فيه الأدب بالتقصير، لأنه دائما، وفي كل الأمكنة والأزمنة والثقافات يأتي متأخرا بعض الشيء، لكن إتيانه يكون شاملا وضافيا، لا يكتفي باللهاث وراء العابر والمتجدد يوميا والغارق في التفاصيل الصغيرة المتكررة، إنما يغوص إلى الأعماق، ويبحث في التفاصيل عن المنسي والمهمل، غفلة أو قصدا، رغم أنه يمثل جوهر الأشياء، وقلب الأمور ولبها، ومع هذا يتم طمسه وطمره خلف طلاءات مزيفة من الدعايات والشكايات، وخلف جدران شاهقة من أكاذيب السياسة، ومداراة المجتمع، ونفاق المستفيدين، وتجار الأزمات، ومروجي الشائعات.
ويضيف “الروائي، إلى جانب أنه فنان، فهو أشبه بمختص في علم النفس الاجتماعي، لذا عليه أن يتوقف مليَّا أمام ما يجري، ويمعن التفكير والتأمل فيه، كي يصل إلى الحقائق العميقة، والغايات البعيدة. لكن هذا لا يمنعه أحيانا من أن ينخرط في ما يجري، كمشارك فيه، أو معبر عنه في لحظته، بالتصريح الشفاهي أو التدوين على شبكات التواصل الاجتماعي أو كتابة المقال السيَّار، أو مسجلا له أدبيا في طزاجته وفورته، وهو حتى في هذه الحالات، يقدم ما هو مختلف وفارق وأكثر ديمومة”.
ويتابع “أعتقد أنه بعد قرن من الزمن سيكون الأدب العربي مصدرا مهما لفهم ما يجري حاليا، لأن المؤرخين، كالعادة، سيتنازعون الرأي والموقف، فالتاريخ اختيار أو انحياز مهما تجرد كاتبوه، وربما تؤدي كثافة الأحداث إلى غرقهم في التفاصيل السياسية والأمنية والحربية متناسين أن من صنعوا الأحداث هم بشر من لحم ودم، وليسوا آلات صماء محايدة باردة. لن ينتهي العقد الذي نمر به الآن حتى تكون الرواية والقصة والمسرحية، بل والشعر العربي، قد وضعت الرتوش قبل الأخيرة على لوحة أيامنا العصيبة، بحيث يراها كل من يأتي بعدنا مكتملة، ناطقة بفداحة ما يجري“.
ويقول الناقد والروائي الجزائري حمزة قريرة “منذ نحو عشر سنوات بدأت مآسي الوطن العربي على مستويات مختلفة: سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، فالألفية الثالثة كانت إيذانا ببداية عصر جديد بدأناه للأسف بالموت الذي تعدّدت طرائقه من الحرب إلى الجوع إلى التهجير الذي قتل المواطنة فينا، إنه بداية عصر مضطرب بمخاض عسير نحو تشكّل جديد على المستوى السياسي والاجتماعي والثقافي، وأمام كل هذه التحوّلات يُلاحظ تأخر السرد العربي والرواية بشكل خاص، على معالجة هذا التحوّل المتسارع، فرغم الكم الهائل من الروايات التي تصدر يوميا في الوطن العربي إلا أنها عالجت موضوعات مختلفة أغلبها ذاتي واجتماعي محلي، وبقيت القضايا الراهنة محصورة في عدد بسيط جدا من الأعمال الروائية خصوصا للشباب”.
ويتابع “يعود هذا العزوف المؤقت لعدة أسباب أهمها عامل الزمن، فلا يمكن معالجة القضايا، التي تظهر في عصر ما، فنيا خلال حدوثها، وفي العادة تكون المعالجة وصفية سطحية لأن الرؤية لم تتشكّل بعْد، لهذا فالقضايا التي شهدها الوطن العربي خلال السنوات الماضية تحتاج زمنا لتتخمّر في مخيّلة الروائيين وتُنتج نصوصا تشرّح تفاصيلها، والعملية عبر مختلف مراحل التاريخ كانت تمر بذات الكيفية، فلم تظهر، مثلا، روائع الرومانسية إلا بعد فترة معتبرة من الصراعات السياسية والعسكرية والتحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بهذا فالأدب عموما والرواية بوجه خاص يحتاج إلى رؤية أكثر شمولا للتعبير عن واقع معيّن”.
ويشدد الناقد على أن النص الجيّد يتموقع على مسافة من أحداث مكتملة لنقلها بصورتها المثلى. لكن هذا لا يعني، في رأيه، عدم وجود نصوص ترافق التحوّلات لكن في العادة يكون عددها قليل وبناؤها يشوبه الاضطراب في التشكيل والتسرع في الأحكام والسطحية في التصوير. وإضافة إلى سبب الزمنية أرى أن الروائيين العرب في زمن التحوّل فقدوا الأمل في التحوّلات الإنسانية التي يرجونها، وهي حالة يعاني منها أغلب الأدباء والفنانين في فترات التحوّل بسبب صدمة الحروب والانقسامات والموت المفجع في كل شيء، وهذا الأمر يدفعهم إلى التراجع عن أي قضية راهنة والاكتفاء بالانكفاء على الذات ومعالجة موضوعات تبعدهم عن واقعهم المزري. لكن لن يطول الأمر وتبدأ مرحلة جديدة بنصوص أكثر قوة تقدّم لعصر جديد في الكتابة مضمونا وبناء.
ويرى القاص والروائي سمير الفيل أن الكاتب ليس بالضرورة مهيئا لتناول قضايا مشتتة في عقله، فمن فرط تداخل الواقعي بالخرافي صار الولوج إليها صعبا.
ويوضح أن الروائي بحاجة إلى وقت ليتبين مواقع قدميه، فهو لن يخوض مغامرة الكتابة إلا إذا توفر له الحد الأدنى من المعلوماتية والمعرفة، وهذا حدث في تجربة الحرب الأهلية بلبنان حين كتبت عنها هدى بركات، وكتب حسن داود وغيرهما، بعد مرور سنوات على اشتعالها. وهو الأمر نفسه مع الحرب العربية الإسرائيلية في أكتوبر 1973 حين تصدى للكتابة عنها محاربون أو مرسلون عسكريون بعد مضي عقود على وقوعها كما في حالة جمال الغيطاني، ومعصوم مرزوق، ويوسف القعيد، ومحمد عبدالله الهادي وكاتب هذه السطور. أتصور كذلك أن ما حدث من وقوع مدن في قبضة الفاشية الدينية، وقتل المختلفين مسلمين وغير مسلمين، والاعتداء الجنسي على اليزيديات وغيرها من ممارسات غير الأخلاقية تحتاج إلى هدوء، وتمرس، وإعادة تأمل المحن عبر قراءات معمقة في التاريخ.
ربما لهذا الاحتراس والحذر والتردد يختفي النص الروائي إلى حين ولن يظهر بقوة حتى تستقر الأمور ويصبح جزءا من الماضي أو ملفا مغلقا وهو ما نراه في حالتنا.
كتابات في الحرب
يلفت الروائي والشاعر علي عطا إلى أنه من الصعوبة بمكان الإحاطة بكل ما صدر من أعمال أدبية عربية في السنوات الأخيرة لتحديد عمل أو أكثر منها تناول تلك القضايا.
ويقول “عن نفسي يحضرني عملان صدرا في 2019: رواية الكاتبة السورية عبير إسبر ‘سقوط حر‘ (دار نوفل)، ورواية الكاتب العراقي أزهر جريس ‘النوم في حقل الكرز‘ (دار الرافدين). الأولى تحكي عن امرأة مسيحية تضطر إلى الهجرة من بلدها سوريا، تحت وطأة الحرب التي أفرزت صراعات طائفية مقيتة. والثانية عن شاب عراقي اضطر للهجرة إلى بلد أوروبي في شكل غير شرعي، فرارا من دموية صدام حسين تجاه معارضيه، لكنه بعد أن تتاح له فرصة ‘العودة الآمنة‘ إلى وطنه، يفضل البقاء حيث هو؛ ليضمن أن يكون له قبر معروف بعد موته، فالقتل على الهوية بات أمرا سائدا هناك، والقتلى يُدفنون في مقابر جماعية”.
ويضيف “هناك أيضا رواية الكاتب اليمني علي المقري ‘بلاد القائد‘ والصادرة حديثا عن دار المتوسط، وإن اعتمدت الرمزية في البحث عن أصل الداء الذي عرته ثورات الربيع العربي. وهناك رواية ‘لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة‘ للكاتب السوري خالد خليفة الصادرة عن دار العين والفائزة بجائزة نجيب محفوظ عام 2013، وهي رواية عن مجتمع عاش بشكل متواز مع البطش والرغبات المقتولة٬ عبر سيرة عائلة اكتشفت أن كل أحلامها ماتت وتحولت إلى رماد ليستمر الآخرون في العيش. هي كذلك رواية تثير وتطرح أسئلة أساسية وتحاول الكشف عن حقائق خراب الحياة العربية في ظل الأنظمة الاستبدادية التي استباحت ودمرت حياة وأحلام المواطنين العرب. في هذه الرواية يكتب خليفة عن كل ما هو مسكوت عنه في الحياة العربية عامّة والحياة السورية خاصّة“.
ويؤكد الروائي والناقد السوري نذير جعفر أن الواقع الراهن والصادم في بعض البلدان العربية أصبح أغرب من الخيال بسبب الحروب التي نشبت على أثر ما سمي بثورات الربيع العربي، ويعتقد بعض الكتاب أن أهوال هذه الحروب ومروياتها الشفوية اليومية لم تترك للمبدع ما يقوله؟ ويتساءل بعضهم الآخر: ما جدوى الأدب برمّته ما دام الموت اليومي يتصدّر المشهد بسواده، ويطغى على كل ما عداه؟ وقبل كل هذا وذاك أليس من المبكر الكتابة عن أحداث عاصفة بل عن زلازل لا نهاية محدّدة لارتداداتها المفجعة؟
ويقول “صحيح أن بعض الكتاب انكفأ على ذاته وانشغل بها بعيدا عن الهم الجماعي، لكن تلك التحفظات لم تقف حائلا أمام كثير من كتاب الرواية والقصة للكتابة عن الحرب وتداعياتها وويلاتها، وربما لم تحضر مجمل التفاصيل التي يشير إليها الدكتور هيثم الزبيدي في رواياتهم وقصصهم، ولكن يكفي أن أشير في حدود متابعتي لما صدر من روايات عن الحرب في سوريا وما قمت بتحكيمه عبر مسابقتين للرواية أن نحو 400 رواية صدرت لكتاب سوريين وعرب داخل سوريا وخارجها عن الحرب وما أسفرت عنه من دمار نفسي وروحي ومادي، وما خلّفته من مشكلات اجتماعية واقتصادية على الصعد كافة. ومن هنا لا يمكن الحكم على مدى تفاعل الكتاب مع الحرب وتصوير مآسيها عبر انطباع فردي بل عبر عمل مؤسساتي موسوعي يجمع النتاج الصادر ويقوم بدراسته ثم يحكم إلى أي حد كان الكتاب متفاعلين أو محجمين عن كتابة سردية الحرب ومآلاتها”.
ويوضح الروائي العراقي عمار الثويني أن الرواية كان لها الدور السباق في التطرق إلى العديد من الثيمات مثل الحروب ومآسيها وتأثيرها على الشخصية العربية وكذلك الإرهاب بكل أشكاله. ولا يظن من الإنصاف أن نقول إنها أغفلت عن ذلك.
ويقول “معظم الروايات العراقية التي صدرت بعد عام 2003 عالجت الحروب والإرهاب والاقتتال الطائفي والهجرة وأئمة الكذب والنفاق، وكذلك عالجت الرواية السورية التي صدرت بعد عام 2011 القتال الدائر في سوريا منذ عشرة أعوام وبشكل مكثف، ونادرا ما نجد أن رواية ابتعدت عن هذه المواضيع. الروايات اللبنانية مازالت تتطرق إلى ثيمة الحرب الأهلية مع أنها انتهت قبل أكثر من ثلاثة عقود. وأعتقد أن مواضيع الحروب وتأثيراتها ستظل المحور الرئيس للكثير من الأعمال التي تصدر قريبا أو حتى مستقبلا. ربما الأمر بحاجة إلى قراءات موسعة من جانب الأستاذ هيثم في هذا الجانب فهو على دراية تامة أن الرواية العربية مرآة للمجتمع وهي واقعية بامتياز”.
ويشير إلى أن رواياته الأربع “في ذلك الكهف المنزوي” و”القديسة بغداد” و”مشحوف العم ثيسجر” و”الغول البهي” تناولت الحروب وتأثيراتها في المجتمع العراقي وما رافقها من نتائج وكذلك حالة الانشقاق المجتمعي الذي صاحب دخول القوات الأميركية إلى العراق عام 2003.
ففي العمل الأول ناقش ما حصل في الانتفاضة الشعبية التي تلت حرب تحرير الكويت عام 1991 ونتائجها الكارثية وكيف أنها شكلت مرحلة مفصلية من حياة المجتمع والشخصية العراقية. وفي الرواية الثانية ‘القديسة بغداد’ تطرق إلى الجيل الذي عايش الحرب الأولى مع إيران (1980 – 1988) وحرب تحرير الكويت (1991) والغزو الأميركي وتأثير كل ذلك على نفسية الفرد العراقي. في حين عالج في رواية ‘مشحوف العم ثيسجر’ أثر الحروب في تدمير البيئة المائية وتهجير أكثر من نصف مليون إنسان يعيشون في المسطحات المائية الأكبر في الشرق الأوسط. وفي روايتي الأخيرة ناقشت أثر الحروب على النفسية العراقية وكيف صنعت من شخصية هادئة ووديعة شخصية مجرمة تحب الدماء والقتل.
ويقول الروائي السوري نيروز مالك “روايتي ‘سنوات خمس‘ التي صدرت 2020 عن دار ببلومانيا في القاهرة، قسّمتها إلى قسمين. الأول كان للحديث عن الأسباب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي أدت إلى القسم الثاني، وهو الحديث عن الحرب التي استمرت لخمس سنوات في مدينة حلب حيث أعيش. رسمت مأساة الناس في قسميّ المدينة. القسم الشرقي منها الذي سيطرت عليه قوات المعارضة المسلحة، والقسم الغربي الذي كان تحت سيطرة القوات الحكومية. كانت الحرب سجالا بين قوتين، وكانت النتائج في كلا الجانبين الخراب والدمار والقتل والتهجير والاعتقال والنزوح إلى خارج البلاد وإلى مدن في داخل البلاد أكثر أمنا من مدينة حلب”.
ويتابع “بيّنت في روايتي الأسباب التي أدت إلى الحرب خاصة أن فقدان الحريات العامة والخاصة (منع العمل السياسي، منع نشوء الأحزاب المعارضة، وتحويل النشاط الثقافي وجهة وحيدة وهي تلميع وجه السلطة عبر شعارات زائفة) أدى إلى موت المسرح والسينما ودور الموسيقى، وكل النشاطات الفردية التي لها علاقة بالشأن الثقافي العام، إلا بأشكاله التي تمجد السلطة. ولما كان المثقف جزءا من النسيج الإجتماعي، حاولت هذه السلطة قتل روح الحرية والتمرد والإبداع في داخله حتى روضته على أكمل وجه في سبيل إخصائه وجعله أداة تخدمها وتخدم شعاراتها الزائفة”.
ويضيف “لقد أكد الكاتب الكبير عبدالرحمن منيف هذه الظاهرة حين قال في كتابه سيرة الباهي: كان أغلب المثقفين يكتسب دوره وأهميته بمدى اقترابه من السلطة، أما إذا كان للمثقف دور متميز ومختلف ومعارض أيضا فإن أقل ردود السلطة شأنا على اختلافها معه أن تطوقه بالصمت وتهمشه.. وحين يلجأ هذا إلى التحدي فالسجون واسعة”.