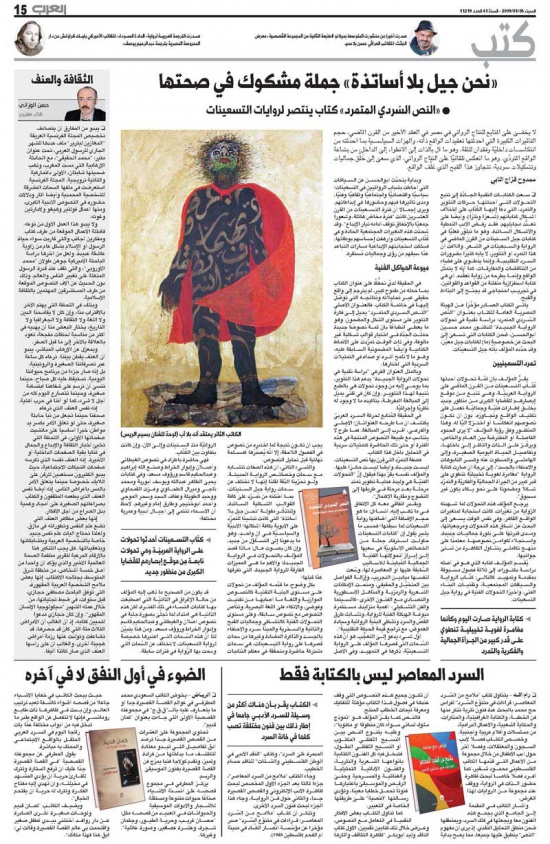"نحن جيل بلا أساتذة" جملة مشكوك في صحتها
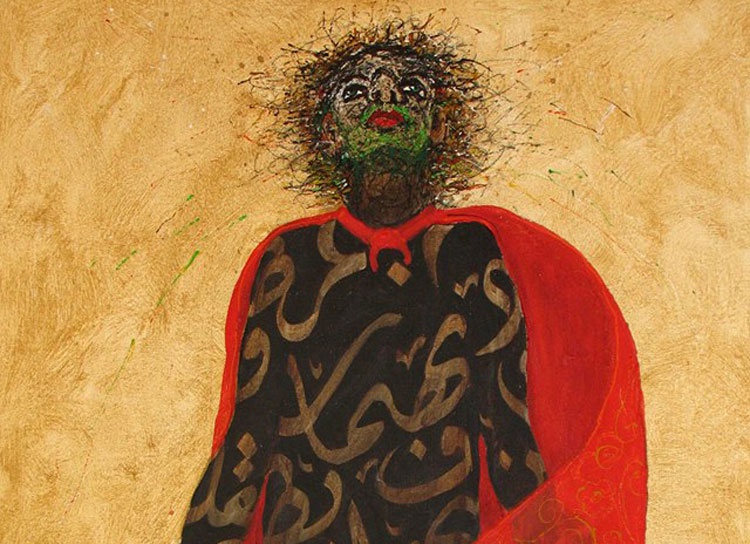
لا يخفى على المتابع للنتاج الروائي في مصر في العقد الأخير من القرن الماضي، حجم التأثيرات الكبيرة التي أحدثتها تعقيدات الواقع ذاته، والهزات السياسية بما أحدثته من انتكاسات داخليّة وفقدان للثقة، وهو ما آل بالذات إلى الانطواء إلى الداخل، من بشاعة الواقع المتردّي. وهو ما انعكس تلقائيًّا على النتاج الروائي، الذي سعى إلى خَلْق جماليات وتشكيلات سردية، تتجاوز هذا القبح الذي غلَّف الواقع.
سعت الكتابات النقدية الجادّة إلى تتبع التحولات التي أحدثتها حركات التثوير والتمرد، التي دعا إليها الكُتّاب على اختلاف أشكال كتاباتهم (شعرًا ونثرًا)، وأيضًا على تعدُّد مجايليهم. فقد رفض الأدب النمطية والأشكال السائدة. وهو ما تبلوّر فعليًّا في كتابات جيل الستينات من القرن الماضي في الرواية والسبعينات في الشعر. واللافت أن هذا التمرد أو التثوير، لا يأبه كثيرًا بضرورات السرد التقليدية، وإنما ينطوي على فضاء من التناقضات والمفارقات. كما أنه لا يتمثّل الواقع وإنما يطرحه من زواية تعقُّده. أي هي كتابة استفزازية منفلتة من القواعد والقوانين، في تجريب احتجاجي قد يجنح إلى البذاءة والقبح.
يأتي الكتاب الصادر مؤخّرًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب بعنوان “النّص السّردي المتمرد: دراسة نقدية في تحولات الرواية الجديدة” للدكتور محمد حسين أبوالحسن، ضمن الكتابات التي تسعى إلى البحث عن خصوصية (ما) لكتابات جيل معيّن، وقد حدّده المؤلف بأنّه جيل التسعينات.
تمرد التسعينيين
يقرُّ المؤلف بأن ثمّة تحولاتٍ أحدثها كُتّاب التسعينات من القرن الماضي على الرواية العربيّة. وهي تنبع مِن موقع إبصارهم للقضايا الكبرى من منظور جديد يخلق إطارات فنيّة وجماليّة تعمل على تكثيف الواقع وتجاوزه. دون أن تكون نصوصهم انعكاسًا أو اختزلاً آليًّا له.
وهذا المنظور وفق رؤية المؤلف “لا يرى الحدود الفاصلة أو المفترضة بين العام والخاص، ويركّز على الذات والنظر إلى داخلها، وتفاصيل الحياة اليومية الصغيرة، وإلى الهامشي والمسكوت عنه وكسر التابوهات والاحتفاء بالجسد”، إلى درجة أن صارت كتابة الرواية “مغامرة لغوية تخييليّة تنطوي على قدر كبير من الجرأة الجماليّة والفكريّة والتمرّد شكلاً ومضمونًا على نحو يكاد يكون غير مسبوق”.
يرجع المؤلف هذه التحولات لما شهدته الرّواية من تغيّرات، كانت استجابة لمتغيرات الواقع القاهر. وفي نفس الوقت يسعى إلى البحث عن أنساق هذه التحولات ومرجعياتها، ومدى قدرتها على بلورة جماليات جديدة، واستجلاء لكوامن نصوصها. معتمدًا على منهج تكاملي يتناول الظاهرة من شتى جوانبها.
كتّاب التسعينات أحدثوا تحولات على الرواية العربيّة وهي تحولات نابعة مِن موقع إبصارهم للقضايا الكبرى من منظور جديد
يُقسم المؤلف كتابه الذي هو في أصله دراسة دكتوراه، إلى ثلاثة فصول مسبوقة بمقدمة وتمهيد. كالتالي: كتّاب الرواية والسياقات المجتمعية، وتقنيات البناء الفني، وأخيرًا التحولات الفنية في رواية جيل التسعينات.
وبداية يتحدّث أبوالحسن عن السياقات التي أحاطت بشباب الروائيين في التسعينات؛ سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا وفنيًّا، ومدى تأثيرها فيهم وحضورها في إبداعاتهم. ويرى إجمالا أن فترة التسعينات من القرن العشرين كانت “فترة مخاض هائلة، وشعورا جمعيّا بالإخفاق توقف أمامه تيار الإبداع”. وقد شحذت هذه التغيرات المجتمعية الحادة وعي كُتّاب التسعينات وأرهفت إحساسهم بوطأتها، فسلكت استجابتهم الإبداعية مسارات التباعد عمّا سبقهم من رؤى وجماليات مُستقرة.
مياعة الهياكل الفنية
في الحقيقة لديّ تحفُّظٌ على عنوان الكتاب بما حمله من طموح كبير، لم يترجم إلى واقع حقيقي عبر تحليلاته ونتائجه التي توصّل إليها في خاتمة الكتاب. فالعنوان الأصلي “النص السردي المتمرد” يحيل إلى فكرة التثوير على مستوى الشكل والمضمون. وهو ما يعطي انطباعًا بأن ثمة نصوصًا جديدة حملت الجدّة في اختيار قوالب شكلية غير مألوفة، وفي ذات الوقت تمرّدت على الأنماط الكتابية وأيضًا المضمونية السابقة عليه، وهو ما لا نلمح أثره أو صداه في التمثيلات السردية التي اختارها.
وبالمثل العنوان الفرعي “دراسة نقدية في تحولات الرواية الجديدة” يدعم هذا التثوير، بما يوحي إليه من وجود تحولات هي بالطبع نتيجة لهذا التثوير. وإن كان في ظني يميل إلى المبالغة المفرطة، بتأكيده ما لا وجود له نظريًّا وإجرائيًّا.
في الحقيقة المُتابع لحركة السرد العربيّ يكتشف أن ما طرحه العنوانان؛ الأصلي والفرعي، أقرب إلى المبالغة. فما طُرح لا يتناسب مع طبيعة النصوص المنتجة في هذه الفترة أو حتى تلك الحاضرة كتمثيلات سردية في التحليل داخل هذا الكتاب.
فصفة التمرّد التي قرن بها نص التسعينات، ليست جديدة، وأيضًا ليست حكرًا عليها. والمؤلف نفسه يقرّ بهذا فيقول إنّ “التحولات الفنيّة هي وليدة عملية تطوير تمتد مرحلة بعد مرحلة في طريقها إلى النضوج ومقاربة الاكتمال”.
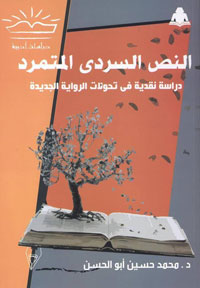
وبقدر اتفاقي معه كل الاتفاق في ما ذهب إليه، أتساءل: ما هو حجم الإضافة التي أضافتها رواية التسعينات لما سبقتها؟ فحسب ما يشير يقول إن “كتابات التسعينات حاولت استرفاد جملة من الخصائص الأسلوبيّة في سعيها إلى إبراز ‘تحولاتها الفنية‘ الجمالية المُباينة للأساليب السّابقة عليها أو المعاصرة لها، وسّعت لنفسها ميادين التجريب، وإزالة الفواصل بين المتخيّل والحقيقي، ومنحت الإمكانات الشعرية والرمزية والمناهل الأسطورية والتصادي مع الفنون الأخرى –كالسينما والفن التشكيلي– أهمية متزايدة، مستثمرة ميوعة الهيكلة الفنية للرواية، وتشابك طرق القصّ والسرد وتشظي البنية الروائية وسيادة الغموض، مع تراجع قيمة الحبكة التقليدية”.
أوّل شيء يدعو إلى التعجُّب، هو أنّ هذه السّمات التي قصرها المؤلف على الرواية التسعينيّة، ذكرها في التمهيد، وفي الأصل يجب أن تكون نتيجة لما اختبره من نصوص في الفصول اللّاحقة، إلا أنّه يُصدِّرُها كمسلّمة نهائية قبل تحليل النصوص.
والشيء الثاني، أن هذه الصفات تتشابه مع سمات وخصائص الرواية الحديثة. ولو تحرّينا الدّقة لقلنا إنها لا تختلف عن سمات رواية جيل الستينات، بما أصّلته من تمرّد على كافة القوالب الشكلية السائدة، ولنتذكّر مقولة “نحن جيل بلا أساتذة” التي كانت تدشينًا للتمرّد على الأبوية بكافة أشكالها؛ الأدبيّة والسياسيّة في آنٍ واحدٍ، وهو
ما يدعونا إلى التساؤل من جديد، وإن كان بصوت عال: ماذا قصد المؤلف بالتحولات في الرواية الجديدة؟ والأهم ما هي المميزات الفارقة للرواية الجديدة، التي تفرقها عمّا قبلها؟
بكل وضوح، ما قدّمه المؤلف من تحولات على مستوى البنية التقنية كالنصوص الموازية واللغة ما أصابها من تفتيت وفوضى، والاتكاء على اللغة البصرية، وتناص النصوص مع نصوص سابقة، وعلى مستوى التحولات الفنية كالتشظي وجماليات القبح والذاتية والسخرية والميتا سرد والاحتفاء بالجسد والذاكرة المضادة وغيرها من سمات قصرها على رواية التسعينات، هي سمات مشتركة حاضرة ومتحقِّقة في معظم النتاجات الروائيّة منذ الستينات وإلى الآن، وإن كانت بتفاوت بين الكُتّاب.
فهي حاضرة باطراد في نصوص الغيطاني وأصلان وإدوار الخراط وصنع الله إبراهيم وعبدالحكيم قاسم ورؤوف مسعد، وفي كتابات يحيى الطاهر عبدالله ويوسف أبورية ومحمد ناجي وميرال الطحاوي وعزت القمحاوي ووحيد الطويلة وعفاف السيد وسحر الموجي وأحمد أبوخنيجر وطارق إمام وغيرهم. لاحظ أن الأسماء تنتمي إلى أجيال أدبية وعمرية مختلفة!
قد يكون من الصحيح ما ذهب إليه المؤلف من حالة الإغراق في الذاتيّة التي اصطبغت بها كتابات النساء في تلك الفترة، لكن هذه الذاتية هي امتداد لما تجلّى بصورة جلية في نصوص أصلان والغيطاني وعبدالحكيم قاسم وإدوار الخراط وروؤف مسعد. ومن هنا يتبيّن لنا أنّ هذه السّمات التي اعتبرها خصيصة لرواية التسعينات، لا تختلف عن السّمات التي وسمت بها الرّواية في فترات سابقة.