"نبلاء وموتى وحزينون".. قصائد تواجه فوضى العالم
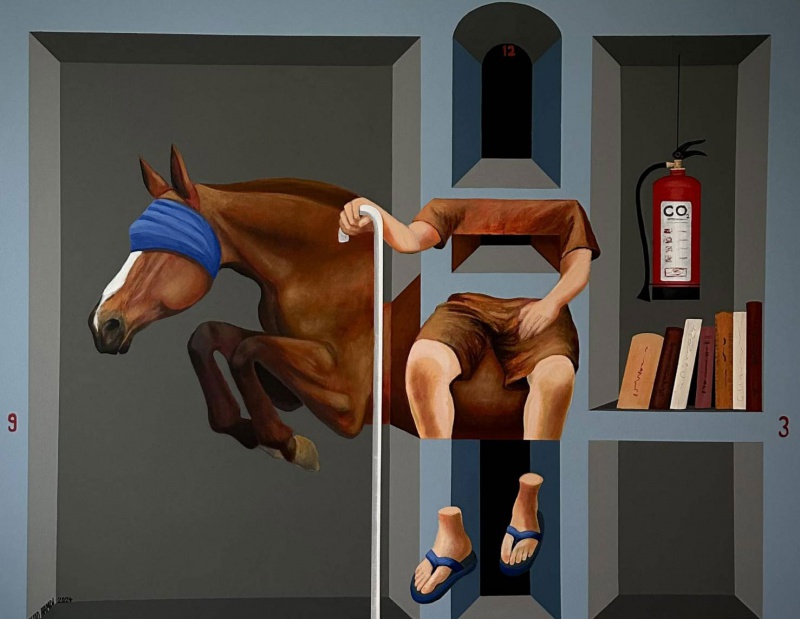
أمام الشعراء اليوم مهمة صعبة للغاية وهي استعادة الإنسانية وحمايتها من الاضمحلال الأخير، فمن خلال اللغة والفكرة والمشاعر يحاول شعراء عرب كثيرون ذلك اليوم، في مواجهة هي الأصعب على مر التاريخ، في أوطان ممزقة وهويات تائهة وانغلاق واغتراب عن مجتمعاتهم المتخبطة. الشاعر العراقي عامر الطيب من هؤلاء وهو يشق طريقه بوعي خاص.
عن دار لاماسو للنشر والتوزيع في السويد أصدر الشاعر العراقي عامر الطيب أحدث دواوينه والذي اختار له عنوان “نبلاء و موتى وحزينون”. ولم يجعل الشاعر عناوين لقصائده واختار أن يتركها في شكل نصوص نثرية تبدو منفصلة عن بعضها البعض، لكن ما يجمعها هو تشظي ذات شاعرة تستعرض ما هو ذاتي وموضوعي ضمن تجربة وجودية تفتح على آفاق رحبة.
هذا الكتاب الشعري هو الثامن في رصيد الشاعر عامر الطيب، وقد نشر دواوينه السابقة في العراق ومصر وتونس والأردن.
عتبات الديوان
“نبلاء وموتى وحزينون”، اختار الشاعر عامر الطيب أن يكون عنوان ديوان مجموعة من الصفات التي وردت خالية من لام التعريف، هذا يجعل القارئ لا يعرف من يقصد الكاتب بالنبلاء والموتى والحزينين، غير أننا عندما نقرأ الديوان يمكن أن نقول إن عامر الطيب يتحدث تحديدا عن الشعراء، ويختار أن يشير إليهم من خلال صفات تحدد هويتهم، إنهم نبلاء لأنهم اختاروا أن يكونوا ضمير الوطن وصوت المهمشين، وموتى لأنهم غير قابلين للتدجين في نظام التفاهة الاجتماعي، ويعيشون الموت الرمزي في كل حين، وهم دائما في حالة حزن شديد لفرط شفافيتهم العالية، التي تجعلهم يعيشون في الظل قريبا من المنبوذين والمنسيين.
ونحن نقرأ النصوص الشعرية في هذا الديوان لن نجد غير الشاعر ذاتا متشظية تعيش تجربة حياتية قاسية تجعل منه أنوات متعددة في نفس الوقت، بمعنى أنه هو الواحد المتعدد، أي أن عامر الطيب – في هذا الديوان – هو حشد من الشعراء النبلاء والموتى والحزانى جدا.
الشاعر عامر الطيب يبشر في ديوانه أن الثورة الحقيقية هي التي تنطلق من داخل القصيدة ومن أفواه الشعراء
جاء الغلاف على خلفية خضراء توحي بالخصوبة والنماء، وفي وسط الغلاف يبدو رسم خطوط تشكّل ربطة عنق، وهي من إكسسوارات ملابس الرجال عادة وبنسبة أقل النساء، تعتبر ربطة العنق من العناصر المهمة لتكملة الزي الرسمي في مهن نظامية أو في مناسبات تفترض نوعا من الوجاهة الاجتماعية.
يبدو أن الشاعر أراد من خلال ربطة العنق أن يجعل الشعراء في موكب رسمي وبالتالي يخرجهم من الهامش ويجعلهم في المركز، يسحبهم من أدوارهم الثانوية عبر التاريخ حيث كانوا عادة إما مارقين عن المجتمع أو مجرد ظلال للسياسي أو منسيين في قاع المجتمع، ربطة العنق كانت تميز الفرسان الكروات (منذ القرن السادس عشر) وتدل على الشرف والشجاعة والتضحية، ثم أصبحت رمزا لمساندة ودعم لهؤلاء الفرسان ومن ثم انتشرت في أوروبا.
الشاعر عامر الطيب يجعل من ربطة العنق إشارة إلى الشعراء، فهم فرسان مجتمعاتهم ونبلاء في كل العصور والحزانى جدا، يجعلهم الشاعر الطيب محط الأنظار عندما يمنحهم أصواتا للتعبير عن أحلامهم وانكساراتهم.
في رسم ربطة العنق على الغلاف نجد لمسة خاطفة بواسطة ريشة الرسام لخط جعله بلون أصفر أضفى نوعا من الحيوية والبهجة على ربطة العنق، وزخة ضوء باللون الأحمر توحي بالقوة والثقة والسلطة لصاحب ربطة العنق.
الاغتراب لماذا وكيف
تتعدد الدلالات التي يوحي بها هذا الديوان وتعكس تنوع الأفكار والمشاعر التي تضمنها وأشار إليها، غير أن أشد ما لفت انتباهي حضور الاغتراب الذي أجده يتمدد على أغلب النصوص الشعرية ويأخذ مستويات متعددة تفيد غياب التطابق بين الذات وواقعها، يبدو شعور الاغتراب حادا بل مأساويا عندما يشعر الفرد بذلك وهو في وطنه وبين أهله، وهذا ما يجعل من الذات في مواجهة أزمة حقيقية عندما تكتشف أن الوهم يحل محل الحقيقة وأن كل الأبطال من حوله من ورق، يقول الشاعر:
“اسمحوا لي أن أحدثكم عن حياتي/ متجنبا الإطالة/ أن أعيش مأساتي/ قبل أن أخسر حقيقتها، ذلك أن القصص/ الزائفة/ هي التي تصنع أبطالا”.

تأتي مشاعر الاغتراب من شعور الفرد بأنه كائن مرفوض في مجتمعه لأنه يحمل وعيا يشقيه، وهو ما يجعله يدرك الحقيقة ويرى ما لا يرى، هنا لن نتحدث عن الاغتراب (أو الاستلاب) وفق الدلالة الماركسية التي تتحدث عن اغتراب العامل عن العمل المنتج وهي حالة مأساوية يعيشها العامل في مجتمع طبقي، ويتحول الاغتراب إلى نسق فكري يعبر عن جوهر الإنسان. أقصد بالاغتراب غياب التطابق بين الذات والواقع الذي تعيشه والذي يحتد ليصبح حالة وجودية يعيشها العديد من المبدعين العرب وتشتد في وضع اجتماعي متأزم يجعلهم خارج الوعي القطيعي وبمنأى عن التدجين والانصهار في الوعي السائد وتمثلاته.
هذا الاغتراب أصبح الآن سمة العصر وأحد أهم الإشارات التي تدل على تأزم الواقع وتلاشي البعد الإنساني في ظل زمن سائل حسب تعبير باومان، زمن الرداءة والفوضى والوهم.
يبدو أن المبدعين عامة والشعراء خاصة بحكم هشاشتهم النفسية التي تجعل من المشاعر الرافعة التي تشدهم للواقع وتمنعهم من الانصهار والقبول بقواعد لعبة الزمن السائل، هم أكثر من يعاني الاغتراب وتمثلاته المختلفة.
مفهوم الاغتراب في الشعر العربي ليس حديثا فقد ظهر بداية من السبعينات بتأثير مباشر من انتشار الفلسفة الوجودية وذيوع أفكار سارتر وخاصة نتيجة فشل المشاريع السياسية للدولة الوطنية بعد المرحلة الاستعمارية، وخصوصا عند انكسار الوعي العربي إثر هزائمه العسكرية المتتالية، بدءا من هزيمة 1948 وما تبعها. في هذه المرحلة عبّرت النخبة العربية عن انكساراتها وخيباتها من خلال العديد من الشعراء، لذلك يمكن أن نتحدث عن الاغتراب عند الشاعر بدر شاكر السياب وعزالدين المناصرة ومريد البرغوثي وغيرهم.
بدلا من أن يحدث انفراج في الوضع العام ظهرت العولمة التي هي في الظاهر تبشر العالم بالخير وفي الباطن تحمل له الويلات، لذلك أطل علينا الفيلسوف الشهير باومان ليسقط القناع عن وجه العالم المتمدن الذي نعيش في ظله ويصفه بأنه عالم متوحش يجعلنا نعيش زمن هيمنة الفوضى والرداءة والفساد واللاقيم واختزاله بأنه زمن سائل بلا قيمة. هذا يعني أن الوضع العربي سيكون أكثر بؤسا وأشد فوضى ورداءة، وهو ما نلاحظه في واقع ازداد تخلفا وتشتتا وبؤسا وعنفا. هنا سنجد أن الجيل الجديد والمعاصر من الشعراء العرب يستعيدون حالة الاغتراب في ظل ظروف أشد قسوة وإحباطا وتناسب حالة التشرذم وفقدان الهوية، وبذلك سنشهد صراعا دراميا من أجل الثبات على أرض رخوة وسائلة.
الشاعر العراقي عامر الطيب في ديوانه الجديد “نبلاء وموتى وحزينون” يمثل إشارة لشاعر متأزم يقف وحيدا أمام فوضى العالم.
نتحدث عادة عن الاغتراب عندما يعيش الشاعر علاقة متأزمة بالمجتمع تجعله يفقد كل الروابط النفسية والثقافية، فيشعر بالنبذ وينتج عن هذا آليا فقدان العلاقة التي تشده إلى وطنه فلا يتمثل قيمه الاجتماعية والثقافية، من هناك يتولد لديه الشعور بالغربة وهو بين أهله، بمعنى يفقد الشاعر تدريجيا مشاعر الانتماء إلى الوطن الأم، لذلك قال التوحيدي في إحدى رسائله “الغريب من هو في وطنه غريب” للتعبير عن عمق الأزمة الوجدانية والذهنية التي تجعل من الاغتراب حالة انفعالية وموقفا ذهنيا، لذلك من أسباب الشعور بالاغتراب تأزم العلاقة بالمجتمع من جهة وفقدان الهوية ومشاعر الانتماء من جهة أخرى.
التأزم وفقدان الهوية

يبدو أن الواقع العربي عموما والعراقي خصوصا يشهد حالة تأزم نتيجة لتفكك سياسي وانتشار الفساد والجهل، لذلك نجد المبدع الحقيقي بما يملكه من حس نقدي يرفض التدجين ويصعب ترويضه، وهذا يجعله في علاقة رفض للواقع بكل تمثلاته الاجتماعية والدينية والسياسية، وينتج لديه أزمة حقيقية. الشاعر عامر الطيب في هذا الديوان يتحدث عن مستويات متعددة لهذه العلاقة المتأزمة بالواقع ويعبّر عنه من خلال ثنائيات متضادة من ذلك أنه يذكر العنصر ويترك الآخر خلف المعنى، يشير إلى السعادة ويترك القارئ يتلمّس الحزن، يذكر اليأس ويخفي التفاؤل، يتحدث عن العجز ويبحث القارئ عن الإرادة.
يقول: “سعادتي نتاج يأس شديد من أن هذا لن يحدث وتلك لن تستمر طويلا وهذه ليست من أجل../ أما حياتي بالمجمل فهي نتاج سعادات طفيفة كجراح/ فإلى أي حد أبدو عاجزا حتى يتوجب علي أن أقدم تفسيرا لجراحي”.
يطرح الشاعر عامر الطيب في ديوانه “نبلاء وموتى وحزينون” دلالات متعددة تعبر عن فقدان الهوية وفق أبعاد مختلفة، يعود تحديدا إلى الهوية في بعدها السيكولوجي الذي كرّس فيه فرويد جهوده العلمية، ليجيب عن سؤال محدد هو “ماذا تريد المرأة؟،” الشاعر ينطلق من هذا المشروع الفرويدي ليعلن أن السؤال الحقيقي لا يجب أن ينطلق من التساؤل حول ما تريده المرأة بل حول ما يريده الرجل أولا، وهو هنا لا يتحدث عن الرجل بالمعنى الذكوري بل الرجل بما هو قيمة تختزل الوجود الإنساني ككل، بمعنى أن سؤال الهوية ليس سؤال المرأة تحديدا، بل هو سؤال الإنسان عموما.
لذلك يقول الشاعر: “ما الذي يريده الرجلُ؟ْ هذا هو السؤال الذي لم يكلف فرويد ثلاثين عاما/ في التحليل النفسي ليجيب عليه.. يريد الرجل/ أن يحب دون أن يلتمع ويرحل دون أن ينطفئ”.
الشرط الأول الذي يشغل الإنسان ككل هو كيف يكون محبوبا أي كيف يتقبل من الآخر وهنا تطرح إشكالية العلاقة بين الأنا والآخر وهي علاقة شائكة لأن رفض الآخر يغذي ثقافة الإقصاء، ويشرّع للعنف بمختلف تمثلاته الرمزية والمادية، ويزرع الفتن والمؤامرات ويطلق الحروب.
حتى نفهم خطورة العلاقة بين الأنا والآخر يمكن اختزال تاريخ البشرية من خلالها، بمعنى أن تاريخ الأزمات والحروب هي علاقة تأزم بين الذوات، وفي المقابل كل فترات السلم هي علاقة اعتراف متبادل بين الذوات بالمعنى الهيغلي. ما يقترحه الشاعر هنا أن العلاقة بين الأنا والآخر يجب أن تؤثث بالحب لنحقق السلام، لذلك فالمشروع الذي يقدمه المبدع يضمن للإنسان البقاء أولا وحسن البقاء ثانيا حسب تعبير برغسون.
الشرط الثاني الذي يشغل الإنسان هو أنه يريد “أن يرحل دون أن ينطفئ” وهو يعني الأثر الإنساني الذي يخلفه المبدع أو ما نعبر عنه بالرغبة في الخلود التي جعلت غلغامش يكرّس حياته من أجل البحث عن عشبة الخلود، في حين أن الشاعر عامر الطيب في ديوانه يميل إلى اعتبار عشبة الخلود هي الحب.
نلاحظ أن هذين الشرطين في علاقة عضوية ببعضهما البعض، بمعنى أن توفر السلام يحقق حسن البقاء والحب هو كلمة السر، لذلك نجد الشاعر يقول: “لي موتتان سعة الواحدة منهما مهولة/ ويتوجب أن أحبك لتضيق المسافة بينهما فقط”.
الثنائيات الضدية
في النصوص الشعرية في هذا الديوان نجد الشاعر ذاتا متشظية تعيش تجربة حياتية قاسية تجعل منه أنوات متعددة
بما أن الاغتراب إحدى السمات البارزة في الشعر العربي المعاصر تعبيرا عن توتر اللحظة الحضارية التي يعيشها المجتمع العربي، وخاصة عن حالة الانكسارات التي مثلت جروحا في الوجدان العربي، في ديوان “نبلاء وموتى وحزينون” يأخذ الاغتراب شكلا تراجيديا من خلال علاقات ضدية، تأخذ تمثلات عديدة وتعبر عن حالة الإحباط الشديد، وتعكس توقا للانطلاق والحرية التي تربط عادة بين متناقضات مثل اليأس والأمل، الفرح والحزن.
يبرز التضاد في الواقع الذي يعيشه الشاعر والذي يجعله بين شد وجذب بين الحركة والسكون بين الحياة والموت وترد أحيانا في المقطع الشعري الواحد من ذلك يقول الطيب: “الأمل بأمس الحاجة للأيدي والحدائق وأعمدة الإنارة/ كل ذلك من أجل أن يقف بجانبك في العاصفة/ أما اليأس فهو من سيرافقك بأجنحة/ كأن قوته تكمن في الاستغناء عن الخطى”.
هنا يجمع الشاعر بين الأمل واليأس، الأمل الذي يحتاجه الشاعر ويحيل على الحدائق والضوء والإرادة والفعل، في مقابل اليأس الذي يحيل على العواصف والتوتر والقلق، المفارقة في هذا المقطع أن الشاعر يحتاج الأمل غير أن اليأس هو الذي سيرافقه، ولعل الإشكال يتمثل في السؤال التالي: كيف يمكن أن نتحدث عن الأمل ونحن نتخبط في اليأس؟
تأخذ ثنائية التضاد شكلا آخر عندما يجمعهما الشاعر في آن واحد بمعنى ينتقل بالضدين من التجاور إلى التداخل، يقول الشاعر: “في البدء كان ثمة احتمال ضئيل بأني سأجدك في الأغاني الأليمة ثم في الغناء السعيد”.
هنا يتحدث الشاعر عن الحبيبة التي تحيلنا على الوطن والتي يجدها في الأغاني المبهجة كما في الأغاني الحزينة، نلاحظ هنا أنه يجمع الحزن والسعادة في الغناء، بذلك يعكس فيضا من المشاعر الرهيفة، ويعبر عن التركيبة النفسية للشاعر الذي يعيش انفعالات مختلفة ومتناقضة تجعله على درجة من الهشاشة النفسية، هذه الهشاشة التي تميز عادة الشعراء لأنها تجعلهم مؤهلين أكثر للتعبير عن مجتمعاتهم يما يتوفر لديهم من صدق وشفافية، ويؤهلهم ذلك ليكونوا صوت المجتمع وضمير الإنسانية، لذلك حاول العديد من الفلاسفة مثل كانط وهيغل إعادة الشعر إلى مجال الفنون الجميلة.

من جهة أخرى يجعل الطيب الضدين متكاملين بمعنى أنه لا يستقيم أحد الضدين إلا بنقيضه، بحيث تصبح العلاقة عضوية يقول: “الحب نائم قدر حاجتي الملحة لإيقاظه بالسكين”.
نلاحظ هنا أن الشاعر يجمع بين الحب والسكين، في هذا المقطع الشعري تبدو وظيفة السكين ضرورية من أجل إيقاظ الحب من سباته ليقوم بدوره الرئيسي ويخلق توازنا في الكون، كأن العلاقة تصبح شرطية بين الحب بما هو مشاعر شفيفة تحيلنا على المتعة واللذة والجمال والسكين تلك الآلة الحادة التي مهمتها عادة الاستئصال والقطع والذبح وتنتج الألم، من خلال الحب والسكين يجمع الشاعر علاقة المتعة بالألم ومرة أخرى نجد أنفسنا في علاقة ضدية تعبر عن عمق التجربة الإنسانية وذروة الانفعال الذي يجعل من لذة الحب تقترن بألم السكين وبذلك يكشف عن الخطر الحقيقي عندما تتحدى الذات لذاتها وتواجه وضعها التراجيدي.
لئن برزت الثنائيات الضدية بأشكال متعددة لتعبر عن عمق اغتراب الشاعر وتجعل من الألم تجربة مألوفة، فإن الشاعر عامر الطيب يقود قارئه إلى جهة الحركة في مقابل السكون، أو هو انتقال من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل حسب أرسطو والذي يجعل من الحركة فعل الممكن، بمعنى أن التغيير يحدث في الانتقال من اللاوجود إلى الوجود، من اليأس إلى التفاؤل، هذا ما يجعل الشاعر يعتقد في وجود ضوء آخر الطريق المليء بالحواجز والفخاخ، وهذا ما يسمح للشاعر أن يكون فاعلا في واقعه بل يتحول إلى منقذ البشرية من زمنها السائل ومن مصيرها المحتوم.
يقول الشاعر: “فإني أراهن/ على أن الظلام لن يكون دامسا للغاية إلا لتمنحني ظلا”.
يحول الشاعر الظلام الدامس إلى ظل للشاعر. السردية العربية تحدثت مطولا عن ظل الشاعر بوصفه إحدى مصادر التخيل والإبداع، واعتبر الكاتب العراقي علي حسن الفواز في مقالة مهمة بعنوان “الشاعر العربي، استعارة الظل وأوهام البطولة” أن أدونيس ومحمود درويش من أكثر شعرائنا صناعة لسرديات الظل، إذ يمارس هذا الظل حضورا فائقا (…) ويفتح لنا أفقا مفارقا ومكشوفا للأسئلة”.
ما يعنينا أن الشاعر عامر الطيب من خلال الإشارة إلى الظل أنه يعيد للشعر وظيفته التأسيسية من حيث هو حارس القيم ومنتج لملكة تخيل خصبة تتغذى منه الإنسانية وأيضا بوصلة حتى لا يفقد العالم نفسه، يقول الشاعر “الكتب قاسية وأليفة”، الكتب قاسية لأنها تحقق المعرفة المزعجة التي تخلخل الوعي السائد وتقض مضجع رجل السلطة، إنها توفر الوعي الشقي الذي لا يمكن النجاة دونه، لذلك قال المعري شعرا “ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم”. بهذا المعنى يتأكد الافتراض الذي انطلقنا منه أن الشعراء نبلاء لأنهم صوت المجتمع وعقله، وهم موتى لأنهم اختاروا أن يكونوا بعيدا عن الفوضى والظلم والفساد والزمن السائل، وهم محزونون يبالغون في حزنهم من فرط وعيهم الشقي، ولأجل كل ذلك هم حاملو المشعل يقودون مجتمعاتهم نحو الحرية والسلام.
حضور الاغتراب يتمدد على أغلب النصوص الشعرية ويأخذ مستويات متعددة تفيد غياب التطابق بين الذات وواقعها
يقول الشاعر: “أنا حزين وشعري ليس كذلك”.
لعل الشاعر عامر الطيب يبشّر في ديوانه أن الثورة الحقيقية هي التي تنطلق من داخل القصيدة ومن أفواه الشعراء، وهذا يعني أن الثورة الحقيقية هي ثورة العقول التي تجرف الفساد والظلم وتؤسس للعدالة والديمقراطية.
من خلال ديوان الشاعر عامر الطيب تتحول التناقضات الضدية إلى آلية إبداعية تكشف للقارئ آفاق النص الشعري وعوالمه الرحبة، كما تقدم مستويات مختلفة في قراءة النص والوقوف على دلالاته. يعبر ذلك عن رؤية الشاعر وفلسفته في الكتابة الشعرية التي تقوم على فهم للحياة وفق تناقضاتها التي تجمع بين الحركة والسكون.
في علاقات التضاد يميل الشاعر إلى العنصر الفاعل والمؤسس، بمعنى أنه ينحاز إلى الحركة في مقابل السكون وإلى الأمل في مواجهة اليأس وإلى الفرح بديلا عن الحزن، يقول: “لا تذهب رفقة أحد إلى اليأس لأن ذلك سيجعلك أشد أملا فقط”.
كما نلاحظ استعماله لغة مجازية ورمزية وكل ذلك يعبر عن ارتباطه بالواقع ويبرز تناقضاته، لننظر مثلا إلى هذه الصور الشعرية الجميلة يقول الشاعر: “بكائي مألوف كريح منزل مهجور”. أو قوله: يمسي حرف الألف مصباحا كافيا لإضاءة طريقنا.” أو قوله: “أحبك في اللغة التي ولدت بها”.
يبدو أن الاغتراب الذي يأخذ منحى تراجيديا في ديوان عامر الطيب “نبلاء وموتى وحزينون” يعبر عنه أيضا بتوتر لغوي يبرز في استعمال لغة مجازية ورمزية تبدو في بعض مستوياتها من خلال الثنائيات المضادة، وهو ما يمنح الشاعر نضجا يجعله يقترح قصيدته بما هي تعبير جمالي يؤسس من خلالها رؤيته للحياة.
إذا كان أفلاطون قد طرد الشعراء من جمهوريته لأنهم يمثلون خطرا على الناس، يبعثرون اطمئنانهم وينشرون بينهم الأسئلة ويدفعونهم في اتجاه تحقيق رغباتهم، فإن عامر الطيب يبشّر بعودة الشعراء إلى المدن ليعلنوا فيها الحياة وينشروا الفرح والسلام.






















