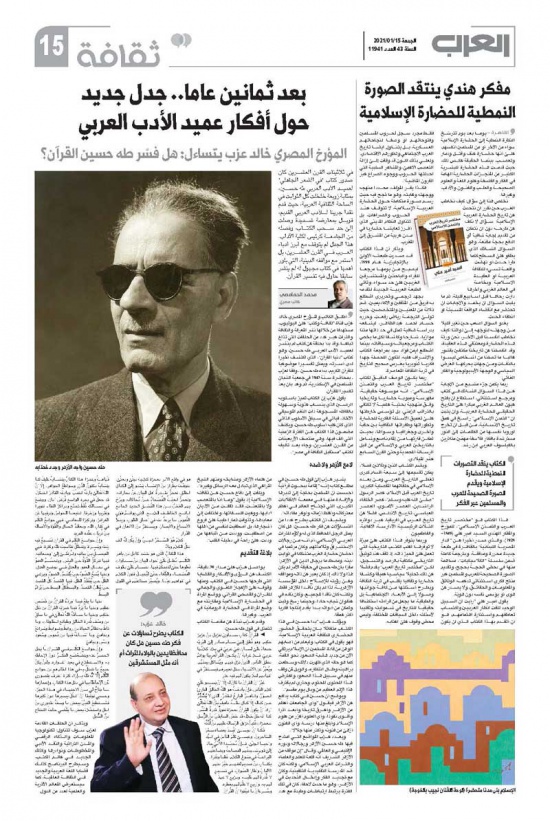مفكر هندي ينتقد الصورة النمطية للحضارة الإسلامية

القاهرة – يوما بعد يوم تترسّخ النظرة النمطية إلى الحضارة الإسلامية سواء من الآخر أو من المسلمين أنفسهم، على أنها حضارة عنف وقتل ودمار وتعصب، بينما الحقيقة عكس ذلك، حيث قدمت هذه الحضارة للبشرية الكثير من المنجزات الحضارية الهامة في الفكر والفلسفة وعلوم اللغة والعلوم الصحيحة والطب والفنون والآداب، وغيرها.
نخلص هنا إلى سؤال: كيف نخاطب الغرب حين نقرر أن نتحدث عن تاريخ الحضارة العربية الإسلامية؟ سؤال لا نكف عن طرحه دون أن نتمكن من تقديم إجابة شافية أو الدفع بحجة مقنعة، وهو السؤال الشائك الذي يطفو على السطح كلما طرأ حدث أو نهضت واقعة تسيء للثقافة العربية أو العقيدة الإسلامية وبخاصة في العالم الغربي وآخرها دارت رحاها قبل أسابيع قليلة، ثم ما يلبث السؤال أن يخمد والإجابات أن تحتضر مع انقضاء الواقعة المسيئة أو انطفاء الحدث.
يغدو السؤال أصعب حين نغير قليلا من وجهته لنوجّهه إلى ذواتنا: كيف نخاطب أنفسنا قبل الآخر، نحن ورثة هذه الحضارة ومعتنقي هذه العقيدة، وقد انفصلنا عن تاريخنا مكتفين بقشور غالبا ما تصلنا من أشخاص ليسوا بالثقات ومن جهات يحركها الغرض السياسي والوجهة الأيديولوجية والفكر الغائي؟

ربما يكمن جزء مشبع من الإجابة عن هذا السؤال الشائك في كتاب ومرجع استثنائي، استطاع أن يفتح عيون العالم الغربي مبكرا على التاريخ الحقيقي للحضارة العربية، وأن يثبت أن “التمدن الإسلامي” راسخ في عمق تاريخ الإنسانية، من قبل أن تخرج أوروبا نفسها من الظلمات إلى النور مسترشدة بأفكار فلاسفة مهمّين متأثرين بالفيلسوف العربي ابن رشد.
هذا الكتاب هو “مختصر تاريخ العرب والتمدّن الإسلامي”، للمؤرخ والمفكر الهندي السيد أمير علي (1849-1928)، والذي صدر أخيرا عن “الدار المصرية اللبنانية” بالقاهرة في طبعة جديدة محررة ومدققة، وبترجمة كاملة ضمن سلسلة “الكلاسيكيات”، مساهمة منها في دحض الحجة بحجج، وتقديم الصورة الصحيحة للعرب والمسلمين عبر منتج فكري استثنائي تدعمه الوثائق والمعلومات والحقائق، ولا يصدر عن هوى أو يؤسس نفسه دون هويّة.
يقول أمير علي “رأيت أن السبيل الوحيد للفت أنظار الغربيين واكتساب تعاطفهم واستثارة اهتمامهم، هو أن أتقدم بهذا الكتاب الذي لن يكون فقط مجرد سجل لحروب المسلمين وفتوحاتهم أو وصفا لنجاحاتهم العسكرية، بل يتناول أيضا تاريخ العرب الاجتماعي وتطورهم الاقتصادي. ولعلي بذلك أكون قد وفقت إلى إزالة التعصب الأعمى، والمشاعر السلبية التي أحدثتها الحروب ووجوه الصراع عبر القرون الماضية”.
هكذا يقر المؤلف، محددا منهجه ووجهته وغايته، وهو ما نجح فيه حيث رسم صورة متكاملة حول الحضارة العربية الإسلامية، لا تتوقف عند الحروب والصراعات، بل تتناول النظام المديني الذي أفرز تعايشا حضاريا في مدن عربية من المشرق إلى المغرب.
ويذكر أن هذا الكتاب قد صدرت طبعته الأولى بالإنجليزية عام 1899، ليصبح من يومها مرجعا للقراء والباحثين والمستشرقين الغربيين على حد سواء، وتأتي الطبعة العربية الجديدة لتقدمه بجهد ترجمي وتحريري اضطلع به فريق من المثقفين والأكاديميين، ضم ثلاثة من المعنيين والمتخصصين، حيث تولّى الترجمة رياض رفعت، وحرره حسام أحمد عبدالظاهر، ليشفعه بدراسة ضافية تمثل في حد ذاتها متنا موازيا، شارحا وكاشفا لكل ما يخص الكتاب ومرجعياته وسياقاته، بينما اضطلع أيمن فؤاد سيد بمراجعة الكتاب والإشراف عليه، لتكون المحصلة جهدا فكريا تنويريا يغرس صحيح التاريخ في تربة الثقافة المعاصرة.
ربما يكون الوصف الدقيق لكتاب “مختصر تاريخ العرب والتمدّن الإسلامي”، أنه موسوعة حقيقية، مفهرسة ومبوبة حضاريا وتاريخيا وفق منهجية بحثية علمية لا تكتفي بالتراتب الزمني، بل تؤسس خارطتها على تعميق الأسئلة الفكرية للحضارة وتطوراتها وطفراتها الثقافية بين حقبة وأخرى وجغرافيا وسواها، بحيث تمكن قارئها من إلمام ناصع وشامل بالتاريخين العربي والإسلامي من قبل الرسالة المحمدية وحتى القرن السابع عشر الميلادي.
ويضم الكتاب اثنين وثلاثين فصلا، يمكن تقسيمها إلى سبعة أقسام كبرى تغطي التاريخ العربي ومن بعده الإسلامي في حلقاتهما المفصلية الكبرى: تاريخ العرب قبل الإسلام، عصر الرسول “صلى الله عليه وسلم”، عصر الخلفاء الراشدين، العصر الأموي، العصر العباسي، تاريخ الأندلس، فضلا عن تاريخ العرب في أفريقيا، عبر دوائره الثلاث الرئيسية: الأدارسة، الأغالبة، والفاطميون.
وربما يتوفّر هذا الكتاب على ميزة لا توفرها أغلب الكتب التاريخية التي تعمل على الحيز ذاته، إذ تقف عند توثيق التاريخي مكتفية بالرصد والتسجيل، لكن “مختصر تاريخ العرب” يقدم فضلا عن ذلك، تحليلا سياسيا عميقا وكشفا حضاريا وثقافيا يقلّب في تربة الثقافة ويطرح أسئلتها من كافة جوانبها وصولا إلى الأبعاد الاجتماعية بل والطبقية، ما يجعل من قراءته استكشافا حقيقيا للتاريخ في شموليته وتقليبا لأسئلته داخل السياقات المختلفة، وليس محض وقوف على أعتابه.