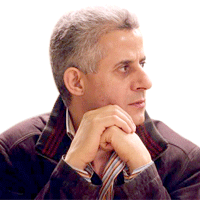مصر تدمن صرعة "الأخلاق" بديلا للقانون

انتفاء الشيء يتناسب طرديا مع الإلحاح على إثباته. وحضور الشيء وتحققه ربما لا يثير الانتباه، ليس نتيجة الاعتياد وإنما لعدم جدوى إقناع الناس بالمستقر، المتفق عليه، والمعلوم من العقل بالضرورة؛ فلا أحد يحاول إثبات أهمية الهواء، ويطارد الناس في دور العلم والعبادة والأسواق ووسائل الإعلام ووسائل المواصلات ورنات الهواتف، لتوعيتهم بوجود الأكسجين وحيويته، لن يكون إلا مجنونا.
ولن تصادف في بلد ديمقراطي مسؤولا يتغنى بالحرية، ويمنّ على مواطنيه بأنهم ينعمون في عهده بأزهى عصور الديمقراطية، بفضل كرمه وتسامحه. فإذا سمعت إفراطا في “الكلام” عن الديمقراطية فاحذر وتحسس رأسك، وتذكّر أن اسم الحزب النازي كان يعني الحزب القومي الاشتراكي، وأن هوس التفاخر باحتكار “الأخلاق” يؤكد أحيانا غياب معناها ودلالاتها. لن يمكنك إحصاء لفظ الأخلاق مسبوقا بكلمة “مكارم” أو متبوعا بكلمة “الحميدة”، في خطب تضخها ميكروفونات مساجد وزاويا يوم الجمعة، تصب في آذان تلتقط طرفا من عدة خطب في مساحة جغرافية صغيرة، فتسمع أول الجملة من خطيب مسجد وبقيتها من خطيب مسجد آخر، وكلهم يربطون نهضة الأمة بالأخلاق. وبانتهاء الخطبة يُستأنف سلوك فظ في التعامل لا علاقة له بمواعظ لا تزال نيئة، ولم تجفّ في الآذان.
في مصر صرعة اسمها الأخلاق، يرددها مدمنو الشتائم. أحدهم عضو في البرلمان لا يكفّ عن سباب مخالفيه بالأم والأب والدين، وتسكت السلطة عن ضجيجه الذي يتضمن تكفيرا وطنيا، وإرهابا نفسيا لخصوم لا يملكون منصات تلفزيونية ترحب بحضوره كاستثمار إعلاني للفضائح. وأما خطاب رأس الدولة فلا يخلو من تذكير بالأخلاق وتغييب لذكر الحقوق القانونية. والوزراء على دين رئيسهم، ومنهم وزير التربية والتعليم طارق شوقي الذي لا تخفى عنه حقيقة وجود مدارس بلا تعليم، ليست إلا أماكن لأداء الامتحانات، وهذه الفوضى تنتظر قانونا عادلا للمدرس وملزما للطالب، ولكن الوزير يقول إن وزارته “تعمل على استعادة القيم والأخلاق في المدارس”، وقد هجرها الطلبة إلى دروس خاصة تكلف الأهالي نحو 30 مليار جنيه، وهذا اقتصاد سري لا يخضع لأي نظام محاسبي وضرائبي رغم علانيته.
من وسائل التغييب أن يرهن الخطاب الديني والسياسي النهضة بالأخلاق، وفي الوقت نفسه يحرّم الاقتراب من أسس نهضة الأمم، وأولها الكفاءة والعدل بوجهيه الاجتماعي والسياسي، وكلاهما يرتبط بالقانون. ولا تزال البلاغة العربية تؤدي دورا في هذا الإيهام بعدالة دفع فاتورة الظلم والتخلف؛ لانهيار الأخلاق. ويتفق التربويون والوعاظ على ذلك، وإذا لم يسعفهم نص ديني مدّوا أيديهم إلى ديوان الشعر العربي، واغترفوا بيتا منقوشا في الذاكرة، ويفرحون به كصيد أو غنيمة وهم يذيعون هذا الارتباط الشرطي:
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت
فإن هُمُ ذهبت أخلاقهم ذهبوا
ولا يعنيهم من قائل هذا البيت الذي يتقاسم نسبته كل من حافظ إبراهيم وأحمد شوقي. وقد غرقتُ في دروب الإنترنت ومتاهاته ليلة كاملة، ثم عدت إلى الشاطئ أكثر حيرة. ولم أستطع الاستدلال عليه بالتصفح غير المتأني لديوان حافظ، ولكني وجدته في الليلة السادسة من كتابه “ليالي سطيح”. ولم يكن شوقي أقل تقصيرا في ربط هذه بتلك، فقال في “نهج البردة”:
صلاح أمرك للأخلاق مرجعه
فقوّم النفس بالأخلاق تستقم
من وسائل التغييب أن يرهن الخطاب الديني والسياسي النهضة بالأخلاق، وفي الوقت نفسه يحرّم الاقتراب من أسس نهضة الأمم، وأولها الكفاءة والعدل بوجهيه الاجتماعي والسياسي، وكلاهما يرتبط بالقانون
في ظل الاستعمار والاستبداد المحلي، ومع قلة الحيلة وتواري الأمل، تجد سوق “الأخلاق” رواجا لفظيا يخفف وطأة الشعور بالهوان. وقد انتبه الشيخ رفاعة الطهطاوي إلى أن “سائر الفرنساوية مستوون قدام الشريعة (القانون)… كل واحد منهم متأهل لأخذ أي منصب كان وأي رتبة كانت… كل إنسان موجود في بلاد الفرنسيس يتبع دينه كما يجب لا يشاركه أحد في ذلك، بل يعان على ذلك ويمنع من يتعرض له في عبادته”. ومما سجله أيضا في كتابه “تخليص الإبريز في تلخيص باريز” أن “العدل والإنصاف من أسباب تعمير الممالك… فلا تسمع فيهم من يشكو ظلما أبدا، والعدل أساس العمران”. واستحسن من طباعهم “أخلاقا” ورفض أخرى، ولكنه احترم قيمة الحرية ورآها مساوية في المفهوم العربي والمصري للعدل والإنصاف، “لأن معنى الحكم بالحرية هو إقامة التساوي في الأحكام والقوانين، بحيث لا يجور الحاكم على إنسان، بل القوانين هي المحكمة والمعتبرة”.
باختصار قال الطهطاوي “العدل أساس العمران”، ثم مضى نحو قرنين من نوائب النهب الاستعماري الكارثي، وثورات التحرر الوطني، وقبضة بوليسية لم تنهها ثورات عربية مجهضة، باستثناء ثورة تونس الناجية من نيران الحكمين الديني والعسكري، ولا يزال الخطاب الديني يلوم الضحايا ويرى ما يحلّ بهم هو العدل؛ لأنهم “نسوا الله فنسيهم”. ولا تتأسس قوة الدولة بالأخلاق، وإنما بقوانين بشرية لا تعرف دينا، ويتساوى أمامها الحاكم والشعب القادر على اختيار حكامه وعزلهم ومحاكمتهم واختيار آخرين، في تداول حرّ على السلطة يضمن محاسبة السابق، وفق قانون لا يفلت منه اللاحق إذا ارتكب خطأ.
قبل تجربة البلاء، قال عثمان بن عفان “إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن”، والسلطان هو عدل القانون، وقدرته على ردع من ينوي ارتكاب خطأ والقصاص ممن أخطأ، فليس للترغيب الأخلاقي والترهيب الوعظي أثر القانون. قول موجز يدل على بذور حكم مدني، ولكن الخليفة في التجربة حين وقعت الفتنة الكبرى لم يتمثل كلامه، وانتهج خطابا دينيا بعد انقطاع الوحي، وقال لمن طالبوه بالتنحي “لا أخلع قميصا ألبسنيه الله عز وجل”، ربما بإيعاز من عبدالله بن عمر الذي نهاه قائلا “لا تخلع قميص الله عنك، فتكون سنّة من بعدك، كلما كره قوم خليفتهم خلعوه أو قتلوه”. وقتل عثمان، ونجا الإمام الحسن من هذا المصير، إيثارا لحقن دماء المسلمين.
وإذا كان ابن تيمية يؤخذ من كلامه ويرد، فلنأخذ قوله “إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة”. وهناك رواية تضع “ينصر” مكان “يقيم”، وكلتا الروايتين أصدق نهاية لهذا المقال.