كتيبة ألمانية تائهة تواجه الجيش الروسي في قتال أخير
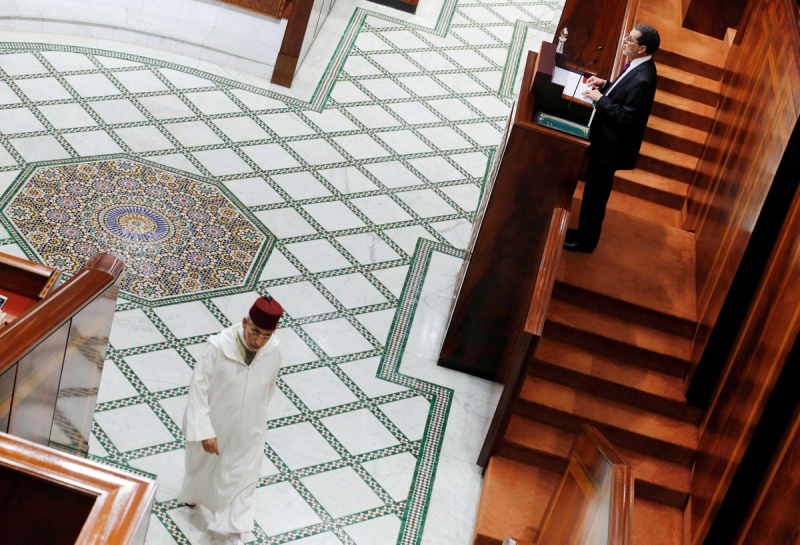
في الحروب والصراعات لا تبقى إلا الذكريات ونقوش التاريخ، ذكريات الجنود وتاريخ المنتصرين والمهزومين، وما بينهما هنالك ثلة من الجنود تتعثر خطاهم وهم بانتظار مصيرهم الأخير للخروج من أتون الحرب. وقليلة هي الأفلام التي تصور الانسحاب من المعارك كفكرة رئيسية، وهو ما نشاهده في فيلم “الجبهة الشرقية” الذي كان مثار جدل واسع.
لا شك أن ثيمة الصراع المفضي حتما إلى منتصر ومهزوم تدفع نحو المزيد من التجارب السينمائية في هذا الاتجاه، لاسيما في أفلام الحرب العالمية الثانية التي كانت وما تزال خلفية مشجعة لإنتاج المزيد من الأفلام، ويمكننا هنا استعراض العشرات من الأفلام التي كانت خلفيتها تلك الحرب الطاحنة والتي أودت بحياة الملايين من البشر وبقيت جراحاتها ممتدة إلى زمن طويل.
صورة الجيش النازي هي العلامة الفارقة في هذا النوع من الأفلام ولعلها صورة نمطية متكررة، الجنود النازيون مميزون بثيابهم العسكرية ومعاطفهم والعلم المعقوف وسيرة هتلر وطريقة التحية ووجوه الجنرالات المتجهمة وشديدة الشراسة باتجاه الإبادة بلا رحمة.
الهروب الدامي والحب
في فيلم “الجبهة الشرقية” للمخرج ريك روبرتس، والذي يعرض على الشاشات الآن، هنالك الكثير مما ذكرته من مواصفات الفيلم الحربي القائم على أساس ثيمة الصراع بين قوتين، والقوتان هنا هما الجيشان الروسي والنازي، وهذا الأخير يبدو أنه في مرحلة هزيمة جسدية ونفسية، وعلى هذا نشاهد انسحابا صامتا لثلة من الجنود النازيين يقودهم جنرال بسيط ومتواضع (كريس ويلسون) في رحلة تدل أو توحي بأنها رحلة انسحاب.
هذه الكتيبة الصغيرة المنسحبة تجد نفسها في سماء وأرض مفتوحتين، ومع أنها منطقة للغابات، إلا أن العدو من الممكن أن يجهز على الجميع في أية لحظة، ولهذا كان الخوف عاملا أساسيا في هذه الدراما الفيلمية وكل يبحث عن خلاص بطريقة ما.
خلال ذلك لا يجد الجنود من وسيلة للتعبير عن قلقهم وخوفهم إلا من خلال حواراتهم مع بعضهم، وشعورهم أنهم غير محميين ولا توجد قوة قادرة على إنقاذهم وأن عليهم مواجهة قدرهم بأنفسهم.
التحولات الدرامية ضعيفة في الفيلم فكل الشخصيات تبدو وكأنها تدور في دائرة لا نهاية لها وتحاول الخروج منها
من هنا يمكننا فهم هذا الفيلم على أنه امتداد لسلسة من الأفلام التي عالجت قضايا الهزيمة والنصر على السواء وحيث أن سمة القتل هي علامة مميزة لدى النازيين، ومن ذلك مشهد مرور سيارة تقل عددا من الضباط النازيين ليشاهدوا امرأة وطفلها، يوقفون المرأة قائلين إنهم بصدد قليل من اللهو، وكل الظن أنهم سوف يتحرشون بها لكنهم بدلا من ذلك يرتكبون جريمة قتل الطفل الرضيع ببرودة دم عجيبة، ومن دون أي سبب يذكر.
بالطبع سوف يقودنا هذا الحدث في السياق الفيلمي إلى أفعال أخرى مثيرة للانتباه، وتستدعي تساؤلا حول جدواها وجديتها وعدم إشباعها صوريا أو في إطار المغزى الذي يريد المخرج الوصول إليه.
ومن ذلك العلاقة التي سوف تربط بين الضابط وبين إليا (الممثلة ميهيري كالفي)، فالضابط الذي تشتغل كل حواسه من أجل إنقاذ كتيبته العسكرية ها هو مشغول بفتاة سوف نعلم في ما بعد أنها أوكرانية، وأن الضابط هو الذي أنقذها، التفاصيل هنا غائبة تماما ولا نعرف حيثيات العلاقة مع الفتاة وأين عثر عليها، لكنها في كل الأحوال تسير بنفس مسار الجنود وتتبع تعليمات الضابط، ولكن إلى أين؟ لا أحد يعلم.
نحن هنا أمام قصة حب في وسط الحرب، إذ أن العلاقة بين إليا والضابط تتطور، ومع ذلك لا نعلم كيف نشأت تلك العلاقة ولماذا تتنقل الفتاة مع الجنود بحضورها الباهت وشخصيتها المسالمة والمستسلمة، لا تملك إلا الوفاء للضابط والمضي معه إلى النهاية.
يعد الضابط حبيبته أنه سوف يذهب بها إلى برلين بعد انتهاء الحرب، وهناك سوف يعود إلى سيرته الأولى، حيث أنه فنان وكاتب وذو شخصية مرهفة وأكثر إنساينة بحسب إليا، لكن في المقابل نشاهد الضابط في ما بعد وهو يحاول التخلص من الأزمة التي لم يستطع الخروج منها، وكذلك الأمر بالنسبة إلى إليا لأنه لم يتمكن من حمايتها من منطلق أنها من الممكن أن تُقتل أو يتم الاعتداء عليها في غياب الضابط، ولهذا من الأفضل أن ترحل بعيدا لكي تنقذ نفسها.
الشكل التوثيقي

لننظر أيضا، من زاوية أخرى، إلى الحياة اليومية التي يسيطر عليها الخوف وكيف انتشل الضابط تلك الفتاة الأوكرانية وأنقذها، بينما في المقابل سوف يتم العثور على فتاتين ممرضتين من الجيش الروسي، وقبل أن يتم التخلص منهما يتم اعتمادهما ممرضتين لمساعدة أحد الجنود الجرحى.
بالطبع لن نجد في هذا الفيلم الكثير مما نبحث عنه في الفيلم الحربي، إذ لا مواجهات مباشرة مع الخصم كما لا تتضح بالضبط الجغرافيا المكانية وكم يفصل بين الكتيبة النازية المنهزمة وبين الروس، على أن الاشتباك سرعان ما يقع، وسوف يؤدي إلى مواجهة متوقعة من خلال معركة سوف تقع مع نهاية الفيلم، حيث تكون الممرضة الروسية ضمن وحدة الجيش الأحمر.
وإذا نظرنا إلى نسيج العلاقة بين أفراد الكتيبة فإنها علاقة يلفها الصمت والكل يريد الخروج من المأزق ما عدا الضابط الذي يشعر أنه ممزق وحائر ما بين إنقاذ الفتاة الأوكرانية والذهاب بها إلى برلين، أو تركها تواجه قدرها في وسط الطريق، وهو ما سوف يفعله مضطرا في مشهد شديد العاطفية، يتخلى عنها ويكون ذلك مؤشرا لموته، إذ ما يلبث أن يقع تحت نيران الروس، ليستمر إطلاق النار عليه بينما أفراد كتيبته يهربون تباعا.
الشكل الواقعي التوثيقي في هذا الفيلم يكمن في جعل أحداثه اليومية لا تتعدى حدود محاولات الكتيبة إنقاذ نفسها والتخلص من مجرد الإحساس أنها من الممكن أن تقع تحت دائرة الخطر من الجيش الأحمر، وكل ذلك أضفى شيئا من الواقعية والبساطة والابتعاد عن المبالغات التي تخرج عن مساراتها الصحيحة.
في المقابل وبموازاة ذلك الأداء الواقعي واليومي المبسط، تابعنا شخصيتي الممرضتين الروسيتين اللتين كان من الممكن تصفيتهما، لكن تم انتشالهما لتنظمّا إلى أفراد الكتيبة الألمانية، وبسبب تصميمهما على الفرار من قبضة النازيين بأية طريقة ممكنة كنا نتوقع منهما المضي إلى هدف محدد والمناورة السريعة، لكننا تابعنا فرارهما في سلسلة مشاهد غير مصنوعة بعناية وأقل إقناعا مما يجب.
وهما في الواقع ورغم أدائهما غير المتكلف إلا أنهما خاضتا صراعا ورغبات في الهرب لا معنى لها وببرود تام، وحتى اعتداءهما على الجندي الألماني لم يكن مقنعا ولا مترابطا، لتكتمل المفارقة في ما بعد بعودة ظهورهما أو إحداهما على الأقل في صف الجيش الأحمر.
الخط السردي

في بناء المكان الحربي تبرز مهارات خاصة تجعل ذلك المكان الكابوسي مكملا لأداء الشخصيات، وهي تعيش أزماتها ولا تعرف مصائرها، لكننا افتقدنا في هذا الفيلم ذلك البناء الفريد والجغرافيا المكانية العسكرية، في ثغرة غير احترافية تماما، وجد المخرج نفسه في وسطها ربما مستسهلا مع فريقه الإنتاجي وباتجاه إيجاد بديل هو ذلك الأفق المفتوح وتلك الطبيعة الممتدة، وبذلك تم التقليل من الكلفة الإنتاجية كما يبدو.
هنا، لا بد لنا من وقفة تتعلق بالمكان والجغرافيا، فالوقائع تشير إلى أن زمن الانسحاب النازي والتقهقر تحت وطأة اندفاع الجيش الأحمر قد تحقق غالبا وكان الوقت شتاء، ولم تكن الطبيعة لتسمح بتلك الحركة الحرة للجيوش، بل كان الوضع مأزقا حقيقيا بالنسبة إلى الجيش النازي في انسحابه العسير من تلك المواجهة القاسية، وهي إشكالية أخرى وقع فيها الفيلم في عدم إحاطته بالجغرافيا المكانية بشكل موضوعي وصحيح.
ولا شك أن هذه الأجواء الخانقة لا بد أن تتسبب في المقابل في ردود أفعال غير محسوبة وغير مسيطر عليها بين الشخصيات، وهو ما يقع فعليا من خلال المواجهة بين الضابط وبين مساعده برونو (الممثل نيال وارد)، فهذا المساعد تم بناء شخصيته الدرامية على أنه الند والخصم غير الظاهر للضابط، ولهذا لا يتورع عن التحرش بإليا صديقة الضابط والمضي في ذلك السلوك بوقاحة، فضلا عن نزعته العدوانية وتسرعه، وصولا إلى عدم دفاعه عن الضابط وهو يلفظ أنفاسه على أيدي الجيش الأحمر.
نجد أن المخرج قد استعان بخط سردي متكامل من خلال شخصية برونو، يوازي ويكون ندا للضابط، ولهذا يسعى إلى ترسيخ نفسه بعد مقتل الضابط وفرار صديقته، وهنا تتضح شخصيته الأنانية وسطوته في تعامله مع الجنود الآخرين، وبذلك نكون قد دخلنا في دائرة جديدة من الصراع ما تلبث أن تتصاعد، ولكن من دون أن تكون لصالح الجنود ولا لمستقبله المهني.
تفاصيل غائبة
إذا توقفنا عند التحولات الدرامية فلن نجد الكثير في هذا الفيلم، الشخصيات وكأنها تدور في دائرة لا نهاية لها وتحاول الخروج منها، ولعلها هنا فكرة طريفة تلك الدوامة، لكنها هنا مرتبطة بالكراهية التي تنبعث فجأة وتسري في النفوس بشكل تلقائي، كراهية الواقع ومحاولة التمرد عليه من جهة وإيجاد خصم من بين الجنود يمكن مواجهته وخوض صراع ما معه.
وفي واقع الأمر، إن هذه واحدة من المصاعب التي تواجه العديد من الأفلام الحربية ومن ضمنها عدم التوسع والتدقيق في العناصر الأساسية الفاعلة في الفيلم، أي الشخصيات الرئيسية باتجاه فرز أداء كل منها وأن تظهر خواص وطبيعة كل شخصية على انفراد وعدم الوقوع في النمطية والتكرار، وكذلك إبراز الخواص الفردية، لكن وقعنا في المتاهة مجددا، والحاصل أن عدم المضي مع مسير القطيع هو الذي يجب على المخرج أن يشتغل عليه من خلال تمييز كل شخصية بخواصها ودوافعها وسلوكها.
ولننتقل إلى عنصر آخر يكمل أداء الشخصيات وهو عنصر الحوار، ورغم الكم الاستثنائي من الحوارات التي تمت وتتم بين شخصيات الفيلم الرئيسية، لكن الملاحظ أنها حوارات نمطية، حملت إشكالا فنيا تنبه إليه العديد من النقاد وهو يتلخص في كون الشخصيات ألمانية، لذا لا بد أن تتكلم بلغتها الأصلية أو حتى بعضها، لكن ما شاهدناه وما سمعناه هو لغة إنجليزية بلكنة بريطانية وأحيانا أميركية، وغابت تلك الطريقة الألمانية في الحوار، ولربما ظن المخرج أن نقطة مهمة كهذه يمكن المرور عليها.
لم ينج الفيلم من انتقادات النقاد والمشاهدين على السواء، لاسيما وأن فيه الكثير من الحوارات وبالتالي الاختلاف في اللهجات كان واضحا تماما، إلى درجة أن سلوك الجنود يبدو وأنه غير متطابق بشكل أو بآخر.




























