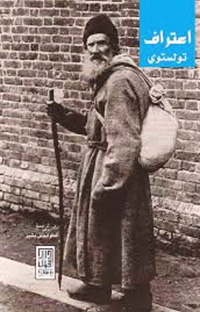عشر سنوات بوهيمية في حياة تولستوي

يعترف تولستوي في كتابه الموسوم بـ«اعتراف تولستوي» بالكثير من المثير في حياته، ورحلته من الكفر إلى الإيمان وهو ما حدا بالسلطة إلى رفض نشر الكتاب في روسيا فاضطر إلى نشره في جنيف بسويسرا في عام 1879.
مع اعتلاء تولستوي قمة المجد الأدبي إلا أنه يعود في كتابه «اعتراف تولستوي» الصّادر عن دار سؤال للنشر ببيروت، بترجمة أنطونيوس بشير، إلى حالة مراجعة للذات في رحلة بحثها، وطموحها في أن تكون ذاتا صالحة، وإن كان وحيدا منفردا في تفتيشه عن الصلاح، ليعترف بأيام الكفر السّوداء من حياته أو كما يسميها أيام الأهواء الجامحة “قتلتُ الكثيرين في الحرب، بارزت الكثيرين لأفقدهم حياتهم، خسرت أموالا كثيرة بالمقامرة، وأنفقت الأموال الكثيرة التي وصلت إليّ بأعراق الفلاحين، قاسيا عاتيا مع معاملة خدمي، لم أترك سبيلا من سُبل الفسق إلا وسلكته، السرقة، والزنا، والسكر، والتمرد، والقتل، كل هذا جزء من حياتي في تلك الأيام”، وقد استمر غارقا في هذه الحياة البوهيمية مدة عشر سنوات.
حياة عارية
سلك تولستوي دروب الأدب والفن كنوع من الهروب من الإيمان، وعاش حالة من الجنون لمدة ست سنوات، سافر فيها إلى أوروبا تعرّف فيها على عظمائها ومفكريها وعلمائها، ساعيا للوصول إلى الكمال العام الذي كان مفكرو أوروبا يؤمنون به. بما أنهم جماعة تؤمن بأن واجبهم في الحياة كمفكرين وفنانين وشعراء أنْ يعلموا الناس الطريق الصحيح.
بعد حالة من الريبة في عدم إقناع نفسه بالتفكير في الموت يجد السلوى في الفن زينة الحياة وسحرها
في خضم هذه المسيرة أدرك شيئا وحيدا هو أن الحياة لا معنى لها. وبعد حالة من الريبة في عدم إقناع نفسه بالتفكير في الموت، يجد السلوى في الفن الذي هو زينة الحياة وسحرها.
العودة إلى الإيمان
يذهب تولستوي في جدلية من الأفكار حول الإجابة عن ماهية الحياة، رافضا التفسيرات التي يقدمها العلم التجريدي أو حتى العلم الفلسفي الذي يجنح إلى إجابات تتصل بماوراء الطبيعة، وتنتهي الإجابة إلى لا شيء، أو لأنها موجودة، الحقيقة التي يصل إليها في رحلة بحثه عن جوابه أن هذه العلوم الدقيقة والفلسفة المخلصة لغايتها ومبادئها لا تستطيع الجواب عن سؤاله المطروح إلا بالجواب الذي قدمه سقراط وشوبنهاور وسليمان وبوذا. هذه الرحلة في حقول المعرفة البشرية لم تنته به إلى معرفة وري لظمأ السؤال بل زادت من الفشل في شفائه من يأسه، وزادته يأسا وشكا.
ثم يهرع إلى الحياة ذاتها علّها تقدم له الجواب الذي فشلت فيه المعرفة والفلسفة والعلم، فراح يراقب الناس المحيطين به، فالناس يقاومون الحياة إما بالهروب من الحياة المرعبة بالجهل، والغالبية من هذه الفئة من النساء والأطفال والشباب، وإما باللامبالاة وهم الشهوانيون وعبّاد أهوائهم الجامحة، فغضوا الطرف عن التنين ورؤية الوحش الذين في انتظارهم، أو بالالتجاء إلى القوة والعزم، وكلها تأمر بالقضاء على الحياة بعد معرفة شرها وبطلانها، وأخيرا بالضعف، فصاحبه مع علمه بشر الحياة وبطلانها فهو يواظب على المحافظة على حياته، فأبناء هذه الطبقة يدركون أن الموت أفضل من الحياة، ومع هذا فليست لديهم القدرة والقوة على الإقدام على الانتحار.
|
حيال ما يراه تولستوي من فزع وخواء لدى طبقته من النبلاء يتساءل «ما المعنى الذي أعطته الحياة للملايين من الناس، الذين عاشوا ويعيشون في هذا العالم؟» وللإجابة عن هذا السؤال يلوذ أحيانا بما ذكره شوبنهاور عن الحياة التي لا معنى لها وهي شر بذاتها، لكن بعد بحث دقيق يرى أن هذا الجواب ليس بالجواب البات أبدا.
كان شرطه في قبول الإيمان هو ألا يتطلب منه في مقابل هذا نكرانا ظاهرا لعقله. وبعد رحلة بحث مضنية وجد ضالته عند البسطاء من طبقة الفقراء والعمال، فحياة الفلاحين البسطاء والعمال مليئة بالتضحية والألم، الانتحار معدوم في ما بينهم، عن طريق الألم يعرف تولستوي معنى الحياة، عكس ما رأى في طبقته من النبلاء. فطبقة الفلاحين الإيمان الحقيقي كامن في قلوبهم، وأن هذا الإيمان مكمل لحياتهم. ومع أنهم حرموا كل الملذات التي تجعل الحياة ذات قيمة في نظر سليمان الحكيم فهم يعيشون، ووسط سعادة لم يحلم بها سليمان في مجده.
يَنتهي المطاف بتولستوي بعد رحلة شك وبحث إلى أن الحياة لا تكون دون الله، وما إن آمن بهذه الحقيقة حتى شعر بقوة الحياة الحقيقية، ولم يفارقه النور الذي أشرق على حياته، ثمّ شارك البسطاء في صلواتهم، ومناولة الأسرار المقدسة. كان الإيمان في بدايته في حياة تولستوي، مما أجبره على مسايرة الكنيسة وعدم الاعتراض على أي شيء قد يعيد إليه أيام الشك الرهيب. ومع عودته إلى الكنيسة إلا أنه ما لبث أن انفصل عنها بلا عودة بسبب علاقة الكنيسة الأرثوذكسية مع بقية الكنائس الأخرى الكاثوليكية والبروتستانت، أمّا السبب الثاني فقد كان بسبب الحرب، فقتل المسيحي للميسحي في رأيه بمثابة الجريمة التي يجب أن يدان عليها زعماء الكنيسة.