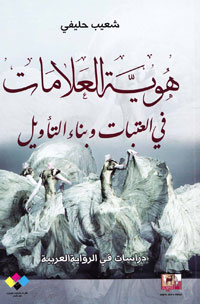شعيب حليفي باحثا في قضايا الرواية العربية

يواصل الناقد المغربي شعيب حليفي منجزه النقدي، مركّزا على اقتران الممارسة النقدية النظرية بالنقد التطبيقي بصورة تكتمل معها دائرة الفعل النقدي، واختبار منظومة المفاهيم وأدواتها إجرائيا على خلاف العديد من الممارسات النقدية النظرية العربية الأخرى، التي تستغرق في التنظير.
في كتابه الجديد “هوية العلامات: في العتبات وبناء التأويل” يكشف الناقد منذ العنوان الرئيس عن الموضوعين الأساسيين اللذين ستدور حولهما محاور الدراسة، وهما العتبات ووظيفة البدايات، والبناء الروائي ومحاور التأويل والتي يتفرع عن كل قسم منهما محاور كثيرة بغية الوصول إلى الإدراك المقنع للنسيج العلاماتي المحقق لهويات متعددة ومختلفة في النصوص الروائية إلى جانب البحث عن الأداة النقدية لإعادة اكتشاف البناء المرآتي والمعرفي للسرود من خلال تفكيك خطاب العتبات والدنو من هوية المتخيل وما ينشره من امتدادات حيث ينفتح التحليل على بعض العلامات التي ظلت زمنا بعيدة عن البحث والدرس النقدي، وهي العنوانوالخطاب المقدماتي والبدايات.
العنوان والكتابة
يركز الناقد في دراسته لاستراتيجية العنوان على أهمية هذا العنوان من حيث كونه عنصرا من أهم العناصر المكوّنة للكتاب وما يقوم به داخليا من وظيفة تجعله ممثلا لسلطة النص وواجهة إعلامية له تمارس على المتلقي سلطتها، إلى جانب دورها في الكشف عن طبيعة النص وفك غموضه. ويؤكد الناقد في هذا السياق أن علاقة العنوان بالنص يمكن رصدها من خلال زوايا متعددة في أزمنة مختلفة من خلال السيرورة التاريخية، فالعنوان كان دائما يقوم بمهمة تعيين معنى النص كله وإظهاره، من خلال الدور المصاحب الذي تقوم به العناوين الداخلية. وينطلق في تحليله من طروحات السيميائي “ليوهوك” التي يرى أنها الأعمق لكونها تتناول العنوان من منظور مفتوح.
لقد استدعى التطور الذي عرفته الكتابة وجود العنوان كضرورة للتعريف به من أجل تداوله، ما نجم عنه خصائص راحت تؤطر المحكي القديم وتشمل الأشكال التعبيرية ، التي تشكلت معها علامات أساسية منها التعريف بالمؤلف والجنس الأدبي وتعيين مضمون المؤلف والعمل على تحفيز القارئ. إلى جانب التناول الموسع لوظائف العنوان، يرصد الخصائص التي ميزت العنوان في المؤلفات القديمة من كتب التراث.
يركز الناقد في دراسته لاستراتيجية العنوان على أهمية هذا العنوان من حيث كونه عنصرا من أهم العناصر المكونة للكتاب
العنوان والرواية
يتتبع حليفي تاريخ العنونة الروائية العربية وتحولاتها من خلال دراسته للعلاقة بين العنوان والوعي بالجنس الروائي العربي في الأعمال الروائية الأولى، التي حافظت على المنحى القديم في العنونة، وأظهرت بروز الطابع الرومنسي فيها والمباشرة والوضوح أو التناص مع عناوين قديمة. ومع بروز الدعوة لتحرير المرأة هيمنت الأسماء النسوية على تلك العناوين. ومما تتعمّقه الدراسة موضوع بنية العنوان الروائي من حيث التحولات البنيوية التي طالته في إطار الكتابة العامة ومنها الاختصار والتكثيف والاشتمال والوضوح والعنوان الفرعي الذي يضفي نوعا من الإثارة والتشويق يقوم به العنوان الفني.
خطاب المقدمات
في محور آخر يتناول الناقد والأكاديمي خطاب المقدمات من حيث علاقته بالوعي النقدي ابتداء من تعريف المفهوم باعتباره خطابا موازيا للنص الروائي يؤسس له انطلاقا من تكوينه الذي يشتمل على أسئلة أساسية أو قضايا فكرية تتعلق بالخاص والعام للرواية، ثم يوضح أهمية دراسته من خلال كونه لا ينفصل عن النص الروائي ما دام قد أنتج حوله ليتصل به اتصالا مباشرا. بعد هذا التمهيد النظري يحاول الإجابة عن سؤال أولي يتعلق بمدى قدرة خطاب المقدمات على بلورة تصور نظري حول الرواية.
|
هذا التصور يرتبط كما يراه بالشروط الاجتماعية والثقافية أولا، ثم بالتراكم الذي يحقق قوانين المحكي من خلال تجربة الكتابة الروائية. واستكمالا لهذا البحث يدرس مرتكزات هذا الخطاب البنائية التي جرى النظر إليها نقديا من زوايا مختلفة، وكذلك جذور هذا الخطاب الذي لم يكن وليد الحاضر، إضافة إلى دراسة خطاب الوعي الذي صاحب نشوء هذا الجنس عربيا منذ منتصف القرن التاسع عشر، والبحث في الجهود التي أسست لتكوين الوعي الروائي النقدي العربي، حيث شهد خطاب المقدمات في الرواية العربية تحولات سريعة بالمقارنة مع الخطاب القديم مما ترتب عليه بلورة تصور موحد أساسي لنظرية الرواية. ومن أنواع خطاب المقدمات التي يتوقف عندها خطابات المقدمات الذاتية وخطابات المقدمات الغيرية، التي يلحق بها الآراء النقدية التي تثبّت على غلاف الرواية الأخير، وخطابات المقدمات المشتركة وهي تتوزع على مقدمات تقريظية ومقدمات نقدية وأخرى موازية للنص. وعلى غرار المنهج الذي اتبعه في الفصل السابق، يقوم الناقد بتحليل خطاب المقدمات في رواية “فقهاء الظلام” لسليم بركات.
وظيفة البداية
بدأ الاهتمام النقدي بوظائف خطاب المقدمات متأخرا ما استدعى منه تخصيص حيز واسع لدراسة وظيفة البداية ومجازات المعنى، كما تجلت في الرواية العربية، من حيث كونها حلقة تواصل بين المؤلف والسارد من جهة، وبين المتلقي من جهة ثانية. فهي مجازفة وباب يقود المتلقي عبر اللغة السردية والأوصاف إلى عالم النص الرحيب.
يتتبع حليفي تاريخ العنونة الروائية العربية وتحولاتها من خلال دراسته للعلاقة بين العنوان والوعي بالجنس الروائي
وفي إطار هذا السياق يبحث في بناء المتخيل السردي والحكائي والتأويل وعلاقاتهما بالوعي الروائي، متناولا بالتحليل المتخيل الروائي في عدد من أعمال بهاء طاهر، لا سيما ما يتعلق منه بالملمح التاريخي وبناء الجملة السردية وعلاقة الصورة بالمرجع أو بالوعي بالعالم، بينما يفرد لدراسة بنية العجائبي في الرواية العربية مساحة خاصة بعد أن تمّ توظيفه فيها، من خلال مستويات وطرائق مختلفة، سواء على مستوى الوقائع أو الشخصيات الروائية. ويذهب حليفي إلى أن العجائبي في الرواية العربية قد جاء خارقا مكسّرا للحدود بين الماضي والآتي ومؤسسا للحيرة والتعجب، ثم يوضح كيفية توظيفه في أعمال عديدة كرواية “مدينة الرياح” لموسى ولد إبنو، و”عين الفرس” للميلودي شغموم، و”أبواب المدينة” لإلياس خوري التي تخضع فيها أزمنة الرواية وأمكنتها لتحولات عنيفة و”امتساخات” من داخل رحم ما هو واقعي.