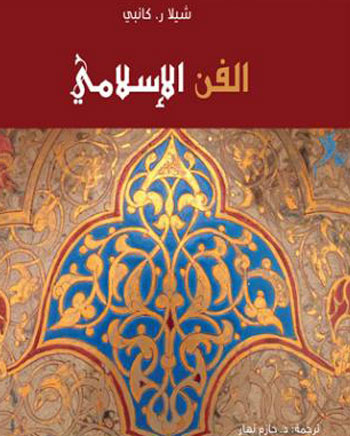رحلة استكشاف بحثا عن خصوصية الفن في الثقافة الإسلامية

اتخذ الفن الإسلامي طابعا مميزا وخاصا في تاريخ الفنون العالمية عُرف بفن الرقش أو الزخرفة أو الأرابيسك، والذي تطور كثيرا عبر مراحل مختلفة من تاريخ الحضارة العربية والإسلامية، معبّرا عن انشغالات وموضوعات مختلفة، كانت تشغل الثقافة العربية الإسلامية في تلك المرحلة التاريخية.
الباحثة شيلا. ر. كانبي المسؤولة عن القسم الخاص بالفن الإسلامي في متحف المتروبوليتان والعضو في دائرة الفن الإسلامي في المعهد البريطاني للدراسات الفارسية، تتناول في كتابها الفن الإسلامي، الذي صدر في طبعة فاخرة وأنيقة ضمن منشورات مشروع كلمة بأبوظبي (من ترجمة حازم نهار) خصائص هذا الفن، من حيث التفاصيل الخفية للقطع الفنية الإسلامية المزخرفة، بهدف الوصول إلى تكوين فهم أوفى وأشمل لأسلوبها ونهجها في التصوير، حيث تقدم نماذج متعددة وهامة من أنواع هذه الفنون مترافقا مع دراستها لكل شكل من أشكال هذا الفن والمراحل التاريخية التي ظهر فيها، والجغرافيات التي شهدت تحولاته وتطوره.
خصوصيات فنية
توضح المؤلفة الغرض من تأليف هذا الكتاب الذي يحاول دراسة العناصر والمواضيع الخاصة بهذا الفن حيث نستطيع من خلالها تعريف هويتها الإسلامية رغم امتدادها التاريخي الطويل وانتشارها الجغرافي الواسع إلى جانب ما شهدته من تحول أخير عبر أرجاء العالم. في ضوء هذه التباين ووفقا للعصور والمناطق التي ظهر فيها، فإن فن العراق في القرن التاسع لا يمكن أن يشبه فن شمال الهند في القرن التاسع عشر في حين أن فن الخط العربي والأرابيسك والتصاميم الهندسية نجدها تتكرر في فنون العالم الإسلامي حيث تتم إعادة تأويلها في كل عصر وفي كل منطقة.
الباحثة تحاول من خلال كتابها الرد على بعض المقولات الشائعة التي تدّعي أن الفن الإسلامي يخاف من الفراغ ما دفعه للإحجام عن ترك أي سطح فارغا أو غير مزخرف. لكنها رغم إقرارها بتلك المبالغات إلا أنها تعود لتؤكد أن أسطح كثير من القطع الإسلامية مغطاة فعليا بالزخارف، التي غالبا ما تكون صغيرة وتقوم على دمج مجموعة أنواع الزخارف.
القضية الثانية التي تحاول مناقشتها هي الادعاء بأن الأشكال التصويرية محرمة في الفن الإسلامي، حيث تعتمد على عدم وجود نص قرآني يحرم ذلك، لكن في نفس الوقت ترى أن غيابها عن نسخ القرآن جعلها تبدو وكأنها شريعة إلهية، الأمر الذي انعكس على وجود الأشكال الحيوانية والإنسانية في العمارة الدينية كالمساجد والمدارس الدينية.
تذهب شيلا إلى أن أنواع الزخارف الإنسانية والحيوانية والنباتية في الفن الإسلامي يمكنها أن تدلنا على بيئة الحياة التي عاشها الناس والذين صنعت هذه الأشكال من أجلهم، فقد تم تصوير التسليات الممتعة كالصيد والشراب والرقص وعزف الموسيقى إلى جانب الانبهار الذي ظهر فيها بالسماوات، من خلال رموز الشمس والقمر، يقابل ذلك كله الانتشار الواسع لصور الحيوانات الخيالية والطبيعية فيه. إن الأشكال التي تعرضها الباحثة في هذا الكتاب مأخوذة من المتحف البريطاني في حين أن رسوم السجاد والمنسوجات والأزياء والعناصر المعمارية الكبيرة لا تتوفر في هذا الكتاب رغم كونها جزءا مهما من هذا الفن. ولكي تقدم عرضا واسعا ومتنوعا من تاريخ هذا الفن وجغرافياته المتباعدة عمدت إلى أن يكون الكتاب مرتبا وفق المواضيع، حيث يساعد ذلك في تقديم تفاصيل واسعة للمعروضات التي تنتمي إلى مصادر جغرافية وفترات زمنية مختلفة. لكنها على خلاف الباحثين الآخرين لا تسعى في هذا الكتاب لتقديم عرض تاريخي لهذا الفن بل تسعى إلى إظهار براعة الفنانين الذين صنعوا هذه الكنوز والمخيلة العظيمة التي أنتجت ذلك.
|
ما الفن الإسلامي
على هذا السؤال الذي تجعل منه عنوانا لبحثها الأول تحاول شيلا أن تجيب بالقول إن الأعمال المصورة التي تقدمها في هذا الكتاب قد أنتجت خلال مراحل معقدة من التاريخ، الأمر الذي يجعل هذا الفن يتناول الأراضي الصحراوية والجبال والسهول والمستنقعات، إضافة إلى أن كثرة السلالات التي حكمت تلك البلاد وحركات التمرد والغزو والنزاعات المدنية تخلق عند الباحث انطباعا بأن حياة هؤلاء الفنانين ومن يرعاهم كانت استثناء.
في البداية تتناول فن الخط العربي من حيث اعتبار العربية لغة مقدسة لكونها لغة القرآن، ثم تتحدث عن فن الأرابيسك القائم على رسم لفائف الكرمة المعرشة، في مناطق شرق البحر المتوسط التي حكمها الرومان. إن هذا الفن التزييني قد جرى دمجه مع عناصر هندسية وأشكال ونقوش مختلفة وغالبا ما استخدم في تزيين أجسام متباينة من المشغولات المعدنية والسجاد. وتشكل الزخارف الهندسية عنصرا أساسيا ثالثا في هذا الفن، حيث تستخدم في أنسجة العصر الروماني والعصر القديم وفي الفسيفساء. وقد لعبت دورا مهيمنا أكبر في التصاميم الإسلامية كالأشكال النجمية والمضلعات في كل الفنون، إلى جانب أنها شكلت مصدرا لكثير من التزيينات المعمارية، وكانت كغيرها من أشكال الفن السابقة متعددة الاستخدامات، ويمكن أن تكون معقدة كثيرا.
الخط العربي
تفرد الباحثة للخط العربي فصلا خاصا تعرض فيه بداية تاريخ كتابة أحرف الأبجدية وتطورها مع تطور أنماط الخطوط العربية، استجابة لحاجات متعددة كالكتابة السريعة والكتابة بالخطوط المطورة لنسخ المخطوطات يدويا. عملية التطوير الأولى التي قام بها ابن مقلة ومن بعده ابن البواب تجلت في تحديد ستة أنماط من الكتابة المتصلة على أساس نظام صارم في نسبة أجزائها، وهي خطوط النسخ والثلث والمحقق والطوقي والريحان والرقعي حيث يمكنها أن تجاري الخط الكوفي ما يجعلها مناسبة لنسخ القرآن. لقد جعل الخطاطون الأوائل من النقطة المعينية الشكل الوحدة الأساسية لتحديد نسب أبعاد الحروف العربية، بينما شكلت الهندسة المستوية الجزء الأساس من التصاميم الإسلامية، الذي تقوم عليه الزخرفة اللاّتصويرية المرسومة على القطع والهياكل في الفن والعمارة الإسلاميين، والتي نمت في القرنين السابع والثامن حتى أصبحت مع بداية القرن التاسع سمة قياسية للزخرفة الإسلامية.
الأرابيسك
تعرّف الباحثة فن الأرابيسك بأنه لفيفة مع عناصر متكررة وتبادلية من الزهور وأوراق النباتات، تتصل بكرمة معرشة كأدة للتأطير والحشو في الفن الإسلامي. وهي تعيد نشأته إلى زخرفة الأقنثا الشوكية الأثرية المتأخرة ولفائف الكرمة، التي تتميز بتموجها الإيقاعي. لكن هذا الفن يمكن أن يتضمن تصميما لا نهائيا دون وجود بداية أو نهاية محددة. كذلك فإن المنحى التبادلي للكرمة المعرشة يكون عادة على شكل هندسي أكثر من كونه شكلا طبيعيا. ويتسع هذا النوع من الفن ليظهر كإطار لعناصر أخرى، أو يحتل موقعا رئيسا ويغدو موضع المركز في هذه الزخرفة. ويذهب بعض العلماء إلى القول إن العديد من العناصر النباتية التي تشكل الأرابيسك لم تكن حكرا على الفن الإسلامي، إلا أن استخداماتها وتوزّعاتها الجغرافية كانت فريدة من نوعها في هذا الفن. وتؤكد الباحثة أن هذا الفن تحرر في مراحل لاحقة من ارتباطاته بما سبقه من الزخارف الأثرية بصورة تدريجية، وبدءا من القرن العاشر أخذ تقيده الصارم بالتناظر يتراجع، بينما أخذت أشكل الكرمة المعرشة والأوراق تلتف أو تتدفق خارج الإطار الهندسي للشكل. وفي مراحل لاحقة بدأ دمج الأرابيسك مع الكتابة لا سيما الخط الكوفي في زخرفة قطع النسيج.
الأشكال البشرية
على خلاف ما شهدته العمارة وعملية صك العملة الإسلامية من استبدال الأشكال البشرية بالزخرفة، تجد شيلا أن تمثيل البشر والحيوانات قد استمر بلا انقطاع في اللوحات الجدارية لقصور بلاد الشام. وفي القرن الثاني عشر مع تزايد إنتاج الخزف المزجج في مصر وسوريا وإيران انتشرت الرسوم البشرية على نطاق واسع، لكن معظم تلك الأشكال البشرية لم تكن تمثيلات للبشر، بل شكلت معيارا أيقونيا تصويريا يرتبط بحياة البلاط والتجسيدات الفلكية والتنجيمية. وتبين الباحثة الوظيفة التخطيطية للأشكال البشرية ومحاولات تجاوزها في عهد الحكام الصفويين، الذين أدخلوا بدءا من القرن السادس عشر صور الحكام والرسوم التي توضح الأحداث في السرد القصصي للوحات. وتعود الباحثة في فصول خاصة إلى استعراض نماذج واسعة من الزخرفة الحيوانية والنباتية التي استخدمت في الزخرفة، في مراحل لاحقة من تاريخ هذا الفن، الذي كان يتطور ويتوسع وفقا للعصور التاريخية والأسر الحاكمة في مناطق العالم الإسلامي المختلفة.