حسن المودن: لا يمكن مواجهة المستقبل دون حكاية عائلية تسند الذات

اهتم الناقد المغربي حسن المودن على مدار مشواره النقدي بالمقاربة النفسية للنصوص الأدبية، موليا جل اهتمامه بمناهج التحليل النفسي وعلاقتها بالأدب سواء عن طريق ما أنجزه من ترجمات لأهم النُقاد وعلى رأسهم الناقد الفرنسي جان بيلمان نويل والمحلل النفسي الناقد الفرنسي بيير بيار، أو ما قدّمه من قراءات في الأعمال الأدبية. “العرب” حاورت المودن حول الوضع الراهن لنقد النصوص الأدبية من منظور نفسي انطلاقا من بعض ما أورده في كتابه الصادر حديثا “الأدب والتحليل النفسي”.
أسس فرويد مفاهيم أساسية في التحليل النفسي، انتقلت بعد ذلك إلى النقد الأدبي، لكن الجهود التالية لفرويد كأدلر ويونج لم تنل الاهتمام نفسه على مستوى التحليل النفسي للأدب رغم أن بعض المفاهيم لهم قد تصلح بشكل أكبر في قراءة الكثير من الأعمال الأدبية.
يوضح المودن أن هذه ملاحظة صحيحة إلى حد كبير رادا ذلك إلى أن فرويد هو الذي قرأ الأدب من زوايا متعددة ومختلفة؛ درس الكتاب والشعراء، درس النصوص والأعمال الأدبية في حد ذاتها، درس تأثيرات الأدب والأعمال الفنية.
وهناك دوما، وفق المودن، عودة إلى فرويد، عندما كان النقد البيوغرافي هو السائد، كان النقد النفسي يدرس لاوعي الشعراء والكتّاب؛ وعندما ظهر النقد البنيوي، انتقل النقد النفسي إلى دراسة لاوعي النص الأدبي؛ وعندما تراجعت البنيويات لصالح التداوليات ونظريات التلقي، أصبح انشغال النقد النفسي هو هذا التفاعل بين النص ولاوعي القارئ.
التحليل النفسي والأدب
ينوه المودن بأهمية ما قدّمه الناقد الفرنسي جان بيلمان نويل في حقل النقد النفسي للأدب، ففي النقد النفسي المعاصر، الفرنسي على الأقل، بدأ يتأسس ويتطور تصوره من السبعينات إلى اليوم، ويعود إليه الفضل في نقل النقد النفسي من الانشغال بلاوعي الشعراء والأدباء وعقدهم وغرائزهم إلى الاهتمام بالنصوص الأدبية في حد ذاتها، والتركيز على الكيفية التي يشتغل بها اللاوعي داخل النصوص، مؤسسا نظرية جديدة في التحليل النفسي النصي في كتاب نظري بعنوان “التحليل النفسي والأدب” صدر أواخر السبعينات، وتمت ترجمته إلى العربية سنة 1997 صادرا عن المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة؛ وفي كتب تطبيقية أهمها “نحوَ لاوعي النص”، الذي صدر في التسعينات.
عقدة الأخوة تهتم بالعلاقة بين أعضاء العائلة/المجتمع، وتطرح مسألة العلاقة بالآخرين داخل الوسط العائلي وداخل المجتمع
وبعد أن كان يدرس لاوعي النص تحت تأثير المدرسة البنيوية، صار في السنوات الأخيرة أكثر انشغالا بلاوعي القارئ تحت تأثير التداوليات ونظريات التلقي، وكتابه الصادر سنة 2011 بعنوان “أن تقرأ بكل لاوعيك” يحمل تصورا جديدا يستحق القراءة.
وتعد جهود الناقد الفرنسي بيير بيار في مجال الأدب والتحليل النفسي من أبرز الجهود في مجالي الأدب والتحليل النفسي وقد اقترح، حسبما أوضح المودن في كتابه “الأدب والتحليل النفسي” تطبيق الأدب على التحليل النفسي.
ويبيّن الناقد المغربي في هذا الصدد أن مشروع بيير بيار مهم جدا، لأنه حرر النقد النفسي من كسله وعجزه بعد أن قلب العديد من المسلمات، وخاصة في كتابه الصادر سنة 2004 بعنوان “هل يمكن تطبيق الأدب على التحليل النفسي؟”، فبعد أن كان تطبيق التحليل النفسي على الأدب هو السائد، تساءل بيير بيار إن كان من الممكن تطبيق الأدب على التحليل النفسي، وحجته أن التحليل النفسي تأسس أصلا انطلاقا من الأدب، ولن يتجدد إلا انطلاقا من الأدب، ففرويد قد استمد نظريته من نصوص سوفوكل وشكسبير ودوستويفسكي وغوته..إلخ. ومن الممكن أن نستخلص مفهومات نفسانية جديدة من الأدب.
يتابع المودن “قبل سنوات قليلة، وبعد أن قدمت تصور بيار نظريا، شرعت في تطبيقه عمليا، فنشرت في مجلة عربية دراسة بعنوان ‘عقدة الأخوة أولى من عقدة أوديب‘، موضحا أن قراءة جديدة في نصوصنا الدينية ‘سورة يوسف في القرآن‘ يمكن أن تساعدنا على تجديد النقد النفسي، وبدل إسقاط عقدة أوديب على كل نصوصنا الأدبية، ها هي قصة النبي يوسف توضح أن الصراع لا يكون دائما بين الابن وأبيه، وأن موضوع الصراع ليس هو المرأة/الأم، بل الصراع الأساس هو بين الأبناء الإخوة، وموضوع الصراع هو الأب نفسه: من يحق له أن يرث الأب، أن يرث الخطاب، أن يرث السلطة؟ وعقدة الأخوة أهم وأولى، لأن عقدة أوديب تهم الفرد الواحد فقط، في نموه النفسي والجنسي، في حين أن عقدة الأخوة تهتم بالعلاقة بين أعضاء العائلة/المجتمع، وتطرح مسألة العلاقة بالآخرين داخل الوسط العائلي وداخل المجتمع، وتهم العلاقات الاجتماعية، وكيفية تدبير التواصل مع الآخر”.
ويضيف الناقد المغربي “منذ سنوات وأنا أشتغل على هذه العقدة في كتاب سيصدر قريبا، وهو يدرس العلاقة بين الإخوة الأعداء في النصوص الدينية ‘قابيل وهابيل، يوسف وإخوته..‘، وفي النصوص المسرحية عند سوفوكل وشكسبير وراسين..، وفي النصوص الروائيةعند دوستويفسكي وكازانتزاكي ونجيب محفوظ..، وفي هذا الإطار نفسه، وفي كتابي الصادر مؤخرا ضمن منشورات الدوحة ‘الأدب والتحليل النفسي’، نشرت دراسة في قصص الكاتب الأرجنتيني المشهور خوخي لويس بورخيس، مفترضا أن هذا الأخير كان من خلال نصوصه الأدبية يؤسس تحليلا نفسيا مغايرا للذي أسسه فرويد”.
المحكى العائلي
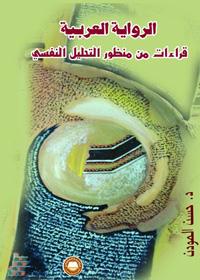
انتقالا للحديث عن قراءاته في التحليل النفسي للأدب العربي، لاسيما ما قدّمه في كتابه “الرواية العربية.. من الرواية العائلية إلى محكي الانتساب العائلي”، يشير المودن إلى أن هذا الكتاب الذي فاز سنة 2016 بجائزة كتارا للدراسات النقدية، تناول فيه نصوصا روائية عربية، مغربية ومصرية وخليجية. وهو محاولة نقدية تطبق مفهومين نفسانيين جديدين على النقد العربي: مفهوم ‘الرواية العائلية‘ الذي وضعه فرويد واشتغل به نظريا وتطبيقيا، ونقلته مارت روبير إلى النقد الروائي في كتابها المعروف ‘أصول الرواية ورواية الأصول‘، والمفهوم الثاني هو مفهوم ‘محكي الانتساب العائلي‘، وهو مفهوم جديد في النقد الأدبي الفرنسي المعاصر”.
ويوضح المودن “في ضوء هذين المفهومين، أعدت قراءة الرواية العربية عبر تاريخها، مفترضا أن هذا التاريخ ينقسم إلى محطتين كبريين: المحطة الأولى هي محطة الرواية العائلية، وفيها تلك النصوص ‘نصوص توفيق الحكيم ويحيى حقي وسهيل إدريس والطيب صالح وعبدالمجيد بن جلون…‘ التي تحكي عن ذات غادرت عالمها العائلي الأصلي (مصر، السودان، المغرب، لبنان..) نحو عالم عائلي جديد، عجيب ومدهش (باريس، لندن..)، وهي ذات ساردة معجبة بهذا العالم العائلي الجديد وتريد أن تنتمي إليه، لكنها في الوقت نفسه لا تريد الانفصال عن عالمها العائلي الأصلي، فبقيت موزعة وممزقة بين العالمين، فلا هي عرفت كيف تبني عالما عائليا جديدا، ولا هي عرفت كيف تحافظ على عالمها العائلي الأصلي، وتلك ربما روايتنا العائلية جميعا وإلى اليوم”.
ويتابع المودن “المحطة الثانية هي محطة محكي الانتساب العائلي، وهي بدأت تتأسس منذ ثمانينات القرن الماضي مع نصوص من المغرب وتونس والكويت وبلدان عربية أخرى بلا شك.. وما يميزها هو هذه الذات التي تعود إلى عالمها العائلي الأصلي لتسائله من جديد: تسأل عن الآباء والأجداد، وتمارس البحث في الأصول والفروع، وتحفر عميقا في الإرث العائلي: من أنا؟ وهنا أفكر في روايات أخرى غير التي درستها في هذا الكتاب: روايات مغربية من مثل ‘جنوب الروح‘ لمحمد الأشعري، ‘المغاربة‘ لعبدالكريم جويطي و‘موت مختلف‘ لمحمد برادة. وأستحضر من تونس رواية ‘أطفال بورقيبة‘ لحسن بن عثمان، وروايات من الكويت مثل ‘ساق البامبو‘ لسعود السنعوسي و‘الجميلات الثلاث‘ لفوزية شويش السالم”.
ويلفت المودن إلى أن الأمر لا يتعلق دوما بانتساب عائلي في معناه الحرفي الضيق، فالملاحظ في الأدب الروائي العربي المعاصر هو تكاثر هذه النصوص التي تعود إلى كتابة/قراءة بيوغرافية كاتب عربي قديم أو كاتبة غربية حديثة، وهو ما يدفعه للتفكير في رواية مغربية بعنوان “جيرترود” لحسن نجمي، وفي روايات مغربية وعربية أخرى تعيد كتابة شخصيات من تاريخنا وتراثنا، من مثل ابن خلدون أو التوحيدي أو غيرهما، ويمكن أن نستحضر هنا جمال الغيطاني وبنسالم حميش وبهاءالدين الطود وغيرهم.. وهنا يتعلق الأمر بمحكي يؤسس لنوع آخر من الانتساب العائلي، يمكن أن نسميه بالانتساب العائلي الأدبي، فالأمر يتعلق بذات ساردة/كاتبة تريد أن تنتسب إلى سلالة معينة من الأدباء والكتّاب.. والسؤال الذي تفرضه هذه الروايات التي تنتمي إلى محكي الانتساب العائلي، بمعنييه المذكورين، هو: هل بإمكان الذات أن تتأسس من دون نسب عائلي، من دون محددات عائلية، من دون حكاية عائلية؟ هل يمكن أن نواجه المستقبل من دون حكاية عائلية تسند الذات؟ ذلك ربما هو سؤالنا الإشكالي اليوم.




























