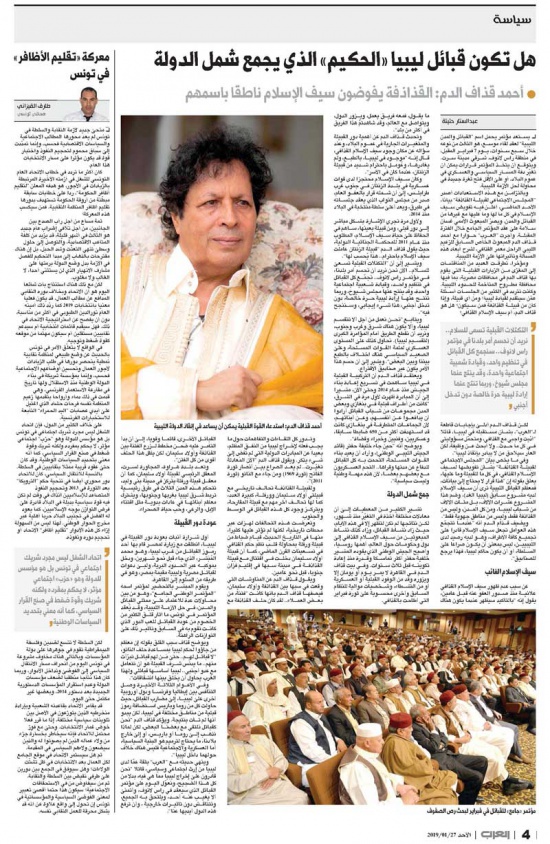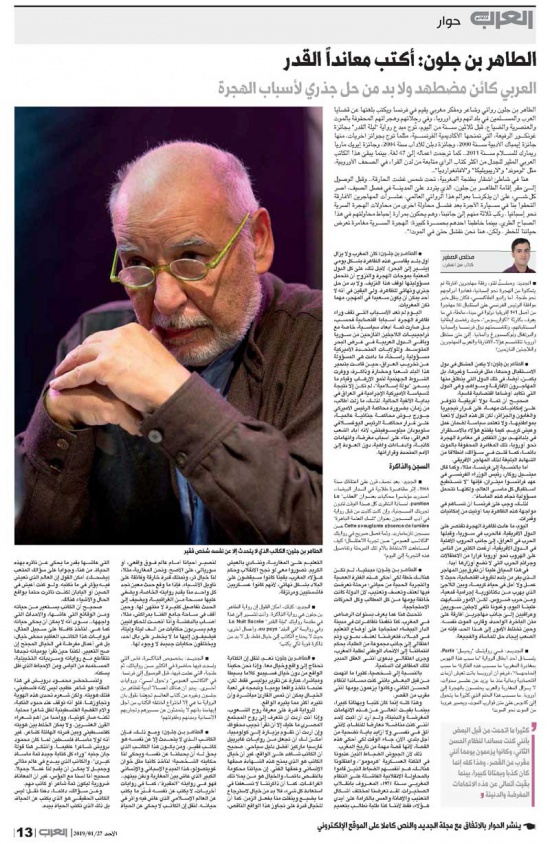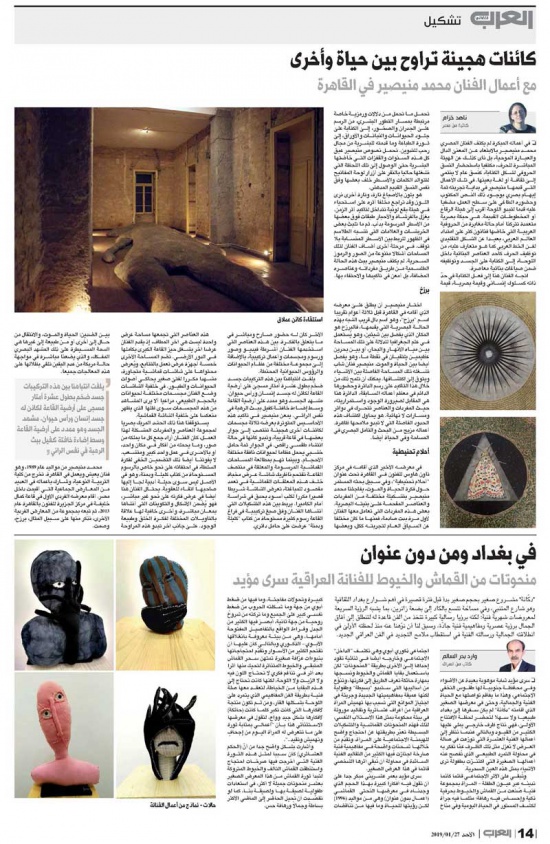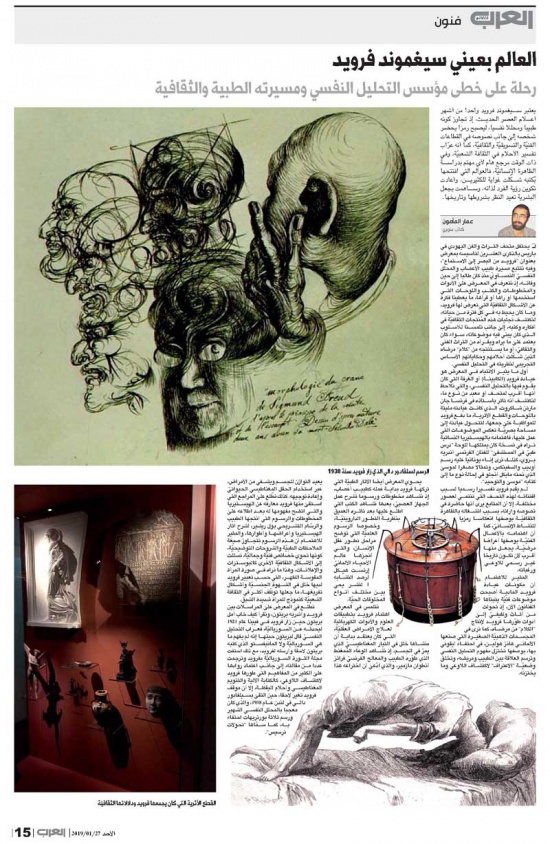تحولات البنية الروائية في "وطن الجيب الخلفي" لمنى الشيمي

تتساءل الناقدة فدوى مالطي دوجلاس، في كتابها الجديد “من التراث إلى ما بعد الحداثة” عن إمكانية إدراج الرواية تحت صيغة البحث العلمي. نظرا إلى ما لاحظته في الرواية من اطراد الهوامش بعد الفصول. إشارة فدوى مالطي تُوحي بأنّ الرواية وهي تطرق موضوعاتها، التي هي مطروحة في الطرقات، ويعرفها العجمي والعربي والبدوي والقروي كما أنبأنا الجاحظ من قبل في سياق آخر، انشغلت على الجانب الموازي بطرائق تشكيلها، وهو ما جعل الرواية منفتحة ليست فقط على أنواع قريبة، وإنما أيضا على علوم ومعارف جديدة.
يمكننا اليوم أن نعيد طرح السؤال من جديد، عن إمكانية إدراج الرواية تحت صيغة البحث العلمي، بعد قراءة رواية منى الشيمي "وطن الجيب الخلفي" الصادرة مؤخرًا. فالترددات التي لاحظتها دوجلاس من قبل حاضرة هنا، وبكثافة، وإن زادت عليها بعض الخصائص الجديدة التي تشدُّ النص بقوة إلى البحث المعرفي. وإن كنّا نزيد: ما الغرض من وراء هذا؟
رواية ما بعد الحداثة
الجواب بكل بساطة، يكمن في هذه الحقيقة، بأن واحدة من تجليّات الرواية الجديدة، أو رواية ما بعد الحداثة، أنها تخلّت عن مفهوم الحكاية الكلاسيكيّة، وتبنّت صيغة الرّواية المعرفيّة، فصارت الرواية أشبه بالبحث العلمي، بما يضيفه الروائي / الباحث (حيث تجلّت صفة الباحث في الروائي في بحثه وجمعه مادة روايته وتقصّيه أيضا) لنصه من قائمة بمصادره، وهوامش يشرح فيها الغريب الوارد في متنه، فحفت الروايات بالمعلومات العلمية كما شاهدنا في “اسم الوردة” لأمبرتو إيكو، و”شيفرة دافينشي” لدان براون، خاصّة بعدما اضطلع بمهمّة الرواية، محترفون وأحيانا علماء. فصارت الرّواية كما تقول لطيفة الدليمي أشبه بـ”مَعلم حضاري وثقافي تنهض به العقول الراقية في مختلف الاشتغالات المعرفية”.
أهمّ سمة من سمات الرواية ما بعد الحداثية، إضافة إلى محافظتها على التشظي الزماني (أي رفض الترتيب الزمني للحوادث وكسر خطية الزمن الكرونولوجي) والمكاني، هو تركيزها على الثيمات الصغرى. فانشغلت الرواية بقضايا صغرى، كما هو متحقّق هنا، حيث تُولي الروائيّة عناية فائقة بقضية تهريب الآثار، التي تعدُّ واحدة من القضايا العصرية، ونتائجها المرعبة في طمس الهُويّات.
وأيضا تنفتح على رواية التعددية الثقافية، بالانشغال بفكرة التسامح والتعددية الثقافية والحفاظ على موروثات الشعوب بما فيها البدائية وطقوسها الفلكلورية لما تحمله من خبرات وثقافة ثرية ومكتنزة، وهو ما نراه واضحا في هذه المروية بما أبرزته الرواية المتفرعة عن الرواية الأصلية من تسامح كان سائدا على الجزيرة في فترة ما قبل احتلال الفرس لها.
رواية منى الشيمي الجديدة “وطن الجيب الخلفي” إذا طبّقنا عليها توصيف فدوى مالطي دوجلاس، هي أشبه بالبحث العلمي، فالنصّ مُدرج أسفله هوامش متنوّعة ما بين الإشارة إلى تفسير معاني كلمات، وتوضيح حوادث مُعيّنة خاصّة وما متعلِّقٌ بسرقة الآثار ونهب المتاحف بعد أحداث الثورة.
الرواية تستدعي قارئا مُعيَّنا، ليس بالقارئ الهاوي (العادي)، وإنما القارئ المُشارك (وليس الطاغية)
بل لم تكتفِ بهذا، وإنما قدّمت في نهاية روايتها قائمة بأسماء المراجع التي اعتمدت عليها في الجزء الخاص بالسيناريو الذي يقوم بكتابته توم وليبور. وقد تنوّعت هذه القائمة بين كتب آثار وكتب تاريخ، عربية وأيضا أجنبية.
علاوة على مصادر صحافيّة خاصّة بتوثيق حوادث سرقات الآثار في مصر بعد الثورة، وآثار العراق أثناء الغزو الأميركي عام 2003، وصولا إلى الجرائم البشعة التي تحدُث الآن في سوريا بعد دخول داعش والتناحر الأيديولوجي على أراضيها.
كما تذيّل نهاية الرواية بملحق تعريفي تحت عنوان “أسماء شخصيات الدراما الوثائقية”. تضطلع فيه بشرح وتفسير الأسماء، وأيضا توضح التسلسل الزمني لخروج الشخصيات إلى النص. وهذه أشياء لم نعهدها في الرواية إلا في حالات نادرة على نحو ما فعل محمد مستجاب في “من التاريخ السري لنعمان عبدالحافظ “، وبالمثل أحمد إبراهيم الشريف في روايته “موسم الكبك”.
يُضاف إلى هذا التوثيق المرجعي الذي يشدّ النص إلى سرد معرفيّ ثريّ، يُضفي بُعدا عميقا على النص. فتطرد معلومات عن سيدات الأنقاض في ألمانيا، والدور المهمّ الذي قُمنَ به، بعد دخول قوات الحلفاء واغتصاب أكثر من مليون سيدة وطفلة وتدمير المصانع والمباني، وما إن تمَّ منع الرجال تحت سن الخمسين من العمل خوفا من أن يكون خروجهم بداية المقاومة، حتى أخذت النساء على عاتقها مهمّة رفع الأنقاض، بل واعتبرن أدوات رفْع الركام أسلحة “وفي مدة لم تتجاوز التسعة أشهر، سقطَ خلالها الآلاف منهن ودُفِن بعضهن أحياء، تم رفْع كل شيء، ليبدأن بناء البلاد مِن جديد!”.
اللافت أن مثل هذه النصوص تستدعي قارئا مُعيَّنا، ليس بالقارئ الهاوي (العادي)، وإنما القارئ المُشارك (وليس الطاغية). وهو ما يشير إلى دلالة مهمة تفيد بأن غياب هذه الهوامش سيفقد النص تواصله مع القارئ، وهذه إحدى الحيل لربط القارئ بالنص أي متفاعلا، وليس استحضاره كمرويّ عليه كما كان سابقا.
رواية داخل الرواية
يمكن اعتبار الرواية “رواية داخل رواية” فثمة حكايتان متداخلتان عبر خيوط سردية وإن تبدو خفيّة، إلا أنها تنسلُّ وتمتدُّ في مرونة بين الحكايتيْن، التي يفصلهما زمن قديم طويل نسبيّا، يصل إلى القرن الخامس قبل الميلاد، حيث احتلال الفرس لمصر، وتجلّي رُوح المقامة لصدّ وطرد المُحتل الفارسيّ.
قد يبدو الرّابط بين الحكايتيْن، ماثلا في الثورة على الظلم، ومقاومة الظالم بكافة أشكاله؛ كمحتلّ أو حاكم فاسد، وأيضا في تناقض الحياة بين العالميْن، فالحياة على الجزيرة بسيطة، قائمة على التسامح والتعاون والعشق، في مقابل العالم الماديّ الذي يسود في أجواء الحكاية الثانية، فالإخوّة يحكمها إطار ماديّ، وبالمثل علاقات الحب والزواج تحكهما المادة تارةً والأنا تارة ثانية. ومن ثمّ الفشل في العلاقتيْن.
الرواية ترصد هذه التفاصيل الحياتيّة، وكأنّها وثيقة حيّة عن الماضي، أو لوحة كرنفاليّة عن مظاهر الحياة والتعايش
الحكاية الأولى تبدأ بحكاية ناصر خبير الترميم، البطل الإشكالي بمفهوم لوسيان غولد مان، وهو يحكي حكايته بين زمانين مختلفين أيضا، وإن كان أحدهما ماضيا قريبا والثاني بعيدا نسبيًّا حيث يعود إلى طفولته وأسرته ووالده الذي هجرهم، وهو ما راكم لديه عُقدة الأب. مرورا بدراسته وحكاية حبّه المجهض من هالة وأهلُها الذين رفضوه لأنه فقير بعدما عجز عن إحضار الشبكة التي طلبوها منه، إلى تخرُّجه وجلوسه في طابور العاطلين حتى أُتيحت له فرصة عمل عن طريق صديقه، بعد أحداث زلزال عام 1992، حيث يطلب منه كتابة تقرير عن الآثار التي تضررت بالزلزال.
وهنا يبدأ طور جديد في حياة ناصر، بعد معرفته بالبعثة الألمانية وكلاوديا ورالف. كما كان يتطوّر عجزه، أمام كلاوديا ورفضها التواصل مع أهله، وأيضًا أمام المنظمة في ما تطلبه منه.
الحكاية الثانية التي يُمرِّرها توم لناصر أثناء جلساتهما، لكتابة سيناريو الفيلم (الدوكودراما) المزمع إخراجه عن الجالية اليهودية، التي استوطنت جزيرة “إلفنتين” في أسوان في القرن الخامس ق.م. من خلال الاعتماد على مجموعة البرديات الآرامية.
يقف توم السيناريو على حالة الجالية اليهودية قبل تشتتها من الجزيرة، فيتوقف عند الحياة على هذه الجزيرة وعاداتِ الزواج والبيع والشراء، والطقوس الدينيّة في الصلاة وغيرها، وكذلك الأعياد وتنوّعها وطقوسها المُصاحبة لها، كعيد السكوت والطقوس التي تحدث، كالذبح والسعف المجدول والآس والصفصاف والطواف حول المذبح، وسكب الماء والتطهر، في اليوم الثامن، وأيضًا ارتداء الكتان الأبيض.
فترصد الرواية هذه التفاصيل الحياتيّة، وكأنّها وثيقة حيّة عن الماضي، أو لوحة كرنفاليّة عن مظاهر الحياة والتعايش، وهو ما نعيش نقيضه الآن حيث الإقصاء والاستبعاد. كما تشير إلى المكائد والدسائس، وولاء اليهود للفرس، ثمّ خيانة الفرس لهم، وصولاً إلى التوريث ومساوئ الحكم والثورة على الظلم، وغيرها من أنماط حياتيّة متنوّعة. فتتقاطع الحكاية القديمة مع الحكاية الحديثة، في وقائع الحياة اليوميّة والعشق، والإحساس بالظلم.
الشخصيات المرشدات
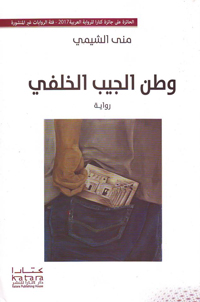
قديمًا ذكر جيمس جويس أنه يستخدم شخصيات في أعماله، وظيفتها تكون مرشدات للبطل. وفي الحقيقة في رواية الشيمي ثمّة حضور للشخصيات المرشدات، مثل كلاوديا وفتحي ومحمد الأسواني والنوبي ووائل. فهذه الشخصيات لا نعتبرها ثانوية بالتعبير القديم، وإنما هي مُرشدات تُدعّم القصّ، وتعمل على إظهار جوانب خفيّة في الشخصية الرئيسيّة.
أولاً نتفق على أنَّ شخصيتي الرّواية؛ ناصر وحياة، اتسمتا بسمات شخصيات الرواية الحديثة، فهما طيلة مسيرتهما لا يُبديان أيّ سمات بطولية. فثمّة بطولة حقيقيّة في اللابطولة التي يضجّ بها عالم لا بطولي إلى أبعد حدّ كما يقول جيسي ماتز.
فالشخصيتان مهزومتان داخليًّا؛ ناصر برواسب الماضي الذي آلَ به إلى هذه الحالة التي وصل إليها، فصار إشكاليًّا، مُستسلمًا لكافة الظروف، وَمُنْسَاقًا لكلّ التحولات حتى لو كانت ضدّ مبادئه الأساسيّة. وحياة بثورتها على عائلتها؛ كي تحقّقَ ذاتها وحريتها. فاعتصامها في “البلكونة” كان هدفه الانتصار لإرادتها فقط، بغض النظر عن تأثّر الطرف الثاني!
السؤال: ماذا حقّقا؟ في الحقيقة، لم يُحقّقا أيّ شيء، سوى خيبات متعدّدة. هو خيبات في حياته؛ في حبّه وزيجته، وفي علاقاته بأصدقائه، وعلى مستوى الأسرة التي انفرط عقدها، ولم يعد يربطه بها سوى أمه، حتى أخته مديحة، عندما تدخّل في المرتيْن كان تدخُّلاً خَاطِئًا انعكس عليها بالضرر. أما هي فلم يَنَلْها من تمردها إلا شعورها بالوحدة، والهروب من واقعها، واجترار حكايتها كونسٍ وتأكيد على بطولة تشعرها بإنجاز ما فعلت، لكن واقعها وهروبها يقول غير ذلك.
ثمة تغيّر في نمط الشخصية، فقد أُسقط البطل الإشكالي لحساب البطل الضدّ، وبهذه الشخصية الجديدة أخذ يُحاكم الشخصية القديمة، ويواجهها بسلبياتها. وأوَّل مظاهر الشخصية الجديدة، أنه بدأ يُعارض ما يسعى إليه توم في السيناريو من تزوير فاعترضه أكثر من مرّة. ومع الاعتراضات التي لم يأخذ بها توم، يُقرِّر في الأخير أن يقوم بعمل سيناريو مُضادّ يكون بمثابة السيناريو الأصلي والحقيقي، يُفسد به مخطط توم وهاينز وألكسندر، وهذه سمة إيجابيّة. حتى عودته في النهاية إلى رؤية ابنيه والاحتفال معهما برأس السنة، جاء كتأكيد على هذا التغيير. وأنه يُعارض فكرة موت الأب التي تحقّقتْ له بموت أبيه معنويًّا في طفولته ومراهقته.
التنوّع في الأساليب ظاهر على مستوى الرواة، فالرواية قائمة على تنوّع الرواة فيتناوب السرد ثلاثة رواة
هذا التغيُّر الإيجابي في طبيعة الشخصيّة كان خلفه عاملان مساعدان لو طبقنا نظرية العوامل وتأثيرها على الشخصيات كما هي عند فيليب هامون. العامل الأوّل يتمثّل في تأثير ثورة 25 يناير، التي عاصرها في منفاه الثلجي، إلّا أنّ تأثيرها كان كبيرًا، وهو ما يصلنا بنقطة غاية في الأهمية عن مفهوم الوطن، وغرس معنى الوطن في الجيل الجديد. كما أنها أحيت في داخله المناضل القديم فخرج في تفاعل حيّ مع هذا الإحساس الداخلي الجديد للتظاهر وكتابة اليافطات كما كان ينظّم المظاهرات. وهذه إشارة مهمّة في التأكيد على تأثير الثورات الإيجابي، حتى وإن مُنيت بالهزائم، إلّا أنّ آثارها مهمة سعى الكثيرون إلى طمسها، حاضرة، على الأقل على المستوى الفرد بخلق ذوات جديدة أكثر إيجابية مما كانت عليه.
أما العامل الثاني، فهو يتمثل في الشخصيات المرشدات، حيث كان لها الدور الأكبر في هذه التحولات للشخصية، بدءًا من أصدقاء الطفولة وصولاً إلى كلاوديا وهاينز وإلى رالف. كما من الممكن اعتبار شخصية حياة الفتاة المتمردة التي خسرت عائلتها لكي تكسب حياتها، واحدة من الشخصيات المرشدات.
فمنذ لقاء المصادفة في حديقة الفندق، وهي تمثّل المعادل لكلّ خيباته في الواقع. فنموذج شخصية حياة كانت بمثابة الشخصية التي افتقدها طيلة حياته. ومن ثم ظهرت حياة كمعادل موضوعي إذا استعرنا مصطلح ت.إس إليوت. فما جمعهما لحظة المراجعة لذاتيهما، وأيضا نبرة اليأس التي هيمنت عليها، وسخطها مما حوله، فلا أحد يشعر في “المدينة بالسعادة، وكل ما يبعث على الاكتئاب يدفعنا إلى الانتحار” كما قالت.
أسلوبية الرواية
قديما أقرّ ميخائيل باختين بأنَّ الرواية تختلفُ عن الشعر الغنائي بتعددية الأساليب والأصوات واللغات. وفي الحقيقة أنّ جماليات النص هنا لا تنبع من حكاية ناصر أو حتى تلك التضفيرة بين الحكايتيْن. وإنما في إشكالية الكتابة، وتعدديّة الأساليب داخل النص، وهو ما كان له تأثيره على إيقاع النص حيث التزاوج بين زمنين متباعدين. وهو ما جعل إيقاع السّرد عبر الاسترجاعات الزمنيّة، يميل في بعضه إلى الغنائية خاصّة في ما هو مُتعلِّق بماضي ناصر، وأيضا في حكاية حياة، وفي بعضه الآخر يميل إلى الدرامية، كما هو متجلّ في الصّراع الداخليّ الذي يعتري ناصر، وسعيه إلى محاكمة ذاته القديمة.
الرواية تدين في أحد جوانبها الاحتلال على اختلاف أيديولوجياته، وما سعى إليه من تجريد مصر من هويتها
التنوّع في الأساليب ظاهر على مستوى الرواة، فالرواية قائمة على تنوّع الرواة. فيتناوب السرد ثلاثة رواة؛ الأوّل هو الراوي الأنا يحكي عن ناصر وعن طفولته وماضيه، وعلاقته بهالة وأيضًا بزواجه من كلاوديا إلى طلب طلاقها وأيضا علاقته بالمنظمة. والثاني الراوي بالضمير الغائب (الهو) وهو حاضر في السيناريو الذي يكتبه توم. والثالث الضمير الثالث (الأنت)، وهو حاضر في مشاهد المحاكمة. فالأنا الإشكاليّة تسعى إلى مواجهة ذاتها. وبالمثل التعددية ظاهرة على مستوى الأماكن، حيث تهيمن القاهرة بأماكنها التاريخيّة والشعبيّة، وأيضا أسوان وجزرها وأيضًا كولن بألمانيا، وتركيا. وهذه المراوحة بين الأماكن سمة الرواية الحديثة التي تكسر الأماكن المغلقة والمحددة.
تدين الرواية في أحد جوانبها الاحتلال على اختلاف أيديولوجياته، وما سعى إليه من تجريد مصر من هويتها، ولم يكتف بهذا بل سعى إلى تجريدها من صنّاعها المهرة.