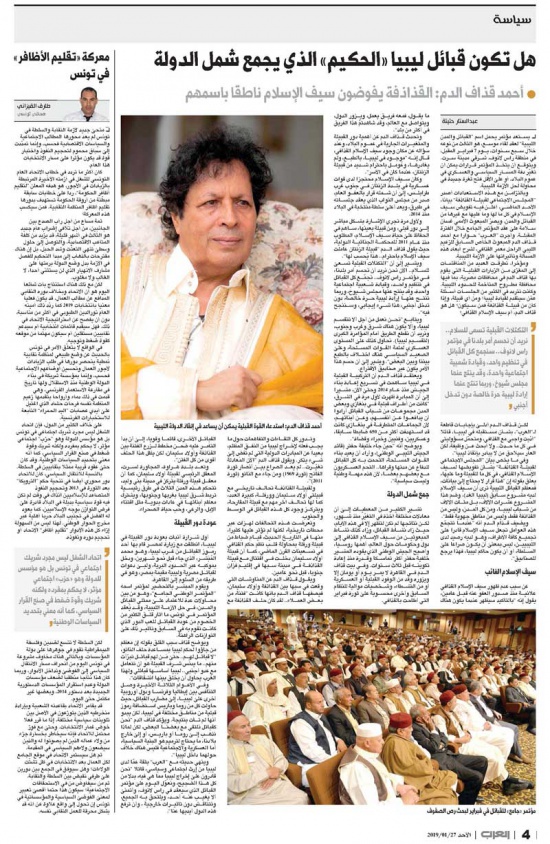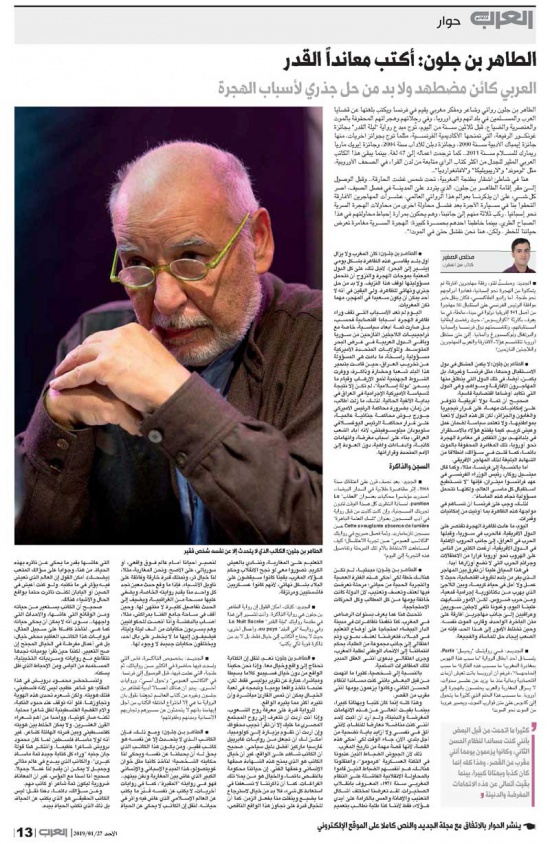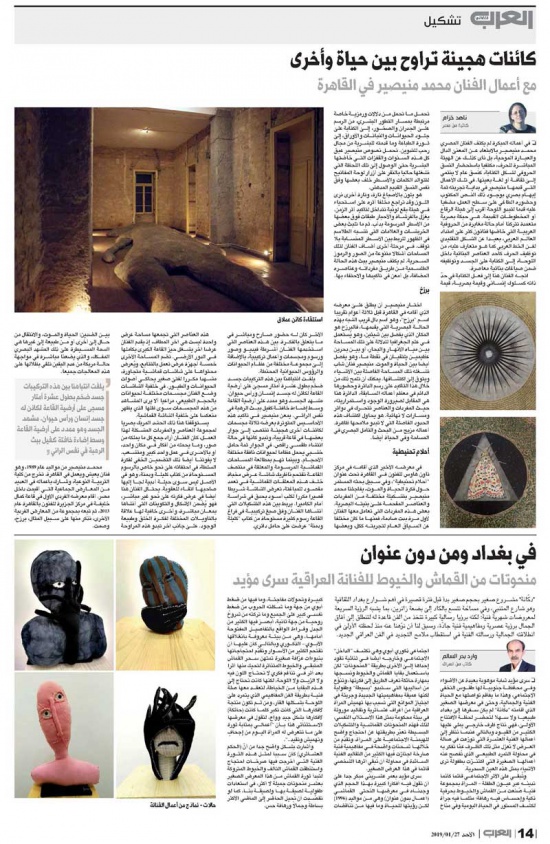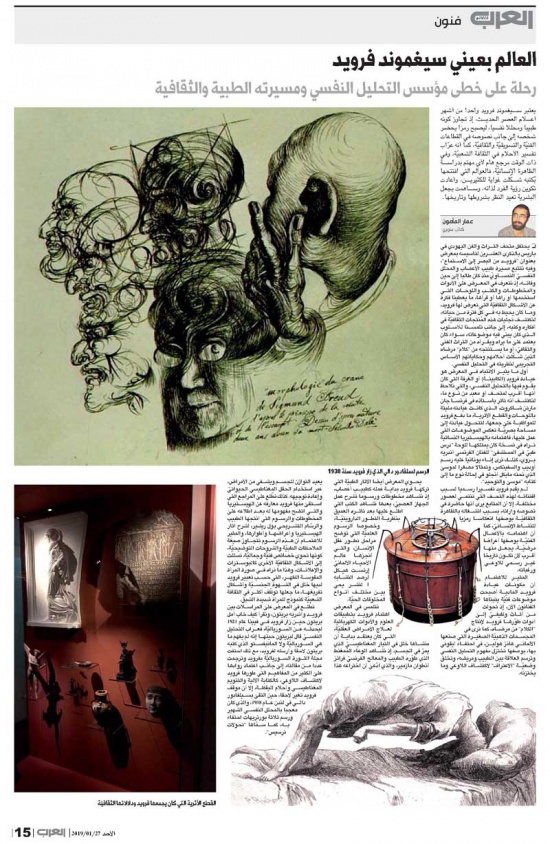بين جد وحفيدته.. سؤال مربك

“أين تضع لحيتك يا جدّي حين تخلد إلى النوم، تحت الغطاء أم خارجه؟”، هكذا سألت الطفلة الصغيرة جدّها الممدّد على فراشه ثمّ غادرت إلى غرفتها دون أن تنتظر الإجابة.
بدا السؤال غريبا على العجوز الذي اعتاد الإجابة بأريحية كاملة عن كلّ التساؤلات البريئة أو الماكرة التي تطرحها حفيدته المشاكسة.
لا، لم يكن السؤال غريبا فقط، بل كان صعبا، مربكا، محيّرا ومحرجا، ممّا جعله يتقلّب مرارا في فراشه وهو يجرّب كلّ وضعيات النوم ويسأل نفسه “صحيح، أين كنت أترك لحيتي طوال هذه السنين، تحت الغطاء أم خارجه..!؟”.
ظّل الجدّ يصارع الغطاء وشياطين الأرق حتى كاد يلعن الساعة التي أطلق فيها لحيته.
لقد ورّطته لحيته في سؤال غير متوقّع، لم يجد له جوابا شافيا ووافيا ثم إنه جاء من طفلة لن تنبت في وجهها الناعم الصغير يوما لحية حتى ترتبك بهذا السؤال.
قادت هذه الحادثة الجد الطيب إلى قضاء الليلة وهو يفكّر في كلّ ما ينبت من شعر على رأس الإنسان ووجهه.
حسنا -قال العجوزـ لأفكر قليلا في هذه المعضلة كي يكون هذا الرأس جديرا بحمل هذه اللحية المربكة.. أليست هي ما يميز صور الفلاسفة عبر التاريخ؟
ظل العجوز يحدث نفسه ويجادلها “مهلا.. إن اللحى والذقون والشعور الطويلة لا تميز الإنسان وحده أمام كائنات حية أخرى، كثيفة الشعر وعديمة العقل. كفانا شططا، لنعد إلى اللحية “الآدميّة”.. لماذا يطلق الفلاسفة لحاهم؟ هل لأنّهم لا يجدون الوقت الكافي لحلاقتها أم للتميّز والدلالة على أنّ غزارة الأفكار من غزارة الشعر. إذا كان الأمر كذلك فماذا يفعل الأمرد والأصلع والأقرع ليكون من المفكّرين؟ وكيف نميّزهم عن إنسان ما قبل أمواس الحلاقة، عن المجانين والمشرّدين، عن الإرهابيين والمجرمين و”البلطجية” الذين يخفون تحت لحاهم آثار السكاكين؟”.
واصل الجد حديثه مع نفسه: شتّان، طبعا، بين من تعلن لحيته وقارا روحيّا أو إرثا فكريّا أو ثقلا اجتماعيّا وبين من قال فيهم الشاعر ابن الرومي في تصوير كاريكاتيري ماسخ، وهو يهجو صاحب لحية طويلة:
“إن تطل عليك لحية أو تعرض/ فالمخالي معروفة للحمير// علّق الله في عذاريك مخلاة/ لكنها من دون شعير”.
استدرك الجدّ قائلا: لكن هذا الشاعر كان معروفا بأنه أمرد، ويبطن نزعة استعلائيّة شعوبية (أبوه من أصول رومية وأمه من أصول فارسية) كما جاء في رثائه للبصرة التي أحرقها الزنج في ثورتهم.
لا شك أن إنسان العصور الحديثة قد وقف متأملا ومفكرا في كيفيّة التعامل مع هذا الشعر الزاحف من جسمه، الأمر الذي يهدّد بإعادته إلى الهيئة البدائية، فاخترع، عندئذ، المشط والمقصّ والشفرة ومجفف الشعر (السيشوار) وشتى أنواع الكريمات والأصباغ، وغيرها من أساليب “تكريم” الشعر الذي تختفي تحته الأفكار والآراء.. وبرز فضاء لمهنة في الأسواق اسمه “صالون حلاقة”.
تعدّدت التسريحات والأشكال والتصفيفات بتعدّد الأمزجة والأهواء فصار يسهل تصنيف الرجال من خلال الذقن والشارب والسالف وقصّة شعر الرأس، وحتى هيئة الصالون الذي يتردّد إليه، ذلك أن الكثير منّا لا يحني هامته ولا “يسلّم ذقنه” لأيّ كان.
أمّا المرأة فلقد أعفتها الطبيعة من اللحية والشوارب، وعوضتها بشعر رأسها الذي يستهلك جزءا محترما من المال والوقت والاهتمام، وقد استأنست الكثيرات إلى المقولة الذكورية الشهيرة “كوني جميلة واسكتي”.
هل يحتاج الرجل الشرقي إلى شارب كي يساعده في القسم و”الحلفان” أو إلى لحية كثيفة كي يفكّر أثناء فركها؟
هل امتُحنت المرأة بشعر الرأس كي تحتار فيه بين التلوين والتقصير والإخفاء أو السفور؟ لماذا ظلّت نساء كثيرات يمتثلن لذائقة الرجل التقليدية في تفضيل الشعر الطويل على القصير؟ هل في الأمر عودة إلى ما يشبه تمثل النص القديم في “نشيد الإنشاد” والذي يقول فيه أحدهم مغازلا حبيبته في الشرق القديم “شعرك قطيع ماعز يتسلّق جبل جلعاد”.
وحدها المقاصل وحبال المشانق عبر التاريخ، لا تفرّق بين التسريحات.. إنها تقرأ وتحاكم ما تحت الشعر من نوازع الخير والشر، حسب مقاصدها ونواميسها.
لم يكن رأس غاندي الأصلع الصغير يحتاج إلى شوارب وشعر كثيف كي يقسم على انتصار الشمس، ويقود شعبه نحو الاستقلال، ولم تكن قبعة وخصلة شعر غيفارا هما اللتان جعلتا منه أيقونة ثورية.
خواطر كثيرة جالت في رأس الجد الذي أخلدت حفيدته الصغيرة إلى النوم وتركته يتخبط في سؤالها المربك “أين تضع لحيتك أثناء النوم؟”.
هل يقدم الجد على حلق لحيته كي يتخلّص من سؤال حفيدته؟ هذا ما تقدم أسر عربية كثيرة حين تواجه سؤالا مربكا؛ تتخلص مما تظنه سبب المشكلة قبل إيجاد الحلول والأجوبة المناسبة، كمن يحرم أطفاله من الكمبيوتر بسبب خوفه من مخاطر الإدمان على الإنترنت.