بورديو الغائب الحاضر
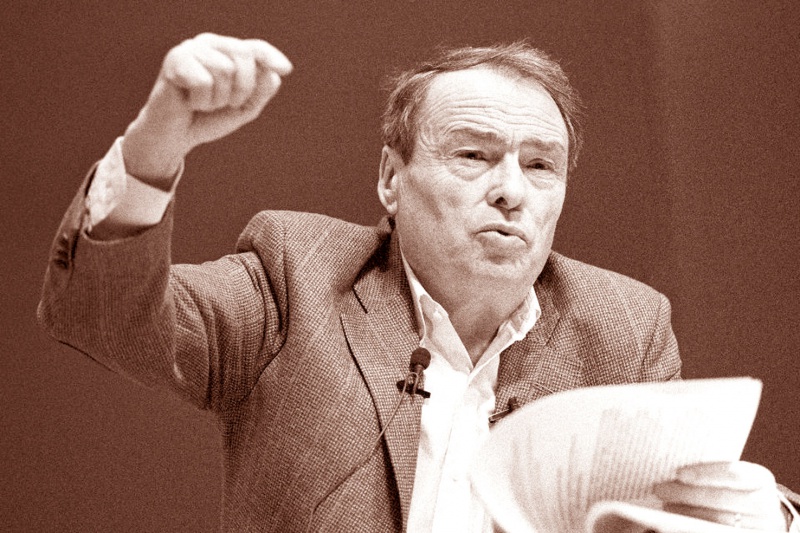
"محادثات مع بورديو" كتاب جديد لعالم الاجتماع الإنجليزي ذي التوجه الماركسي مايكل بورَوايْ يناقش فيه أفكار عالم الاجتماع الفرنسي الراحل، ويفتح أبواب حوار مثمر بين تقليدين من تقاليد البحث الأكاديمي.
ككل مفكر مثير للجدل، لا يزال إرث عالم الاجتماع الفرنسي الشهير بيير بورديو، بعد رحيل صاحبه بنحو ثمانية عشر عاما، محل خلاف حول وجاهته العلمية. فبعض الدارسين يمجّده حدّ التقديس، وبعضهم الآخر ينتقد أساليبَ بحثه والنتائج التي أفضى إليها، ولاسيما نظريته الشاملة عن المجتمع المحكوم بإعادة إنتاج النظام الاجتماعي. وبعد كتاب “بورديو – بنيوية بطولية” لتلميذه جان لويس فابياني، صدرت الطبعة الفرنسية لكتاب “محادثات مع بورديو” لعالم الاجتماع الإنجليزي مايكل بورَوايْ، الذي درّس في بيركلي وشغل منصب رئيس الجمعية الأميركية لعلم الاجتماع ثم الجمعية العالمية لعلم الاجتماع.
نذكر أن فابياني عاب على بورديو عدم تسلحه بما يكفي لتحقيق مطامحه، إذ كان يريد أن يقارب المجتمع في كلّيته، ولكنه اختار إجراء تحاليل ذات طابع ضيّق لا تسمح بالتعميم، كحقل الأدب أو الفن، وكان يطمح لتفسير الأواصر التي تربط متغيرات كثيرة، ويدافع عن مقاربة علائقية للمظاهر الاجتماعية، إلا أنه لم يتوصل إلى تأصيل تحاليله في بُعدها التاريخي، ولم يشأ أن يطور هذا المنحى، نتيجة انشغاله بمطمحه الأساس، أي الإحاطة بالمجتمع في شموليته.
أما بورَوايْ فقد اختار أن يتقمص إهاب مجموعة من المفكرين الماركسيين أمثال أنطونيو غرامشي، وفرانز فانون، وباولو فريري، وسيمون دي بوفوار، وماركس بطبيعة الحال، لمحاورة عالم الاجتماع الفرنسي بلا مجاملة. وينطلق النقاش منذ التوطئة، التي عنوانها “بورديو يلتقي بورديو”، وتشمل تعليقا حول شريط وثائقي عن علم الاجتماع بوصفه “رياضة للقتال” كمبدأ نظري وسياسي في الوقت ذاته، ما يدفع بورَواي إلى التساؤل: “إن كان الأمر كذلك فأين المقاتلون؟” ثم البحث عن هذا النوع من القتال في أعمال بورديو، قبل أن يفسح المجال للمقاتلين الذين اختارهم بنفسه للكشف عن التناقضات التي تشوب واقعا سوسيولوجيا يدّعي القتال.
بيير بورديو بعد رحيله بنحو ثمانية عشر عاما، ما زال فكره محل خلاف كبير حول وجاهته العلمية
وبما أن بورديو في نظره لا يستطيع أن يتبين غير القبول العام للنظام الاجتماعي، فكيف يمكن أن يقف إلى جانب المهيمَن عليهم؟ وكيف يمكنه أن يجعل من الدفاع عن استقلالية حقلَي المدرسة والثقافة في صميم جهازه السياسي، والحال أنه جعل منهما مولّدَي إعادة إنتاج التفاوت؟ وأي صدقية نعطي مفكرَ التأمل التصوري وهو نفسه لم يستعمله إلا قليلا في علمه؟ هذه المفارقات الثلاث تضع إطار المحادثات التي لا ترمي إلى “الانتصار” كما قال المؤلف، بقدر ما تهدف إلى فهم أفضل لحدود التأكيدات والممكنات والأطر التي تدافع عنها.
لئن كان لبورديو نفس نفور ماركس من المثالية، ونفس اهتمام غرامشي، وفريري، ودي بوفوار بأشكال الهيمنة، ونفس تحليل فانون للعنف الكولونيالي، فإن فكره لا يرقى إلى فكر أولئك المفكرين إذا تركنا جانبا مسألة إعادة الإنتاج الاجتماعي. فبورديو، بانغلاقه في نظرية “الهابيتوس” والحقول، يعجز عن تقدير مركزية الاقتصاد في بنية العلاقات الاجتماعية كما فعل ماركس. وإذا كانت الرأسمالية تنتج الهيمنة، فإن المهيمَن عليهم يقبلون بذلك عن وعي وتدبّر، كما قال غرامشي. والفرق هنا، كما يقول بورَوايْ، أن غرامشي يلمس نوعا من الحكمة في أوساط الطبقات الشعبية، كقوام للوعي الطبقي، في حين أن بورديو ينكرها.
نجد هذا الإنكار للقدرات السياسية للخاضعين أو المرؤوسين في تحليله لطبقة المزارعين الجزائريين في خلاف مع رؤية فرانز فانون. كما تقف بيداغوجيا المضطهدين لدى فريري في طرفي نقيض من المقاربة العقلانية للتربية التي وضعها بورديو وجان كلود باسرون في كتابهما “إعادة الإنتاج. في سبيل نظرية عامة لنسق التعليم”.
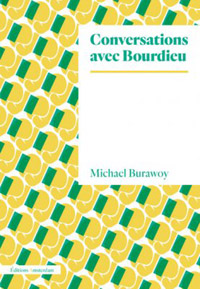
ولا يقنع بورَواي بتفنيد موقف بورديو الذي يعتقد أن الخاضعين سيضطرون إلى الامتثال لطبيعة الأمور، بل يؤكد أن الهابيتوس ليس مصطلحا علميا، بل هو مفهوم متداول يغلفه اسم لامع، ولم يُقم الدليل إطلاقا على خصائصه العلمية. والدليل في اعتقاده ديمومة المواقف العمالية تجاه الإنتاج، كتجربة الورشة التي لا يعنيها الهابيتوس في شيء، وبصورة أشمل انتصار الرأسمالية على المنظومة السوفييتية، فمثال الأول قادر على خلق “خداع” عن أشكال مشروعية الاستغلال الذاتي، بينما المثال الثاني، كضحية إفراط في الشفافية، لا يفلح، وينساق إلى الفشل.
وفي اعتقاد بورَوايْ أن هذا العجز عن الإمساك بأسس الهيمنة ينزع عن بورديو ادعاءه اقتحام المجال العام، فعندما ينكر على المرؤوسين إمكاناتهم السياسية الأصلية، فإنه يمنع نفسه من الإلمام بإمكانات التغيير الاجتماعي نفسه، وفي هذا يلتقي بسيمون دي بوفوار التي لا تؤمن هي أيضا بقدرة الخاضعات على مقاومة أشكال الهيمنة الذكورية، وإن وضعت منطلقا استندت إليه الحركات النسائية السياسية، فيما ظل بورديو غير قادر على خلق مثل “هذا الرابط العضوي بين علم الاجتماع وجماهيره”.
هذا النقاش قاد بورَواي إلى الإفصاح عن نقطة من أهم النقاط التي تضمنها الكتاب، ونعني بها مسألة “السوسيولوجيا العامة”، فبعد أن كان علم الاجتماع النقدي محصورا في الوسط الأكاديمي، حاول بورواي أن يقتحم الحلبة العامة، من خلال ترجمة السوسيولوجيا المهنية إلى لغة في متناول الجميع، وكذلك عبر إطْلاع الجماهير بحصيلة أبحاثه، أي بالتحاور معها. وهي دعوة غرامشية تلتقي بدعوة الأميركي تشارلز رايت ميلس إلى “الخيال السوسيولوجي”، أي الاعتراف بقوى عاملة أوسع وحصر أبعادها. والباحث الإنجليزي لا يكتفي بإبراز تناقضات بورديو بين النظرية والتطبيق، وإنما يريد التأكيد على نوع من عدم معرفة دور هذا المثقف الفرنسي وعمله، ومفاده أن بورديو برغم نقده المتواصل للمثقفين العضويين، فإن التزامه يفضح موقفه ذاك، مثلما يكشف عن ضرورة التقاء علماء الاجتماع وجمهورهم في كفاحهم ضد المهيمِنين.
والخلاصة أن في الكتاب تحاملا شديدا على بورديو، ومغالطات كثيرة، نذكر منها زعمه أن نشاط بورديو كانت الغاية منه الدفاع عن الاستقلالية النسبية لأفضية الإنتاج الفكري، والحال أن التزام عالم الاجتماع الفرنسي قديم، وإن بلغ أوجه خلال التسعينات، فقد كان من الساعين الجادين إلى تأسيس حركة اجتماعية أوروبية، ما جعله قبلة سهام العاملين في الحقل السياسي والإعلامي حتى اليوم. أما عن نبذه المثقفين العضويين، فمردّه إلى رفضه كل أشكال “النطق الرسمي”، وإيثاره الإسهام في الجدل العام، رغبة منه في وضع رأسماله الرمزي في خدمة النضالات الاجتماعية والنقابية.




























