بلا حبكة لا يوجد أدب.. لكن ماهي الحبكة؟

عادة ما يختلط مفهوم الحبكة في النقد الأدبي بالعقدة، حيث يدلّ أحيانا على الشكل وأحيانا أخرى على المضمون. وإذا كان نقاد المسرح يفسرونها في الغالب بالحركة الدرامية نفسها فإن نقاد الأدب، مثل جيرار جينيت، يعتبرونها حكاية، أي ما تشكله المسرودية داخل نص سردي.
تُعلّمنا الأساطير والملاحم والقصص والحكايات منذ القدم أنّ الحبكة هي ما يجعل حكاية ما مبعث تساؤل وفضول، فهي تشوّق المتلقي وتفاجئه بما لم يذهب إليه ظنه، غير أن المنظّرين المحدثين اختاروا العدول عن الحبكة فصارت مجرد رسم تخطيطي عن الحدث، وتنظيمٍ للواقع يحوّل الخطية الزمنية (شيء يتلو شيئا آخر) إلى منطق (شيء يأتي بسبب شيء آخر).
ففي الحقل الأكاديمي تمّت تنقية الحبكة ممّا تروم توليده من خوف وأمل ودهشة، وكأنّ الغاية ازدراء أبعادها الخطابية والجمالية والتطهيرية، أي كل ما تهدف إليه السردية التخييلية. والحال أن الحبكة هي أساس كل عمل سردي واقعيا كان أم تخييليا، فهي من صميم اهتمام البشر بالحكايات، لكونها تنعقد بتصوير أحداث تنتأ على خط الزمن، وتحوّل المعيش اليومي إلى حكاية تروى، فالذي يروي وصوله إلى المكتب لا يمكن أن يشدّ اهتمام سامعيه إلا إذا أدرج حادثة غير مألوفة صادفته في طريقه، تكسر الوضع المعتاد: حادث مرور مثلا، شخص صعد أعلى عمارة يريد الانتحار، عملية نشل عجيبة يصبح فيها النشّال ضحية… أما الفن فيختلق تلك الوضعيات، ولكن بطريقة مقنعة، لكونه يحتاج دائما إلى نصيب من الخداع، كما يقول نابوكوف، وهذا ما يميزه عن الأعمال الحكائية للأنشطة المعتادة، التي تستعجل دائما بلوغ النهاية.
ضد الحبكة
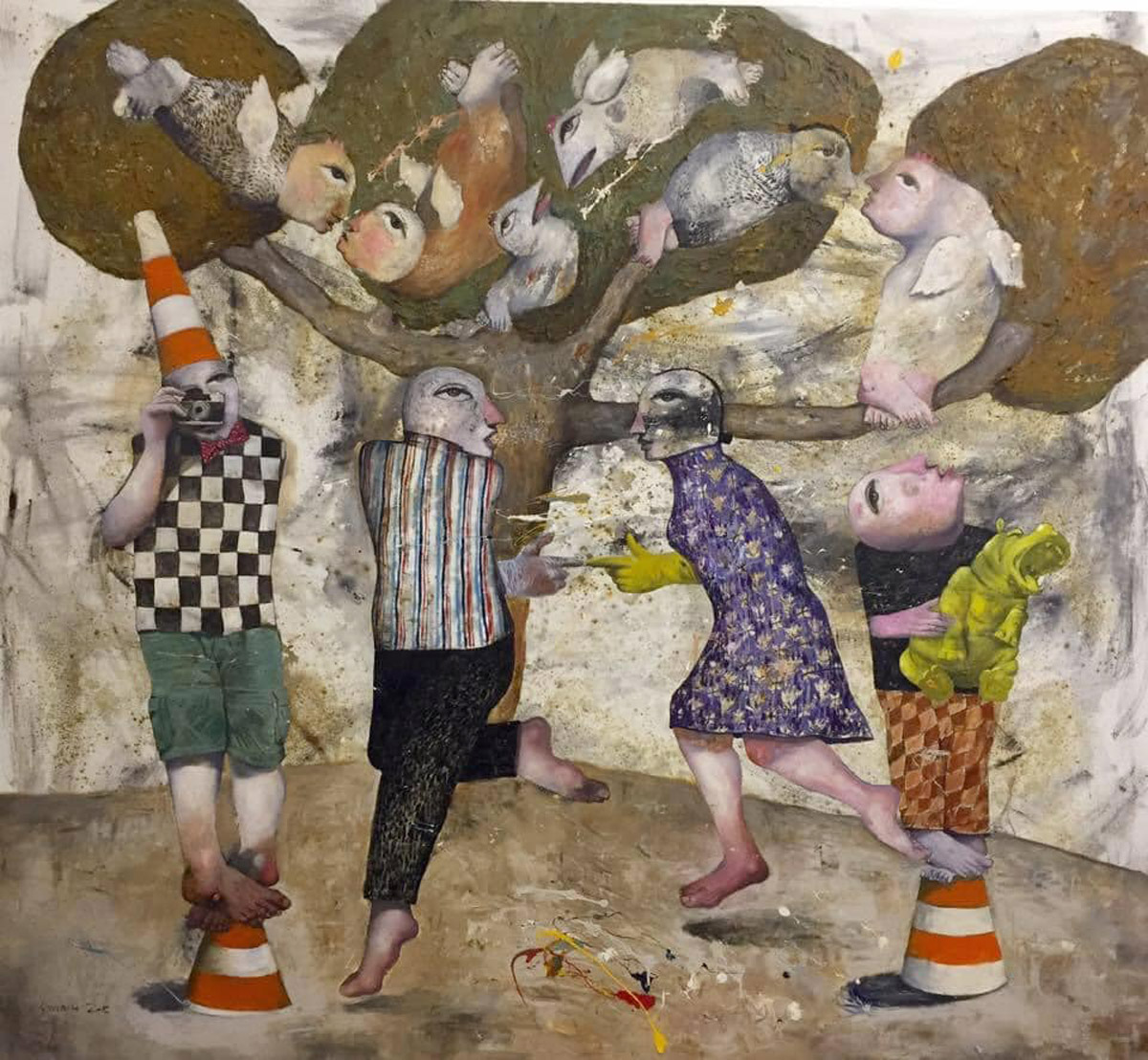
لقد اقتنع جيل من الكتاب والنقاد دون تفكير بأن القصيدة الحق، وكذا الرواية الحق، ليس من غايتها أن تعني شيئا، بل حسبُها أن تكون، فقط. وبعد أن جُرّد المؤلف بدعوى “وهم المقصد”، والقراء بدعوى “وهم المشاعر”، وعالم الأفكار والمعتقدات بدعوى “الهرطقة التعليمية”، والاهتمام السردي بدعوى “هرطقة الحبكة”، جفّت بعض النظريات التي تقول باستقلالية الأثر وموت المؤلف حتى أنها لم تترك سوى منظومات العلاقات اللفظية والرمزية.
فقد استعاض ذلك الجيل عن المفهوم الكلاسيكي للفن الروائي بمقاربة جديدة تستجيب في رأيه لمتطلبات الواقع، فـ”الرواية الجديدة” مثلا أنكرت أهمية الحبكة في العمل الفني، وعدّتها من ملامح الإنتاج الشعبي الهابط حتى أن جان ريكاردو، أحد رموز ذلك التيار الذي لم يتشكل في مدرسة، ثار على ما أسماه توتاليتارية الحكاية حيث كل شيء يدور حول العقدة والانفراج، وأكّد أن “الرواية لم تعد كتابة مغامرة بل مغامرة كتابة”. وهو ما سار عليه كتّاب تلك الجماعة، حيث ألغوا البطل والعقدة.
الحبكة، برغم بساطتها الظاهرة، عسيرة الإمساك، إذ تتعدد طرق تحديد مفاهيم اللقطة والعقدة والانفراج وعلاقاتها بعضها ببعض
تقول نتالي ساروت "الرواية لم تعد ذلك التيار الذي يدفع بالعقدة إلى الأمام، بل صارت مياها راكدة يتشكل في عمقها تحلُّل بطيء دقيق".
وتقول أيضا "تلك المشاعر الموجودة لدى الناس جميعا، والتي يمكن أن تتجلى في أيّ وقت لدى أيّ كان، ينبغي أن تكون لها شخوص نكرات، تكاد لا ترى، مجرد سند”. فالروائي في نظر دعاة ذلك التّيّار مطالب بأن يمّحي من النص ويكتفي بدور سارد خفيّ الاسم يفسح المجال لأشخاص نكرات، بينما يُطالَب القارئ بالمساهمة في خلق النص، وعدم القناعة بتلقي عالم مكتمل، جاهز، منغلق على نفسه.
وكان من الطبيعي أن يظل ذلك التيار محصورا في دائرة ضيقة، إذ لم يجد له أصداء إلا لدى بعض الكتاب العرب ممن يتلقّفون كل ما يطرأ في الغرب، بدعوى مواكبة الحداثة. ومن الطرائف أن كلود سيمون، أحد رؤوس الرواية الجديدة، ليس مقروءا في بلاده حتى بعد حصوله على جائزة نوبل، وأن مكتبة السوربون كانت خلوا من أي أثر من تأليفه عند الإعلان عن فوزه.
التوتر والصراع
الحبكة، بالمعنى الدرامي، تستمد جذورها من مفهوم العقدة، كما توارثها النقد الأدبي منذ العصور القديمة، ولاسيما “الفن الشعري” لهوراسيوس، و”الشعرية” لأرسطو، فالأول يؤكد على وحدة القصيدة وبساطتها، فيما يؤكد الثاني على أن للحكاية بداية ووسطًا ونهاية، ويستعمل صورة العقدة، مثلما يستعمل عبارة plokè التي تعني “نسَج، شبَّك” وكان يقصد بها الحبكة، فالعقدة في تصوره تمتد من البداية إلى المرحلة التي تتحول فيها الأحداث المؤدية إلى السعادة أو الشقاء، وقد أطلق عبارة القرار على ما يأتي بعدها حتى النهاية. وظل هذا التصوّر قائما حتى في الأعمال الدرامية الحديثة.
 الحبكة، بالمعنى الدرامي، تستمد جذورها من مفهوم العقدة، كما توارثها النقد الأدبي منذ العصور القديمة
الحبكة، بالمعنى الدرامي، تستمد جذورها من مفهوم العقدة، كما توارثها النقد الأدبي منذ العصور القديمةهذا مثلا بيتر بروك، رجل المسرح الشهير، يؤكّد أن الوظيفة الأساسية للحبكة إثارة نوع من التوق يدفعنا إلى الأمام، عبر النص. فإذا تناولناها من هذه الزاوية تبدّت جهازًا بلاغيّا وتفاعليّا شديد التعقيد، مثل متاهة نُصبت لتضليل القارئ وحثّه على البحث عن مخرج. صحيح أن بنية الحكاية تؤول أحيانا إلى الانكشاف، ولكنها لا تتجلى إلا في نهاية المسار.
ثمّ إن الحبكة تستلزم التّوتّر، وخلقَ وضعيّةِ صراع من شأنها أن تولّد حركة درامية، لأن بقاء مبدأين متعارضين لا يمكن أن يستمرّ، ولا بدّ أن ينتصر أحدهما على الآخر، أما التوفيق بينهما فمعناه استقرار لا يولّد حركة جديدة ولا يثير انتظار القارئ، ولا بدّ من صراع بين طرفين أو أكثر قبل أن تنحل العقدة وتبزغ لحظة الانفراج.
والحبكة الناجحة رهينة إخبار يتسم بالاقتصاد في الإيضاح والتمنّع المقصود عن تقديم كل العناصر، حيث لا يني السارد يؤجل الكشف عن المعلومة الأساسية ليثير فضول المتلقي الذي يقبل في العادة أن يكون طرفا في لعبة السارد. ولئن كانت مهمة المؤلف الدرامي هي الربط والحل، فإن السارد يعتمد الحبكة لا كوسيلة تأليف بل كأداة تحديد وتوجيه وتحويل للعناصر الأخرى، على رأي الشكلانيين الروس.
إن الحبكة، برغم بساطتها الظاهرة، عسيرة الإمساك، إذ تتعدد طرق تحديد مفاهيم اللقطة والعقدة والانفراج وعلاقاتها بعضها ببعض، وأيّا ما يكن موقفنا منها فلا مناص من الإقرار بضروريتها بوصفها وسيلة تنمي الأحداث وتدفع بها إلى الذروة وتشدّ المتلقّي وتثير فضوله، لأن الوسائل في التجربة الجمالية هي التي تبرر الغاية وليس العكس، ومسار الرحلة هو الذي يحدد المتعة التي يولّدها فينا السفر.
ذلك أن قراءة الحكاية تتغذى بملمحين مختلفين من الحبكة؛ أولهما الصورة السردية الداخلية للأحداث والشخصيات التي تتبدى كحاضنة لإمكانات غير قارة ولّدتها الحبكة في ملمحها الذي لم يتمّ حلّه بعد. في المقابل تغذّي الحبكةُ رغبة القارئ الإدراكية في تملك ملمحها الثاني، أي الصورة النهائية التي تتحقق في ختام الحكاية، عندما تكتمل مجموعة من الأحداث المتناسقة والنهائية.
يقول سارتر “كل حكاية هي دوّامة عجيبة لا تحقق وجودها إلا في حالة حركة”.




























