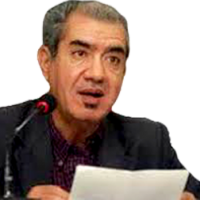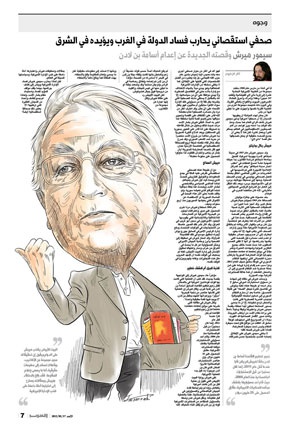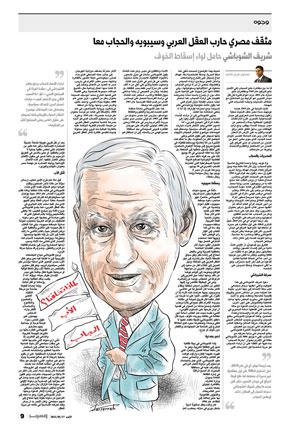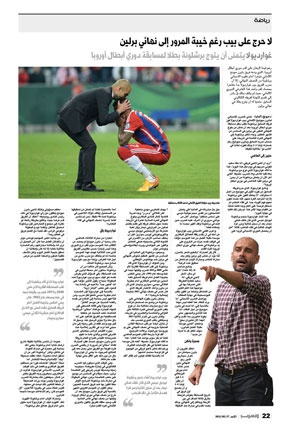اليسار الفرنسي والعرب.. لم يعد هناك فرق بين يمين ويسار

علاقة المثقفين الفرنسيين اليساريين، والمثقفين الفرنسيين عموما، بالقضايا ذات الارتباط بالعالم العربي لا يمكن فصلها عن علاقة فرنسا التاريخية بالمنطقة ماضيا وحاضرا. فقد كان لفرنسا، بوصفها واحدة من أكبر القوى الاستعمارية في القرن التاسع عشر والقرن العشرين، حضور استعماري كبير في العالم العربي، وبالأساس في منطقة شمال أفريقيا، وأيضا في الشام عبر ما كان يعرف بنظام الحماية. وإلى جانب ذلك فإن النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي، نتاج الكولونيالية الغربية عموما، كان ولا يزال يشغل المثقفين الفرنسيين، يمينيين كانوا أو يساريين، خصوصا في ظل حضور لافت ومستمر لمثقفين ذوي أصول دينية يهودية، الكثير منهم جاؤوا من الجزائر، المستعمرة السابقة.
يقوم مفهوم اليمين واليسار عموما على الثنائية الضدية محافظ/ تقدمي، فاليمين، في صيغته الدينية، يرمز إلى المحافظة على التراتبية الاقتصادية والاجتماعية وإلى النظام الأخلاقي الإلهي، وفي صيغته الليبرالية، إلى اقتصاد السوق؛ أما اليسار فيركز أصحابه على قيم العدالة في المجال الاجتماعي والاقتصادي وعلى تكييف قواعد هذا الأخير بما يخدم المجتمع ككل، غير أن التمييز اليوم بين اليسار واليمين على أساس التوجه الاقتصادي لم يعد هينا بعد سقوط الأنظمة الاشتراكية التي قامت في القرن العشرين وبعد انتشار النظام الليبرالي على نطاق عالمي. وعليه فإن الفروق بين اليمين واليسار، بالرغم من تنوعهما، أصبحت باهتة.
ازدواجية خطاب المثقف اليساري
وعندما نتحدث عن المثقفين اليساريين فإننا لا نجد أيضا بينهم وبين المثقفين الذين يعتبرون أنفسهم يمينيين فروقا متمايزة دائما، بل أحيانا نجد بعضهم أقرب في مواقفه وتصوراته إلي المثقفين اليمينيين من اليساريين منهم. يضاف إلى ذلك، عدم إمكان الحديث عن المثقفين اليساريين ككتلة واحدة، فالاشتراك في النسب الأيديولوجي لا يحيل بالضرورة إلى وحدة الرؤية وإلى وحدة الموقف، فالمثقف بوصفه صاحب رصيد معرفي أو فكري أو إبداعي، يتمتع نتيجة لذلك بسلطة رمزية في مجتمعه، يحتكم بالدرجة الأولى، مبدئيا على الأقل، إلى ضميره وإلى ذاته وقناعاته بعيدا عن التعصب والحزبية والانتماءات الجماعية. وهذا ما يؤدي إلى أن الاشتراك في الانتساب إلى اليسار أو إلى اليمين لا ينجرّ عنه بالضرورة انسجام في المواقف.
كما أن قيم العدالة والتحرر التي تنسب عادة إلى المثقفين اليساريين لا تتجسد دائما على أرض الواقع. كمثال على ذلك يمكن أن نتحدث عن الروائي والشاعر فيكتور هيغو الذي قال، عام 1849، في الخطاب الافتتاحي لـ”مؤتمر السلم”: خير لنا إقامة المستعمرات من إطلاق الثورات (في فرنسا). وفي لقاء له مع المارشال بيجو الذي بدا له مترددا بشأن جدوى غزو الجزائر، يطمئنه الشاعر بقوله “أعتقد أن فتحنا الجديد هو شيء موفق وعظيم. إنها الحضارة التي تسحق البربرية. نحن شعب متنور يتقدم على أنقاض شعب غارق في الجهالة”. ويوضح روبر ميرل الذي ورد القولان السابقان في كتابه المعنون “العداء للاستعمار في أوروبا من لاس كازاس إلى ماركس”، بأن “موضوع المهمة الحضارية سيستخدم كمبرر طوال عدة أجيال من طرف اليسار الاستعماري”. نجد أنفسنا هنا أمام ذلك التناقض الذي جعل إدوارد سعيد في كتابه “الامبريالية والثقافة” يتناول “الطريقة التي تجعل دائما المبادئ الإنسانية الكبرى (…) تتوقف عند الحدود الوطنية”، ناقدا بهذا الصدد المثقفين الغربيين الذين تعين عليهم الاختيار بين مبادئهم الإنسانية والكونية وبين المصالح غير المشروعة لأوطانهم، فاختاروا هذه الأخيرة.
عندما نتحدث عن المثقفين اليساريين فإننا لا نجد أيضا بينهم وبين المثقفين الذين يعتبرون أنفسهم يمينيين فروقا متمايزة دائما، بل أحيانا نجد بعضهم أقرب في مواقفه وتصوراته إلي المثقفين اليمينيين
بل يقف المثقف اليساري أحيانا مواقف متناقضة في قضايا ذات طبيعة واحدة، ولعل أبرز نموذج لذلك وأكثره إثارة للإحباط ذلك الذي يمثله الفيلسوف جان بول سارتر الذي ناصر كل القضايا العادلة في العالم، فوقف ضد العدوان الأميركي على فيتنام وناصر بنشاط حركة استقلال الجزائر، هو والعديد من المثقفين اليساريين لا سيما أولئك المعروفين بـ”حاملي الحقائب” لكنه، أي سارتر، لم يناصر المقاومة الفلسطينية. لا هو فعل ذلك ولا العديد من المثقفين الذين وقّعوا ما يعرف بـ”بيان 121 موقِّعا” (Manifeste des 121) سنة 1961 والذين ساندوا “حاملي الحقائب” حين صدر في حقهم حكم بالخيانة العظمى من طرف القضاء الفرنسي.
بهذه المناسبة ظهر تباين واضح بين المثقفين الفرنسيين اليساريين واليمينيين. فبينما وقف “بيان 121 موقٍّعا” الذي ضم أسماء معروفة نذكر منها إلى جانب جان بول سارتر كلا من سيمون دي بوفوار والفيلسوف موريس بلانشو والسوريالي أندري بريتون والروائيون ميشال بيتور وفرانسواز ساغان ونتالي ساروت والمؤرخ جان فيدال ناكي وغيرهم من المثقفين اليساريين، ضمت القائمة المضادة التي صدرت في نفس السنة، ردا على البيان المذكور، أسماء لمثقفين مناصرين للاستعمار الفرنسي كلهم يمينيون. لكن ينبغي ألا نستنتج من ذلك أنه لم يوجد مثقفون يمينيون كانوا مع استقلال الجزائر، فريمون أرون الفيلسوف وعالم الاجتماع الذي بدأ حياته يساريا ورفيقا لسارتر، قبل أن يغير موقفه مع صعود الأنظمة الشمولية، ويؤلف كتاب “أفيون المثقفين”، منتقدا تعاطف المثقفين اليساريين مع الأنظمة الشيوعية، ويتحول إلى منظر سياسي للنظام الليبرالي وإلى صورة المثقف المضادة لسارتر، لم يمنعه كل ذلك من الوقوف مع استقلال الجزائر.
لكن وسط التأييد العام من طرف المثقفين الفرنسيين لإسرائيل، كانت هناك أصوات قليلة خرجت عن هذا الإجماع. نذكر في هذا الصدد صوت ماكسيم رودنسون وجاك بيرك اللذين يعتبران من أوائل من نهضوا مدافعين عن القضية الفلسطينية في القرن الماضي. وقد بين ماكسيم رودنسون في مقال طويل نشر بمجلة “الأزمنة الحديثة”، عدد مايو 1967، تحت عنوان “هل إن إسرائيل واقع كولونيالي؟” بأنه “من الواضح جيدا بأن إسرائيل واقع كولونيالي ذي خصوصيات، شأنها في ذلك بالمناسبة شأن حالات كولونيالية كثيرة أخرى”.
|
هناك أيضا عامل نفسي كان نتاج تاريخ أوروبا مع اليهود، عبر عنه سارتر في عدد “الأزمنة الحديثة” الصادر إبان عدوان 1967، قائلا “يوجد لدى الكثير منا تبعية عاطفية، لكن ذلك لا يقلل من أهمية هذا الأخيرة من حيث التأثير على ذاتيتنا، فهي نتاج عام لظروف تاريخية وموضوعية تماما نحن أبعد من أن نكون على مقربة من نسيانها. لدينا حساسية إزاء كل ما يشبه من بعيد أو من قريب معاداة السامية”. ربما ذلك ما يفسر أن ماكسيم رودنسون لم يقع فريسة هذه “الحساسية”، لأنه لا يمكن أن يتهم بالعداء للسامية، فهو يهودي الأصل ووالداه هلكا في محرقة أوشويتز. كان رودنسون من أوائل المدافعين عن القضية الفلسطينية وسط المثقفين اليساريين الفرنسيين المعروفين تقليديا بما يسمى في الفرنسية (philosimite)، أي محاباة إسرائيل.
المثقف اليساري والصهيونية
ومع سقوط الاتحاد السوفياتي (1992) والكتلة الشرقية التابعة له، تغيرت الخريطة الجيواستراتيجية والأيديولوجية للعالم. وكان لكل ذلك انعكاسات سلبية أساسية على العالم العربي والإسلامي، إذ حل مفهوم “صدام الحضارات” الذي جاء به صامويل هنتنغتون محل الصراع بين الرأسمالية والشيوعية الذي ميز القرن العشرين، الشيء الذي جعل من الإسلام والمسلمين، وبالتالي من العالم العربي والإسلامي، بؤرة الصراعات التي بدأت مع القرن الحادي والعشرين. وقد بدا هجوم 11 سبتمبر 2001 على برجي نيويورك من قبل “القاعدة”، حسب الرواية الرسمية، كما لو أنه جاء ليؤكد مقولة “صدام الحضارات”، يعني بالأساس الصدام بين الإسلام والغرب.
وكان لكل ذلك انعكاساته على مواقف المثقفين الفرنسيين. فقد أدى هجوم 11 سبتمبر إلى جعل عدد من المثقفين اليساريين ممن شاركوا سابقا في ثورة مايو 68 الطلابية، مثل الفيلسوفين باسكال بروخمر وأندري غلوكسمان والمخرج السينمائي رومان كوبيل وغيرهم، يصطفون إلى جانب الرئيس جورج بوش في حربه ضد ما كان يسميه “محور الشر”، ويشيدون في مقال مشترك نشر يوم 14 أبريل 2003 بغزو أميركا للعراق، منددين فيه بما أسموه نزعة “العداء لأميركا” في فرنسا حيث وقف الرأي العام ضد الاحتلال الأميركي الذي كان يستهدف الثروات البترولية لبلاد الرافدين. مسار لافت لثوار سابقين جاؤوا من أقصى اليسار، ليتحولوا فيما بعد إلى مثقفين مناصرين للغزو والاحتلال بدعوى القضاء على “الدكتاتورية”. ولعلنا نجد في الخلفية اليهودية الصهيونية لجل هؤلاء المثقفين الفرنسيين اليساريين، على غرار بروخمر وغلوكسمان وبرنار هنري ليفي وإلزابيث شملة ومارك وايزمان، جانبا من الجواب على هذا التحول من العداء لـ”الإمبريالية” إلى الدفاع عنها، فأميركا هي الحليف الأول والتقليدي لإسرائيل، وهؤلاء المثقفون ليسوا بأقل ولاء لهذه الأخيرة من المثقفين اليساريين الذين سبقوهم.
إن معالجة موضوع الإسلام من طرف المثقفين اليساريين بفرنسا لا تجري فقط على خلفية الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، بل أيضا بوصفها مشكلة داخلية خاصة بفرنسا. فقد نتج عن الوجود الاستعماري الطويل والاستيطاني لفرنسا
المثقفون اليساريون والربيع العربي
وما سبق قوله، أي عدم عزل المثقفين اليساريين الفرنسيين، ذوي الانتماء الصهيوني، مواقفهم عن معطى الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، هو مبدأ عام لهم. هكذا نجد، مثلا، غلوكسمان وبروخمر وفيينكلكروت وغيرهم يؤازرون ويدعمون كل التحولات وحركات التغيير السياسي التي حدثت في العالم منذ سقوط جدار برلين، لكنهم يلتزمون في المقابل الصمت إزاء الحراك الشعبي المطالب بالتغيير، سنة 2011، في العالم العربي. وهو الشيء الذي حدا بجريدة “لوموند” إلى القول إن “المثقفين الذين كانوا في العادة السبّاقين إلى الدفاع عن الشعوب عندما تثور ضد الطغاة، يركنون هذه المرة إلى صمت عجيب”.
ذلك أن هذا الحراك الشعبي كان من شأنه تقويض إحدى المسلّمات التي أسست عليها إسرائيل أسطورتها الدعائية كجزيرة للديمقراطية وسط محيط من الأنظمة الاستبدادية ومن الشعوب المتعصبة والمتعطشة للموت والدم. ويفسر الفيلسوف رجيس دوبريه هذا “الصمت العجيب” بكون هؤلاء المثقفين “مرعوبون تماما من الإسلاميين، وبأنهم لا يدرون كيف ينظرون إلى هذه الحركات الشعبية التي قد تنقلب على إسرائيل إن آجلا أو عاجلا”. على أن أهم ما يمكن قوله بهذا الشأن هو ربما ما كتبه باسكال بونيفاص في كتابه المعنون “المثقفون المخادعون” (Les intellectuels faussaires) الذي كانت قد رفضت نشره 14 دور نشر، قائلا “غريب أمر نجومنا الإعلاميين الثلاثة! (برنار هنري ليفي، ألكسندر أدلر وألان فيينكلكروت).
|
المثقفون اليساريون و الإسلام
ومثل كل القضايا ذات الصلة بهذه الدرجة أو تلك بالعالم العربي، نجد أن الموقف من المسلمين في فرنسا ومن الإسلام عموما، الموضوع المركزي في فرنسا وفي الغرب عامة منذ سقوط جدار برلين، لم يسلم بدوره من تأثير من معطى الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني. هكذا نجد، مثلا، الفيلسوف ألان فيينكيلكرولت، أحد كبار مناصري الدولة الصهيونية، يؤكد بأنه “توجد مشكلة تتعلق بالإسلام في فرنسا” ويتحدث في آن واحد عن “توسع معاداة السامية لدى المسلمين”، رابطا هكذا بين الإسلام والموقف من إسرائيل، إذ أن معاداة السامية لا تشير حصرا في خطاب مستعمليها إلى معاداة اليهود كبشر، أي إلى نمط معين من العنصرية الموجهة ضد العبرانيين، بل إلى كل خطاب ناقد للكيان الصهيوني، كما جرى مثلا لإدغار مورين الذي تعرض لمتابعة قضائية بتهمة معاداة السامية بعد نشره لمقال مشترك نقدي إزاء السياسة الإسرائيلية، تحت عنوان “إسرائيل-فلسطين: السرطان”.
غير أن معالجة موضوع الإسلام من طرف المثقفين اليساريين بفرنسا لا تجري فقط على خلفية الصراع الفلسطيني-الاسرائيلي، بل أيضا بوصفها مشكلة داخلية خاصة بفرنسا. فقد نتج عن الوجود الاستعماري الطويل والاستيطاني لفرنسا في المنطقة المغاربية، خصوصا في الجزائر، تواجد جالية إسلامية كبيرة في عقر دار المستعمِر السابق يتراوح عددها، حسب إحصائيات 2010 بين 5 إلى 6 ملايين نسمة، أصبحوا اليوم يشكلون جزءا من واقع المجتمع الفرنسي، مما حوّل هذا الأخير إلى مجتمع متعدد الديانات، يحتل فيه الإسلام المرتبة الثانية بعد المسيحية.
وبالرغم من معاداته للديانات عموما، يرى أونفراي بأنه “يجب أن نخشى الإسلام أكثر من الكاثوليكية”، وبأن أوروبا، وبالتالي فرنسا، ستصبح مسلمة بعد خمسين سنة بحكم التطور الديمغرافي للمسلمين فيها. الأمر الذي يكشف عن هاجس الخوف على الهوية الفرنسية كخلفية أخرى لنقد الإسلام في فرنسا، إلى حد أن الروائي ميشال هويلباك يصور في عمله المعنون “الخضوع” (Soumission)، الصادر عام 2015، فرنسا وقد أصبحت في عام 2021 مسلمة تماما على إثر انتصار سياسي يحققه حزب إسلامي يأتي برئيس فرنسي مسلم، اسمه محمد بن عباس، إلى سدة الحكم.
المسألة الإسلامية في فرنسا والغرب عموما هي ظاهرة ما بعد كولونيالية وعلى هذا الأساس نتاج تاريخي غير متوقع للاستعمار الغربي
وبالرغم من أنه لا يمكن تعميم خطاب “الإسلاموفوبيا” على كل المثقفين اليساريين الفرنسيين، إلا أن الشعور بوجود مسألة تحتاج إلى دراسة وإلى حلول مرتبطة بوجود جالية تقدر بملايين من الأفراد ذوي جنسية فرنسية ولكن ينتمون إلى ديانة إسلامية، في دولة ذات تقاليد علمانية راسخة ومجتمع ذي هوية مسيحية، هو انشغال نلمسه لدى كل المثقفين اليساريين الكبار، وغير اليساريين أيضا بالطبع، خصوصا منذ مقتل صحفيي “شارلي إيبدو”، يناير 2015، على أيدي اثنين من مسلمي فرنسا، في عملية ذات صلة بالرسوم المسيئة للرسول.
ويمكن القول في الأخير إن “المسألة الإسلامية” في فرنسا والغرب عموما، بما تثيره من مواقف وجدل ورفض وقبول وخوف وعداء وتوظيف، سواء على صعيد المثقفين أو على مستويات أخرى، هي ظاهرة ما بعد كولونيالية، وعلى هذا الأساس نتاج تاريخي غير متوقع للاستعمار الغربي، فلا شك أن المشروع الكولونيالي لم يكن يرمي إلى إدخال الإسلام والمسلمين إلى عقر داره، ولكن ذلك ما حدث في الأخير. غير أن “المسألة الإسلامية” هي أيضا نتاج الشكل الجديد لهيمنة “الغرب” على “الشرق”، من خلال إعادة إنتاج هذه الهيمنة في بلاده وأيضا من خلال دعم أنظمة مستبدة وفاسدة في دول ما بعد الاستقلال. كما أنها نتاج إخفاق تجارب ما بعد الكولونيالية في بناء الدولة الوطنية في مستعمرات فرنسا السابقة.
كاتب من الجزائر