المساواة الملفقة والانتماء إلى مجتمع الحداثة

هل تقبل الكتابة المساواة، حين تنبع من إرادة فردية حرة، ومستقلة عن الجماعة؟ أعتقد أنه لا يمكن الجمع بين الحرية وشرط العدالة في فعل الإبداع، فالحرية إطلاق للقدرة، والعدالة مكافأة وتجميع مختل، ونفي للملكة والطاقة، والصوت، التي من دونها لا يستقيم الأسلوب.
وبقدر ما تشترط الكتابة الحرية الفردية، يقترن تلقّيها بمبدأ المساواة، لهذا أجدني أدرك ذلك الشعور الشائع في أوساط الروائيين والمسرحيين والرسامين والسينمائيين برفض الموزانة والمحاصصة، وتأليف ما لا يؤلف من القلوب والعقول والضمائر؛ شعور يتجلى في صور شتى، لعل أظهرها ذلك المقرون بالتعفف عن التشارك في قضايا واشتغالات، وأحيانا حتى في رفض الجلوس جنبا إلى جنب للحوار.
والحق أنه لا يمكن اختزال الأمر في مجرد عنجهية زائدة، أو زيغ مرضي، وإنما بإدراك أن مساحة الإبداع ترفض المساواة، ونفي الفوارق، ومحو المسافات، ففي تخطيها وأد للقيمة، وتمريغ لرمزية الأسماء والنصوص والتجارب.
وليس من شك في أن المساواة مع ما يتصل بها من قيم العدالة والحقوق، في الوصول إلى المعارف والآداب والفنون، قاعدة لازمة لتشييد مجتمع متمدن، هو وحده الكفيل برعاية قيم المواطنة، إذ لا تقترن الثقافة بالنخب إلا في المجتمعات التقليدية، التي لا تعترف بالفردانية وإنما بالتبعية والولاء، ولعل من أهم إنجازات المجتمع الحديث هو بناؤه لشروط المساواة والعدالة الثقافية، بالنظر إلى سعيه إلى ضمان تعليم جيد لكل طبقات وشرائح المجتمع.
لكن في المقابل لا يمكن أن نتحدث عن مساواة في الإبداع إلا في المجتمعات الشمولية التي تصادر الحريات الفردية، وترتهن لسلطة “مجتمع الثقافة”، بضمان العدالة في النشر والتوزيع والحضور الرمزي، حيث يتحول الكاتب إلى عنصر ضمن جماعة متساوية الحقوق والواجبات.
من هنا تتجلى العدالة بوصفها قمعا للطاقة الفردية وتعويما لرمزية الكتابة، فالشاعر والروائي والرسام والمسرحي هم نقيض الوجود ضمن منظومة تتكافأ فيها الأفعال والمقامات، ما دامت الكتابة رأسمالا فرديا وملكية لا تقبل التشارك، ومن شأنها دوما صنع ما اصطلح عليه النقاد العرب القدماء بـ”الطبقات”، من الشعراء إلى النحاة.
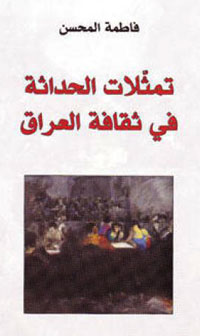
بيد أنه يجدر التمييز في هذا السياق بين المساواة القهرية، المنتجَة بتلفيقية ظاهرة، من قبل السّلط الثقافية، وتلك التي يفرزها تاريخ الفن والأدب، والممارسة النقدية والنظر الجمالي، إذ لا تلبث الأسماء والمقامات أن تتوارى فاسحة المجال لجوهر التيارات والمدارس والأساليب، ضمن أجناس التعبير المختلفة، بحيث يغدو التمييز التعبيري خاضعا لمقولات “التجانس” و“التناظر” و“التحاكي” والاشتغال ضمن دوائر تتشابه فيها المرتكزات والقواعد، فتنشأ المساواة بما هي محصلة تضافر قيم متماثلة، وإن انطوت على اختراقات نصية أو تصويرية.
لهذا يبدو تاريخ الفنون منطويا على جوهر عقلاني، حتى لا نقول ديمقراطيا، مناهضا لتسلط مجتمع الثقافة، المنتج لمقامات مصطنعة، في الآن ذاته الذي يبدو فيه مناقضا لتمركز العلامات والأسماء حول عقيدتها وصورتها المتخيلة عن إبداعاتها، والتي تفرز دوما أوهاما مولدة لحروب طفولية بصدد الحضور والنشر وتقاسم المنصات والمعارض وترتيب الأسماء، وهي في العمق لا تتجاوز مبدأ رفض المساواة في القيمة، ولو كانت في قرار القرار من الضعف والاختلال.
وبقدر ما يبدو وعي الفردانية مركزيا في ممارسات الكاتب والفنان المعاصر، فإن ذلك لا يتنافى في العمق مع وعيه بضرورة الانتقال من الفرد/ المنتج الثقافي إلى المؤسسة الثقافية، التي هي نقيض الجماعة، وما تفترضه من اشتراطات المساواة داخلها، وفي هذا السياق يكاد يتماثل الانتساب إلى الحداثة الثقافية وما تستدعيه من تحصين للحرية والإيمان بالإبداع المستقل، وتجاوز أمراض المساواة التلفيقية، بتشييد المؤسسات الفنية والأدبية.
هل توفرت أسباب هذا الانتقال في الممارسة الثقافية العربية اليوم؟ الصورة توهم بظاهر يناقض العمق، مع تفاوت في تجارب التطور والارتكاس الثقافيين من المحيط إلى الخليج، وربما من أصدق القراءات التي واكبت الظاهرة، في السنوات الأخيرة تلك التي قامت بها الناقدة العراقية فاطمة المحسن في كتاب صدر قبل أربع سنوات بعنوان “تمثلات الحداثة في ثقافة العراق”، حيث تخلص في فقرة دالة من متن الكتاب إلى اعتقاد يرى أنه “في الأربعينات والخمسينات (من القرن الماضي) بدأت الصياغة العملية لبناء المؤسسة الثقافية في العراق، أي وضع النظم والضوابط لمأسسة الدولة حيث الدخول في عصر الحداثة ينهي الجماعات القديمة أو يضعفها ويقيم بدلها مؤسسات.
هذا المشروع بشر به مثقفو النهضة وحاولوا خلق معادل له على المستوى الفكري، ولكن الأنساق الثقافية التي أشادو عليها أفكارهم، بقيت تحكمها عوامل الإعاقة القديمة التي كانت تسكن رؤاهم وتصوراتهم عن المجتمع والمعتقدات والقيم”.
ولعل ما ينطبق على العراق في هذا الصدد قد ينطبق بدرجات متفاوتة على باقي الأقطار العربية، حيث ظل شرط الحرية وشرط المساواة مختلين في دلالاتهما ووظائفها، قاصرين عن إنجاح الانتقال الثقافي من الجماعة إلى الفرد، ومن الفرد إلى المؤسسة، الذي لا يستقيم بغيابه الانتماء إلى مجتمع الحداثة.




























