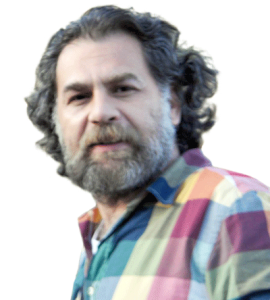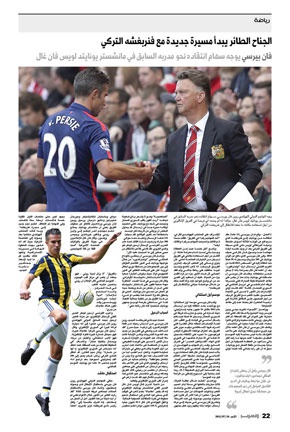المدينة العربية بين حلاقين "البديري" و"أبو عصام" باب الحارة

ظهر فيالمدينة العربية خلال الثلاثمئة سنة الماضية، حلاقان، رصد كل منهما تحولات هذه المدينة، بغض النظر عن اعتداد المثقفين والنقاد، بحجم كل منهما، ودوره الوظيفي (المفترض) أو حتى دخوله في باب الترفيه والاستثمار السياسي والإعلامي، فكان البديري الحلاق، مؤلف كتاب “حوادث دمشق اليومية” الحلاق الأول الذي دوّن يوميات المدينة ومجريات الأمور فيها، ليتحول إلى مرجع وحيد عن عصر معتم، قليل الأخبار والتوثيق، الحلاق الثاني، هو شخصية تلفزيونية صنعتها الدراما، ليس بقصد استنساخ البديري، لكن ظروف الإنتاج وانسحاب النجوم وتتالي الأجزاء في مسلسل “باب الحارة” ترك المجال أمام الشخصية التي أداها الفنان عباس النوري، ليتحول بدوره إلى راصد وراوٍ ومدوّن وشاهد على المدينة ذاتها بعد مرور القرون الثلاثة.
البديري الحلاق
ولد شهاب الدين أحمد بن بُدير، المعروف بالبُدَيْري الحلاّق في دمشق في تاريخ مجهول، وتوفي فيها، نحو 1175 وفق التاريخ الهجري الذي كان معمولاً به في بلاد الشام وقتها، أي بحدود العام (1762 للميلاد) وكانت المهن تتوارث ابناً عن أب عن جد، لذلك فقد ورث شهاب الدين مهنة الحلاقة عن أسرته، التي عاشت في القبيبات في حي الميدان الدمشقي، وافتتح لنفسه محلاً لتزيين الشعر، وبقية شؤون الحلاقين قرب قصر أسعد باشا العظم والي الشام في ذلك الزمان.
وبدأت رحلته في التدوين اليومي لكل شيء في العام 1154 (1741 للميلاد) واستمرت واحداً وعشرين عاماً حتى سنة وفاته، وانطوت مخطوطته بين ما انطوى من تراث ذلك العصر في المشرق، عصر شهد غزوات واحتلالات مختلفة، وتقلبات اجتماعية وسكانية مهولة، حتى وقعت بين يدي الشيخ طاهر الجزائري أحد أهم قادة الرأي والتنوير في أواخر القرن التاسع عشر، وبدايات القرن العشرين، وأستاذ زعماء الفكر العربي المنطلق من دمشق مثل الدكتور عبدالرحمن الشهبندر وفارس الخوري والأمير فيصل بن الحسين.
وكان أول اهتمام بمخطوط البديري، قد وقع على يد الشيخ محمد القاسمي، الذي طلب النسخة من الشيخ الجزائري وحققها ونشرها بعنوان “تنقيح الشيخ محمد سعيد القاسمي لحوادث دمشق اليومية”، وفي العام 1959 نشر أحمد عزت عبدالكريم نسخته المحققة بعد الرجوع إلى النسخة الأصلية من المخطوط.
يبدأ كتاب البديري الحلاق بالكلمات التالية “وفي سنة 1154 كان والياً بالشام الحاج علي باشا من الأتراك وذلك بعد مضي إحدى عشرة سنة من جلوس مولانا السلطان محمود خان بن السلطان مصطفى خان، أيد الله عرش هذه الدولة إلى آخر الدوران، وجرى على لسان العامة أنه سيحدث بدمشق الشام زلازل عظيمة تتهدم بسببها أماكن كثيرة، وأن الرجال ستقلب نساء، وأن أنهار الشام تجري طعاما. وتحدثوا في حوادث كثيرة من مثل هذه الخرافات، وصاروا يتداولونها فيما بينهم، ولم يحدث شيء فيما بعد من هذه السنة”.
البديري الحلاق يظهر من عمق القرون المعتمة للمدينة العربية، قادما من القرن الثامن عشر، مؤرخا يوميات وحوادث دمشق، ناقلا صورة السكان والحياة بما يخالف المظاهر التي رسخت في أذهان الناس عن تخلّف حياتهم وبدائيتها
الحاكم والمحكوم
تبدأ الأحداث في الإثارة حين يجري الحديث، عن التقاطعات الطائفية في المناخ، فمع تتالي السنوات في يومياته، يذكر البديري “وفي تلك الأيام حصلت وقعة عظيمة بين الدروز والمتاولة (الشيعة العلويين)، ومع المتاولة أيضاً أولاد الظاهر عمر حاكم طبرية، وقُتل من الفريقين، وحصروا قتلى الدروز، فكانوا نحواً من تسع مئة قتيل، وهي فتنة كبيرة” أو حين يرد وصفه للوالي الجديد “ووجهت الدولة العلية على الشام سليمان باشا بن العظم، فأرسل سليمان باشا قبل دخوله للشام سلحداره زوج بنت الوفائي متسلماً وبقي نحو شهرين لم يدخل الشام، ثم أتى ونزل على البقاع، وأراد محاصرة جبل الدروز، فصالحوه بمال عظيم حتى أرضوه”.
كان البديري لسان حال البسطاء، فكانت يومياته تتخللها سلوكيات العامة ومكرهم ومجاملاتهم أيضاً، فتارة يبجل بالسلطان والوالي، وتارة ينقل نميمة، أو يصوّر نكبة كمن يتشفى بمصير طاغية، ولا يخفي نقمته حين يتحدث عن أوضاع المعيشة، وإدراكه أنها بسبب السياسات التي تتبعها السلطات المختلفة التي تولت التحكم في مصائر البشر، “وفي عاشر ذي القعدة دخل مصطفى باشا متولي طرابلس الشام نهار الاثنين إلى دمشق، عينته الدولة العلية سرداراً على الجردة. والمذكور كان سفاكاً للدماء ظلوماً غشوماً أهرق دماء كثيرة حينما كان في طرابلس، وكان غالب قتله بالكلاب والشنكل، يترك الرجل حتى يموت جوعاً وعطشاً، فهربت غالب أهالي طرابلس من ظلمه وتفرقوا في البلاد، وكانت تلك الفتنة في يوم الجمعة، حتى بطلت صلاة الجمعة في كثير من الجوامع″.
ولا يستثني البديري الثورات على السلطة في زمنه من يومياته “وفي ذلك اليوم جاء خبر قتل متسلم دمشق، قتله عرب الزبيد وقتلوا من جنده جماعة كثيرة، وذلك لما كانت هذه العرب عاصية على الدولة، فحين بلغ هذا الأمر أكابر دمشق عملوا ديواناً ثم أمروا منادياً ينادي: من أراد طاعة الله والسلطان ممن له قدرة وقوة على الركوب فلا يتخلف، فالغارة الغارة على عرب الزبيد الذين قتلوا المتسلم وعسكره، فخرجت الإنكشارية والسباهية والزعماء”.
يضع البديري مشهداً كاملاً، تتخلله الشخوص في كل زواياه، فمنهم المثقف والطفل والمرأة والعسكري واللص، والعالم، ولم يكن مائلاً لأحد سوى صوت الناس، فقد كان واحداً منهم وحسب، وحين يروي الحادثات يرويها من خارجها، في تأكيد على ثبات شخصية المواطن المدني العربي منذ تلك الأزمنة، والتي كانت قليلة التدخل في الشؤون الكبرى، تستقبل ما يحدث وتتأقلم معه، يقول البديري “أحضر السلخور القاضي والأعيان، واستجلب حرم سليمان الباشا، وأحضر الجلاد وآلة العذاب، وشدّد على الحريم بالطلب، وأن يعلموه عن المال أين مخبأ، فلما رأوا التشديد خافوا من العذاب وأقروا له عن بعض مخابئ تحت الأرض، فبان عن سرداب، فرفعوا عنه التراب، ونزلوا في درج، فإذا فيه سبع براني مملوءة من الذهب المحبوب السلطاني، فلما رأى الحاضرون ذلك الحال زاغت منهم الأبصار، ثم عدوه وضبطوه، فوجدوه ثمان مئة كيس وخمسين كيساً. فلما بلغ الناس ما خرج عنده من هذا المال، وكان في أيام شدة الغلاء، مع سوء الحال، لهجوا بالذم والنكال، وقالوا قد جوّع النساء والرجال والبهائم والأطفال حتى جمع هذا المال من أصحاب العيال، ولم يراقب الله ذا الجلال”.
ألا يتذكر القارئ الحديث عن مليارات مبارك وعلي عبدالله صالح والقذافي وبن علي وبشار الأسد في لحظات كهذه؟
كثيرون يدّعون أن المدينة العربية القديمة، كانت مدينة محافظة، يصبغ عليها الطابع الديني، غير أن الواقع والوثائق يظهران نقيض هذا، لا سيما في بعض المظاهر التي استمرت حتى اليوم، كما في يوميات البديري ذاتها “تفاقم الأمر من تعدي الزرباوات وهم الأشقياء، فاستطالوا في سب الدين وظلم الناس وغير ذلك. وحاكم الشام حضرة أسعد باشا لا يحرك ساكناً، ولم يفعل شيئاً، حتى صاروا يسمونه (سعدية قادين، نائمة مع النائمين)، ونرى الأشقياء للعرض والمال مستحلين. لكن البلد من الحركات ساكنة ومن ظلم الحكام آمنة”.
متدينون وغير متدينين
في المدينة ذاتها، يذكر البديري بنات الهوى، في مناطق سكنهن، ومظاهر حياتهن، بما يشبه ما استمر من تلك المظاهر في مدينة كتونس حتى هذه اللحظة في “نهج عبدالله القش” الذي تسكنه بائعات الهوى، دون أن تتمكن أي سلطة من محوه وإغلاقه” و”في تلك الأيام قتل نفسه شيخ التكية. وفي تلك السنة كثرت بنات الخطا، ويتبهرجن بالليل والنهار، فخرج ليلة قاضي الشام بعد العصر إلى الصالحية، فصادف امرأة من بنات الخطا، تسمى سلمون، وهي تعربد في الطريق، وهي سكرى ومكشوفة الوجه، وبيدها سكين. فصاح جماعة القاضي عليها، أن ميلي عن الطريق، هذا القاضي مقبل، فضحكت وصاحت وهجمت على القاضي بالسكين، فأبعدوها كذا عنه أعوانه”.
حلاق باب الحارة يجسد الانخراط البدائي للمجتمع المديني مع كل سلطة وكل تيار، قابلا للحكم والدين والزعامات والتقاليد، في ليونة وهلامية لم تعرفها المدينة العربية كما يراد لنا أن نصدق اليوم
من غرائب ما يرويه البديري أنه “مما اتفق في حكم أسعد باشا في هذه الأيام أن واحدة من بنات الهوى عشقت غلاماً من الأتراك. فمرض، فنذرت على نفسها إن عوفي من مرضه لتقرأن له مولداً عند الشيخ أرسلان. وبعد أيام عوفي من مرضه، فجمعت (شلكات) البلد وهن المومسات، ومشين في أسواق الشام، وهن حاملات الشموع والقناديل والمباخر، وهن يغنين ويصفقن بالكفوف ويدققن بالدفوف، والناس وقوف صفوف تتفرج عليهن، وهن مكشوفات الوجوه سادلات الشعور، وما ثم ناكر لهذا المنكر، والصالحون يرفعون أصواتهم ويقولون: الله أكبر”.
في الوقت الذي يظهر فيه أبو عصام باب الحارة، أن النسوة الدمشقيات كنّ مشغولات بالنميمة والطلاق والزواج والغيرة والكنة والحماة والحجاب.
ثم ينقل البديري ما وصلهم من أخبار بغداد في ذلك الزمان، لتبدو المدن متشابهة في حوادثها ويومياتها وطرق حكمها والحياة التي سادت فيها.
بغداد ودمشق والقدس
يقول البديري “وفي هذا العام جاءنا الخبر بوفاة أحمد باشا بن حسن باشا والي بغداد وقيل إن سبب موته أن الدولة أرسلت له فروة مسمومة فلبسها فدبّ السم في بدنه، فمات رحمه الله. كان رحمه الله شجاعاً مقداماً مدبراً للأمور أطاعته العباد ودانت له البلاد، وقد دفع عن بغداد كل جبار، ولقد قصده طهماسب الخارجي ومعه عسكر جرار، وحاصر بغداد أشهراً فلم يقدر على فتحها فرجع ذليلاً صاغراً، وطلب بلاد الهند والتتر، فسلط عليه ولده فقتله ودمره، وتولى ولده مكانه، ولم يخرج على الدولة وكان اسمه دبوس. ولما توفي أحمد باشا والي بغداد أرسلت الدولة إلى بغداد والياً كور محمد باشا، وكان صدراً أسبق، فلما استقر ببغداد، طلبت منه الانكشارية العلايف أي المعاشات، فقال لهم: علايفكم عندي. قالوا: لا، فقد كان أحمد باشا الذي كان قبلك يعطينا إياها من ماله، ولما تأتي له من الدولة يأخذها. قال لهم: أنا لا أفعل”.
يطوف البديري على الأخبار والمدن في يومياته “نزل ثلج عظيم بدمشق وأقام أياما وهدم أماكن كثيرة. وفي تلك الأيام جاء قبجي برجوع القدس إلى أسعد باشا والي الشام. وفي ذلك الشهر جاء خبر بأن عرب الحجاز محاصرين مدينة الرسول صلّى الله عليه وسلَّم، ولها نحو شهرين في المحاصرة، حتى هدّموا ما حولها وقطعوا نخلها وضيّقوا على أهلها، وهم الآن في كرب وضيق ما سبق ولا سمع من عهد الجاهلية”.
أما في يوميات أبو عصام باب الحارة، فتبدو تلك الحارة التي تنتمي الى مدنية اسمها “الشام” معزولة عن العالم، لا تتأثر ولا تؤثر في أيّ من المدن المحيطة بها في مراكز الحضور العربي في المشرق.
تبرز مدينة دمشق في يوميات البديري مصباً لسيول هجرات من هنا أو هناك من أصقاع العالم، فمرة يذكر قادمين من المغاربة والعراقيين، ومرة يذكر آخرين جاؤوا من عوالم بعيدة، لتتشكل المدينة ممن يقرّر السكن فيها، وليس من عرق أو طائفة معينين، ولتتحول المدينة بحد ذاتها، إلى ذهنية مكتسبة وتراكمية، فيرحب أهلها بالقادمين الجدد، ولا يضيقون بهم، بل يذكر البديري ما أتوا به معهم في هجرتهم تلك، يقول البديري “وفي هذه السنة جاءت حجاج كثيرون من العجم، وهم على ما نقلوا ألف وست مئة عجمي، ما عدا البغّادة والعرب، وصار جبر خاطر لعموم الناس في البيع والشراء. وجاء مع العجم ربيّات ذهب كل واحدة بثلاثة عشر غرشاً ولؤلؤ كبير وصغير وأحجار ومعادن وشال وغير ذلك”.
وفي الوقت ذاته لا يمكنك أن تفوّت عبارة كهذه ترد في يوميات البديري “وفي تلك الأيام بلغنا أن أهل مصر طردوا كل غريب، والذي يجدونه بعدما نهبوا ماله وعذبوه أشد التعذيب”.
في يوميات أبو عصام باب الحارة، فتبدو تلك الحارة التي تنتمي الى مدنية اسمها “الشام” معزولة عن العالم، لا تتأثر ولا تؤثر في أيّ من المدن المحيطة بها في مراكز الحضور العربي في المشرق
أبو عصام باب الحارة
تبدو المدينة التي يتحدث عنها أبو عصام باب الحارة، أشبه بكاريكاتير مبسّط، فيه علاقات بدائية، قائمة على العقلية التوفيقية في كل الأمور، فلا حدود لما يمكن أن يوافق عليه الحلاق وأهل الحارة، ولا نتائج لخلافاتهم وخصوماتهم، فكل شيء سيجري حلّه بعد حين.
أما العلاقة مع السلطة (الوطنية) فقائمة على الرشوة والفلقة والابتزاز، والعلاقة مع المحتل الفرنسي تتأسس على أن فرنسا مشغولة بتلك الحارة الصغيرة، ما يوحي بإحساس عميق بالدونية، أن الوجود المدني الكبير الذي أورده البديري، تحوّل في نهاية المطاف بعد قرابة ثلاثة قرون إلى مجرد حارة صغيرة، ينتهي الجزء السابع من المسلسل، بشروع الفرنسيين بهدمها.
لافت أن أكثر الكلمات وروداً في يوميات البديري، كلمات دمار، وخراب، وهدم، وحريق، وغرق، وسيول، لكن البديري كان يأتي على ذكر هذه الأمور، وكأنها من التفاصيل المعتادة والمألوفة، لتستمر المدينة بعدها، وكأن شيئاً لم يكن، ولعل الشاهد على هذا العصر الذي خربت فيه بغداد وحلب ومدن كبرى في المشرق، يجد عزاء بما يقرأه في صفحات البديري.
“وفي ليلة الثلاثاء ثامن ربيع الثاني من تشرين الثاني من هذه السنة في الثلث الأخير من الليل والمؤذنون في المآذن صارت زلزلة زُلزلت منها دمشق زلزالاً شديداً، وحسبت أهل دمشق أن القيامة قد قامت، فتهدّمت رؤوس غالب مآذن الشام ودور كثيرة وجوامع وأماكن لا تحصى، حتى قبة النصر التي بأعلى جبل قاسيون زلزلتها وأرمت نصفها، وأما قرى الشام فكان فيها الهدم الكثير، والقتلى التي وجدت تحت الهدم لا تحصى عددا. وقد زاد الخوف والبلاء، وهجرت الناس بيوتهم، ونامت في الأزقة والبساتين وفي المقابر والمرجة، وفي صحن الجامع الأموي”.
“وفي أوائل الشتاء من آخر هذه السنة قلّت الأمطار، ويئست الخلق ونهض الغلاء على قدم وساق، فأغاث الله عباده بالأمطار كالبحار، وذلك في ابتداء كانون الثاني، واستمر ليلاً مع نهار لا يفتر، وأثلجت الدنيا سبع مرات، واستمر ذلك خمسة وأربعين يوماً، وتهدمت أماكن كثيرة بحيث ما بقي محل ولا جهة في الشام إلا ووقع الهدم فيها، ثم بعد ذلك طلعت الشمس، وأحيا الله الأرض بعد موتها”.