الكتب السينمائية في المغرب: أفكار غربية مستنسخة أم دراسة ميدانية بحثية
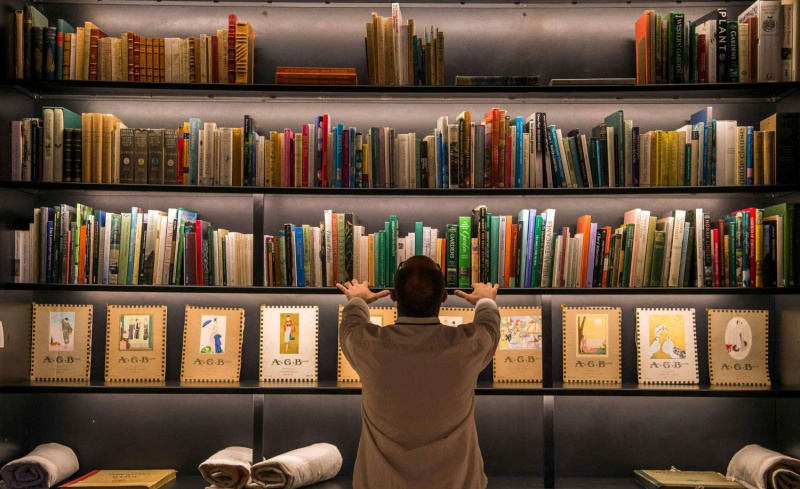
تتعدد الكتب والإصدارات المغربية الجديدة التي تهتم بالسينما، لكنها تهتم بها بمعناها الشامل والعام ولا تلتفت إلى خصوصية الفن السابع وتاريخه في المملكة، ما يجعل المكتبة السينمائية لدينا منقوصة، لا تمنح الباحث ما يثري معرفته بفن صناعة الفيلم في بلاده وخصوصيته وأهم المراحل التي مر بها.
الرباط - يمكن النظر إلى قضية تأليف الكتب السينمائية في المغرب من منظور أكاديمي أولا، للتحقق مما إذا كانت معتمدة لدى طلاب الجامعة من حيث المعايير العلمية التي تشمل المفاهيم والنظريات والرواد والمدارس والمصادر والمراجع، ثم في سياق التكوينات التي تقوم بها الأندية السينمائية، والتي تكون محدودة جدا معرفيا، لهذا نجد هذا الموضوع يشغل حيزا كبيرا في نفس الطالب السينمائي الباحث، نظرا لارتباطه بدراسة السينما المغربية، وليس تلقينه السينما الإيرانية أو الأميركية أو الأوروبية فهذه متاحة للجميع على الإنترنت.
وإذا ما استحضرنا قضية غياب الكتب التي تتناول تاريخ السينما المغربية، وتاريخ الأندية السينمائية التي خلفت إشكالات معرفية عميقة، أبرزها فراغات مهولة في الهوية السينمائية المغربية، سنطرح تساؤلا حول كيف يتحدث الناقد ويفتي في السينما المحلية ونحن لا نملك كتابا واحدا عن تاريخنا السينمائي؟
في محاولة للإجابة على الإشكالات السابقة، يتبين لنا أن الفكرة تتناول تأليف الكتب السينمائية في المغرب وما إذا كانت فعلا كتبا مغربية مبنية على دراسات وقراءات في أفلام تركز على الهوية الثقافية والفنية والاقتصادية والسياسية والرياضية والاجتماعية المغربية بشكل كامل، أم هي مجرد كتب مستنسخة من أفكار غربية تم تعديلها لتناسب السياق المغربي، وهو ما يظهر بوضوح من خلال العناوين التي يعتمدها بعض الكتّاب.
لا أحد ينطلق من الواقع الذي يعيشه قطاع السينما المغربية، وهو أزمة شركات الإنتاج الخاصة وأزمة الدعم الرسمي
نجد، على سبيل المثال كتاب “ما هي السينما” للمخرج المغربي شريف طريق، والذي يحمل نفس عنوان كتاب “ما هي السينما” للناقد والمفكر الفرنسي أندريه بازان، وللأمانة تطرق بازان إلى تطور مفهوم السينما عبر العصور من خلال دراسة مبنية على الأفلام الأولى والثانية التي أسماها الموجة الجديدة، لكن هذا الناقد لم يكن مستعدا لتعريف السينما بأنها فن، ورغم أنه دارس حقيقي في هذا المجال، إلا أنه ترك سؤال ماهية السينما مفتوحا أمام العالم، ثم قام بمقارنة بين السينما الحديثة والسينما الكلاسيكية، ومن هنا نبع المفهوم، أي من خلال دراسة الأفلام.
الأمر نفسه متعلق بكل النظريات السينمائية التي تحدث عنها المفكر الأميركي جيمس ديدلي أندرو في كتابه “نظريات الفيلم الكبرى” والذي يعتبره النقاد المغاربة مرجعا، وهذه النظريات صراحة خرافة معرفية محضة، لماذا؟ لأن هذه النظريات بنيت وتأسست من خلال الواقع الأوروبي والغربي للسوق السينمائية آنذاك، وليس للسينما المغربية، فعندما تنظر بنظرية الشكليين والواقعيين، فلن تجد لهم مكانا في الساحة السينمائية المغربية، لأنها ببساطة سينما تجريبية، فيها مزيج من ثقافات متعددة، من بينها حوارات نصفها فرنسي ونصفها إنجليزي والباقي باللهجة المغربية المنقحة وليست الشعبية العامة.
والسؤال هنا، حتى لو كان عنوان كتاب شريف طريق قد كان صدفة مماثلا لعنوان كتاب المنظر أندريه بازان، كيف سيكون محتوى هذا وذاك؟ لأن هناك كتابا آخر لنفس المخرج تحت عنوان “لغة السينما”، وهذا الكتاب في الحقيقة ألفه المنظر السينمائي الفرنسي مارسيل مارتن، ويعتبر من أهم من يؤلف في أدبيات السينما لأنه دارس للفلسفة أولا، ثم فنون السينما ثانيا، وإذا اجتمع هذان التخصصان في كاتب فاقرأ له.
يفصل مارسيل مارتن في كتاب “اللغة السينمائية” أربعة فصول مهمة، أحدها في الخصائص العامة للصورة المتحركة، ثم انتقل إلى عناصر اللغة السينمائية من خلال الدور الخلاق لآلة التصوير والانتقالات والإضاءة والديكور والملابس والمكياج، ثم المونتاج والزمان والمكان وعمق الميدان والحوار والصوت، كما تطرق إلى سيميولوجية السينما التي تبنى على الدراسات وليس النسخ واللصق، كما تحدث عن السرد الفيلمي وفروعه، وهذا الرجل في الحقيقة ما ترك شيئا له علاقة باللغة السينمائية أو بدراسة الأفلام، إلا وتطرق إليه.
فإذا كان الأصل موجودا، فماذا سيضيفه كتاب من نفس العنوان وغير قائم على أيّ دراسة ميدانية مثلا؟
إن توظيف بعض كتّاب السينما المغربية لبنية مفاهيمية منسوخة أو مسقطة أو عناوين طبق الأصل، أو أفكار تتم إعادة صياغتها وإدراجها ضمن المؤلفات السينمائية المغربية هو محض هراء معرفي وثقافي وعلمي، في نظر الطالب الباحث الذي يكشف ألاعيب كتّاب تبنى أسماءهم على أكتاف العمالقة.
ومن أجل إقناع القارئ بوجاهة موقف الطالب الباحث، يمكن النظر إلى ما تم تأليفه مؤخرا، وهو كتاب تحت عنوان “فن فهم السينما”، في الحقيقة لم أطّلع على هذا الكتاب ولا ذاك، ولكن السؤال المطروح هو، ماذا عن كتاب “فهم السينما” للمنظر السينمائي لوي دي جانيني؟ وهو باختصار موسوعة شاملة تتضمن كل ما يتعلق بصناعة الأفلام وتذوقها، بداية من التصوير والحركات والمونتاج إلى الفرق بين الفيلم التسجيلي والروائي والدرامي، والنظرية السينمائية، وفن فهم السينما دائما يكون مبنيا على ما ذكره لوي دي جانيني في كتاب “فهم السينما”، الذي لم يترك فراغا في هذا المجال.

إن موضوع تأليف الكتب السينمائية بعيدا عن الاهتمام بهوية السينما المغربية يمنح طابعا سطحيا وعشوائيا في التأليف، حيث يتم تلقين هواة السينما ما ألفه الغرب في مجال الفن السابع على مر السنين، سواء في ما يتعلق بنظرياتها أو جمالياتها أو فلسفتها أو علاقتها بالشعر والأدب وعلم النفس، وغيرها من المواضيع التي تم تناولها في كتبهم الأصلية، فلماذا إذن نقرأ النسخ المقتبسة أو المعادة صياغتها إذا كان بإمكاننا الوصول إلى المصادر الأصلية مباشرة؟
إن هناك كارثة معرفية أعظم مما تم ذكره، تخيل نفسك مثقفا سينمائيا معترفا به كناقد ومنظر سينمائي معروف، لكن لا يوجد في خزانتك كتاب أكاديمي واحد في تاريخ السينما المغربية، باستثناء كتاب ألفه الدكتور والباحث بوشتى المشروح منذ شهور قليلة، حيث قدم مجهودا جبارا تحت عنوان “تاريخ السينما في المغرب من أواخر القرن التاسع عشر حتى عام 1912″، وقد كشف المؤلف في هذا الكتاب عن كوارث و روايات ملفقة في تاريخ السينما المغربية، مما أحرج جميع النقاد الذين عملوا في هذا الميدان لسنوات، إذ لم يتمكنوا من تأليف كتاب واحد حول تاريخ السينما في المغرب أو تاريخ الأندية السينمائية، فماذا كانت تفعل جمعية النقاد والكتاب من التسعينات حتى اليوم؟
لا نملك جوابا ولكن غياب الكتب التاريخية السينمائية المغربية المرجعية يعتبر ردا يوضح جدارة النقد الكبير في بلادنا.
وبناء على كل ما سبق، يمكن القول إن موضوع تأليف الكتب السينمائية المغربية الذي نناقشه هو مشكلة تتعلق بالمصداقية والجودة، وهو أكثر تعقيدا مما اعتقدنا في البداية، وهذا ما يفرض ضرورة تحضير جيل من الطلاب الذين يبحثون في هذا الميدان باستخدام تكنولوجياتهم الجديدة وأساليبهم العلمية الحديثة، بعيدا عن الأيديولوجيات التي عفا على أصحابها الزمن وعرقلت قيمة البحث والتطوير في هذا المجال.
ومن بين هذه الأيديولوجيات، نجد هناك من يشجع على السينما الإيرانية، ومن يعطي أهمية كبيرة لجوائز الأوسكار، ومن يركز على المهرجانات الكبرى مثل كان وبرلين، ومن ينجذب إلى نظريات السينما ويعتبرها مرجعا للسينما المغربية التجريبية.
ولا ينطلق أحد من الواقع الذي يعيشه قطاع السينما المغربية، وهو أزمة شركات الإنتاج الخاصة وأزمة الدعم الرسمي الذي يتحكم فيه المركز السينمائي المغربي، وأزمة كتابة السيناريو المغربي الأصيل الذي ينبع من ثقافتنا وأفكارنا وجذورنا، ويكون غير مستنسخ من الثقافات الدخيلة التركية والغربية والأوروبية، إلى جانب عدد المهرجانات السينمائية التي تفوق 84 مهرجانًا، والتي تكرّر نفسها تنظيميًا وثقافيًا، وأزمة التكريمات والجوائز التي تعطى للمحاباة وليس للكفاءات، واحتكار شركات الإنتاج وغيرها من الأزمات.






















