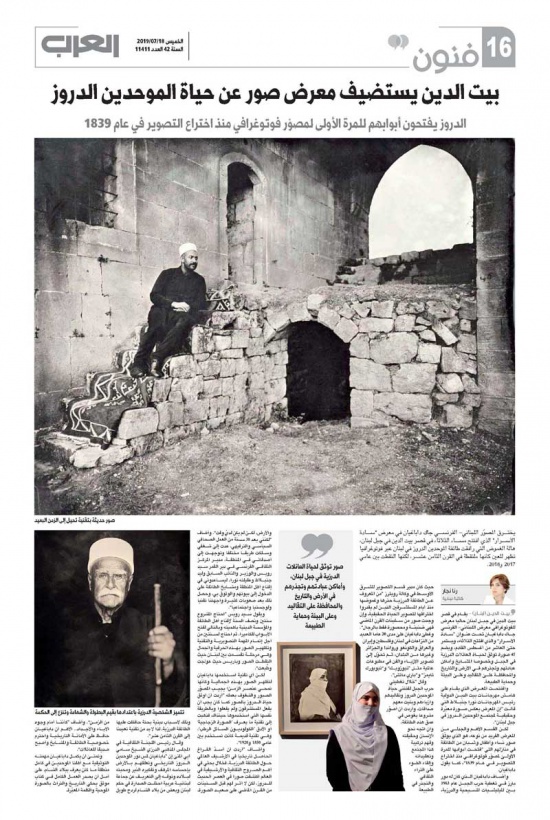الكاتب الجزائري أحمد دلباني: نعاني من الولادات غير المكتملة

كثيرة هي القضايا المنوطة بالمثقف العربي اليوم، وخاصة المفكرين، الذين وجدوا أنفسهم أمام أزمات عربية وعالمية متسارعة تستدعي خلفها قرونا كامنة من الإشكالات العالقة. “العرب” التقت المفكر والناقد الجزائري أحمد دلباني في حوار حول إشكالات الكتابة والمثقف والفكر العربي والآخر.
“نعم. نشأت شاعرا في البداية” هكذا يبدأ لقاؤنا مع المفكر والفيلسوف أحمد دلباني، الذي وجد نفسه منجذبا، كما يقول، نحو “اللغة الشعرية والإيقاع وأرى فيهما طريقا يقود إلى لقاء مع ذاتي العميقة وهي تنشد الاتحاد بجوهر بعيد يومئ ولا يتجلى”. ويضيف “كنت مسكونا، ولا أزال، بالبحث عن هارمونيا كونية تردم الهوة بين الذات والعالم من خلال إيقاع ينتشل الكينونة من سديم الأشياء وفوضاها. هذه ميتافيزيقا الشعر، إن جاز التعبير، وتلك ينابيعه”.
سنونوة واحدة
تأثر دلباني بوالده الذي كان كما يقول محبا للغة العربية والشعر العربي في بعض ذراه العليا عنترة والمتنبي والمعري قديما، وشوقي وحافظ والشاعر القروي والشابي حديثا، ولكنه ما لبث أن شهد، منتصف الثمانينات، زلزالا بهيجا فتح عينيه ووجدانه على مغامرة اللغة والرؤيا، وهو يتعرف على بعض فتوحات الشعرية العربية الحديثة، ويقف على مقدار جسارة اللغة عند جيل الرواد وهم يتوسلون السبل إلى قول التجربة وإعادة خلق العالم في أفق التخييل وشفافية المعنى الذي يخترق كثافة اللحظة التاريخية.
“أنا من جيل التسعينات”.. يحدد دلباني موقعه في خارطة الأجيال الثقافية، “أين ولدت، ثقافيا وإبداعيا، بعد انتفاضة الشباب الجزائري في أكتوبر 1988، وفي ظل ما عرفته الجزائر بعد ذلك من انفتاح سياسي وإعلامي. لقد استعادت الكتابة الشعرية حقوقها في المغامرة من جديد بعيدا عن أدبيات الالتزام في صورته المتصلبة أيام الأحادية الحزبية والثقافية. وأدى تحطم العكاز الأيديولوجي إلى سقوط الكثير من الأصنام الشعرية وإلى تحرير الشعر من العناصر غير الفنية وغير الجمالية”.
كان محور اهتمام ذلك الجيل يرتكز على “كتابة قصيدة جديدة تسافر بعيدا في الذات وتحاول أن تتماهى مع لحظتها بمعزل عن كليشيهات الأيديولوجيا الجاهزة. لقد تم مع جيلي العبور من الصخب الأيديولوجي إلى الخيمياء الفنية لغويا، والانتباه إلى حضور الأشياء الناتئ بفعل ضربة شمس الوعي. كما أتيح للمدونة الصوفية أن تحظى عندنا باهتمام بالغ أيضا باعتبارها، أساسا، تجربة في الكتابة تستثمر طاقات اللغة وإبداعيتها من أجل قول المواجيد العميقة في محاولة التماهي مع المطلق”.
ويشير دلباني إلى أنه في تلك الفترة تحديدا كان “مأخوذا أكثر بمحاولة فهم العالم وإيقاع العصر المتسارع بمعزل عن خطاطات الأيديولوجيات الآفلة. هذا ما دفع به إلى العكوف على القراءة والتأمل، لسنوات، في المنجز الفلسفي والفكري الذي ظل يرقب تحولات المعنى ويسائل مصير الحداثة ويحرر النظر إلى التاريخ من السرديات الخلاصية المستهلكة”.
على كاهل المفكر العربي اليوم أن يناضل من أجل اكتساب الفلسفة حق المواطنة في المدينة العربية
في سياق حديث آخر عن المثقف ودوره يحب المفكر دلباني، كما يقول، أن “ينطلق من ذلك التمييز التعليمي الممتع الذي أقامه سارتر بين رجل التقنية والمثقف من خلال مثال علماء الذرة الذين تجاوزوا اختصاصهم العلمي عندما نبهوا إلى مخاطر إنجازهم على الحياة البشرية والسلام العالمي. فالمثقف بهذا المعنى البسيط هو من يجد نفسه معنيا بالتدخل في الشأن العام منتصرا للحرية والعدالة والكرامة الإنسانية والحقيقة المتخلصة، قليلا أو كثيرا، من تأثيرات السلطة”.
ولكن “ما يهم”، في كل ذلك، يقول، هو أنه “على المثقف المحافظة على الحد الأدنى من استقلاليته بإحداث تلك المسافة النقدية مع المؤسسة الرسمية التي تجتهد في تحويله إلى موظف من جهة أولى، ومع ذاته ومسبقاته الفكرية والأيديولوجية من جهة ثانية”.
في ظل هذه النظرة نسأل دلباني هل أنتج الحراك العربي منذ 2011، ونظيره الجزائري اليوم أيضا، مثقفه؟ ليجيب “لم يحدث ذلك بعد، رغم أن حروب التحرير منذ الخمسينات، ومن بينها حرب التحرير الجزائرية بكل تأكيد، أسهمت بشكل فعال في إنتاج المثقف الما بعد كولونيالي الذي أعاد صياغة المعنى وطرح فهما للتاريخ من زاوية تفلت من المنطق الإمبراطوري المركزي للغرب الحديث. لقد ولد التفكيك، بمعنى ما، من الشقوق التي أصابت قلعة الفكر الغربي في العمق وفتحتها على تعدد العالم وكثرته. هذا ما يجعلنا نعتقد أن نمط المثقفين السائد اليوم لا يرقى إلى أن يجدد خطاب التعامل مع اللحظة التاريخية الراهنة ما دام لم يطأ بعد أرض المراجعة النقدية التي تقرأ فشل انتفاضاتنا وعدم إمكان خلخلة رواسب المجتمع الأبوي التقليدي. لقد قيل إن ‘سنونوة واحدة لا تصنع الربيع‘. فهل يمكن لسنونوة الحراك الشعبي أن تصنع ربيع الديمقراطية والحرية والخلاص من أزمنة الفساد والقهر؟ لماذا نعاني دوما من الولادات غير المكتملة؟”.
الأنا والآخر
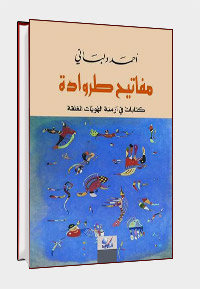
يـشرح دلباني الحوار مع الآخر عبر النقد والحفر في هذه العلاقة فيقول “باعتبارنا عربا ومسلمين، فإننا نقصد بالآخر الغرب الأوروبي تحديدا. وأكاد أقول ليس لنا ‘آخر’ غيره على المستوى الحضاري منذ القديم مع استثناءات قليلة أبرزها، ربما، بلاد فارس كما هو معروف. فقد كانت اليونان القديمة رافدا ثقافيا عظيما ولد أهم مشكلاتنا الفكرية من خلال مقارعة العقل ومعطى الوحي. بينما مثل اللقاء الصدامي مع الغرب الحديث ميلاد مشكلاتنا التي عبرت عن التحديات المطروحة أمام شللنا التاريخي تجاه الحداثة”.
ولكن هل الصورة التي يكونها العالم الغربي-الأوروبي عن الإنسان العربي- حقيقية؟ يرد المفكر “هي نتاج مخيال جبار ينهل من ذاكرة ذلك الصراع الماضي على احتكار رأس المال الرمزي للخلاص في حوض البحر المتوسط. وهنا تقفز إلى الذهن بسرعة ذكرى الحروب الصليبية والاستعمار الحديث وصولا إلى أشكال الهيمنة الراهنة على العالم العربي-الإسلامي. إن العربي-المسلم ظل يمثل دائما ذلك ‘الآخر‘ الذي يحمل إرث المجابهة التنافسية مع الغرب. وهذا، طبعا، لا يكفي لتفسير الصورة المصدرة اليوم عن الإنسان المسلم في الإعلام الغربي والتي هي في أساس ‘إسلاموفوبيا‘ متفاقمة حتى بين المثقفين والنخب السياسية. إذ ربما لم يكن استحضار التاريخ إلا ذريعة للاستثمار في الخوف من أجل أهداف سياسية تخدم اليمين المتطرف المنتعش بصورة لافتة والذي يعرف ربيعه الانتخابي عبر أرجاء أوروبا المنهكة بمشكلاتها وأزماتها”.
إذن أين تكمن المشكلة الأساسية في علاقة الذات بالآخر؟ يقول “المشكلة لا تخرج، دائما، عن حضور جملة المسبقات الثقافية والعرقية والدينية المترسخة تاريخيا والمرتبطة بذاكرة الصراع معه. ونعتقد أن تنشيط هذه المسبقات لا يخدم إلا من يرى في الصراع الأبدي ترسيخا لمركزية الذات وتفوقها أو أحقيتها في فرض منطق الهيمنة والسيطرة. وعلى هذا نرى أن صنع صورة نمطية استهلاكية عن الآخر تجعله فزاعة في الفضاء العام لا يستند إلى الذاكرة التاريخية العالمة فحسب، وإنما أيضا إلى الأوضاع المعقدة التي تعيشها البلدان الحاضنة لتدفق المهاجرين وعدم قدرتها، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، على تجديد خطاب الاندماج الإيجابي لأبناء الهجرة في ظل سيادة فلسفة ليبرالية ظلت تفتقر إلى إمكانية إدارة الشأن العام بالانفتاح على الأبعاد الثقافية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنة، بعيدا عن الشكلانية الحقوقية الموروثة عن تنوير علا وجهه الشحوب”.
يعتقد مفكرنا أنه يقع “على كاهل المفكر العربي اليوم أن يناضل من أجل اكتساب الفلسفة حق المواطنة في المدينة العربية التي لا تزال، في عمومها، تحمل صفات ‘مدينة الله’ لا ‘مدينة الإنسان’. لا يمكن أبدا ان تزدهر الفلسفة، باعتبارها بحثا وتأسيسا لجدارة الحياة في أفق الاستقلالية والإبداع، إلا من خلال انبثاق ‘الكوجيتو’ العربي الذي طال انتظاره كما ذكرت آنفا. على العربي أن يتعلم ‘فن الإقامة في العالم’ كما يعبر علي حرب. دون ذلك لن يكون لنا وجود فاعل وسيكون العدم أليق بنا. نرسيس العربي لم يعد يتأمل وجهه في مرآة الأرض وإنما في السماء والأبدية بوصفهما بديلا عن السقوط غير الموفق في الزمنية والتاريخ”.