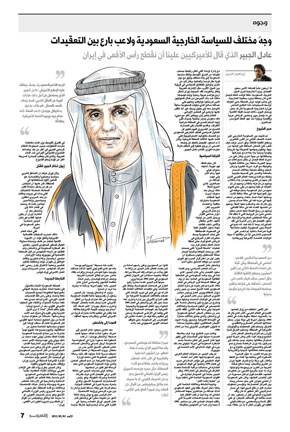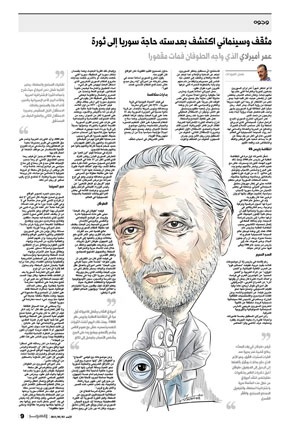الحداثي الانقلابي: نزار قباني – إعادة نظر

في مثل هذه الأيام قبل 17 سنة غاب نزار قباني عن عالمنا، بعدما قضى في لندن سنوات حياته العشرين الأخيرة بعيدا عن أندلسه الدمشقي، الذي بنى له في شعره أسطورة من أطواق الفل والياسمين، وأقمار الحب الساهر في الشرفات، وفراشاته المتخطفات في شمس الضحى وراء حبال الغسيل.
في منفانا اللندني بغيومه الكالحة كان نزار علامة فارقة بيننا نحن الشعراء الجدد الغاضبين، اختلفنا معه، وهجانا في شعره، بصفتنا “حداثيين منخلعين من الجذور”. وما كنا نرفضه من غير شاعر من هجوم على الكتابة الشعرية العربية الجديدة كنا نقبله من نزار، فقد كانت له مكانة خاصة لدينا.
وكنت أرى أن نزارا مهما ابتعد في المكان تبقى دمشق المدينة الأكثر حضورا في شعره، ويبقى اسمه كشاعر يستحضر هذه المدينة العظيمة إلى الأذهان.
-I-
كنت قبل رحيله بأشهر كتبتُ -تحت عنوان “نزار قباني حداثيا”- كلمة في الشاعر عاتبتني عليها جمهرة من الشعراء العرب ممن يوصفون بأنهم حداثيون، رأوا أنني مبالغ، وأشعروني أن هذه هي إحدى سقطاتي. ومما قلت في هذه الكلمة “إن نزار قباني ليس فقط أشهر شاعر عربي حيّ، وإنما أحد أبرز وجوه الحداثة الشعرية العربية التي دأب نزار نفسه على هجائها، وهذه مفارقة طريفة لا تصلح للاستعمال الصحافي بمقدار ما تصلح للتأمل النقدي العميق”.
يمكن فهم أن نزار شخصية شعرية حادة المزاج، وخطابه النقدي الموازي لشعره أولا -والمندمج به لاحقا- هو صاحب خطاب برقي، انفعالي، انقلابي، من سماته عنف اللهجة. وهو بالتالي خطاب فعّال في قراء غاضبين، وقراء يرغبون في أن يغضبوا، وعلى الأرجح فإن هذا العصب الشعري المشدود وإهابه الانقلابي، والتدفق شبه العفوي لما انتقاه نزار من مفردات يومية سريعة الاشتعال، هو ما ظلّ يحبب إليه الفئات الأوسع من القراء، على رغم خفوت وهج الشعر في نصوصه الأخيرة.
فهل يجوز لي أن أشبهه بضوء يصل إلى الأرض من قصيّ، وهو ضوء نجم خمد منذ زمن؟! ربّما… لكن العرب الذين اختلفت نخبهم المثقفة حول هذا الشاعر ودوره في تحرير الشعر من تعاليه المتوارث، وإضفاء طابع شعبي على القصيدة الحديثة سوف يعتزّون أكثر فأكثر بشاعرية نزار، وسيعيد النقد -مستقبلا- النظر في شعره، والبحث في علاقة قصيدته بالحداثة.
وإذا كانت قصيدة نزار هي القصيدة بالنسبة إلى الفئات الأعرض من القراء العرب، فإن لغته شكلت منهلا لا واعيا لشعراء كثيرين لاحقين عليه، ففي مرحلة من العمر، هي الأخطر بالنسبة إلى تشكل الحواس في علاقات جمالية عبر اللغة لدى الشعراء الناشئة، بدا عسيرا على هؤلاء، خلال العقود الثلاثة الماضية، تجنب إغراء شعر نزار. ولربّما كان أحد أبرز الأبناء الذين أسهم نزار في تربيتهم الشعرية، هو محمود درويش الذي اعترف بذلك غير مرة، وهناك غيره من “الأبناء” الذين يفضلون إنكار هذه “الأبوة” على نزار، أو أقله الصمت عليها.
ولو كان موضوع البحث هو حداثية شعر نزار، فلعل أبرز معالمها تكون جلية في لهجة هذا الشاعر ونبرته، ولغته التي تتوسط “اللغات” الشعرية الحديثة كلها، وتتوسط بعلاقاتها السلسة وتشكيلاتها الرشيقة وجمالياتها الخاصة المنجز الشعري الحديث برمته.
زار هو \'شاعر الرجل\' في تمثلات أنثوية مفترضة، لغة وتعبيرا، لكن هذه التمثلات تبدو أحيانا مبدعة
وهذا لم يتمّ للشاعر دفعة واحدة، فقد حققه على مراحل، ربّما كانت أزهاها تلك التي تقع في قلب عقد الستينات حيث قدّم نزار أرفع نصوصه الشعرية وأكثرها شهرة أيضا. ولربّما كان يكفي هذا الشاعر الذي يحفل القول في شعره بالتناقض، بينما تتماسك صياغاته في علاقات انسجام لا سابق لها في الشعر الحديث، إنه الشاعر العربي الذي أسس عمارة المرأة في الكتابة الشعرية، أي باختصار، وعلى الرغم من كل ما يخالف هذا في القول الشعري لديه، أسس تمثلا رجاليا جديدا لصورة المرأة وصوتها؛ هو درجة وسطى بين صوت الرجل وصوت المرأة على اختلاف هذين الصوتين، وأقام لها هيئة جديدة في الكتابة، وحررت قصيدته القول حول المرأة من غموض، ظل الشعر يفتعله بطريقة دغمائية بائسة وبنبرة عاطفية متهاوية، تجعل من المرأة إبليسا تارة، وقديسة تارات أخرى.
صحيح أن شعر نزار لم يقطع برؤيته الخاصة للمرأة حبل السرة مع الرؤى الاجتماعية السائدة، لكنه في المقابل ملأ المكان الخالي من المرأة في اللغة بأشياء المرأة من دبابيس شعرها، وحتى من أوراق رسائلها، أو دفتر مواعيدها المتخيل. وقيمة ذلك، في نظري، ليس في صدقه الفني دائما، وإنما في حيويته الكبيرة وقدرته على تحقيق الإيهام، أعني أن قيمته تحديدا في صدوره عن لاعب بالكلمات وبنّاء في اللغة، ومجرب في البحث العاطفي لم يعد لديه انشغال آخر سوى المرأة.
صحيح أن نزار هو “شاعر الرجل” في تمثلات أنثوية مفترضة، لغة وتعبيرا، لكن هذه التمثلات تبدو أحيانا مبدعة إلى درجة أن قصيدته أعطت -في حالات معينة ونادرة لكنها عظيمة- صوتا للمرأة وعينين جديدتين، أيضا، لترى بهما العالم.
والآن يخيل إليّ، أننا نحن الشعراء الذين نصف أنفسنا بالحديثين والحداثيين، قرأنا نزار بغرور المراهقين وبانحياز باهظ إلى أنفسنا، فضربت قراءتنا آفة التعالي على قصيدته، التي ما كان لها أن تكون غير ما كانت، حتى يمكنها أن تكون الطبعة الشعبية للحداثة، والجسر الكبير بين القراء العرب والشعر كفكرة متوهجة، دائما وصالحة للاستمرار.
-II-
إذا كانت دمشق قد اشتهرت بالياسمين فإن قصائد نزار قباني حملته إلى كل شبر من الأرض العربية، من دمشق إلى نواكشوط ومن القاهرة إلى زنجبار. ومن لم يقرأ شعره في كتاب سمعه في شريط تسجيل، أو ردده مع المغني عبدالحليم حافظ الذي غنى لنزار، فأشجى العشاق المتألمين، وأضاف ملمحا جديدا إلى صورته مغنيا.
نزار هو الشاعر الوحيد بين العرب الذي ينسخ العشاق قصائده في رسائلهم العاطفية، وما من مراهقة عربية لم تعتقد في يوم ما أن لها في شعر نزار وجها أو يدا أو ضفيرة
ونزار هو الشاعر الوحيد بين العرب الذي ينسخ العشاق قصائده في رسائلهم العاطفية، وما من مراهقة عربية لم تعتقد في يوم ما أن لها في شعر نزار وجها أو يدا أو ضفيرة، وأن بين قصائده واحدة لها، تنطق باسمها، فهي رسالتها إلى من تحب، وما استحقت من مديح نفسها عند نفسها أمام المرآة.
وبين العاشقات الصغيرات في العالم العربي أساطير متداولة همسا، فواحدة تظن أن تلك القصيدة قيلت فيها لكونها تخيّلت أن الشاعر كتب قصيدته بعدما لمحها ذات مرة لمحا في أمسية وكانت هي بين الحضور، وأخرى تظن أن القصيدة نفسها كان يمكن أن تكون عنها لو كان نزار قد رآها بذاتها، إذ ذاك أما كان يمكن أن تكون القصيدة أحلى؟
ولو استوقفت عابرا في الشارع وسألته هل تقرأ الشعر؟ لأجابك:
- أقرأ نزارا
- ومن أيضا؟
- المتنبي
نزار، إذن، هو الاسم الحركي للشعر، والشاعر لدى الناس المعاصرين هو نزار.
لم يختلف العرب كما اختلفوا واتفقوا على نزار قباني وشعره الذي يجمع بين البساطة والعذوبة، وجرأة التعبير، والطرافة والجدة؛ فهو الشاعر الذي أنزل القصيدة عن حصان المتنبي وجعلها تمشي على قدمين في شارع عربي معاصر مزدحم بالسابلة والعربات.
-III-
أيديولوجيتان حاربتا نزار منذ أن أصدر ديوانه الأول “قالت لي السمراء” سنة 1944، وتصدتا لخطابه الشعري الراديكالي في قول الغزل، ولاحقا في القول السياسي -خصوصا بعد كارثة 5 يونيو- لمّا تحوّل نزار إلى كتابة “القصيدة السياسية” العنيفة ذات الطابع الهجائي المقذع أحيانا:
الأيديولوجيا الأولى تمثلها التقليدية المحافظة التي وجدت في عمارة نزار من صور وأفكار ورؤى وقول يدعو المرأة إلى التحرر، والمجتمع إلى تجاوز الماضي والثورة على الحاضر، ضربا من التهديد المباشر للقيم التي تحرسها. والأيديولوجيا الثانية تمثلها “الحداثة البدوية” أحادية الجانب ذات الخطاب الاستعلائي المرضي، والتي لم تستطع استيعاب فكرة أن يكون الشعر شعبيا وحديثا معا، ولكونها أيضا لم تتمكن من حل معضلة أن تنطوي، وتقوم، تجربة شعرية كبيرة كتجربة نزار على عناصر ورؤى متضادة ومتناقضة إلى أقصى حدود التضاد والتناقض، بما يشكله ذلك من تحدّ مربك لشخصيتها البسيطة القائمة على مانوية تبسط العالم إلى ثنائيات متضادة ومتصارعة حتى الموت.
لم يختلف العرب كما اختلفوا واتفقوا على نزار قباني وشعره الذي يجمع بين البساطة والعذوبة، وجرأة التعبير، والطرافة والجدة
من جدل العلاقات الخاصة بتجربته، وجدل الصراع مع هذه الثنائية العدوة “التقليدية- الحداثة” أقام نزار لنفسه مكانة مستقلة لم تستطع أيّ تجربة شعرية عربية أخرى خلال هذا القرن من إقامتها، وتنازعت تجربته المبدعة وخيمت عليها، دائما، تلك المتناقضات الهائلة التي تحوّلت إلى سمة من سمات خطابه الشعري، الذي تدرّج في تقلبه وانقلابيته بين الطبقات الهائلة التي تحوّلت إلى سمة من سمات خطابه الشعري، الذي تدرج كذلك في تقلبه وانقلابيته من الطبقات الأعمق في نصه، حتى سطوحها المتمثلة في عناوين كتبه التي تميزت بالإثارة، وعبّرت عن قدرة لافتة للشاعر على بناء علاقة متينة ومتميزة وحارة مع القارئ، تسمح لنرجسيته، باستمرار، أن تهيمن على هذه العلاقة، ولصورته أن تتيه بملامحها في خيلاء.
ولو كان السؤال من هو شاعر هذا القرن الأكثر شهرة لما كان هذا الشاعر هو الجواهري مثلا، ولما كان بدوي الجبل، ولا عمر أبوريشة، أو سعيد عقل، أو غيرهم من الشعراء الكلاسيكيين الذين كان لهم مجدهم، وإنما نزار، فهو شاعر القرن الأكثر شهرة بين الناس. وهي شهرة استحقها عن قصائده التي بنت لها مكانة بينهم، خاطبتهم في أكثر شؤونهم الروحية والعاطفية تفجّرا. ومهما قيل عن تراجع شعبيته أو تقدمها، فهذا شاعر عاش مجده الشعري على مدار أكثر من نصف قرن.
-IV-
في مطلع الخمسينات عندما كان الوطن العربي يشهد حركات التحرّر الوطني، والجدل الفكري الواسع بين القومية والماركسية، وبينهما وبين الفكر الديني، كتب نزار قصيدته “خبز وحشيش وقمر” وثارت بفعل القصيدة الجريئة ضجة كبرى في الأوساط الثقافية والاجتماعية في دمشق وبيروت والقاهرة. وبينما كان الصراع الأيديولوجي بين الأفكار المختلفة -في جانب منه- صراعا تجريديا، كان نزار ينحت لنفسه أيديولوجيا خاصة، ويضع اللبنات المكينة لخطابه في لغة شعرية بسيطة، حارة، ونضرة، والأهم من كل هذا، مبتكرة، فهي لغة ذات إغراء جمالي وتعبيري غير مسبوق.
خفف نزار من ذكوريته، عبر لعبة التمثل في التعبير، والإيهام الجمالي في القول نيابة عنهن
-V-
من ذلك الفضاء الثالث، أو تلك الأرض الثالثة بنى نزار موقعه الفريد في الشعرية العربية، ومن هنا يمكن فهم عدم استجابة تجربة نزار للنقد بصورته المانوية السائدة التي تقسم العالم وفق أيديولوجيتين تقليدية متزمتة و”حداثية استعلائية”. نزار ذهب نحو منطقة ثالثة، لذلك وقفت له متاريس النقد وهوجم من الجبهتين، ولم يقصر، هو نفسه، عن مهاجمة كلا الجبهتين، بلا كلل، وكان طوال الوقت شرسا في مقاومته، ومتطرفا في سخريته.
أما في الهجاء السياسي فنزار لاعب بأعصاب باردة. ولو كان السؤال: كم يبقى من نزار وشعره في المستقبل؟ فهذا متروك للمستقبل، لكن نزار بكل نرجسيته وسقطاته وتناقضاته وجمالات شعره، وحتى إخفاقات هذا الشعر هو شاعر عصره بلا منازع.
إقرأ أيضا:
يوم مع نزار قباني على ضفاف التيمز قبل رحيله بعام