الثقافة الجزائرية ارتبطت بالأشخاص لا بالمشاريع

يعتبر الشاعر والكاتب محمد زتيلي من أهم الأصوات الأدبية لجيل السبعينات في الجزائر، هذا الجيل الذي يوضع غالبا في دائرة الاتهام من اللاحقين. “العرب” التقت الكاتب في حديث حول مجمل قضايا الثقافة ورؤيته للمشهد الثقافي في الجزائر وغيرها من المواضيع.
لا يخفي الشاعر محمد زتيلي انتماءه لجيل يعرف عادة بجيل السبعينات، وهو جيل يؤخذ عليه الكثير من الزلات، بحيث لم ينجز إبداعا حقيقيا نظرا لارتباطه بالحزب الواحد وهذا يعني الفكر الواحد والرؤية الواحدة والنمط الواحد والإبداع الذي يساير الحكم والسلطة.
إلا أن الشاعر يخالف هذا الرأي، يقول “تاريخيا أنتمي لجيل السبعينات، وهذه التسمية رغم أنها متداولة في كل البلدان العربية وغيرها، فهي ذات مضامين مختلفة في كل بقعة من الجغرافيات المختلفة، ففي الجزائر تكتنز دلالة ذات بعد نضالي وروحي كبيرين، فهو الجيل الذي ظهر بعد أعوام معدودات من الاستقلال عام 1962، وهو الجيل الذي عاش طفولته تحت قصف المدافع وقتل الأبرياء وتهديم القرى والمدن وحرق الغابات بالنابالم، وذكرت ما عشته ورأيته بأم عيني وكذلك جيلي”.
ويضيف “عند الاستقلال حدث أمر مذهل لا يصدق وهو نزوح الملايين من الأطفال والفتيان من المدن والقرى إلى المدارس يدقون الأبواب ويفتحونها طلبا للتعليم. لهذا وعندما وصل هذا الجيل إلى المرحلة المتوسطة صار يتطلع للكتابة مثل جبران والمنفلوطي وطه حسين ورضا حوحو ومحمد العيد ومفدي زكريا وأبي القاسم خمار وسعدالله وغيرهم”.
ما بين جيلين
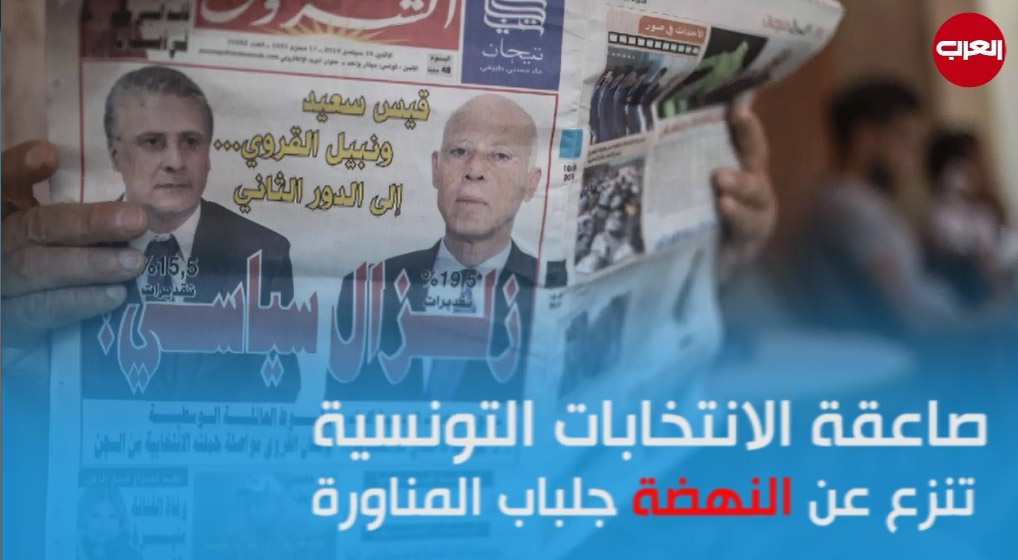
يستطرد محمد زتيلي قائلا “مثل هذا الجيل الذي سرعان ما تشكل كقوة ثقافية إبداعية نضالية كان مدفوعا بروح قوية هي روح ثورة نوفمبر التي حررته وحررت البلد وشعر أنّ من مسؤوليته استكمال التحرير بالتحرر الثقافي، وهذه المعاني ليست إسقاطا حاليا مني على مرحلة مر عليها الآن نصف قرن، بل تكفي العودة إلى تصريحات هذا الجيل، وأنا واحد منهم، لنعرف أن الوعي كان حاضرا منذ سنوات الميلاد الأولى. هذا مع العلم أن هناك جيل آخر كان ينتمي لنفس الفترة ولكنه جاء في ظروف مغايرة مشحونا بأفكار دخيلة مهدت لتيارات محمولة خصيصا لضرب التقدم والحداثة والحرية باسم الأصالة والانتماء للإسلام“.
وعن المباشرة والشعاراتية وغيرها من التهم التي وجهت إلى هذا الجيل فيرى أنها “أسقطت بفضل إنتاجاتنا وأشعارنا، في حين سقطوا هم فيما كانوا يتهمون به جيل التأسيس، فلم تنفعهم أشعار الثورة الخضراء من إيران، ولا أشعار الوئام المدني المسايرة للمرحلة البوتفليقية”، ويؤكد على أنهم أصبحوا “في مرمى الاتهام بعدما ألصقوا بنا مقولة جيل الثورة الزراعية والاشتراكية، وطبلوا لقضايا سياسية محضة”.
تميزت فترة السبعينات بوفرة الإمكانيات والوسائل والفرص وغيرها، وقد عاب النقاد على كتاب تلك المرحلة بأنهم لم ينتجوا نصوصا قوية أو حركة ثقافية مستمرة، إلا في ما ندر، وتعد على الأصابع، وفي تحليله لهذا الوضع، يقول زتيلي “عندما أسمع كلاما كهذا أجد نفسي محتارا هل أضحك أم أبكي؟ هذا إحساسي عندما أفكر طبعا في مجال النشر إذ لم تكن هناك سوى مؤسسة عمومية واحدة هي المؤسسة الوطنية للكتاب التي يشرف عليها أناس لا يعطون للكتاب الإبداعي إلا مساحة ضيقة جدا من الأهمية، فضلا عن البطء الممل وخاصة خضوعها للرقابة”.
يتابع الشاعر “وفي المرحلة الأخيرة تحالفت الإدارة مع التيارات المعادية للشعر والقصة والرواية، فهيّمن الكتاب الديني والتاريخي لأشخاص فرضت أسماؤهم وكرست، لكن وفي مجال الملتقيات والمهرجانات فإن الدولة كانت تطلق يدها تحت رقابة الحزب الواحد. أما النشر الخاص فكانت دوره تعد على أصابع اليد الواحدة تتعامل مع الكتاب الفرنسي بدعم من فرنسا، وتوجد دار واحدة بالعربية تخصص صاحبها رحمه الله في نشر سلسلة كراسات إسلامية، ولم ينشر ديوانا شعريا واحدا ولا قصة ولا رواية، مقابل المئات من الكتيبات حول أهوال يوم القيامة وعذاب القبر وشروط النكاح والزوجة الصالحة”.
أما القول إنه ورغم تلك الإمكانيات فلم تظهر أعمال أدبية كبيرة، فيعتقد زتيلي أن “انعدام الإمكانيات في تلك الفترة، ورغم الإمكانيات الضخمة، وإن كانت فوضوية، والتي توفرت في التسعينات من خلال الدعم الكبير للنشر الذي دفع بظهور مئات من دور النشر من أجل الاستفادة من الريع، رغم هذا فإن الأعمال الأدبية الكبيرة التي ظلت تحتل الريادة هي أعمال جيل السبعينات. مع ملاحظة هامة جدا وهي أن هذا الجيل لا يتعامل مع من جاء بعدهم بمنطق الصراع والرفض، بل العكس هو الصحيح، فمفهومنا للكتابة أنها لا تقاس بالكيلومتر ولا بالعشريات ولكن بالمستوى وبالإبداعية والإضافة سواء تحقق هذا من إبداع جيل السبعينات أو جيل الألفين”.
تجارب متباينة

للشاعر زتيلي تجربة مميزة في الكتابة للطفل فقد خاضها منذ ثلاثين سنة حيث يقول “كتبت ونشرت قصة للأطفال بعنوان ‘الضفدعة والمطر’ صدرت في شكل جميل برسوم وخط الأستاذ علي حكار، تلتها قصص أخرى نشرتها في الصحف والملاحق”، ومع ذلك فهو يرى أن “الكتابة للأطفال بمختلف فئاتهم العمرية صعبة لكون النشر غير المدعم من وزارة الثقافة غير موجود تقريبا في الجزائر، ماعدا قلة من دور النشر تستثمر وتغامر بنوع من الاحترافية مع أسماء معينة في مجال الرواية، أما هذا العدد الهائل الذي يعد بالمئات من كتاب وكتبة الرواية من الشباب الذي تتراوح أعمارهم بين العقد الثاني والثالث فإن دور النشر تبتزهم ماليا فتحقق هي الربح المادي ويحقق صاحب الرواية حلما راوده ليصير كاتبا روائيا”.
ويضيف “معظم هؤلاء يبرم صفقات نشر مع دور نشر مصرية وأردنية ويدفعون ثمن نشر رواياتهم بأعداد قليلة جدا ليلعبوا اللعبة الإعلامية بالقول صدرت روايتي في عمان أو القاهرة أو عاصمة عربية أخرى لإيهام الرأي العام بأن النشر تم للأهمية الأدبية، وكذلك مسألة التكريمات ‘ورقة’ تسلم له في جلسة ضيقة في تلك العواصم يسافر لأجلها ويلتقط صورا للقول إن القاهرة كرمت الأديبة فلانة بنت فلان، رغم أن كل تكاليف نشر العشرات من النسخ والطائرة والإقامة مدفوعة من الطرف الجزائري“.
في رأي الشاعر زتيلي فقد عرفت الجزائر منذ الاستقلال تجارب متباينة في الممارسة الثقافية، تباينت قوة وضعفا، وارتبطت بالأشخاص والمراحل ولم ترتبط ببرنامج أو مشروع ينفذ كيفما كانت طبيعة وتقلبات تلك المراحل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وكيفما كانت قناعات الحكومات والوزراء المتعاقبين على قطاع الثقافة.
يضيف الشاعر “الحديث عن الثقافة في الجزائر يتم من خلال شخصنتها في تصرفات الوزير الذي يتولى مهمتها طالت هذه المهمة أو قصرت. فقد ألغيت وزارة الثقافة في وقت رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش وعوضت بمجلس أعلى للثقافة، دون أن تكون هناك رؤية لتسيير القطاع، فكانت النتيجة أن ظل المجلس الذي وضع على رأسه الروائي عبدالحميد بن هدوقة هيكلا بلا روح، وضاع قطاع الثقافة بموظفيه ومرافقه لصالح قطاعات عديدة كانت لها أثارها السلبية عليه، ولم تعد وزارة الثقافة للظهور من جديد إلا بعد خمسة أعوام”.
مع كل هذه الحركية والاختلاف في تسيير قطاع الثقافة إلا أن الفاعلية الثقافية في الجزائر، كما يؤكد زتيلي “ضعيفة، والسبب يعود إلى عدم إشراك المثقفين في مختلف القطاعات ذات الصلة، وهيمنة بنسبة واسعة من العناصر الدخيلة والمعادية للثقافة وللمثقف من القاعدة إلى القمة، كما أن المثقفين في الجزائر متقوقعون على أنفسهم إلا من رحم ربك، لكون الجدران عالية بينهم وبين المؤسسات الرسمية من جهة، وبينهم وبين مجتمعهم من جهة أخرى. وكل محاولات القفز عليها آلت إلى السقوط”.
فالثقافة، كما يؤكد الشاعر، يصنعها المثقفون، وهؤلاء مشتتون، وتكوينهم النضالي هش، ولهم تصورات طوباوية حول العمل الثقافي وحول مفهوم الدولة والسلطة، وخاصة حول نظرة السلطة لدورهم الذي يتوهمون أنها واعية بأهميته.
ويتابع “هذا ما جعل الجزائر غائبة ومغيبة عن التأثر والتأثير في الحوار الثقافي العربي، أضف إلى ذلك كتبت مرات عديدة أن الحوار الثقافي بين المشرق والمغرب يمر فوق سماء الجزائر ولا تشارك فيه، وفي هذه المسألة لا يجب قبول مبرر الهيمنة الفرانكفونية لأنها ليست ظاهرة جزائرية محضة، ولأنها عنصر إثراء فيما لو كان العقل المؤسساتي يشتغل بوعي وهدف”.
ونذكر أن محمد زتيلي شاعر وروائي وكاتب من مواليد جوان 1952 بلدية العنصر بولاية قسنطينة. حاصل على شهادة البكالوريا. تابع دراساته العليا بالمعهد العالي للتخطيط بسوريا.
أصدر المجموعات الشعرية التالية: “نهيار مملكة الحوت”، “ومضات الحزن والذهول”، “ظلال المراثي”، “لست حزينا لرحيل الأفعى”.




























