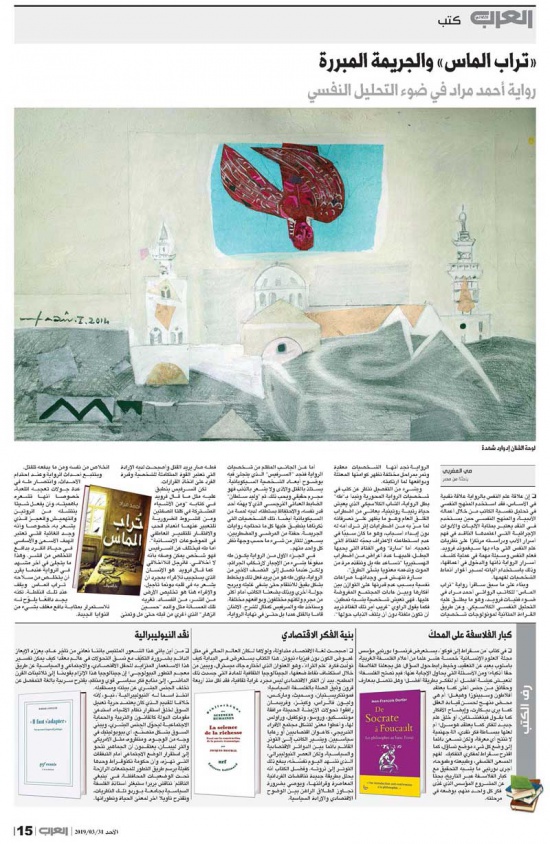الترجمة النسوية.. جسر المرأة العربية نحو تفعيل حقوقها الأساسية

يسعى فريق من المترجمات العربيات إلى تسليط الضوء على بعض قضايا المرأة العربية الدقيقة، والتوعية بحقوق السيدات عبر تدشين رابطة تجمع عددا من المترجمات هدفهن نقل وترجمة الأعمال الغربية إلى العربية برؤية نسوية، حيث باتت الترجمة في هذا المجال مطلبا حيويا لسدّ الفجوة بين ما تحتاجه المرأة من حقوق، وبين ما يجب أن يضاف إليها من واجبات.
القاهرة - تقول الفيلسوفة الفرنسية الشهيرة سيمون دي بوفوار “نحن لا نولد نساء، بل نصبح كذلك”. بتلك الكلمات ترسّخت حقب متعددة من البحث عن هوية المرأة وحقوقها والترويج لأهمية الحصول عليها.
وبعد حراك عالمي واسع، بات من الصعب أن يختلف الكثير حول دور المرأة وأهميته في المجالات الثقافية والمجتمعية دون تمييز. لكن ظل العالم العربي بعيدا عن الفهم الكامل لقضايا السيدات ورؤيتهن في تقرير مصيرهن.
ورغم ما تحاول أن تقدّمه بعض الدول، مؤخرا، وعلى رأسها السعودية والإمارات، من مساع لتعزيز المكانة النسوية، تبقى النظرة المترسّخة في النفوس حول مكانة المرأة قاصرة تقريبا على المربية المقيمة في المنزل والتي لا تناسبها الكثير من الأشياء، ولا ترتقي لممارسة الكثير من الأفعال، وبقيت تلك الصورة قابعة في عقول الكثير من المواطنين، رجالا ونساء.
ودفع التأخر العربي في فهم تكوين المرأة ومكانتها المتغيّرة في المجتمع العالمي، إلى المطالبة بتعزيز أدوات تساعد على الفهم الأمثل للحقوق النسوية التي باتت تملأ العالم ضجيجا. ومن تلك الأدوات وأكثرها فاعلية انتقال الثقافة النسوية برؤيتها العالمية، ومحتوياتها من أدب وفكر وعلوم، إلى العقل العربي، وهو ما عرف مؤخرا بعلم “الترجمة النسوية”.
وأعاد الإعلان عن تدشين رابطة تجمع مترجمات عربيات من مصر وسوريا والعراق والإمارات والمغرب في 9 مارس الماضي، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، التساؤل حول غياب دور الترجمة باعتبارها جسر انتقال الفكر التنويري في دعم حقوق المرأة العربية.
ووصفت هالة كميل، أستاذة الأدب بجامعة القاهرة، وهي إحدى المشاركات في تأسيس الرابطة الفكرة بأنها “محاولة لتطويع الأدب والفكر في خدمة قضايا المرأة وحقوقها المهدرة في العالم العربي”.
وقالت كميل لـ”العرب” إن المجتمعات العربية مازالت متأخرة في إعطاء المرأة حقوقها في كافة المجالات، وإحداث تغيّر نوعي في النظرة إلى المرأة يحتاج إلى نقل التجربة الغربية الأدبية في تناول المرأة، ولذلك ركّزت أعمالها الأخيرة حول فكرة الترجمة بصبغة نسوية كوسيلة للدفاع عن حقوق السيدات.
مترجمات من مصر وسوريا والعراق والإمارات والمغرب يعملن على تعزيز مراجع الباحثين بالمصطلحات النسوية من أجل صنع نخبة تؤمن بمكانة المرأة
وترى أن المرأة مظلومة على مستوى اللغة العربية أو اللغات الرائجة والمستخدمة في الترجمة عموما، وهي تحابي الرجل على حساب المرأة، وأبرز تلك القواعد، المذكر يُجبّ المؤنث، وعلى مستوى تناولها الأدبي بالتركيز على الصفات الجسمانية باعتبار المرأة جسدا بلا عقل.
وأضافت أن الترجمة أداة قوة للتأثير على المجتمع وتعزيز حرية المرأة وتقديمها للعالم، وأن فكرتها بدأت بترجمة الأعمال حول التاريخ الإسلامي والعربي من وجهة نظر نسائية.
وبدأ مصطلح الترجمة النسوية، أي التي لها طابع خاص وتهتم بالمرأة في أوائل القرن الماضي، بعد أن اعتمدت عليه الحركات النسائية التحررية في الولايات المتحدة وبريطانيا كطريق للترويج للمرأة وقيمتها في المجتمع.
مرتكزات نسوية
يعدّ ذلك الطابع من الترجمة أهم مرتكزات الفكر النسوي، في ما يتعلق بتطوّره وتقاطعه مع كثير من التخصصات والتشابك مع الدراسات الأدبية، وكلها معرفة ليست متوافرة بعد بالقدر الكافي في المكتبة العربية، ما يُسهّل الهجوم الدائم على الفكر النسوي، ويحجب المغزى من توظيفه في قراءة الأدب.
وأشارت كميل إلى أن الباحثين العرب واجهوا أزمة كبيرة في تقديم أبحاث عن المرأة وحقوقها، بسبب غياب الأعمال البحثية عن المرأة ودورها، وتشكّل أعمال الترجمة أهمية قصوى لكثير من الأبحاث في المستقبل للاعتماد على تلك الترجمات كمراجع علمية موثقة.
ويقدّم مفهوم الترجمة النسوية أحيانا باعتباره منهجية بحثية داخل علوم الترجمة، لأن العلوم اللغوية ليست مجرد إلمام بلغة أخرى أو إتقان لمفرداتها، لكنها قدرة على استيعاب العمل المترجم ونقل أهدافه للآخرين. وتعتبر تلك الأزمة من بين التحديات التي واجهت المترجمات عند إضفاء لمسة أنثوية على أعمالهن، لأن كل مترجم يجب أن يحمل طابعا وإدراكا واسعا بالقضايا النسوية.
ووضعت الرابطة في بيان تأسيسها مجموعة من الشروط حول تحويل النص النسوي إلى اللغة العربية، منها الإلمام بلغتين لا يكفي لترجمة النص، فالأساس في الترجمة الإلمام بمعنى المصطلحات وفهم الفكر النسوي من ناحية تطوّره والفلسفة المعرفية، كي يمكن في النهاية نحت مصطلحات عربية جديدة تعبّر عن المعنى في النص الأصلي.
ويرتكز الشرط الثاني على ضرورة الوعي بكون الترجمة جزءا من عمل وليس العمل كله، وهو ما يتطلّب الفهم الكامل للقضية وأبعادها.
ويبقى الشرط الثالث في فكرة تبنّي قضية أثناء الترجمة، وهنا تكمُن القضية في الدفاع عن المرأة والتوعية بحقوقها.
وكشف بحث بعنوان “صورة المرأة من منظور الكتابة”، صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، النقاب عن تلك الصورة التي رُسمت للمرأة على مستوى الكتابات العربية.

وأكّد البحث أن الخطاب المنتج حول المرأة في مجمله “طائفي ويضعها دائما في مقارنة مع الرجل”، وحدّد معالم الاضطهاد في ثلاثة أشكال من الاضطهاد النوعي، أولا تفوّق الرجل وسيادته على المرأة، وثانيا اضطهاد أبوي ذكوري، وثالثا الاضطهاد المجتمعي والقانوني.
وذهب البحث إلى تحليل كافة الأدبيات التي تناولت خطاب المرأة في المعاجم والآداب العامة، مثل أدب الأطفال والرواية والقصة القصيرة وحتى الفن التشكيلي الذي اختزل المرأة في الجسد، مشددا على أن الترجمة فشلت أيضا في تحقيق العدالة المنتظرة للمرأة، لأن نقل الأعمال الأدبية لم يكن منصفا للنسوية، ولم يجد من ينتقده.
وأوضحت رشا خليل، وهي ناشطة سورية في حقوق المرأة، أن مشكلة المرأة العربية في نشأتها وتربيتها وفقا لتاريخ ذكوري مزيّف يحتكر المعرفة وتشكيل العقول وفقا لأيديولوجية سلطوية بحتة، وبالتالي خلق وعي مضلّل يضمن استمرار الهيمنة وفرض تصوّر بأن السيدة لها ظروفها الخاصة التي تمنعها من اعتلاء المناصب أو تأدية الكثير من المهام.
مقاومة سلمية
قالت خليل لـ“العرب” إن النسوية لم تأت فقط لتقدم معرفة جديدة عن وضعية النساء، لكن أيضا لمناصرة حقوق أغلب الفئات المضطهدة من سلطة الفئات المهيمنة.
وتظهر النسوية، في تعريفها كصورة أكثر توسعا من الدفاع عن حق المرأة السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتبدو أقرب لحركة مقاومة عالمية لحماية حقوق الإنسان، وتهتم بقضايا الأقليات عموما، رغم بعدها المرتبط بالمرأة، لكونها تخضع لنفس البنية الأبوية والنظام الذي يضطهدها.
وتشترك الفئات المضطهدة مع النسوية في الخضوع لنفس المنظومة، وتهدف النسوية إلى عدم تعريض الأفراد، رجالا ونساء، بطبقاتهم وأعراقهم، للاضطهاد والوصاية.
وأشارت خليل إلى أن الجميع يحتاج لأن يكونوا نسويات، كي يتمكّنوا من الإبصار بكل الاضطهاد والظلم، والنظر إلى جذوره وكيف يعمل ويسيطر على حياة الجنسين بمختلف الطبقات والأعراق، فيجعلهم في صراع نفسي واجتماعي يولد واقعا من البؤس والتمييز، تعيش تحت وطأته النساء والرجال بدرجات متفاوتة.
وعلى مدار أكثر من نصف قرن حاولت أوروبا والولايات المتحدة، تقديم دعم بحثي علمي شامل لفهم أسباب التفرقة بين الرجل والمرأة على مرّ التاريخ، وبات أمام القارئ العالمي مكتبة عامرة بدراسات نسوية عميقة تقدّم الكثير من التصوّرات الفكرية والفلسفية، التي تسعى إلى فهم جذور وأسباب التفرقة لتساهم في تحسين أوضاع المرأة وزيادة فرصها بجميع المجالات.
وظلت تلك الدراسات غائبة عن المكتبات ومراكز الأبحاث العربية، ومن الصعب إيجاد فهم دقيق في البلدان العربية لتصوّرات ونظريات ترتبط بالمرأة، واقتصر الأمر على مساع متفرقة لم ترتق لحقائق أو إحصاءات تكشف ما تعيشه المرأة العربية.

وكانت النسوية توليفة من النظريات السياسية والفكرية التي تهدف إلى نقد وتفكيك وتحليل البنيان الاضطهادي للمرأة في تجليّاتها السياسية والدينية والاقتصادية والثقافية، والترجمة النسوية هي البوصلة الموجّهة لذلك.
وهنا لا تمثّل الترجمة النسوية مجرّد منظور أدبي أو فكرة ثقافية، لأن لها تداعيات أكثر رحابة وتمس القضية الأم، وهي حقّ السيدات في العدل والمساواة.
وفي كثير من المجتمعات العربية لا يعلم الرجال ولا النساء شيئا عن تلك العدالة المفقودة، ولا يبحثون عنها لأنهم يجهلونها أصلا، وإذا كانت الترجمة جسر التناقل والتواصل بين الشعوب، فهي أيضا ذلك الممرّ الضيق إلى عوالم نسوية تغيّر مفهوم العرب نحو المرأة بشكل عام وتعلّم السيدات العربيات حقوقهن في حياة كريمة.
ويحتاج الرجال معرفة مقدار تلك الحقوق وقيمتها للوصول إلى معدل مرتفع من النموّ في بلدانهم العربية، وعلى السيدات إدراك أنهنّ حماة المجتمع كله، كأم مربية، وزوجة محتوية، وابنة رؤوفة، وعضو مجتمعي فعّال في البناء والتنمية.
كشفت سوسن رافع، مترجمة متخصّصة في الإسبانية والإنكليزية، أن اللغة العربية بمرادفاتها أبرز دليل على التميّز العربي الفاحش ضد المرأة، وهناك بعض الكلمات التي يصعب ترجمتها من الإنكليزية إلى العربية، بسبب ارتباطها بالمجال الحقوقي للمرأة، وهي مصطلحات جديدة على المجتمعات العربية ولم يعرفوها من قبل.
الجنوسة والجندر
شرحت رافع ذلك لـ”العرب”، قائلة “إحدى تلك الكلمات هي جندر (gender) وتعني بالعربية في المعاجم اللغوية النوع البيولوجي للإنسان، لكن على مدار العقود الماضية اتسع المعنى في المجتمعات الغربية وأصبح يشمل معاني أعمق، مثل البنية الاجتماعية والفكرية أو النوع الاجتماعي”.
وقدّم باحثون حقوقيون، مثل لويس فان بلوتو، وهو يعدّ أول من اهتم بالترجمة النسوية، مصطلحات أشمل تجعل من اللغة إنصافا للمرأة، فالـ”جندر” هو بنية اجتماعية من الأفكار التي تعرف الأدوار ونظم الاعتقاد والصور والقيم والتوقّعات للرجل والمرأة.
وقالت رافع إن الجنس يشير إلى الاختلافات البيولوجية الطبيعية بين الرجل والمرأة، بينما الجندر مبني على أساس المثل الثقافية والنظم الاعتقادية والصور والتوقّعات حول الذكورة والأنوثة في المجتمع، ولذلك قرر فريق المترجمين تعريب الكلمة ليصبح لفظ جندر أو الجنوسة على وزن ذكورة كلمة عربية تعرّف البعد الثقافي للمرأة في اللغة العربية.
ويظهر في الأدب العربي كيف نعيش في نظام اجتماعي منظم جندريّا، وإن كان يَبسط هيمنته وعنفه على النساء بشكل كبير، ومن خلال التنشئة الاجتماعية والسياسية التفاضلية يهيئ الرجال للعب أدوار السلطة، وربط الرجولة بقيم وتوقّعات أقرب إلى المثالية، تتمخّض عنها سطوة على الرجال أنفسهم، أو بتعبير سيمون دي بوفوار، “يعيشون رهابها باستمرار، مما يولد سلوكيات العنف والقسوة”.
وتبقى المشكلة مرهونة بأن المترجمات أنفسهن يتعرضن لعنصرية أدبية وفنية تجعلهن لا يحصلن على الفرصة ذاتها في النشر أو الإبداع، مثلما يحصل عليها الرجال.
وهنا ترى الكثير من المترجمات أن تحقيق ثورة ثقافية في عالم أدب المرأة وانتقاله إلى عقول النخبة العربية، ومن بعدها العامة، أمر يحتاج إلى عمل متواز ومشترك بين الرجل والمرأة حتى تأخذ الترجمة النسوية حقها.