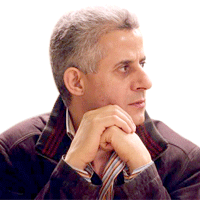الاستشراق المصري يجني على الدراما

أيّا كان الحصاد الهزيل لموسم الدراما الرمضانية المصرية (2019)، فإنه جرس يحذّر من خطورة الفهلوة، وينذر بانتهاء صناعة ثقيلة نهضت على أسماء راسخة في الكتابة والإخراج قبل التمثيل، وهي تنحدر على أيدي مستشرقين مصريين يقدمون أعمالا يمكن قبولها من خواجة لا يرى أعمق من السطح، ويكتفي بالتعرف على مصر من خلال الأفلام والمسلسلات، بعين زجاجية سياحية تتعجل إنتاج 30 حلقة تلفزيونية، لتعبئة الوقت، وبيع المياه في حارة السقائين.
وتظل دراما الصعيد والريف معيارا للحكم على صدق المعرفة وأصالة الموهبة لصناع الدراما وخاصة كتاب السيناريو، ولكن المستشرقين يستخفّون بالجمهور، وهو أكثر وعيا منهم، ولن يصدّق أن فلاحة تغطي رأسها، عام 1992، بمنديل زهري مطرز بورد الجناين، وترتدي ثيابا اختفت من القرى، ولا وجود لها إلا في مسلسل “حدوتة مُرّة”. وفي غيره من المسلسلات التي توجد فيها أيضا وجوه مختلفة لهذا الاستشراق.
لا تمنح مصر سرّها بيسر لأي عابر، مصري أو غير مصري، ما لم تطمئن إليه، وتثق في أن أسرار العلاقة ليست للاستثمار، وإنما للمعرفة والمعايشة والحب الحقيقي، ثم يأتي الإبداع لصوْغ المعرفة في دراما غير مصطنعة. وكل الأعمال الأصيلة عن الريف المصري ثمرة لهذه المعرفة والمعايشة والحب، وأنجزها أسطوات تركوا ذكرى أطول من أعمارهم: محفوظ عبدالرحمن في أجزاء مسلسل “بوابة الحلواني” وجانب من مسلسل “أم كلثوم”، وأسامة أنور عكاشة في مسلسل “المصراوية” بجزأيه. ومعهما دراما ريفية كتبها بشير الديك ووحيد حامد؛ فهؤلاء الكتاب لم يهبطوا على الريف بمظلة من أجل تربّح نفعي اسمه الدراما، وإنما هم أبناء خبرة ومعرفة ومعايشة، هم من أهل البيت. ثم ابتليت الدراما باصطناع مسلسلات ربما لم يرَ كتابها الريف إلا في مسلسلات ليعيدوا إنتاجها في نسخ غير منقّحة.
البعض من الأصدقاء العرب يجاملوننا بنطق كل قافٍ همزة. هكذا يرون سطحا يخفي فروقا وتفاصيل واستثناءات، ففي مصر نحتفظ بالقاف في كلمات كثيرة: القرآن، الموسيقى، القاهرة، القواقع، القادسية، القيروان، القارئ، قسنطينة، قرطبة، قريش، القرية، قزوين، القسطنطينية، القربان، القروح، القرائن، اللقاء، القروض. ولا يوجد الآن في مصر كلها رجل واحد يقول في الحوار مع أي مخلوق “يا خرابي”، وقد كتبها قبل سنوات صديق عربي في عمل أدبي، وأرسل إليّ المخطوط، فنبهته إلى أنه يكتب عن مصر من مشاهداته لأفلام ومسلسلات يقلد بعضها بعضا، وليس أسوأ من تقليد نسخة مقلدة، ودائما يخفي الإبداع كتلة كبيرة صامتة وغاطسة من ثقافة عميقة لا يطفو منها إلا الأكثر خفة، فيراه المستشرق -ولو كان مصريا- ويفرح به.
ليس في مصر صعيدي يقول “أبّاي، أمّاي” إلا في الدراما المستنسخة. ولا يوجد فلاح يتكلم باللهجة الدرامية الممطوطة المائعة، ولا ترتدي فلاحة مصرية الآن ملابس مستنسخة من فيلم “زينب” في نسخته الصامتة، عام 1930. وربما تكون أفلام مثل “الأرض” و”الزوجة الثانية” و”الحرام” أصدق تعبيرا عن الفلاحين؛ حوارا وعلاقات وأزياء وأداء تمثيليا. وبحكم التطور وتأثير وسائل الإعلام حتى قبل الإنترنت، لم يعد الحجاب الشعبي العملي يفرّق بين من تقيم في القرية، أو من تعيش في حيّ شعبي بالقاهرة، ولكن المسلسلات التي تُصنع من مسلسلات تصرّ على استنساخ جلابيب فيلم “زينب”، متجاهلة أكثر من مئة عام قد مرت على زمن أحداثه.

هناك أطعمة أو قهوة تعدّ على مهل، بمحبة وبمقادير محسوبة بدقة، ويشعر الإنسان أنها أعدّت له وحده، على العكس من أطعمة في الفنادق، جاهزة لأي أحد، ذات مذاق موحّد ينتقل من مطعم إلى آخر في سلسلة الفنادق عبر العالم، وكذلك قهوة يصنعها النزيل بنفسه، في المطعم أو في غرفته، أو تقدم إليه في الاستراحة، وتخلو من الخصوصية.
من وسائل الحياة الطويلة للعمل الفني صدق الأداء، هذا الطهي المتمهل لكل مشهد، واستيعاب كل كلمة لكي تخرج من القلب، وتدل على المعنى ملامح الجسد كله قبل الوجه. في فيلم “الأرض” ربما لا تتذكر الشيخ حسونة المثقف الفاسد والمتواطئ مع السلطة (يحيى شاهين)، ومساحة دوره لا تقل عن مساحة دور محمد أبوسويلم (محمود المليجي) الذي يترك بصمة بعد كل مشهد، في كلامه أو صمته الجميل.
في استدعاء الأداء يدهشني روبرت دي نيرو في فيلم “كايب فير” (Cape Fear) لمارتن سكورسيزي. الذي يتحدث عن مجرم مضطرب نفسيا ينتمي إلى الجنوب الأميركي يحاول الانتقام من محاميه الخائن. استعد دي نيرو للفيلم بكيفية الشعور بكلمات الحوار، وكيف تنطق وبأي مشاعر. ولم يجرب هذا في جلسة عمل مغلقة (بروفة قراءة)، وإنما بالذهاب إلى الجنوب حيث تجري الأحداث، واختبر جمل الحوار مع السكان، ووثق طريقة نطقهم للكلمات، مع استعدادات أخرى فيها قسوة بدنية؛ لكي تتماهى ملامحه الجسدية مع سمات الخارجين على القانون، وسبق أن جرّب مثل هذا الاستعداد النفسي والجسدي في فيلم “الثور الهائج”.
لا نشعر بهذا الاستشراق المصري مع مخرجين عرب أثروا الدراما المصرية بأعمال راسخة في الذاكرة، مثل السوري حاتم علي في مسلسل “الملك فاروق”، والتونسي شوقي الماجري في مسلسل “أسمهان”، قبل بدء تآكل ذاتي لا يجهدك في العثور على جمل حوارية تنتقل من عمل درامي إلى آخر “اللي بيحب بيسامح، عُمر الفلوس ما تصنع بني آدم، حاسس باللي أنا حاسس بيه؟”، فضلا عن مونولوجات عالية النبرة، مستعارة من المسرح، ويغني عنها موقف غني بالمشاعر، أو الحوار المعدّ على مهل لهذه الشخصية وحدها، في هذا العمل وحده، ولا يشبه غيره.
في الفن لا يذهب التعب سدى، ولا جمال ينسى. وفي كتاب إنجا كاريتنيكوفا “كيف تتم كتابة السيناريو” تنويه بأن “الإيجاز الضروري يرفع بدوره الصياغة التعبيرية للغة المستخدمة في الفيلم… وليس من باب المصادفة أن بعض جمل الحوار السينمائي قد تسللت إلى كلامنا اليومي وكأنها حكم وأمثال”، وباختبار ذلك على فيلم “الأرض”، فلن نتذكر جملة للشيخ حسونة، وإنما نتأسى كثيرا على محمد أبوسويلم، لما “كنا رجالة ووقفنا وقفة رجالة”.