الإنسان العربي أسير ثقافة قبل علمية
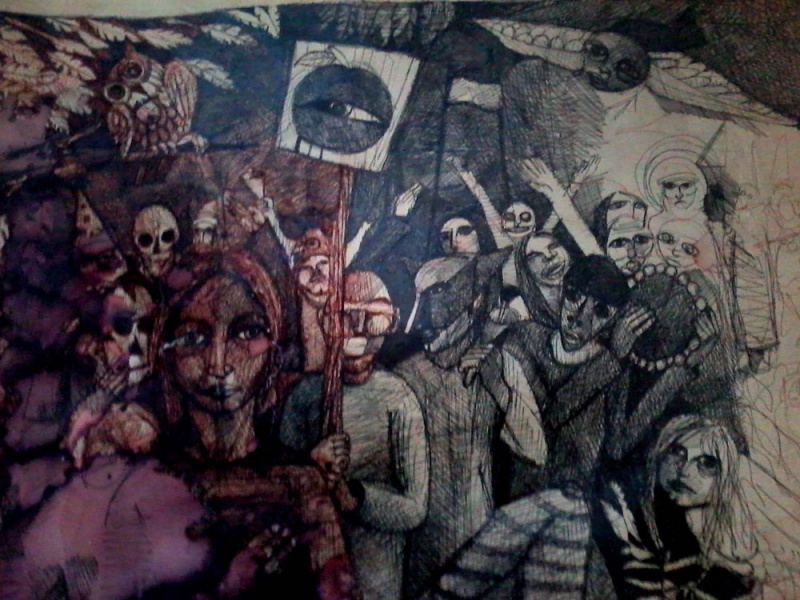
الشعوب العربية في حالة سكون منذ القرن الخامس عشر، وبات السؤال الحضاري أمرا ملحا: لماذا اختفى الدور العربي في بناء الحضارة الحديثة؟ ولماذا اغترب الخوارزمي والبيروني وابن خلدون في موطنهم، بينما احتفت بهم واستفادت من إنتاجهم المعرفي مجتمعات أخرى؟ أسئلة يناقشها بدقة المفكر والمترجم شوقي جلال في كتاب جديد.
يناقش المفكر والمترجم شوقي جلال في كتابه “الفكر العربي وسوسيولوجيا الفشل” أزمة الفكر العربي باعتباره أحد أهم المنتجات الحضارية والاجتماعية، ويسلط الضوء على معوقات تحرره، كالنظر إلى التراث باعتباره الموروث الثقافي المقدس، والفهم المغلوط للهوية الإسلامية باعتبارها كينونة متجانسة، بدلا من الوعي بالصيرورة التاريخية بكل تفاعلاتها وتناقضاتها، وإخفاق الخطاب اليساري نتيجة استخدامه الآليات القديمة.
كما يسلط الضوء على سمات كل من المجتمعات الزراعية والصناعية، وأثر ذلك على الفكر، مؤكدا على ضرورة عقلانية الفكر، وتفكيك طرق التفكير التقليدية، وأن يكون نسقا مفتوحا يؤمن بأن جميع الحقائق قابلة للنقد والتفنيد، ومستوعبا نظريات الفكر الإنساني وتياراته.
وعي زائف

يشدد جلال في كتابه، الصادر عن مؤسسة هنداوي، على أن الفكر هو الفاعلية الجدلية بين الذات (الإنسان/ المجتمع) والموضوع في تشابك لا انفصام بينهما، حيث لا فكر بدون مجتمع في التاريخ، ذلك أن الإنسان لا يفكر إلا في المجتمع. وفكر المجتمع حصاد تاريخية الفعل أو النشاط الاجتماعي. وهكذا يكون الواقع الموضوعي متحدا مع النشاط الإنساني الاجتماعي، ويشكلان معا كلا واحدا لاحتمالات حركة لا حصر لها. وهذا النشاط، بحكم كونه كذلك، هو نشاط معرفي يتكامل الإنسان/ المجتمع من خلاله مع العالم.
يقول “هكذا يكون الفعل والفكر المجتمعيان سدى ولحمة الوعي التاريخي الجمعي، وأساس الانتماء والتلاحم على الصعيد الاجتماعي والصياغة المشتركة لصورة المجتمع بين أبنائه في حركته المستقبلية، ذلك أن الفعل والفكر هما المشروع الوجودي الجمعي، فمثلما لا يوجد فكر دون مجتمع، كذلك الفعل، إن فكر الأمة ليس حاصل تراكم فكر أفراد، وكذلك نشاط الأمة. الفعل الإنتاجي هو فعل جمعي في تناسق، وهو مناط ومجلى التفاعل الاجتماعي الذي هو علة ترسيخ الروح الاجتماعية وأساس التضامن الجمعي”.
ويتابع “من ثم فإن فكر الأمة هو حاصل فعل أو نشاط مجتمعي إنتاجي مترابط في التاريخ والواقع الراهن مستشرفا المستقبل. ويتعطل فكر الأمة حين تتعطل هذه العناصر؛ أي حين يتعطل الفعل المجتمعي الإنتاجي المطرد. ويعيش أفراد المجتمع أسرى وعي زائف وواقع يغلب عليه طابع النمطية والتكرار العشوائي الذي لا يلد جديدا. وهذا وضع أدنى في سلك التطور الارتقائي وأقرب إلى المستوى الحيواني؛ إذ إن أهم ما يميز الإنسان أن الإنسان/ المجتمع ينتج حياته اجتماعيا، وهذا هو ما نسميه الحضارة في تطورها بوجهيها المادي والثقافي. وإنتاج الحياة هو مشروع وجودي ينطوي على ابتكار متجدد آليته التغير كشرط أساسي للتكيف”.
يرى جلال أن الخطاب اليساري العربي أخفق، لا لأن خطابا آخر مناهضا انتصر، فقد أخفق الجميع اليسار واليمين، إذ تعلقت أبصارنا وطموحاتنا بالسماء، حيث المفارق المتعالي والفكر النظري المجرد بينما أقدامنا جميعا بعيدة عن أرض الواقع، واقع الفكر والفعل الاجتماعيين في ترابطهما الجدلي الذي لا ينفصم، ولم يكن الإخفاق استثناء، بل قاعدة للجميع امتدت قرونا، ومن دانت له السلطة إنما كفل له البقاء وجوده في منطقة التعادل أو الخمود.
ويعني باليسار كل تيار أو صاحب موقف نقدي التمس تغيير المجتمع على غير مثال سابق في تاريخنا العربي؛ أي الانتقال حضاريا إلى حضارة العصر، حضارة التصنيع وما بعد التصنيع بكل مقتضياتها وعناصرها، ولقد كان اليساريون بعامة نبض حياة في مجتمعاتنا؛ كل فريق بحجم حضارة أمته ومدى ثقلها النوعي، صدقت النوايا والجهود إجمالا، وعانوا باسم رسالتهم شدائد وأهوالا تتضاءل أمامها شدائد الرسل، ولكن الجهود المخلصة جاءت مبتسرة والإخفاق مآلها.
الإنسان العربي اليساري واليميني أيديولوجيا وسياسيا أسير ثقافة قبل علمية كما أنه ضحية وضع اجتماعي تاريخي أيضا
ويوضح “في عبارة مثيرة للدهشة قال زعيم مؤسس لواحدة من أقدم الحركات اليسارية في أوراقه عن ذكريات مطلع الأربعينات ‘يمكن القول بأن الجماهير في ذلك الوقت كانت مستعدة لأن تستمر في سلوك طريقنا، ولكننا لم نكن نعرف إلى أين نقودها’. وقال زعيم عربي عسكري مؤسس لثورة، وكأنه يتحدث بلسان نظرائه ‘سقطت السلطة بين أيدينا ولم نكن نعرف وقتها غير البندقية، ولكن كان علينا أن نمضي في طريقنا’. هاتان العبارتان نموذجيتان حيث توضحان عمق الانفصال بين الفكر والفعل الاجتماعي في حياتنا حيث إرادة ولا منهج، ولا وعي نقديا بالوسيلة والهدف، قطيعة بين الفكر ومقتضيات الواقع ومنهجية الإنجاز أو فن وتقنية العمل التي هي خبرة وممارسة وثقافة اجتماعية تاريخية في تلاحم مع الفكر المنهجي”.
ويضيف جلال “إنهما عبارتان تكشفان عن قطيعة حقيقية في حياتنا الثقافية، قطيعة بين الفكر وبين العمل الهادف، الهدف كواقع حياتي متحرك، كإنجاز عملي، إنها أزمة الدلالة الوظيفية للفكر، وأزمة الدلالة الاجتماعية للعمل، قد نملك الهدف أمنية تلخصها فكرة تتصف بالعمومية، الثورة أو التغيير، ولا نملك الإجابة المستمدة من واقع حياتي ومنهجي، أو من الممارسة المنهجية، وكيف يكون التغيير ومقتضياته وكأن الحياة كلمة لا فعل، تماما كمن يملك الحلم أو الصورة ولكنه لا يملك الأداة التي هي اكتساب أو ابتكار من خلال العمل”.
ويبين أن النتيجة هي أن يفاجئنا أو يصدمنا الواقع ونواجه الموقف صفر اليدين فكرا ومنهج عمل ونتعامل مع الحدث في آنيته وفي ظاهره الجزئي، إننا لا نتعامل مع ظاهرة الإنسان/ الواقع في كليته وشموله، كظاهرة مدروسة التاريخ والاحتمالات بل مع فكرة عامة ثم مع حدث آني، وبذا نكون في أحسن الظروف أصحاب منهج المحاولة والخطأ، أو المنهج الخبري الجزئي أو التجزيئي أو رد الفعل، ولا تراكم معرفيا يفضي إلى نسق عام، فكل جيل أو كل فرد يبدأ من جديد ولا قدرة على الإبداع، ولا استقلالية للرؤية، والمرجعية دائما مفارقة، واقع غير مدروس، واحتمالات في طي المجهول.

ويؤكد جلال أن اليسار كان في ممارساته امتدادا لبنية ذهنية أو ثقافية موروثة من حيث النظرة التجزيئية والنظرة الأيديولوجية القائمة على ثنائيات نقيضية، إما، أو، خضوع أو تسلط، أنا أو الآخر، ولا تعتمد الحوار القائم على حركة جدلية منهجا وحافزا للتغيير المطرد، ولا ريب في أن ممارسات المرء ونهج تعامله ثقافة اجتماعية ومناخ علاقات تفاعل اجتماعي. وعلى الرغم من أن المنهج اليساري في التفكير يرى، نظريا، الحركة الجدلية بين الفكر والواقع. وكذلك الجدل بين الأفكار بشهادة الواقع أساسا معتمدا إلا أن نهج التناول اليساري جاء متسقا مع البنية الذهنية الثقافية الموروثة التي هي بنية قبل علمية على نقيض ما بشر به المنهج الجدلي. ومن هنا جاء الخطاب اليساري خطابا أيديولوجيا لا فكرا علميا يتصف بالشمول ومنهجية البحث والنظر.
ويشير إلى أن الخطاب اليساري ناهض الأصولية باعتبارها أيديولوجية، لكنه هو ذاته، وبحكم التنشئة والتكوين الثقافيين، لا بحكم الفكر الماركسي، أبدل أيديولوجية بأيديولوجية لافتقاره إلى القدرة على نقد الذات ولانقطاع صلته بمختلف أوجه النشاط والفعالية الاجتماعية. وبذلك كان حسب تعريف لو كاتش وعيا زائفا شأن تيارات الفكر العربي الأخرى وإن تباينت المسميات. كان من المفترض أن يخلق الفكر اليساري، بحكم كونه موقفا نقديا، وعيا متجاوزا حدود الممارسات السياسية المحدودة والشعارات السياسية أو الاقتصادية المجتزأة ليؤسس وعيا اجتماعيا متكاملا من حيث التاريخ الوطني والقومي والواقع الطبقي والحراك الاجتماعي، وقضايا التحديث والتطوير الاجتماعي الشامل والسياسة التعليمية والتنموية الشاملة للإنسان/المجتمع/الحضارة، فهذه جميعا ركائز النقلة الحضارية والإطار المعرفي/القيمي الملازم لها، ولكن الملاحظ أن اليسار اعتمد على تحديد مناهج عمله وأهدافه بالسلب؛ ضد الإقطاع، ضد الاستغلال، ضد الملكية، وهو في هذا شأن ضد الإسلاميين حين يقولون الإسلام هو الحل..
وهذه شعارات لا تخلق معرفة أو إستراتيجية عمل. لم يخلق اليسار تيارا اجتماعيا راسخ الجذور في مجالات أنشطة المجتمع المختلفة، إذ لو أنه خرج عن إطار الخطاب السياسي ليصبح فكرا اجتماعيا لأرسى قواعد نسق عام لمجموع حالات ومشكلات الواقع التعليمي والعلمي والاقتصادي والتاريخي… إلخ، في إطار الوعي شاملا الفكر والسلوك والممارسة والنقد؛ أي لاستطاع أن يقدم رؤية جديدة متكاملة للعالم وإشكالياته موازية لرؤى أخرى، وكيف أن ما يقدمه هو الأقدر على تقديم الحلول.
ثقافة قبل علمية

يرى جلال أن الإنسان العربي، اليساري واليميني أيديولوجيا وسياسيا، بقدر ما هو أسير ثقافة قبل علمية بقدْر ما هو ضحية وضع اجتماعي تاريخي أيضا. إن الإنسان في تعامله مع الحياة إنما ينطلق من إطار معرفي قيمي يشكل محيطه العقلي الذي تصدر عنه أفعاله وتنبني على هديه أفكاره. ويتألف هذا المحيط العقلي من مكونات النسق الأيكولوجي الذي يحيط بالإنسان وتراثه الثقافي بسلبياته وإيجابياته، وغذائه المعرفي النسقي. ويشكل هذا كله ركيزة إطار حوار الإنسان/ المجتمع مع البيئة ونهجه في معالجة الواقع، وإيجابية الصلة الجدلية بين الفكر والواقع.
ويكون هذا المحيط العقلي مجلى أو مرآة لحياة الإنسان/المجتمع في انتصاراته وهزائمه، وكبواته ووثباته، ولهذا يشكل مصدرا رئيسيا لدراسة البنية الذهنية الثقافية للإنسان/المجتمع. وواقع حياتنا أن المحيط العقلي للإنسان العربي، على اختلاف أقطاره وأوطانه، يمثل أزمة لم تحتل بؤرة الوعي بعد لأسباب موضوعية قائمة وموروثة؛ فنحن نعيش أسرى الهرمسية أو الغنوصية أو الباطنية التي أقالت عقل الإنسان عن أداء أي دور إيجابي وعطلت فعاليته الدنيوية وصرفت جهده ومخاضه إلى المطلق وحصرته في النظر الغيبي المجرد، وتعطل الفعل الاجتماعي الإرادي.
وعاش الإنسان العربي قرونا في ظل هذا المحيط العقلي مما ثبت نسبيا أركان هذه البنية الذهنية في معالجتها للواقع والتعامل معه. وهذه بنية لا تعتمد العقل منطلقا للفعل إذ أقالته وقطعت كل أواصر التفاعل الجدلي بين العقل والفعل، بل أسقطت قدرة الإنسان على الفعل والمعرفة، وحلقت به بعيدا في إطار فراغ من النظر المجرد المبتسر. ودعم هذا التوجه، في ظل الانحسار الحضاري الممتد، غياب العمل أو تعطيل الفعل الاجتماعي. وأفضى بنا غياب الفعل (العمل الاجتماعي الإنتاجي والإبداعي) ومن ثم غياب الفكر بالتلازم إلى شيوع ورسوخ خاصية التبعية الفكرية لتراث الماضي على ما فيه من تشوهات أو لفكر الحداثة الغربية على ما فيه من عناصر استلاب. ونحن في الحالين عاجزون عن النقد العقلاني.
هناك قطيعة بين الفكر ومقتضيات الواقع ومنهجية الإنجاز أو فن وتقنية العمل وهي خبرة وممارسة وثقافة اجتماعية تاريخية
ويؤكد أن حالة اختلال الأنا ليس مصدرها فحسب صدمة العرب إزاء الغرب وقوته وإنجازاته، بل يتعين البحث عن مصدر مواز آخر داخل تاريخية الظاهرة؛ فالأنا الاجتماعية مفككة فاقدة للوعي الجمعي بالذات التاريخية، وإن ما نسميه اليوم إجمالا وتجاوزا باسم الذاتية العربية لم يكن وجودها مكتملا أو واضح المعالم في الوعي الجمعي، بل كان وجودا منسلخا عن ذاته إذ عاش قرونا أسير تهويمات عن ذاتية متعالية في ظل الخلافة العثمانية مثلا، فالمواطن عثمانلي ونحن رعايا، وليس لنا وجود اجتماعي بما له من شروط ضرورية. إن الإنسان/المجتمع لا بد وأن يتوفر له وعي جمعي عبر حس تاريخي صادق لكي تتضافر القوى في حركة مستقبلية تأسيسا على انتماء صادق يشكل الوعي بالتاريخ.
ويشدد جلال على أن الديمقراطية وثقافتنا الاجتماعية المعاشة نقيضان لا يجتمعان، وهكذا الديمقراطية قياسا إلى ماركسيي الشرق أو إسلامييه على عكس ماركسيي وإسلاميي الغرب، إذن الجميع في بلادنا وليس الماركسيون وحدهم، ولا من يحملون صفة الليبراليين ولا الإسلاميين، الجميع مطالبون بابتكار جديد يكون استجابة لحاجة التقدم والاندماج في حضارة العصر، ابتكار لآلية مجتمع لتعبئة جهوده الفكرية والعملية والعلمية، وتحكم علاقات التفاعل الاجتماعي وصراعاته وحواراته، أي تحكم العلاقة الجدلية بين الفئات المتباينة، وتكون قادرة على تصحيح ذاتها بذاتها في ضوء التعبئة الطوعية؛ أي الديمقراطية التي تدعم الانتماء.
ويخلص إلى أن الوعي بالأزمة موضوعيا هو منطلق الوعي بالتناقضات والمعوقات، وهو أيضا صياغة التطور المستقبلي للمجتمع، أي منطلق فكر جديد نقدي للواقع وعمل جديد للبناء، إن غياب العمل متمثلا في مشروع قومي يعني فقدان الوعي بالأزمة في موضوعيتها ويعني بالتالي ضربا في عماء وفقدان التاريخ. وإن توفر الوعي بالأزمة دون الفعل الواعي في سياق اجتماعي حافز للإنسان العام يعني فقدان المبادرة، إن العمل المجتمعي سبيلنا لطمس هوة الاغتراب عن الواقع وعن التاريخ، ولمحو ازدواجية الوعي حيث يجمع المرء بين نسقين معرفيين متناقضين حداثي وموروث دون قدرة انتقادية عقلانية يحسمها واقع العمل.






















