الإنتاجات الأدبية العبرية المعاصرة تسعى لتحطيم الأساطير

إن الأدب العبري الحديث هو ذلك الأدب الذي كُتب بالعبرية في أوروبا أواخر القرن الثامن عشر الميلادي وتميز بنزعته العلمانية التي هدفت بالأساس إلى تثقيف الجماعات اليهودية في أوروبا ومن ثم تشابه شكلا ومضمونا مع الآداب الأوروبية، لكن اليوم تغير الخطاب الأدبي العبري ليشكل له هوية خاصة بحكم التحولات.
تقف الناقدة المصرية نهلة راحيل في كتابها “الرِهان الصهيوني وتحطيم الأساطير.. دراسات في الأدب العبري الحديث” على أبعاد الفكر الصهيوني وما بعد الصهيوني كما تجسدت في نماذج من الأدبيات العبرية الحديثة؛ كاشفة أن الأدب العبري الحديث، خاصة في مراحله الأولى، عكس التغيرات الاجتماعية والتطورات الأدبية التي حدثت في المجتمعات الأوروبية التي عاش بها اليهود قبل استيطان فلسطين، فجاءت موضوعاته وأنماطه تتماشى مع معايير الآداب الأوروبية ومفاهيمها.
وتبين الناقدة أنه عندما انتقل مركز الأدب العبري إلى داخل فلسطين، في مرحلة الهجرات اليهودية وعقب إقامة الدولة، حتمت عليه الحاجة التطوير في موضوعاته وأفكاره كي تتلاءم مع طبيعة الواقع الاستيطاني الجديد في فلسطين، وتلبي احتياجات الفكر الصهيوني المهيمن.
ممارسات ثقافية
أكدت راحيل في كتابها الصادر عن دار خطوط وظلال الأردنية أن المشهد الأدبي العبري ارتبط بمجمل حروب الصراع العربي – الصهيوني بدءا من نكبة 1948 وما أعقبها من حروب متتالية مع العرب.
وقد وجهت نتائج تلك الحروب الأدباء الإسرائليين على اختلاف توجهاتهم نحو التعامل مع التغييرات التي أحدثتها، فانعكست في نصوصهم الأدبية حالة التشكك في القيم التي رسختها الصهيونية في أذهان جموع اليهود، وبدأت تظهر موضوعات تتعلق بالنقد التفكيكي لتوجهات المجتمع الإسرائيلي وسلطته الإقصائية، وبنزع السحر عن الحركة الصهيونية التي حوّلها أصحابها إلى يوتوبيا قومية عليا، فسعى الأدباء للكشف عن الأسباب المتعددة التي صنعت شروط انتصار المشروع الصهيوني في البداية ثم الظروف التي تسببت في انتكاسته، وتزايدت أنواع الأدب العبري الاستباقي الذي يستشرف كل ما ينتظر المجتمع الإسرائيلي في المستقبل ويقدم رؤية مختلفة عن اليوتوبيات الصهيونية الأولى.

النصوص ممارسات ثقافية تعبر عن أنظمة المجتمع وتجسد أنساقه المتعددة عبر رحلة طويلة من التحولات التاريخية والاجتماعية
وتابعت “وهنا برزت ما بعد الصهيونية كتيار نقدي تفكيكي رأى أن وجود دولة إسرائيل لم يكن حلا لمشاكل الجماعات اليهودية كلها، وبالأخص في ظل فرض الهيمنة الصهيونية الأوروبية على الأنظمة الاجتماعية والثقافية بالمجتمع، وتهميشها للآخر (اليهودي الشرقي أو العربي الفلسطيني) ومحاولات صهره المستمرة داخل ثقافة غربية مختلفة عنه بدعوى الحفاظ على وحدة النسيج ‘القومي’ الجمعي للدولة”.
وتجسدت دعوات هذا التيار النقدي في نصوص أدبية عديدة – وبالأخص من إبداع يهود الشرق – تدحض النتائج السلبية للصهيونية ليس على الفلسطينيين فحسب، بل أيضا على يهود الشرق الذين جُردوا من حق تمثيل أنفسهم وتعرضوا إلى إنكار تاريخهم العربي ووعيهم الثقافي لأسباب تخص الصهيونية كحركة أوروبية استعمارية هدفت إلى خلق هوية إسرائيلية غربية مهيمنة تقوم على تاريخ رسمي واحد، لذلك وضعت نفسها في موضع السيد وحولت الفئات الأخرى إلى وضعية التابع.
ورأت راحيل أن خطابا أدبيا مضادا نشأ ليتبنى مقولات ما بعد الكولونيالية ويقوض الفرضيات الصهيونية الرسمية وما تدعمه من التراتبية الهرمية للثقافات، ويعبر أدباؤه عمّا أطلقوا عليه “الاستعمار الجديد” الذي تمارسه دولة إسرائيل ضد مواطنيها عن طريق محاولاتها المستمرة لمحو هوياتهم الأصلية متخفية وراء مقولات تعميمية مثل “التقدم” و”التنوير” و”المواطنة” وغيرها من مفاهيم تسهم في ظنها في تحديد العلاقة بين الدولة والفرد، فجاءت النصوص الأدبية العبرية لتعبر عن أن إلغاء الطابع “القومي” الجمعي للدولة ودحض افتراضاتها المركزية وهو السبيل الوحيد الذي سيمكن المواطن من تحرير ذاته من “عنصرية” الصهيونية و”ظلم” المؤسسة الحاكمة، وبالتالي خلق شرعية بديلة تقوم على تقويض الأسس الأيديولوجية للدولة، وخاصة تلك التى تتعلق باليوتوبيا الصهيونية وبوتقة الصهر.
وأضافت أن “الإنتاجات الأدبية العبرية قد تراوحت في الآونة الأخيرة بين اتجاهين مركزيين، أولهما يوجه جهوده نحو صناعة ولاءات جديدة للمشروع الصهيوني وتنمية قيم الشعور القومي والانتماء السياسي لدى اليهود بإسرائيل، وزرع مفاهيم تؤكد ‘عدالة’ الحركة الصهيونية وضرورتها التاريخية وخاصة وسط الشباب الإسرائيلي الذين انصرفوا مؤخرا عن الفكر الصهيوني بشكل أو بآخر. وأما الثاني فينشغل بإعادة تفسير الفرضيات الكبرى التي تدور عن تاريخ اليهود في أوروبا وذاكرة أحداث النازية، والحركة الصهيونية وترويجها لتحرير اليهود وإنقاذهم بنقلهم إلى فلسطين، وكذلك انشطار الهوية داخل المجتمع الإسرائيلي بعد فشل سياسات الصهر في خلق نسيج ثقافي واجتماعي موحد للمهاجرين اليهود القادمين من خلفيات ثقافية متعددة، وأخيرا التحولات التي رافقت تعيين وضع اليهود القادمين من الدول العربية وتحديد النظرة إلى الثقافة العربية التي يمثلونها”.
اعتمدت راحيل في كتابها على استجلاء الاتجاهات سابقة الذكر ودورها في تحليل الإنتاجات الأدبية المكتوبة باللغة العبرية، وكانت مقولات ما بعد البنيوية والنقد الثقافي والدرس المقارن هي المناهج النقدية والخطوات الإجرائية التي تمت الاستعانة بها لاستنطاق النصوص الأدبية وتفسيرها باعتبار تلك النصوص ممارسات ثقافية تعبر عن أنظمة المجتمع وتجسد أنساقه المتعددة عبر رحلة طويلة من التحولات التاريخية والاجتماعية.
نصوص ناقدة
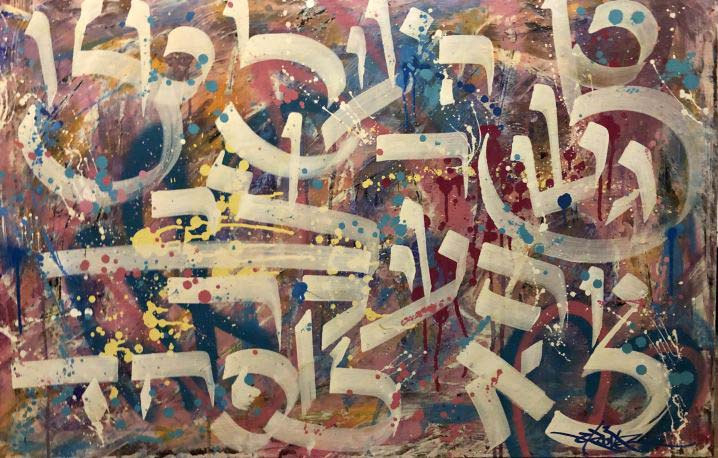
قسمت راحيل كتابها إلى خمسة فصول رئيسة تطرح قضايا فكرية مختلفة تخص المرأة والتراث والصهيونية والصراع والحروب وغيرها من قضايا انشغل بها كاتبو النصوص الأدبية محل الدراسة، وتعرض كذلك أنواعا أدبية متنوعة تتراوح بين الرواية والرواية القصيرة والقصة القصيرة ورواية الرسائل بوصفها قوالب فنية طرح خلالها الأدباء قضاياهم المجتمعية المتشابكة.
في الفصل الأول الذي عنونته راحيل بـ”جماليات التشكيل الزمكاني في رواية ‘رسائل من رحلة متخيلة’ لليئة غولدبرغ – قراءة نقدية في بنية النص الروائي”، حاولت الناقدة تفكيك المقولات التي سعت الصهيونية لترسيخها في خيالات المهاجرين اليهود، في محاولة لدفعهم إلى الانقطاع عن أوطانهم الأوروبية التي جاءوا منها، والتمسك بالوطن المقصود “فلسطين”.
وعرضت راحيل المحاولات الأولى لرفض الصهيونية وخطابها الإنقاذي الذي اتجهت به نحو يهود العالم من خلال تبني الكاتبة ليئة غولدبرغ خطابا كوزموبوليتانيا ينحرف عن المسار الرسمي للخطاب الصهيوني الذي يلتزم بتأسيس “وطن قومي” لليهود بفلسطين يجمعهم فيه نسيج ثقافي موحد، وذلك من خلال استنطاق البنية الكرونوتوبية/ الزمكانية في رواية “رسائل من رحلة متخيلة” عن طريق تتبع بعض التقنيات الفنية التي لا يمكن فيها فصل عنصري الزمان والمكان بوصفهما المعطيين المؤسسين للفضاء الروائي وبناءً على دراسة تحليلية لتلك التقنيات، معتمدة على رؤية ميخائيل باختين للزمكان الأدبي.
وتناولت في الفصل الثاني “الغواية بين ليليت والنداهة – دراسة مقارنة في قصتي ‘ليليت’ و’النداهة'”، وسبل استثمار الكاتب أيا كان انتماؤه للخطاب الأسطوري في نقد الواقع الاجتماعي الذي يعاصره والتنبؤ بالمستقبل المتوقع إذا تغير أو لم يتغير الوضع القائم الذي يدينه، حيث قام الكاتب دافيد فريشمان بتطويع الأسطورة للتعبير عن تمرده على السلطة الدينية التي استغلها الحاخامات للسيطرة على يهود أوروبا قبل إقامة الدولة ومنعهم من الانفتاح على القيم الغربية الحديثة.
وتذكر في الطرف المقابل كيف قام الأديب المصري يوسف إدريس باستثمار الأسطورة لتجسيد أزمة التحديث التي عانى منها البعض في مصر منذ أوائل عقد الستينات من القرن العشرين، وتداعيات الصدام الحضاري بين مجتمع الريف ومجتمع المدينة. وقد تم استقراء سمات الشخصيتين بين الأسطورة الأصلية والتمثّل الأدبي لها، ورصد أسباب الاستدعاء الأسطوري وشواغله الاجتماعية، وبيان آليات توظيف الشخصية الأسطورية لبناء عوالم تخييلية لا تعيد إنتاج الأسطورة بل تستخدمها للتعبير عن معطى واقعي.

وواصلت راحيل في الفصل الثالث “الجولم بين التراث الشعبي والتمثّل الأدبي – دراسة في رواية ‘الجولم’ ليتسحاق بن مردخاي”، عارضة استلهام المبدع للشخصية الأسطورية داخل نصه الروائي من أجل إنتاج دلالة جديدة لها تتصل بالواقع الحاضر الذي يجسده.
ويقتنع الكاتب يتسحاق بن مردخاي بالأسطورة بهدف نقد السلطة السياسية، ورفض أجهزتها القمعية المتمثلة في ممارسات الجيش الإسرائيلي وإدارته الوحشية للحروب، ومحاولاته للدمج بين الواقعي والعجائبي من أجل إدانة التعامل الصهيوني مع الأبعاد المختلفة لما يسمى بـ”إبادة” يهود أوروبا والناجين في فترة أحداث النازية.
وقد كشفت الدراسة عن آليات توظيف شخصية “الجولم” في الرواية، وبيان أسلوب الكاتب في استلهام مستويات الأسطورة، كليا أو جزئيا، لبناء عوالم تخيلية روائية تتصل بمجموعة من المرجعيات الاجتماعية والسياسية أراد الجهر بها عن طريق استدعائه لمكونات الأسطورة والاشتغال عليها على المستويين الفني والرؤيوي.
وتطرقت في الفصل الرابع “سرد الضحية – دراسة مقارنة في قصتي ‘تمزيق’ و’ألعاب نارية'” إلى وقوع المرأة اليهودية ذات الأصول العربية ضحية للهيمنة الذكورية وللإقصاء العنصري بعد تصنيفها كجزء من كل يعتريه النقص من قبل المؤسسة الصهيونية الإشكنازية داخل إسرائيل، وذلك عبر تمثيل الكاتبة براخا سري لما تعانيه المرأة اليهودية اليمنية من مظاهر متعددة من العنف الاجتماعي أو الجنسي سواء في بيئتها القبلية في اليمن أو عقب هجرتها إلى إسرائيل في بداية خمسينات القرن العشرين.
وقد سعت الدراسة لمقاربة تمثيل الهوية النسوية في القصتين بهدف استكشاف الأنساق الخطابية المضمرة التي تحرك السرد النسوي في بناء صورة المرأة/ الرجل، وبعد رصد السياقات البيولوجية والاجتماعية والثقافية التي تحرك دوافع الكاتبتين اليمنيتين تبين أن التمثيل السردي للمرأة وتصوراتها عن ذاتها وعن الآخر هو تمثيل ثقافي ارتبط بعلاقات القوى الجندرية داخل المجتمع اليمني.
وتناولت راحيل في الفصل الأخير بعنوان “مسرحة الرواية – دراسة نقدية في رواية ‘عائد إلى حيفا’ لغسان كنفاني ومسرحية ‘العودة إلى حيفا’ لبوعز جاؤون” إجراءات تحويل العمل الروائي القائم على السرد إلى نص مسرحي قابل للعرض، من خلال استغلال الكاتب بوعز جاؤون للعناصر الدرامية التي تحملها بنية رواية كنفاني “عائد إلى حيفا” خلال إعادة صياغة النص دراميًا وإعداده للعرض المسرحي.
ويحاول الفصل أن يرصد – بجانب التحولات الشكلية – تحولات الدافع، أي الموقف الأطروحي الجديد الذي دفع الكاتب إلى تحويل نص كنفاني إلى مسرحية، وما يتضمنه هذا الموقف من إشارات سياسية وأيديولوجية تحكمها في الأساس علاقة الصراع بين الصهاينة والفلسطينيين. وقد نجح جاؤون في نصه المسرحي في الاستفادة من العناصر الدرامية الموجودة بالرواية التي قام بمسرحتها، بشكل ساعده على إحلال عناصر جديدة في الشكل والمضمون تلائم قناعاته الفكرية ورؤاه الفنية التي تختلف بالطبع عن الرؤية التي تبناها كنفاني في روايته. فإذا كان كنفاني في نصه يدعم خيار المقاومة كحل لا يقبل التفاوض لاستعادة الأرض بالقوة، فإن جاؤون في نصه الممسرح يدعم خيار العيش المشترك وقبول الأمر الواقع الذي فرضه المستوطنون الصهاينة على أصحاب الأرض الأصليين.




























