الأدب بين السلطة الطاغية والذائقة المضلّلة
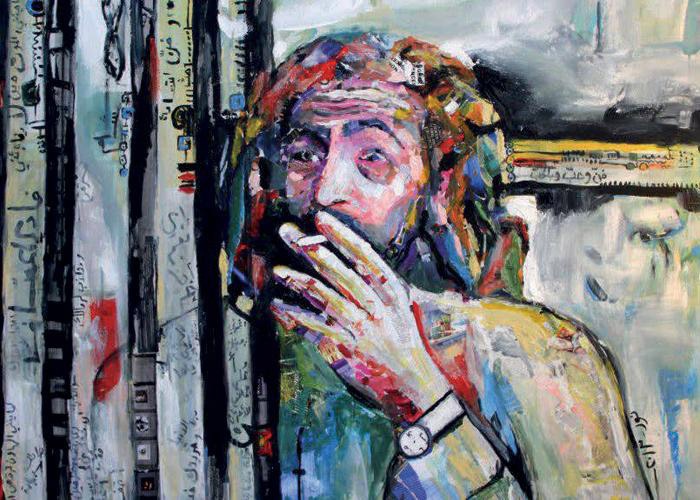
يحضر القارئ اليوم بشكل طاغ في الأعمال الأدبية، دون مراعاة لخطر الانسياق إلى الجماهير ورغباتها، ما جعل الأدب تحت رحمة الذائقة الجماهيرية العامة. وهذا الحضور اللافت للقارئ يدعو إلى التساؤل عن طبيعة هذه السُّلْطة التي اكتسبها القارئ وما مصدرها ومدى تأثير هذا على النقد والنصوص؟
لا يخفى على المتابع للتحولات في مسار النظرية الأدبية ما أَوْلته من اهتمام بالغ في الفترة الأخيرة بالجمهور/القارئ أو “القطب الثاني الجمالي” وفق تعبير الألماني فولفجانج الذي اعتبر أن الأساس بالنسبة إلى قراءة كل عمل أدبي “هو التفاعل بين بنيته ومتلقيه”. هذا الاهتمام جاء بعد أن سادت فترة غير طويلة نظريات تدعو إلى استقلال النص الأدبي، فأسقطت القارئ تمامًا، كما فعل نورثروب فراي في كتابه “تشريح النقد” عام 1957، حيث أسقط القارئ تمامًا، وحوّل الأدب إلى عمل طقسي يشبه دورة الفصول.
مقابل إسقاط القارئ وإنكار وجوده كان ثمة تيار آخر يؤكّد وجوده. فوين بوث يشدّد على أن الاتصال بين النص وقارئه هو أساسي لوجود “الأدب الحقّ”، وهو ما أكّده جاك دريدا بقوله “القارئ يكتب النص”. وتارة أخرى يصرّح بوث بـ“أن كل جرّة قلم تتضمن شخصيته الثانية”. وهو بالطبع يقصد القارئ بالشخصية الثانية. وهو ما يعتبر كسرًا للقاعدة، أو الجيتو، التي تقول “إن الفن الحقيقي يتجاهل الجمهور” أو حتى تلك التي تعزل المؤلف عن قارئه “الفنانون الحقيقيون يكتبون لأنفسهم فقط” بعكس المؤلف الذي يفكّر في قرائه، ويعمل كل ما بوسعه كي يكون مقروءًا.
خلخلة النظرية
قد يكون لتأثير ثورة الطلاب في أوروبا عام 1968 الأثر الكبير في التحوّل الجذري لخلخلة الثوابت، حيث نجحت في تغيير مسار النظرية الأدبيّة ووجهة التعليم الأكاديمي في حقل العلوم الإنسانية، وإن كانت فشلت في هزِّ أركان السُّلطة السياسيّة والاجتماعيّة في أوروبا وأميركا وفقًا لتصوّر فخري صالح في مقدمة كتاب “موت الناقد”. ومع هذا فآثار هذا التحوّل الجذري في دراسة الآداب والفنون تَكْمُن في أنْ حلّ القارئ غير المتخصص محل القارئ المتخصص الذي يعمل في المؤسسة الأكاديمية.
الحقيقة أن حضور القارئ واهتمام المؤلفين به قديمان. حتى سلطاته التي تجاوزت إبداء الرأي بالإعجاب أو تشكيل جمهور فعلي للكاتب، إلى تدخله، وارتقائه سلطة طاغية هي الأخرى قديمة. وقد جرى إظهار التخوف من تأثيرها باكرًا، لكن في ظل الفورة لاستقطاب أكبر عدد من الجمهور للمؤلف تمّ التغاضي عن هذه الصيحات، فوصلنا إلى المطالبة بموت الناقد لحساب هذه السلطة الجديدة، أو تلك الظواهر التي جعلت من مبيعات سلسلة هاري بوتر، مثلاً، تبلغ ملايين النسخ، مقارنة بأعمال رصينة لم يتحقّق لها هذا الشيوع والانتشار والرّواج.
التغيُّر اللافت في المنظور للقارئ وعلاقته بالمؤلف انعكس سريعًا، فتبوأت طيلة السنوات الماضية كلمتا القارئ والجمهور مكانة عالية ولامعة في حقل الدراسات النقدية، وبعد أن كان للنقد بعض من صفات الفن كما يقول فراي، والنقاد مثقفون يتذوقون الفن ولكن تنقصهم القدرة على خلقه والثروة لدعمه. ومن ثمّ اعتبرهم وسطاء أو سماسرة يوزّعون الثقافة في المجتمع، تغيّر الحال واستغنى الجمهور عن النقد، وهو ما حذّر من عاقبته بروب مُبكّرًا حيث قال إن “الجمهور الذي يحاول الاستغناء عن النقد، ويؤكّد أنه يعرف ما يريد أو ما يحبُّ، يُسيء إلى الفنون ويفقد ذاكرته الثقافية”.
حضور القارئ واهتمام المؤلفين به جعلا سلطاته تتجاوز إبداء الرأي بالإعجاب إلى التحكم في النص فعليا
الجدير بالذكر أنّ الصعود المتوالي للقارئ أو الجمهور، كانت خلفه أسبابٌ عديدة تُبرز هذا التحوّل في المنظور. يدخل فيها أنّ ثمة اتجاهًا عامًا يُعنى بتأويل -وبشكل واسع- النصوص الفنيّة، وبضمنها النصوص الأدبيّة والعلم وفن الرسم والموسيقى.
وهذا الاتجاه كما تقول سوزان روبين سليمان هو “جزء من اتجاه عام فيما يُسميّه الفرنسيون العلوم الإنسانية، وأيضًا في المجالات الإنسانية التقليدية في الفلسفة والبلاغة وعلم الجمال”. فالتقدم الحديث -وفقًا لقولها الممتد- لهذه المجالات كلها يتجه صوب التأمّل الذّاتيّ؛ أي التساؤل عن تلك الفرضيات وتوضيحها، حتى غدا الانشغال بالجمهور والتأويل أمرًا مركزيًّا في النظرية والنقد الأميركي الأوروبي المُعاصر.
وبما أنّ الموقع الفعليّ للعمل يقع بين النص والقارئ، فإن تحقّقه هو نتيجة تفاعل الاثنين. لكن التوسّع في الاعتماد على القارئ ومغازلته، أتبعه التخلّص من أحكام التقويم وحكم القيمة، وأيضًا من الناقد المتخصّص لينتهي الأمر إلى الارتكان إلى تصورات كما يقول فخري صالح “الجمال في عين الرائي” وأن وجهات النظر التي يُدلي بها القرّاء، بغض النظر عن معارفهم وأذواقهم وتوجهاتهم، متساوية في قيمتها، فلا يَفْضُل واحدٌ منها الآخر، والأدهى أن صار لا يُعَدّ رأي الأكاديمي المتخصص في المسرح الشكسبيري أكثر أهمية، بأيّ صورة من الصور من رأي قارئ عابر لشكسبير.
سلطة القارئ
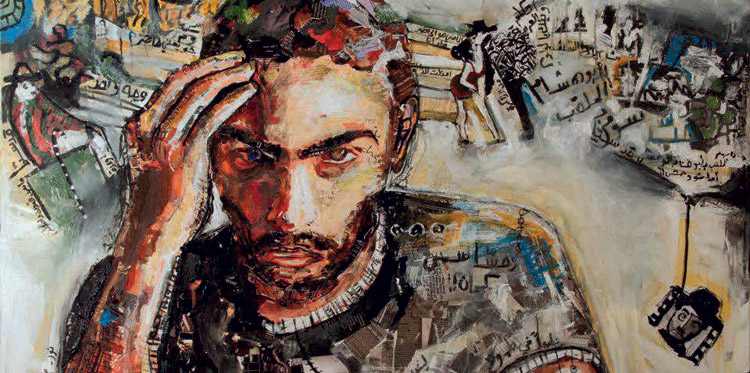
عاد الاهتمام بالقارئ/ الجمهور بقوة في السنوات الأخيرة، ووضعته الدراسات البلاغية وبالأخص بلاغة الجمهور موضع اهتمام وعناية بعد الطفرة التكنولوجيّة الحديثة، وانتشار المدوّنات الخاصّة والمواقع المتخصِّصة ووسائل السوشيال ميديا.

وقد حصل القارئ/الجمهور في ظلها على مزايا عديدة، فمنها اكتسب سلطة، حيث منحت القارئ (أيَّا كانت طبيعته) الحقّ في إبداء الرأي فيما يقرأ أو يشاهد، أي منحته فرصة الاختيار والتقييم. وهذه السلطة تماثل صورة القارئ الطاغية التي وصفتها فرجينيا وولف. فقد تجاوز بها دوره العادي كمتلقٍ إلى مُنتج ومُشارك، وهو ما أهّله لأن يحلّ محل الناقد الأكاديمي الذي شَحُبَ وتضاءل حضوره، بانسحابه إلى صومعته الأكاديميَّة مكتفيًا بكتابة دراسات وبحوث لا يفهمها سوى النخبة المتخصِّصة العارفة باللُّغة الاصطلاحيّة والمفاهيم والمنهجيات كما أشار رونان ماكدونالد في “موت الناقد”.
الشيء اللافت أن هذا الحضور للقارئ أدّى إلى الاعتداء غير المباشر على تلك الجهود السابقة التي بذلها الناقدان الإنجليزيان آي إي ريتشارد ووليام إمبسون، وكذلك النقد الجديد وتيارات البنيوية والتفكيك التي سعت إلى تحويل النقد إلى نوع من العلم الإنساني الجديد، في مقابل إعلاء الذائقة الفردية غير المُدرّبة ولا المحصنة بالعلم. وهو ما يُعدّ مؤشرًا خطيرًا على أزمات جديدة، من أهمها حالة الهرولة نحو القرّاء والسعي إلى استمالتهم من قبل المؤلفين، حتى ولو كان هناك مَن يُردّد أن “استعطاف القارئ هو من دلائل النقص في العمل الأدبي”.
لا يستطيع أحد أن يُنكر المكانة التي حظي بها القارئ العادي (الجمهور) على مستوى الدراسات التي اهتمت بتحليل بلاغة الخطاب السياسي، ثم بلاغة الجمهور كما هو واضح في جهود الدكتور عماد عبداللطيف.
الذائقة المضلّلة
الاستجابة لسلطة القارئ -في الحقيقة- خطرة ومقلقة، حيث أنها تعتمد في المقام الأول على جذب أكبر عدد من القرّاء في مقابل تضاؤل القيمة الفنيّة للعمل، فليس حقيقيا أن يكون واجب الروائي كما دعا ترولوب ذات مرة إلى أن “يجعل نفسه مُحبّبًا (للجمهور)” وهو ما يتطلب منه وفقًا لنصيحة ترولوب “أن يقدّم ما عنده دون أي جهد من قبل القارئ”. وهذه المخاوف من الخضوع لهذه الرغبة المدمرة دفعت فرجينيا وولف لأن تطلب من المؤلف الجادّ أن يحمي نفسه من هذه المطالب.
فقد رأتْ أن هذه المطالب تجعل من القارئ العادي طاغية “يَسْتعْبِد الروائي، بأن يرغمه على أن يقدَّم حبكة وكوميديا وتراجيديا وحبّا وإثارة”. ولما تبدّى من خطورة تمادي سُلطة القارئ، يُهاجم جرانفيل هكس في خاتمة كتابه “الرواية الحيّة” الجمهور ويعتبر أنه هو المشكلة التي تواجه الرواية، فحسب قوله “من الواضح ليس كل شيء على ما يرام بخصوص الرواية اليوم. غير أن المشكلة هي مشكلة القرّاء بصورة جوهرية وليست مشكلة الكتاب”.
التفكير في القارئ وبمعنى أدق تسهيل مهمّة القراءة دفع بعض الكُتّاب أمثال جيمس جويس إلى فكرة المُرشدات؛ أي الأشخاص الذين ينحصر دورهم في النص بأن يعطوا القارئ في شكل درامي نوع المُساعدة التي يحتاجها حتى يفهم القصة. ويشير جويس في مذكراته إلى العديد من الشخصيات التي استخدمها لدور المُرشدات في رواياته مثل ويي مارش، ماريا جوستري في رواية “السفراء”.
الخوف الحقيقي من أن يُسمح لهذه السلطة الجديدة/الطاغية (أي مطالب الجمهور) بأن تتحكم في ما يفعله الفنان.




























