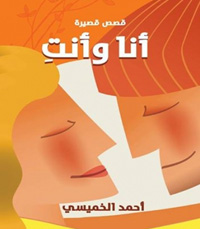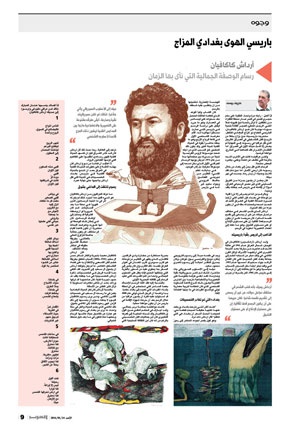"أنا وأنت" لأحمد الخميسي واقع كابوسي وخيال فانتازي

أحمد الخميسي كاتب مصري ينتمي إلى عائلة أدبيّة فوالده الشّاعر الرَّاحل عبدالرحمن الخميسي، يكتب القصة القصيرة، نشر أعماله في مجلات “صباح الخير” و”القصة” و”الكاتب” وغيرها، له في الترجمات “معجم المصطلحات الأدبية عن الروسية”، “المسألة اليهودية للأديب الروسي دوستويفسكي”، و”نجيب محفوظ في مرايا الاستشراق”، ومن أعماله القصصية: “قطعة ليل كناري”، و”رأس الديك الأحمر”. صدر له مؤخرًا «أنا وأنت» عن دار نشر كيان 2015.
يميل نتاج أحمد الخميسي القصصي إلى الترميز وأيضًا النزوع إلى الإنسانية بمعناها الرحب، والانحياز لمهمّشيها والغضب على حقوقهم المسلوبة والضائعة أينما وجدوا، وإن كان يُعبِّر عن هذا في إطار سخرية مريرة من الواقع بكل إحباطاته السياسيّة والاجتماعيّة، كنوعٍ من الإدانة الكاملة للسياسة العالميّة وما اقترفته من أخطاء عانى ويلاتها الأطفال والفقراء والضعفاء في كل أصقاع العالم، فتساوت الطفولة المشردة بين الجنسيات المختلفة، البوسنة والهرسك والسودان، مع أطفال مصر.
الرمزي والواقعي
تتكوّن المجموعة من خمس عشرة قصِّة متقاسمة بين القصة القصيرة التي لا تتجاوز الصفحة الواحدة كقصص (النور، وجه، مرآة، طرح القلب)، والقصة الطويلة التي تنتصر للحكي والسرد والشخصيات كما في قصص (سأفتح الباب وأراك وآليونا) وأيضًا بيت جدي التي تنزع لاختراق حدود القصة إلى أنواع أرحب وتحتمل لكثير من التفاصيل الموزَّعة داخلها إلى جانب التقاطعات مع الجوانب السيرية الذاتية وأيضًا الثقافية في تقديمها لمحة عن حركة اليسار المصري. الجامع بين هذه القصص إلى جانب السخرية المريرة من الأوضاع بأسلوب يمزج فيه بين الفصيح والعامي المتهكّم في الحوارات.
قصص مغزولة بتروٍّ وأناة، لا فائض لغويا في لغتها، جعلت من الإنسان ومأساته تيمتها، مراوحة بين الواقع حينا إلى الفنتازيا حينا آخر لتهرب منه، حتى الرمزية التي غلبت على كثير من القصص
يفارق العنوان في «أنا وأنت» دلالته المباشرة التي يقصدها، فيتجاوز العلاقة الشخصية بين السارد وزوجته الراحلة في مراوحة بين الحضور والغياب، إلى الآخر المهمّش والمقموع في كل مكانٍ مُسجِّلاً حالة من التعاطف والتماهي معه أينما كان. ومع هذا لا يُفارق العنوان دلالته البسيطة في علاقته بزوجته الفقيدة، التي يتردد طيفها في أكثر من قصة، بل يسري عبيرها في داخله حتى يتحوّل إلى شجرة كما في قصة «طرح القلب». ثمّة مراوحة في النصوص بين الرمزي والواقعي، فيتقاطعان معًا كنوع من ردِّ الدال إلى المدلول دون الحاجة إلى فك شفرات وتأويلات تذهب بالنص إلى غير ما هدف وابتغى السارد.
الرمزية موغلة في قصة «روح الضباب» رغم الواقعية التي تحيل إليها فالقصة تلخص حالة الضباب التي اعترتنا بعد الثورة، في صورة الشخصيتيْن الرئيسيتيْن الهاربتين من مجهولٍ والذاهبتين أيضًا إلى مجهول «لمح بصيص نور في آخر زقاق عن يمينه. انطلق نحوه وقبل أن يصل إليه تفجر النور أمامه حريقًا هائلاً» هما على مستوى الحدث مختلفان، ولا ينتميان لبعض لكن يربطهما الخوف والمصير المجهول وحالة الضبابية التي أفقدتهما التمييز «في الحرب كلّ شيءٍ مفهومٍ، أما الآن فإننا لا نرى العدوّ، ولا نعرف أيّ حرب نخوض».
|
الزمن المنسرب
كما تميل بعض القصص إلى الفنتازيا سواء في المتن كما في قصة «روح الضباب». أو في العنوان كما في قصة «الصبي الذي يأكل الماء» فالعنوان يميل إلى الفنتازيا، على الرغم من واقعية القصة المؤلمة، كأن يعمد السارد إلى كسر حدة الواقع المؤلم بهذه الفنتازيا، وهناك نوع ثالث من الفنتازيا رغم واقعية الصورة، ولكن في حدوثه تجاوزَ تأثير الفنتازيا كما في صورة الطفل في إحدى قرى السودان والمطاردة المثيرة بينه وبين النسر الذي ينتظر سقوطه للانقباض عليه.
حالة الحنين بمعناه الواسع سواء الحنين إلى الحبيبة الغائبة بفعل الموت كما في قصتي “أنا وأنتِ” و”طرح القلب” فيستحضرها تارة كشخص له وجود فيزيقي ملموس حاضر، يتبادلان الطعام في مشهد رومانسي يغلف القصة برومانسية شفيفة هي الأخرى مفتقدة في الكتابة القصصية، وتارة أخرى عبر الاستيقاظات المتوالية على روائحها النفاذة، والتي يعقبها حِوارٌ مُتبادل يعوِّض به حالة الغياب المادي والحقيقي.
نتاج أحمد الخميسي القصصي إلى الترميز وأيضًا النزوع إلى الإنسانية بمعناها الرحب، والانحياز لمهمّشيها والغضب على حقوقهم المسلوبة والضائعة أينما وجدوا
الزمن وتسرسبه في غفلة منا له حضوره الطاغي داخل القصص، وإن كان حضورًا أشبه بمرثية لحالة التلاهي التي نعيشها عن الاستمتاع بهذه القيمة التي منحها الله للإنسان فصار غافلاً عنها، حتى يفاجأ بسرقة العمر في غفلة منه كما في قصّة «وجه» فبينما السّارد في انهماك يراجع خططه لهذا الشهر من أعمال، ما بين أعمال منزلية وكتابية، حتى يفاجأ في المرآة بـ«وجه رجل عجوز منهك، تجاعيد عميقة حول عينيه»، وعندما يبحث عن صاحبه يكتشف أنه هو صاحب الوجه. في لحظة المرآة وهي اللحظة الصادقة يُدرك أنه في أثناء صراعه مع الدنيا لم يبق من العمر إلا تلك الملامح المنعكسة على المرآة. تكرر سرقة العمر ولعبة الزمن في قصتي «مرآة» و«خطوبة»، وفي خطوبة يصوّر مشاعر الأب المتضاربة بين الفرح لخطوبة ابنته لتبدأ حياة جديدة، وبين مرور العمر وهو ما يجسِّده في صورة ابنته بفستان الزفاف الأبيض وصورة زوجته بلون الغياب.
المعاني الفلسفية حاضرة أيضًا كما في قصة «النور» وهي أقصر القصص تقريبًا، يأخذنا السّارد في معنى فلسفي حول ماهية النور، فمصدر النور كما يرى السّارد هو قصص العشق، فمع أن العشق صار يسري في كلِّ مكان ومصدره القمر، لكن الغريب أن السماء لم تعد تلهم البشر دروب العشق، نفس المعاني الفلسفية العميقة حاضرة في قصة «قرب البحر»، حيث المعنى الذي يؤكِّد عليه السَّارد أن الإنسان مهما بدّل اللغة وغيّر الأوطان، لكنه لا بد أن يعيش في وطن واحد، وهو المعنى الذي يشعر به مَن يحمل هُويات متعدِّدة.
على الجملة نحن مع قصص مغزولة بتروٍّ وأناةٍ، لا فائض لغويا في لغتها، جعلت من الإنسان ومأساته تيمتها، مراوحة بين الواقع حينًا إلى الفنتازيا حينًا آخر لتهرب منه، حتى الرمزية التي غلبت على كثير من القصص فمع الأسف تتجاور وتتماس مع واقعنا في كابوسيته، وكل هذا جاء عبر لغة طيعة جذلة في فصاحتها، صارمة وحادة في إحالتها لا تحتمل تأويلاً مفرطًا يخلّ بالمعنى الحاملة له، في واقعيتها وسخريتها وأيضًا في عذوبتها ورقتها في التعبير عن الحب والافتقاد والحنين.
كاتب من مصر