أحميدة عياشي مؤرخ جزائري يغوص في عوالم "الراي" ومتاهات الإسلاميين

أتعبه الركض في شعاب الكتابة، فلجأ إلى رياضة الجري في دروب المسافات الطويلة والقصيرة، سعيدا بما تمنحه من طاقة وحيوية ونشاط ولياقة بدنية وتحسينا لضربات القلب. من كان يظن يوما أن أحميدة عياشي سيؤسس لنفسه إيقاع كتابة أخرى تبتغي الحفر في الأرض بالساقين والقدمين؟ وأنه سيعطي للحفر معنى أوسع اتساعا، وتجليا أكثر مما ينص عليه الحفر في جسد الكتابة والرواية والمسرح والصحافة وغيرها من الفنون التي قادته إلى فضاءات متخيلة خاض عمره بحثا عن جواهرها، وبالكاد أراحت رأسه، أقلقت مضجعه، وسهرت لياليه ونهاراته.
مساره يمكنه اليوم أن يلخصه في بضع كلمات لم يعثر عليها وهو يذهب طولا وعرضا، بين الحروف والفواصل، بين الهواجس والأحلام، الهوس والسكون، بين قلق المعنى وسلطة الفهم، ولما ركض ساعة أو ساعتين وجدها بجنبه، بين عينيه، وهو يحطم جريا أرقاما قياسية بالساعة والساعتين “أنا أركض إذا سأكون موجودا”. كوجيتو “ساهل ماهل”. كوجيتو ساحر وغاو مثلما رغب بعناد أن يراها مكتوبة بخطوط اليد وحروف مرمرية.
شياطين وجميلات
كان عياشي روائيا وصحافيا لامعا وأصبح اليوم روائيا وصحافيا متسابقا بارعا في قنص الخيال من هواء العدو والعرق والنفس السريع والسباقات الطويلة والقصيرة، يغالب ويغلب الأصدقاء ومحبي هذه الرياضة، والأهم أنه ينتصر على الوقت ويحقق زمنا مقداره ساعة أو أقل من ساعة؛ دقائق عشر أو عشرين، بالثواني لا تحتسب فهي مدكوكة في “كرونوماتر” معطل أو مصمم كي يتم عدها افتراضيا. لعياشي طاقة أخرى مخزنة في روحه وجسده متروكة لأشياء أخرى ولتكن لسباق الحراك، حراكه المتسابق الجديد في مرماه، في أجندته السرية المخبوءة من يوم الأوهام والأحلام المثالية بالثورات، وهو ككل مثقف فاعل، يساري أو علماني، معتدل أو راديكالي، كان يهفو إليها ويطمح لملامستها ولمسها خالصة لوجه الحرية والتحرر وللإنسان.
روايات عياشي، بدءا من "ذاكرة الجنون والانتحار" إلى "المتاهات" ، ينفق فيها على قارئه بلغة تهتف وتشع بمعان بلورية، قال عنها النقاد باستغراب إن عياشي "فتح ثغرات ميمونة لا سلالة لها ولا أبا متخيلا أو بيولوجيا تمتد إليها، بل نصه الروائي لعبة صوفية يلعبها بسخرية وخفة ساحرة"
ولد في العام 1958 بمكدرة بالقرب من سيدي بلعباس في الغرب الجزائري، ودرس العلوم السياسية. صلة القرابة التي ربطت عائلته بالشيخة الريميتي، مغنية “الراي” الشهيرة، جعلته يرى العالم مختلفا، فقد تلقى عنها الكثير. علاقة أخرى جعلته يذهب نحو الأدب، جمعته مبكرا بواحد من أبرز كتاب الجزائر؛ ولم يكن ذلك الكاتب سوى كاتب ياسين. اشتغل في الصحافة منذ عام 1988. وهو واحد من أهم المتخصصين في الحركة الإسلامية، وقد نشر كتابا بعنوان “الإسلاميون بين السلطة والرصاص”، وتمت مصادرته حينها من طرف السلطة في تسعينات القرن الماضي. وفوق ذلك اشتهر بكتابة سلسلة من المقالات حول أغنية “الراي” ويعتبر واحدا من الذين عرفوا بهذا الفن المحظور. أسس عددا من الجرائد الوطنية منها بالخصوص جريدة “الجزائر نيوز“. ونشر أيضا عددا من الروايات كـ“ذاكرة الجنون والانتحار”، “متاهات ليل الفتنة”، “شير” وغيرها.
لولبي في حياته ومجاور للفتن. يقف على بحار جنونه أنبياء وعائلة وأهل وأحباب غابوا وغيّبوا، ولولاهم لخاضها بمتع وعبث. مخلوط بالسياسة، يتعاطاها ويعرف كيف يثير آلهتها القاسية بنكزة لاذعة ويقتفي الممكن منها والمستعصي والمأزوم. أعداؤه يقولون إنه يهرطق ويثرثر ويناور ولا يقول شيئا ذا بال، لكن أليست السياسة هي فن اللاشيء؟
دراويش وإرهابيون

عندما تدخل إلى عالمه الروائي فإياك أن تفعل ذلك وأنت مرتاح وتجلس رجلا على رجل. وكي يتسنى لك ذلك، اذهب إليه وأنت قاب قوسين من القلق والنار، وتهْ ودرْ كأنك درويش مولوي عربيد فاسق متطهر من ذنوب النصوص الروائية البلهاء التي عمرت طويلا في عش مخك، ستنتشي حيث لا نبيذ أبيض أو أحمر ولا مخدر أو لبن مخثرا أو تمر مخمرا. ستعثر على شياطين وحواة وجميلات ومتوحشين ومتعصبين وملائكة وأصحاب شأن وأبطال خرافيين، وصحافي زوالي يكابد الخوف والإرهاب ويتطلع من باب عينه عله لا يقتل أو يذبح، ستجد أيضا جنرالا مكبوبا على أريكته يدخن ويستغرب كيف لم يقتل ولم يذبح، وإرهابيا هاربا من وساوس تزين له القتل والذبح وتعده بالجنة والحور. ستصادف، وسط كل هذا، الموت والمجهول
والخوف ثم حياة مثالية مثيرة غنّاء تزقزق على كف الغيب يحاول أحميدة أن يبعثها لك بلا وحي أو نبي موحى له، سيفتكها لك من عرين الحب واللوعة بشرط أن تكون عاشقا للمغامرة والتيه والجذب والخصب، وهو ما يبيضه لك دون عتمات أو عتبات. أنفذ إلى نصه الروائي وأنت فارغ ونظيف من لوثات النصوص الجزائرية “اللي أهلكتنا” ببلادتها.
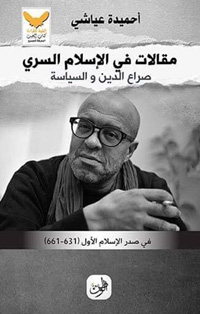
الرواية عنده ليست سوى تنويع محبب، مسكون بالمرح اللاهي على جسد الحياة والتاريخ الغامض والهامشي والسري والمنبوذ. يكتب كل هذا في حالة انشطار ويخطفك على تخوف وبيديه يرميك في متاهة لا تكاد تجد خلجانها وأراضيها وسماواتها حتى يراودك الشك: أأنا في الرواية أم أن الرواية فيّ؟
في كل ما كتبه عياشي من رواية، بدءا من “ذاكرة الجنون والانتحار” إلى “المتاهات”، ينفق على قارئه بلغة تهتف وتشع بمعان بلورية، قال عنها النقاد باستغراب إن عياشي “فتح ثغرات ميمونة لا سلالة لها ولا أبا متخيلا أو بيولوجيا تمتد إليها، بل نصه الروائي لعبة صوفية يلعبها بسخرية وخفة ساحرة”. حتى إذا ما أكملت القراءة صادقت وحوش نصه بألفة وحميمية ولن تتوقف إلا وأنت تحلم وترغب بعالم متوقد بالحب والجمال.
“راي” عياشي رنان بوشوم الشيخات وعطور الكباريهات وحركات خلاخيل الراقصات، والعيطة والرشقة والتبراح، ولذاذات النصوص المحرمة، خبير به ومختبره، عارف بروحه المدنسة والمقدسة، وطقوسه المكشوفة على الجسد المرغوب الفاخر، والنبيذ الفائض على قمصان الهجر والفراق والعشق. يعرف من أي سلسبيل ينبع شجن القصبة والقلال والبندير. يعرف النبرة الشهوانية للصوت والكلمات والتعابير والمعاني وهي تتشهى وتشهي وتمدح وتلتهم وتغرف من تموجات الرفض لكل ما يرمز إلى العفة والعفاف والطهر والعافية، حيث يتفوق “الراي” ويفوق طبوعا أخرى في تسمية الحالات والمواجيد والهواجس، دوّنها عياشي في أكثر من مقال ونص وحوار ودراسة.
لا يمكنك أن تكتب ما تجهله ولا تعرفه. ما لم تلتقط أذنك المسكوت أو المرفوض والمتخفي، أو تكون غصت برحابة صدر في قسوة ومعاناة الهوامش والخبايا. وهو ما فعله عياشي، اختار عن رضا وحب وهوس وطواعية نقل “الراي”، أجواؤه وتاريخه وممنوعاته وخطاياه وسيئاته وحسناته ونصوصه وطقوسه وشياطينه وملائكته، شيخاته وشيوخه الأحياء منهم والأموات وصولا إلى شاباته وشبانه. نقله ورسمه وأغدق عليه بمطر يهمي ولن ينقطع حتى لا تظمأ أرض “الراي” أبدا. وكما تعلم عياشي حكمة الجري ولعبة السياسة وكتابة الرواية وشغف “الراي” قادته خطاه إلى ركح المسرح كاتبا وممثلا، ومبتكرا لنصوص باذخة بالعاطفة والصدمة والرعشة والفوضى. تذهب إلى أفق “بريختي”، كما هو مسكون وساكن في عقول المسرحيين، ولكنها ليست نصوصا عدمية سديمية سوداء كما هي عند بريخت، بل تصافح الفرح وتتخذه صديقا أبديا وتمضي به إلى مستقر مبذول للزهو، ومتظلل بالألوان الكثيرة لطفولة الأرواح المتراقصة بين ثنيات نصوصه.
المؤرخ المختلف

خاض وتعاطى في الإعلام والسير والحركات الإسلامية. وتلك رفوف مرتبة من مكتبة زاخرة بالكشوفات والحقائق والتجارب تدل عليه. مرة كعارف ومتصوف، ومرة كمؤرخ ومنقب بالأظافر عن المبهر والخطير والمشتعل. يستدرجها إلى حرارة شمس النقد تلفح وتكشط طيات الجلد السميك الذي تتخفى من ورائه الحقيقة والحق والتاريخ الساكت، متخطيا موانع وعوازل تضبب الرؤية وتحتجب بغلالات تحجب النور، ويقتطع لك ما يؤهل عقلك وروحك لتكون ضيفا على مائدة زاخرة بالطيب من القول والمعنى.
كتب عياشي مؤخرا يصف ما يختلج داخله في هذه اللحظات “يبحث الجزائريون عن فرح بأي ثمن، لأنهم حُرموا من تنفّس السّعادة التي اغتصبت منهم مرات عديدة، عندما كانت الظروف تضعها بين أيديهم. ولأنهم كانوا صادقين أكثر من اللازم كانوا يضعون ثقتهم بين أيدي ولاة أمرهم، فيمنحونهم كلّ مفاتيح البيت وكل ما يملكونه من أثاث في البيت وهم مطمئنين وسعداء، في تلك الطمأنينة المبنية على حسن النيّة وطيبة السجية، لكنهم في كل مرّة يفتحون فيها عيونهم يجدون حراس البيت قد خانوا الأمانة وظهروا في النهاية مجرد لصوص. لقد فضّلت أن أسير وسط تلك الجموع النابضة وحيدا، رفضت استعمال هاتفي المحمول لأخذ صور في ديدوش والعربي بن مهيدي وعميروش وحسيبة وكريم بلقاسم وزيغوت يوسف. كل أولئك الشهداء كنت أراهم، عيونهم تتلألأ في ذلك الدجى الفاتح والمزركش بالأنوار”.
في الستينات من عمره هو أحميدة عياشي اليوم، يستنهض جسده اللاهث في روح الجري، يعلو به كالطيف، ليرى من بعيد كل حياته وهي منتعشة، كما لم يحدث لها من قبل.




























