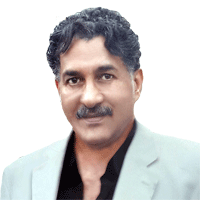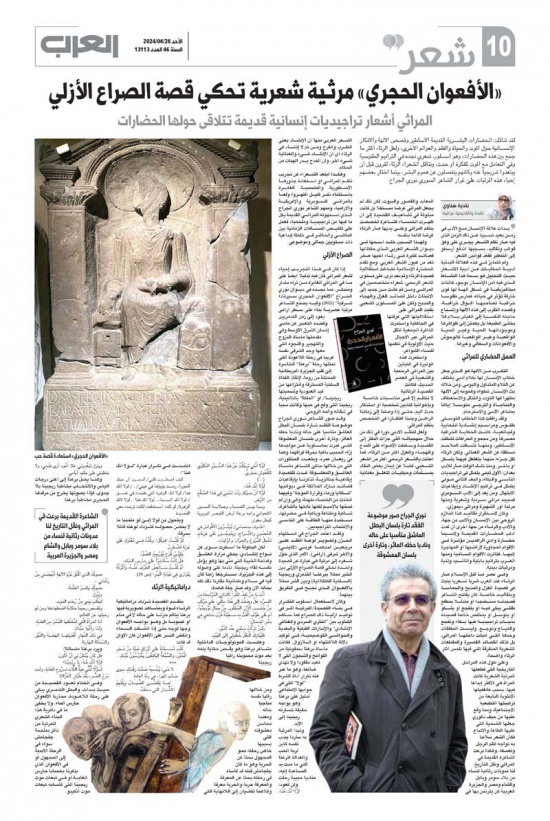الفاشيون الجدد لا يرتدون قمصانا سوداء ولا يخطبون في الساحات

تتصاعد أسهم الرئيس الأميركي السابق المثير للجدل دونالد ترامب مجددا في التنافس على كرسي الرئاسة الأميركية، وهو الذي مثل صعوده صدمة بخطاباته العنصرية في بلد يعتبر الأكثر استقطابا للمهاجرين، ويبدو في ذلك ظاهرة ما تنفك تتوسع تتمثل في صعود اليمين المتطرف والفاشيات الشعبوية بأشكال جديدة مختلفة، وهذا ما يدعونا إلى استعادة التفكير من جديد في هذه الظواهر المتحركة.
لعل السؤال الأكثر جاذبية الآن هو هل يستطيع سياسي واحد تبديد عقود من التوجهات والأطر العالمية والتأثير على مستقبل العولمة والنظام الاقتصادي الجديد؟ وهل وصلت العولمة إلى مستويات لا يمكن تحملها؟
إن المراقب لحركة الأسواق العالمية والمشكلات التي تحيط بها لا بد أن يلحظ تراجعاً ملحوظاً في منسوب التفاؤل، فثمَّة شكوك وتكهنات بشأن السنوات المقبلة التي ستشهد تراجعاً على صعيد حرية التجارة وضعف التنسيق بين ضفتي الأطلسي، حتّى قبل صعود ظاهرة دونالد ترامب في الولايات المتحدة.
وبعبارة أخرى فإن الأرضية كانت ممهدة منذ سنوات لطروحات الرجل الخاصّة بإلغاء اتفاقية التجارة العالمية وفرض ضرائب على الشركات الأميركية التي تستثمر في الخارج والتعهد ببناء الجدار العازل مع المكسيك لمنع الهجرة غير الشرعية، وصولاً إلى التهديد بالانسحاب من اتفاقية النافتا (اتفاقية التجارة الحرة بين الأميركيتين) والتخلي عن دعم الشراكة عبر المحيط، وطرد أكثر من مليوني مهاجر. ولعل السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو ماذا لو نجح ترامب في مساعيه المعلنة تلك؟ وما الذي يتبقى من آثار العولمة؟
الوضوح وليس الأمل

تعتقد الباحثة الاقتصادية الأميركية في مؤسسة بروكينغز برينا زايدل أنَّ التأثير المباشر سيكون على الولايات المتحدة نفسها التي ستشهد انغلاقا على الذات، ذلك لأن الولايات المتحدة هي الأكثر عولمة نسبة إلى بلدان العالم الأخرى، لجهة انفتاحها على المهاجرين، فهي تشكل ما نسبته 19 في المئة من حجم المهاجرين في العالم، أي ما يعادل 4 في المئة من سكان العالم، وفي الواقع فإن الولايات المتحدة هي الوجهة الأولى للمهاجرين على مدى العقود الأخيرة.
في محاولة لفهم المصطلح أجد من المفيد العودة إلى رأي الكاتب والمفكر الإيطالي المعروف أمبرتو إيكو الذي يقول فيه «إن الوضوح وليس الأمل هو المفردة المناسبة المضادة لمفردة اليأس. ولكي تكون مستيقظا للمفاجآت غير السارّة، في مواجهة أدلة متزايدة على أن الجنس البشري يواجه لحظة حاسمة من السياسة الحيوية المُهددّة للتأسيس الحضاري وانهياره أكثر من أيّ وقت مضى».
إنَّ اليقظة يمكن أن تؤدي إلى تنشيط الذهن. هذا التوصيف ربما أكثر من يحتاجه هم هؤلاء الذين يعيشون داخل الولايات المتحدة الآن بعد صعود ظاهرة ترامب المثيرة للجدل، فبالنسبة إلى هؤلاء تبدّى الخوف مما سوف يقوم به ترامب لجعل «أميركا بلداً عظيما مرة أخرى»، إنَّه مزيج من الشعور بالخوف الساحق والإحباط الثقيل للغاية، من دون أدنى اكتراث للأزمة السياسة الحيوية التي تهدد مستقبل الموئل البشري، وانقراض العديد من الأنواع.
يعتقد جان برايسموث، أستاذ الفيزياء النظرية في جامعة لوفان، ومؤلف كتاب «التدخل الإنساني: استخدام حقوق الإنسان لبيع الحرب» (2006) وغيرها من الكتب، بأن العمل السياسي يستند بالدرجة الأساس إلى ثنائية «الأمل والغضب»، الأمل باعتباره مسألة إرادة مستنيرة وهو مناقض للتفاؤل، الذي غالبا ما يكون هروبا من الواقع وعدم الاعتراف بالمخاطر المحيطة بنا والأضرار الناجمة عنها. المتفائلون في الكثير من الأحيان يلوّحون للمستقبل بابتسامة حميدة، كما لو أنه ليس هناك ما يدعو للقلق، طالما أن المرء قادر على التأمل مرتين في اليوم.
واستناداً إلى برايسموث نفسه فإنَّه عندما يكون الرئيس الجديد نتاج الظروف الراهنة، يمثل تحدياً روحياً ويعتمد على نوع من الإيمان المبهم، وبالنظر إلى عمق الأزمات المتعددة التي تهدد البشرية في عصرنا الراهن، فإنَّ «السخط» هو الردّ المناسب على الأخطاء المعقدة التي ترتبط بالفساد واستغلال النظام الأبوي والتمييز غير المبرر، فالسخط هو بمثابة الأساس اللازم لرفع الوعي السياسي، مما يجعل التعبئة مجدية والتحول ممكنا.

انتهى كلام برايسموث، لكن في المقابل ثمَّة آخرون كثيرون قرعوا أجهزة الإنذار المختلفة في الكثير من البلدان للتحذير من صعود الشعبوية اليمينية في العالم، محذرين من أن جرثومة الفاشية الجديدة بدأت تهاجم القلوب والهيئات والعقول بشراسة، وفي الكثير من الأحيان بتفويض ديمقراطي، بما يسمح بصعود جيل جديد من الحكام المستبدّين ومنحهم الشعبية، ومثل هذه الجرثومة معدية وخطيرة وتصيب الجسم السياسي مباشرة في العديد من المجتمعات في الواقع، لاسيما وأنَّها تدفع، ومن دون وعي مباشر، الناس للهروب من الاستياء أو الاغتراب الناجم عن الآثار المفترسة للعولمة النيوليبرالية في أوروبا وأميركا الشمالية إلى التطرف.
لقد تفاقم هذا الاستياء بشكل خطير لدى الأوساط المناهضة للهجرة بطريقة هستيرية وديماغوجية، مسلّحة ببنادق التحرر والسياسة النقديَّة، فما زال البعض ينظر إلى قضية تحرير الاقتصاد كنظرية مقدّسة من وجهة نظرهم، حتَّى لو تطلب الأمر التضحية بالأقليات ومحق المكاسب النسوية وتشجيع نزعة الاستهلاك التي تتحدى العلم، وتحويل الانتباه عن الأخطار التي يشكلها امتلاك أسلحة الدمار الشامل وتطويرها ونشرها، فضلاً عن ارتفاع درجة حرارة الكوكب التي وصلت إلى نقطة اللاعودة.
إنَّ الأمر الذي يدعو للاستغراب هو انتشار الرغبة بضرورة الانخراط إلى الحد الأقصى في الشعور الجمعي الخاص بالخوف من الآخر في الولايات المتحدة، والمطلوب من الجميع البقاء في حالة تأهب قصوى في ما يتعلق بالمخاطر التي تشكلها عملية تحكم يهيمن عليها غوغائيو وسائل الإعلام الموجهة التي حشدت الشعبوية اليمينية كما لم يحدث من قبل، بعد أن أحاطت نفسها بمجموعة من العقائديين الرجعيين.
المشكلة المتفاقمة الآن هي أنَّ الولايات المتحدة ما فتئت تقدم نفسها كدولة عالمية، الأمر الذي يجعل من الأخطاء الشنيعة التي تُرتكب هناك ذات تأثيرات وأصداء تتردّد في جميع أنحاء العالم، وهذا الأمر واضح جداً في ما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والبيئية والأمنية وغيرها. أيضاً هناك الشعور بتفاقم احتمال نشوب الحرب الدولية نتيجة لهذه السلوكيات الجيوسياسية المشينة.
الفاشية وبثور اليمين

في التوصيف العقلاني لمفهوم الفاشية كتب جورج أورويل قبل عقود من الزمان أن الاستخدام المبكّر لهذا المصطلح يعود إلى العام 1922 في أعقاب حكم موسوليني في إيطاليا، الذي عاش وترعرع في أحضان الفاشية الإيطالية الأصلية، التي اشتقت تكتيكاً غامضاً يمزج بين ما أسماه أورويل أسلوب «المكر والقوة»، وفق خطة قد تبدو من الخارج عقلانية إلى حد ما، لكنّها عنيفة في سعيها لطمس الديمقراطية.
هذا الأسلوب أو التكتيك نجده بوضوح في «كفاحي» لهتلر وخطب موسوليني على شرفة قصر فينيسيا التي كان يدعو من خلالها إلى «خلق الإمبراطورية الرومانية الجديدة» ويشيد بمساندة البرلمان الإيطالي آنذاك، أو الكتيبة الفاشية حسب أورويل. مثل هذه الإحالات لا بد أن تتمحور حول السؤال المعاصر والجدل الدائر حالياً في الولايات المتحدة في ما إذا كان دونالد ترامب فاشياً أم لا؟
وبالعودة إلى أمبرتو إيكو، الذي ولد في ظل نظام موسوليني في العام 1932، والذي كتب في العام 1995 مقالاً ناقش فيه دعوات أورويل هذه بشأن استخدام مصطلح الفاشية، قال فيه «إن نعت موسوليني بالفاشية ينبغي أن يخضع للتحليل الدقيق، كي لا يهبط إلى مستوى الشتيمة»، إيكو هنا يأخذ الأمر على محمل الجد حين يقول، ينبغي علينا تفحص الأمر جيداً، فالأساليب تغيّرت كلياً، ولم يعد الأمر مباشراً كما في السابق، إذ ليس بالضرورة أن يرتدي الفاشي قميصاً أسود ويستعرض في الساحات، الفاشية المعاصرة يمكن أن تعود بأشكال أشدّ تنكراً بلباس البراءة، ويعتقد إيكو «إن من واجبنا كشف تلك التنكرات والإشارة إليها بوضوح وفضحها باستمرار أينما وجدت وفي أيّ جزء من العالم».
وحسب إيكو دائماً فإن مصطلح الفاشية الجديدة، وإن استند إلى توصيفات المصطلح الإيطالي القديم، لكنه لا يشترك معه بالضرورة في السمات العامّة، لأن الفاشية الجديدة تستند إلى ما أسماه «شعبوية انتقائية أو نوعية».
الأمر من وجهة نظري يشبه إلى حد ما وصول ترامب إلى السلطة سابقا على محفة الـ”الإستثنائية الأميركية” مدفوعاً بما نسبته 46 في المئة من أصوات الأميركيين، الذين وإن بدوا أقلية من نوع ما لكنَّهم أعداد هائلة من الخائفين أو القلقين على مستقبلهم، أو المصدقين بالخطاب أو النمط الشعبوي اليميني القائم على إستراتيجية إعادة الروح القبلية التي بدأت في أوروبا الشرقية والآن صارت تجتاح الغرب كله، تلك الإستراتيجية التي تعتمد على إحلال الشعور القومي الشعبوي بدل الدين المتطرف في عالم باتت تتصارع فيه مفاهيم العولمة بأسلحتها الاقتصادية الفتاكة مع الحداثة وحرية الحركة والتنقل والتفكير. فتحول ادعاء جنون العظمة كمعادل موضوعي لمشاعر الخوف من الآخر، وهو ما تستغله اليوم عناصر يمينية متطرفة في جميع أنحاء العالم.
إن ظهور بثور اليمين الأوروبي المتطرف تبلورت أكثر ما بعد انتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفييتي، عندما طغى شعور كاسح بالشعبوية لدى الكثير من أفراد الطبقات الوسطى والسياسيين الجدد في دول أوروبا الشرقية، كردة فعل متطرفة على ما أهدر من طاقة وطنية وإمكانيات لعقود من الاشتراكية الشوهاء التي عطلت، من وجهة نظرهم، بناء مستقبل زاهر للأجيال اللاحقة، وبدأت تلك الظاهرة بصعود اليميني المتطرف فيكتور أوربان في المجر أواخر العام 1990 بالتزامن مع صعود سلوبودان ميلوسيفيتش في صربيا وفلاديمير بوتين في روسيا.
لقد أدى ظهور القوميين المتطرفين في أوروبا الشرقية إلى ارتفاع الميول العنصرية كردة فعل لما يعدّه البعض شعوراً بالحيف من الاشتراكية، وارتفعت مظاهر الإعجاب بالديمقراطيات الغربية، وازدادت هجرة الكثير من الناقمين على الماضي كلاجئين إلى أوروبا الغربية، الأمر الذي وفّر فرصة ذهبية لاصطياد هؤلاء من قبل الأحزاب اليمينية المتطرفة في فرنسا وألمانيا وبريطانيا وغيرها من بلدان أوروبا الغربية.

وبات سياسيون يمينيون متطرفون من أمثال مارين لوبان، التي ورثت زعامة حركة متطرفة هامشية من والدها، تحظى بشعبية متصاعدة في أوساط الناخبين الفرنسيين، وهي التي كانت لا تحظى بأكثر من 15 في المئة من الأصوات، وكذلك الأمر مع السياسي البريطاني الهامشي نايجل فيرج الذي كان محط سخرية السياسيين والصحافة البريطانية من اليمين واليسار، ومع ذلك حقق فوزاً ملحوظاً في الانتخابات بعد أن رفع شعاراً مفاده أن الدعوات للتكامل الأوروبي لا تتطابق مع مبدأ الاستقلال، واليوم نرى أن المملكة المتحدة في طريقها للخروج فعلياً من الاتحاد الأوروبي لتدخل مستقبلاً مجهولاً.
ديناميات العنصرية
وبالعودة إلى ظاهرة ما بات يعرف في الإعلام الأميركي بالـ”ترامبية”، أو صعود دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة في الولايات المتحدة، على الرغم من تصريحاته المثيرة للجدل حول المهاجرين المكسيكيين والمسلمين واللاجئين والنساء والأقليات الأخرى. فما هي يا ترى الديناميكيات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي مهدت الطريق لصعوده؟ وقبل ذلك تفوقه على 16 من منافسيه داخل الحزب الجمهوري؟
لقد كان الخطاب التنافسي بين المرشحين النهائيين للرئاسة في العام 2016 مثيراً للغاية نتيجة للتناقضات الأيديولوجية الكبيرة المطروحة للنقاش أو تلك المرفوعة كشعارات، الأمر الذي أفصح عن تباين غير مسبوق في الفلسفات السياسية، وفي الوقت الذي دعت فيه هيلاري كلينتون وبيرني ساندرز إلى ما أسمياه «ثورة سياسية»، تمسك ترامب بشعار استعادة أميركا البيضاء لعظمتها، وهو ما دفع الخطاب السياسي في اتجاهين متعاكسين تماماً، يمين متطرف ويسار لا يقل عنه تطرفاً، على الرغم من أن مواقف هيلاري كلينتون قد تحولت في وقت لاحق إلى الوسطية الواقعية، أو الليبرالية التقدمية تحت تأثير شعبية ساندرز في أوساط الشباب وجاذبيته في المناقشات التلفزيونية والحملات الانتخابية.
ويعتقد الكثير من المحلّلين السياسيين في الولايات المتحدة بأن تمكّن ترامب من تحفيز أتباعه من اليمين المتطرف جاء بسبب استخدامه لمشاعر الاستياء العام لدى هؤلاء من التدهور الاجتماعي والاقتصادي، والعوامل التي أدت إلى تمكين الأقليات من توصيل أول رئيس أسود إلى الرئاسة في العام 2008. إن مثل هذه الطروحات يمكن لمسها بوضوح من خلال تفكيك الخطاب الترامبي، إن جاز التعبير، تفكيكاً نقدياً، وبالعودة إلى النصوص والشعارات يمكن استخلاص نتيجة مفادها أن عنصرية ترامب وشوفينيته تستندان بالدرجة الأساس إلى تحيزات أيديولوجية كامنة في الخطاب السياسي نفسه الذي يدعو للدفاع عن أميركا البيضاء ويتعهد باستعادة القوة الاقتصادية والاجتماعية للغالبية البيضاء على خلفية «الاستثنائية الأميركية»، كما يدعو برياء لما أسماه نصرة الطبقة الوسطى التي بنت البلاد ولاقت التهميش على أيدي مرشحي الحزب الجمهوري من الأكاديميين والرأسماليين.

لقد شهدت الدعوات العنصرية في أوساط الحزب الجمهوري تصاعداً مطّرداً كردة فعل عنصرية على تصاعد الداعين للحقوق المدنية منتصف الستينات من القرن العشرين، وتململ الحركات العنصرية البيضاء بإزاء المساواة العرقية، وصولاً إلى صعود ريتشارد نيكسون إلى سدة الحكم في العام 1968 وتحول الحزب، الذي عُرف تاريخياً بالنهج الليبرالي، إلى ائتلاف للمحافظين العنصريين، ومع مرور الوقت أصبحت الهوية العرقية المحافظة للبيض أكثر وضوحا.
لاحظ مثلاً أن أكثر الذين صوتوا لرومني (90 في المئة) في العام 2012 كانوا من البيض بالمقارنة مع (60 في المئة) لأوباما، كرد فعل مستهجن لآراء السود واللاتينيين والمهاجرين من الجمهوريين ككل، الأمر الذي دفع بترامب في الانتخابات الأخيرة لبناء إستراتيجيته الشاملة على هذا الاستهجان عندما سمّى المهاجرين المكسيكيين بـ”المغتصبين” ودعا لمنع المسلمين من دخول البلاد، وهي دعوات مفتوحة وملتهبة في المواقف العنصرية على نطاق واسع في قاعدة ناخبي الحزب الجمهوري، الذي باتت سياسته في العقود الأخيرة تتميز بالترويج لسياسة الاستقطاب. وهو الأمر الذي يثير الكثير من التساؤلات بشأن تحول حزب لينكولن من الخطاب المعتدل والليبرالي المساند للحقوق المدنية في الخمسينات والستينات من القرن العشرين، إلى الخطاب المتطرف الذي يتبناه دونالد ترامب وغيره الكثير من الجمهوريين المعاصرين.
لقد مرّت أكثر من 100 سنة على انتخاب أبراهام لنكولن للرئاسة في العام 1860، وكانت معطيات السياسة الأميركية مستقرة بشكل ملحوظ. على الرغم من القيود التي كانت مفروضة على تصويت السود، وكراهية الجنوب الأبيض الثابتة لحزب لينكولن، في وقت ظل فيه زعماء الحزب الديمقراطي مواظبين على استيعاب «الحساسيات» العرقية في الجنوب. ومزايا التأمين الاجتماعي للسود في الولايات الجنوبية بعد أن بدأ التحول الكبير في توجهات الحزب الديمقراطي في الستينات من القرن الماضي، عندما تبنى مواقف الحركات الاجتماعية التي دفعت بإدارة الرئيس جون كينيدي ومن بعده ليندون جونسون، لتفتيت المسألة العرقية في أميركا، وشيئا فشيئا بدأ التحول في مواقف الحزب الديمقراطي الحاد نحو اليسار بالاستناد إلى قضايا نبذ مفهوم العرقية، فضلا عن مجموعة متنوعة أخرى من القضايا والمسائل المتعلقة بمسؤولية الحكومة في الاقتصاد وحقوق الأقليات.
لقد أغضب احتضان ليندون جونسون للإصلاح في مجال الحقوق المدنية، على سبيل المثال، الناخبين البيض في «الجنوب الصلب»، الأمر الذي دفعهم للتخلي عن الحزب الديمقراطي لأوّل مرّة في العام 1964، مستندين إلى ما أسماه المحللون التاريخيون «مقاومة حركة الحقوق المدنية كظاهرة الجنوبية»، وقد أدى رد فعل البيض الجنوبيين هذا إلى المزيد من التوجهات العنصرية الجديدة لدى الحزب الجمهوري.
☚ ينشر المقال بالاتفاق مع مجلة "الجديد" الثقافية الشهرية اللندنية