من الأنثروبولوجي إلى الأدبي: أيّ علائق بينهما
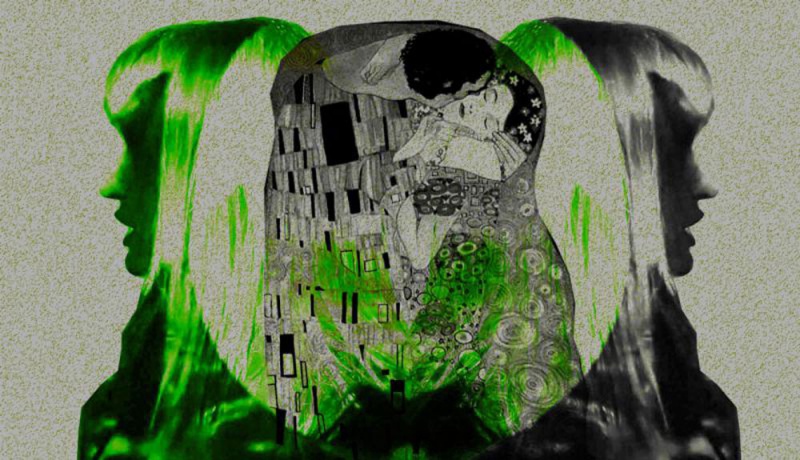
وحدة بحث "دراسات إنشائيّة" بكليّة الآداب بسوسة في تونس تخوض في العلاقات المتشعّبة بين الأدب والأنثروبولوجيا باعتبارهما يقومان على توظيف سرديّة الإنسان وعلى التنوّع الذي يمثّل الأصل. مقاربات في المفهوم وفي الرّهانات المعرفيّة والمنهجيّة والإيتيقيّة هو ما تمّ الاشتغال عليه.
ريم غانم
كفّت المناهج الأدبية المعنيّة بنقد النصوص وإعادة إنتاجها عن الانكفاء على دواخلها، و انفتحت على سبل، مدارات وحقول معرفيّة متعدّدة تطلب فيها ما يُشكّل صورة مختلفة عن النصّ ومادّته والظّروف الحافّة بإنتاجه وعلاقته بالآخر وأشكال توظيفه للمخيال الأدبي والجمعي.
إنها رياح التجديد اليوم، التي اجتاحت مختلف عوالم المعرفة الأدبية، شعارها التعدّد والانفتاح على الخارج النصي حتى لو لم يكن أدبيا. ولعل المقاربة الإنشائية التي نشتغل وفقها قد عُنيت بهذا الانفتاح من خلال طرح أسئلة جديدة تتجاوز الأدب بأجناسه المختلفة وتطمح إلى بناء معرفة بالأطر الفكرية والخلفيات الإبستيمية التي تترك أثرها فينا سواء كنّا من منتجي النصوص الأدبية بمختلف أجناسها أو من مستهلكيها ونقّادها.
وأمام وعيها بهذه الرّهانات اختارت وحدة بحث “دراسات إنشائية” بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة، برئاسة الأستاذ رضا بن حميد، مدير مدرسة الدكتوراه فيها الاشتغال على مبحث ما يزال في حاجة إلى الدرس، وهو “الأنثروبولوجي والأدبي: أي علائق تجمع بينهما”، وهل يمكن للأدب أن يطوع الأنثروبولوجيا مادة للدرس كمثل ما يتسنّى للأنثروبولوجي اعتماد الأدب مادة ومنهجا معرفيا؟
في كلمته الافتتاحيّة يعرض الأستاذ رضا بن حميد موجبات الاختيار انطلاقا من الوشائج العميقة بين الأدب والأنثروبولوجيا التي تعرّف بكونها علم الإنسان أو الإناسة، أو علم معرفة الإنسان معرفة شمولية، وهي من جنس العلوم الإنسانية التي تهتم بدراسة الإنسان من حيث قيمه الجمالية، الدينية، الأخلاقية، الاقتصادية والاجتماعية ومن حيث مكتسباته الثقافية على امتداد أزمنة مختلفة.
والبحث الأنثروبولوجي في نظره يتطلب التمعّن وتسليط الضّوء حول آليّاته وأبنيته وعلاقته بالإنشائيّة خاصة وأنّه قد تطوّر مع المقاربة الأنثروبولوجية الفرنسيّة والأنغلوساكسونيّة وحقّق فتوحات عديدة مثّلت حافزا للخوض فيه من منطلق علاقته بالأدب وبالأبنية الرمزية والأسطورية والمرجعية المنتجة للنص الأدبي والتي تترافد مع أبنيته الجمالية، الفنية والفكرية. وأكّد أن المقوّمات الإبستيمية التي تنعقد عليها المقاربات الأنثروبولوجية جعلت الإنسان صانعا لتاريخه وأدواته وعلاقاته وفقا لثنائية التموقع داخل المركزية الأوروبية الغربية أو خارجها على الهامش.
في الفكر الأنثروبولوجي

ويُلاحظ أنّ اهتمام وحدة بحث “دراسات إنشائية” بلغاتها الثلاث؛ العربية والفرنسية والإنجليزية بمبحث الأنثروبولوجيا والأدب هو حلقة أخرى تنضاف إلى جملة حلقات معرفيّة جسّدتها الندوات السابقة التي عُنيت بثيمات مختلفة مثل: الذات في الخطاب، إنشائية الرواية السياسية، إنشائية الفضاء في الآداب والفنون، المدينة في الخطاب الأدبي، دون أن نغفل عن المشاركة الفاعلة في ندوة كتابة الصمت بتونس، وندوة السرد والانفعالات بالتعاون مع جمعية الرابطة القلمية بمدنين والمساهمة في يوم دراسي حول التناص والأسلوب في الأدب بصفاقس. فضلا عن الأيّام الدراسيّة المنجزة داخل الكلّية .
إنّه عمل دؤوب تضافرت فيه مساعي كلّ الأطراف من إدارة وأساتذة وباحثين ومهتمّين بالحقل المعرفيّ لتحقيق نجاعة للبحث العلميّ ومواكبته التغيّرات الكبرى في عالم المعرفة.
انتظمت مداخلات أربع لتطارح علاقة الأدب بالأنثروبولوجيا في جلستين علميتين، الأولى برئاسة الأستاذ عبدالعزيز شبيل حاضر فيها الأستاذ رمزي بن عمارة مقدّما مدخلا إلى الأنثروبولوجيا الأدبيّة والأستاذ الهادي العيّادي حول أنثروبولوجية الشعر العربي. أمّا الجلسة الثانية فقد كانت برئاسة الأستاذ الهادي العيادي وحاضرت فيها الأستاذة جيهان عامر وموضوعها: ما من فكرة إلا وكان المتخيّل منبعها، والأستاذ رضا الأبيض حول المقاربة الأنثروبولوجيّة في دراسة الأدب وتدريسه. واستبقتها جميعا كلمتا الدكتور كمال جرفال عميد الكلية والدكتور البشير الوسلاتي الرئيس السابق لوحدة البحث.
مفهوميّا عُني الأستاذ رمزي بن عمارة بتتبع الفرق بين الأنثروبولوجيا كفكر قبل القرن التاسع عشر، والأنثروبولوجيا كمبحث منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر إلى اليوم، وفرّعها إلى مجالات بحث مختلفة جوهرها الإنسان في ذاته وغيريته، مفصلا أهدافها وارتباطها بأدب الرحلات وكتابات رجال الدين والمحاربين. كما أشار إلى مؤلفات عربية قديمة خاضت فيها لياقوت الحموي والنويري والبيروني وابن خلدون، منتهيا عند طرح إشكالية دور الرواية العالمية في تجسيد هذه العلاقة باعتبارها تقوم على ما يمكن أن يمثل مادة للبحث الأنثروبولوجي.
أما الأستاذة جيهان عامر فقد انطلقت من كتاب “بُنى المتخيل الأنثروبولوجي" لجيلبير دوران، الصادر سنة 1960، وجعلته مرجعها الأساسي لإثبات أنه ما من فكرة تخطر على بال الإنسان إلا وكان المتخيل منبعها، فقرأت قسميه؛ نظام الصور النهاري ونظام الصور الليلي وتفطنت إلى أن ما يربط تشعّبات هذا الكتاب هو اعتبار جيلبير دوران أن الصورة الذهنية هي الحاصل من “مسار أنثروبولوجي” يربط بين الجانب البيولوجي الجسدي في الإنسان والجانب الثقافي الروحي.
◙ اليوم الدراسي لحظة معرفية مخصوصة تركت أسئلة وسلكت مسارب وعرة في مقاربة العلاقة بين الأدب والأنثروبولوجيا
وأثبتت، كذلك، أن هذا الكتاب قد مثّل إضافة نوعية مرجعية للتراث الإنساني الكوني بما جاء به من نقلة حقيقية في علاقة الفكر الغربي بكل ما ينتجه الخيال البشري وفي الإقرار بالتكامل بين الجانبين الروحي والمادي في الإنسان، إضافة إلى تغييره للنظرة الغربية الدونية إلى الثقافات الكامنة خارج المركز الغربي.
وتنتهي الباحثة إلى تثمين الإضافة الكبرى لكتاب جيلبير دوران الذي اعتبر أن كل ما ينتجه العقل البشري يرتدّ في النهاية إلى تلك البنى الأنثروبولوجية التي لا فرق فيها بين شعب وآخر في ما يقع إنتاجه من صورة ورموز.
المقصود بهذه المقاربة هو إجراء الأنثروبولوجي، على تعدده، وسيلة لاستنطاق النصوص الأدبية رغم أن المسألة قد اعتبرت مثار خلاف بين الأنثروبولوجيين أنفسهم ومثار حيرة عند نقاد الأدب.
والبداية كانت بمداخلة الأستاذ الهادي العيادي حول أنثروبولوجيا الشعر العربي، مشيرا فيها إلى التعدد الأنثروبولوجي الذي أعقب أزمة البنيوية، واتجه صوب النصوص المكتوبة وليس الدراسات الميدانية. وأقر بأن هذه الأزمة قد أفضت إلى توسيع التفكير الأدبي نحو المزيد من فض أختام المسكوت عنه وإخماد صوت المؤسسات القاهرة.
وقد سعى الأستاذ المحاضر إلى الاستعانة بما يتيحه له النقد الثقافي الذي يعنى بدراسة الأنساق المهمشة أو المضمرة في الشعر العربي الحديث ليجعلها مدخلا للبحث في علاقة قصيدة النثر كما كتبها أنسي الحاج في مجموعتيه الشعريتين “لن” و”الرسولة بشعرها الطويل حتى الينابيع” بالجسد من خلال ثنائية “اللحم” و”الجسد".
وهي ثنائية يرسم من خلالها أنسي الحاج خطى السرياليين، مؤكدا أنه صاحب فضل في بلورة نظرية قصيدة النثر وجعل الشعر العربي الحديث ينفتح على التجارب الكونية، ويتمرد على أصوات القمع خاصة ما تعلق منها بجسد الأنثى حتى تضحى الأنوثة مثقلة بالجمالي، تتعمّد بالماء وتتطهر من أدران الحس فيصفو كيانها ويشف.
المقاربة الأنثروبولوجية للأدبي

أما الأستاذ رضا الأبيض فقد عرض بالدرس إلى تتبع خواص العلاقة بين الأنثروبولوجي من ناحية والأدبي من ناحية أخرى في إطار دراسة الأدب وتدريسه، أي الأنثروبولوجيا التعليمية الديداكتية. ووصف العلاقة بينهما كمن يركب قاربا صغيرا في ملتقى محيطين شاسعين التهاميين.
وقد أشار المحاضر إلى رهانات البحث الأنثروبولوجي واختزلها في اكتشاف التنوع الاجتماعي وفهم تماسك المجتمع أو انحلاله ودراسة العلاقة بين البشر والطبيعة. واعتبر أن المسألة مثيرة فعلا لتحد معرفي ومنهجي يشغل الناقد ويشرّع لظهور دراسات نقدية هامة ذات طابع تأملي، تتطلب مساهمة فاعلة فيها من طرف الناقد.
◙ الرهان الأساسي للمقاربة الأنثروبولوجية هو تفكيك المركزية وتنسيب المواقف وتحمل المختلف والاعتراف به
ويؤكد الأستاذ الأبيض أن هذه المساهمة لا تكون بالبحث عن توظيف الأدب للأساطير والحكايات الشعبية والممارسات الثقافية الرمزية فحسب بل بمحاولة إدراك مدى قدرة النصوص على تأسيس أسطورتها الخاصة على غرار ما فعل حنا مينه في سردياته عن البحر أو إبراهيم الكوني في سردياته عن الصحراء.
كما اعتبر أن هذه المسألة تثير الرهان الإيتيقي بالنسبة إلى مدرّس الأدب الذي اختار المدخل الأنثروبولوجي في دراسة الرواية أو الشعر أو المسرح ومن خلاله يستهدف إقدار المتلقي على الاعتراف بالآخر المختلف وتجنب الأحكام القيمية المعبرة عن مركزية حضارية أو دينية أو طبقية. ليستخلص أن الرهان الأساسي للمقاربة الأنثروبولوجية بعد المرحلة الاستعمارية هو تفكيك المركزية، وتنسيب المواقف، وتحمل المختلف والاعتراف به، باعتبارها فرصة هامة للأدب تعيده إلى الأصل المتميز بالتنوع في مواجهة الانحراف الذي حدث بفعل العولمة وطمس الاختلاف والتغاير.
أسئلة نظرية ومنهجية محرجة ورهانات إيتيقية لا تتم النجاة منها إلا بالتقدم بخطى ثابتة من داخل المسافة المشتركة بين الإنية والغيرية وليس على أطرافها. ولا نشك في أن المقاربة الأنثروبولوجية توفر للدارس أو المدرّس هذه الفرصة التاريخية.
لقد شكل هذا اليوم الدراسي لحظة معرفية مخصوصة تركت أسئلة وسلكت مسارب وعرة في مقاربة العلاقة بين الأدب والأنثروبولوجيا، ومن شأنها أن تثير إشكالات تتطلب الدرس النقدي وتتجاوز الأدب بأجناسه المختلفة وتنحو إلى الانفتاح على الخارج النصي الذي يتجسد مخفيا في هذا الداخل. إنها لعبة العلامات التي لا ينفصل فيها الداخل عن الخارج ولا يتميز فيها مجتمع عن آخر.




















