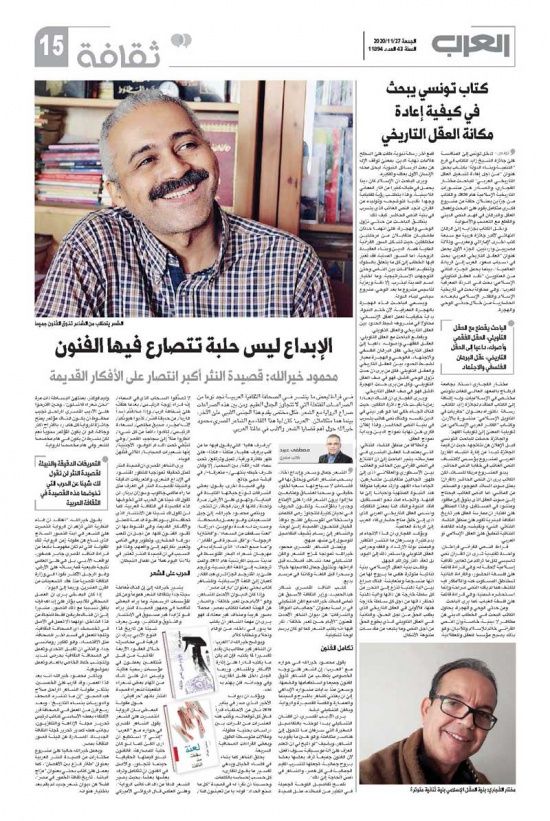كتاب تونسي يبحث في كيفية إعادة مكانة العقل التاريخي
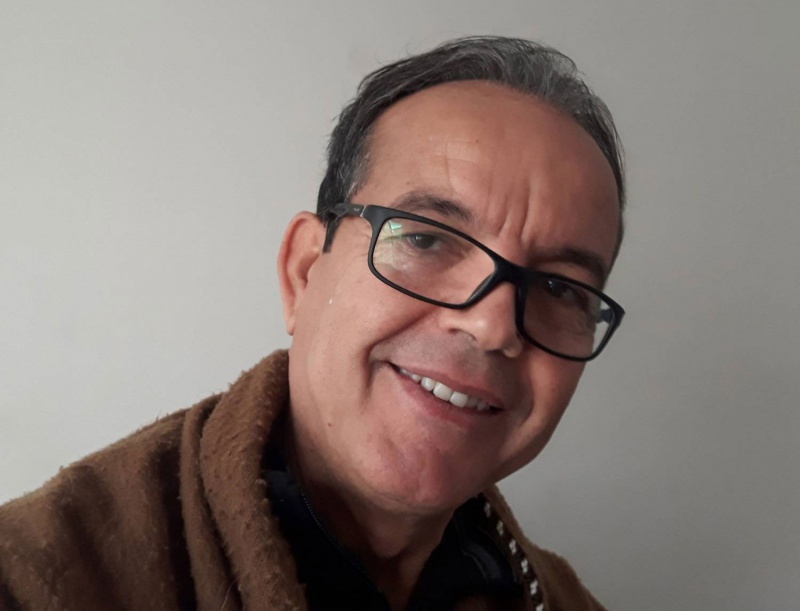
تونس ـ تدخل تونس إلى المنافسة على جائزة الشيخ زايد للكتاب في فرع “التنمية وبناء الدولة” بكتاب يحمل عنوان “من أجل إعادة تشغيل العقل التاريخي العربي” للباحث مختار الفجاري، والصادر عن منشورات التاريخية الإسلامية عام 2020، والكتاب من جزأين يمثلان حلقة من مشروع فكري متكامل يقوم على البحث وإعمال العقل والبرهان في فهم النص الديني والقطع مع التعصب والأصولية.
ودخل الكتاب بجزأيه إلى الرهان النهائي لأكبر جائزة عربية مع سبعة كتب أخرى لإماراتي ومغربي وثلاثة مصريين وأردنيين، الجزء الأول يحمل عنوان “العقل التاريخي العربي: بحث في أسباب صعود العرب إلى الريادة العالمية”، بينما يحمل الجزء الثاني من العناوين، “نقد العقل التأويلي الإسلامي: بحث في الردّة المعرفية للعرب”، وهي محاولة بحث في تاريخية الإسلام والفكر الإسلامي بأبعاده الحضارية من خلال حدثي الوحي والهجرة.
مختار الفجاري أستاذ بجامعة قرطاج بالمعهد العالي للغات بتونس مختص في الإسلاميات، وله إضافة إلى الكتاب المتقدم لجائزة زايد للكتاب، رسالة دكتوراه بعنوان “حفريات في التأويل الإسلامي” منشورة بالأردن، وكتاب “الفكر العربي الإسلامي: من تأويلية المعنى إلى تأويلية الفهم”.
والجائزة حصلت للباحث التونسي قبل الإعلان عن نتائجها، حيث أن قيمة الجائزة تبدأ من إثارة انتباه القارئ العربي لمشروع يؤسس لاكتشاف النص الغائب في خفايا النص الحاضر.
يبدو المشروع مربكا للسائد، لكن الكاتب يرى أن النص الحاضر (القرآن) يمثل صوت السائد الموجود والمستمر من الماضي، أما النص الغائب، فيحتاج إلى صوت العقل الذي يتوق إلى مفقود ومنشود في المستقبل، وهذا المنطقي على اعتبار أن ممارسة العقل عبر تاريخ الثقافة البشرية تقوم على منطق التضاد الثنائي، الشيء ونقيضه، وهذه القاعدة الثنائية تنطبق على العقل الإسلامي أو العربي.
قراءة النص القرآني قراءتان، واحدة تقليدية ترى أن القرآن نص تأسيسي لكل ما تراكم من تعابير ثقافية إسلامية لاحقة له، وهي قراءة قائمة على فلسفة الحضور، والقراءة الثانية تستنطق المسكوت عنه واللامفكر فيه للكشف عما لم يقله النص صراحة وإنما استحضره ضمنيا، وهي قراءة قائمة على فلسفة الغياب، كما يرى الباحث.
ومن حدثي الوحي والهجرة، يحاول الكاتب البحث في الخطاب الديني عن مظاهر لا دينية، خاصة وأن النص القرآني خاتم للإسلام وللأديان، وهو بذلك يصبح مؤسسا للعقل وللعقلانية، فمع آخر رسالة نبوية، طفت على السطح علامات نهاية الدين، بمعنى توقف الإله عن بعث الرسائل النبوية، ليحل محله الإنسان الأول بعقله وتفكيره.
الكاتب يحاول البحث في الخطاب الديني عن مظاهر لا دينية، خاصة وأن النص القرآني خاتم للإسلام وللأديان، وهو بذلك يصبح مؤسسا للعقل وللعقلانية
ويرى الباحث أن الإسلام كان دينا يحمل في طياته كثيرا من آثار المعاني اللادينية، وهذا يتطلب رؤية تفكيكية وجهدا نقديا لتوضيحه وتوليده من القرآن، لنجد النص الغائب الذي يتسرب في بنية النص الحاضر. كيف ذلك؟
ينطلق الباحث من حدثي نزول الوحي والهجرة، على أنهما حدثان مفصليان متقابلان من مرحلتين مختلفتين، حيث تشكل السور القرآنية المكية عماد الدين وبناء العقيدة الروحية، أما السور المدنية، فقد تغيّر فيها الخطاب إلى كل ما يتعلق بالسلوك وتنظيم العلاقات بين الناس وحتى التوجهات الاستراتيجية، وما اختيار اسم المدينة ليثرب، إلا دقة ورمزية لتأسيس مشروع ما بعد الوحي، مشروع سياسي لبناء الدولة.
ويسمي الباحث هذه الهجرة بالهجرة المعرفية، لأن ختم النبوة، بداية حقيقية لعمل العقل الإنساني، محاولا في مشروعه ضبط الحدود بين العقل التاريخي والعقل التأويلي.
ويقطع الباحث مع العقل التأويلي، العقل الفقهي وأصوله، داعيا إلى العقل التاريخي، عقل البرهان الفلسفي والاجتهاد، فالوحي والهجرة معيار لضبط الحدود بين العقل التاريخي والعقل التأويلي، فكل من يرى أن حدث نزول الوحي أفضل، فهو في صف العقل التأويلي، وكل من يرى حدث الهجرة أفضل فهو في صف العقل التاريخي.
ويرى الفجاري أن هناك أبعادا رمزية بقيت خارج دائرة التفكير، حيث هناك اتجاه خفي لما هو غير ديني في الدين نفسه، وهناك نص غائب يتسرب في بنية النص الحاضر، وهذا إعلان فكري عن نهاية نموذج الدين وبداية نموذج العقل.
وانطلاقا من منطق التضاد الثنائي، التي يعتمدها العقل البشري في ممارساته، يشير الباحث إلى أن التنازع في النص القرآني بين الحاضر والغائب، بين الأسطوري والعقلاني أدّى إلى ظهور اتجاهين متقابلين متصارعين، اتجاه أساء الفهم، وارتد معرفيا متوقفا عند النبوة المنتهية وأحيانا إلى ما قبلها، واتجاه امتد نحو المستقبل، فنقد النبوة والنقد هنا بمعنى التفكيك، وأسّس العقل التاريخي العربي الذي أدّى إلى خلق مناخ حضاري قاد العرب إلى الريادة العالمية.
ويؤكد الفجاري أن هذا الاتجاه لم يدم كثيرا، وسرعان ما انتشر التكفير وهيمنت دولة الارتداد والفقه وحراس العقل التأويلي واستمر ذلك إلى اليوم، بل تعقّد أكثر وتراكم الجهل.
وظلت بنية العقل الإسلامي، بنية ثنائية متوترة عكس ما يروج لها من أنها منسجمة ومتعايشة. هناك صراع بين آلية ذهنية تنزع إلى التحرر من كل سلطة خارجة عن ذاتها وآلية ذهنية تحتقر ذاتها من أجل كل سلطة خارجة عنها، فالأولى هي العقل التاريخي الذي يطلب الحق من أجل الحق، والثانية هي العقل التأويلي الذي يطوّع الحق من أجل النص وما يتبعه من مقدسات متنوعة الأشكال.