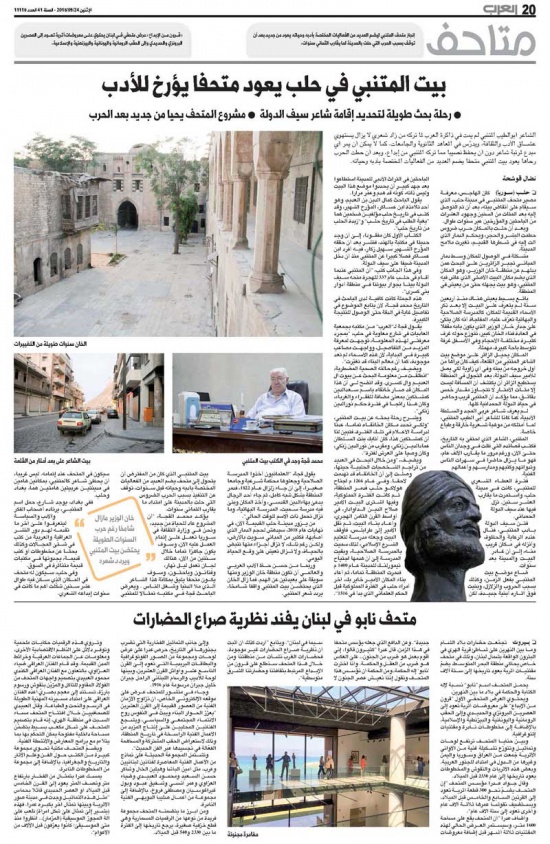كافكا أكثر الكتاب تأثيرا في الرواية العربية

النزعة الكافكوية وأثرها هما المدخل النقدي المقارن الذي استحضره الناقد نجم عبدالله كاظم في كتابه الجديد “كافكا والكافكوية والرواية العربية والبحث عن الخلاص” حيث مقاربة هذه النزعة التي تحولت إلى ما يشبه “العدوى” في تاريخ الرواية، ومنها الرواية العربية، حيث وجدت في عوالم كافكا الغرائبية شغفا بمواجهة محنة الإنسان المطارد، ومحنة الضمير المُعذّب، ذلك الذي يدفع قارئه إلى هواجس البحث عن التطهير، كما استغرقتها بعض روايات كافكا ذات الحساسية الدينية اليهودية.
قد تكون سردياتُ الكوابيس، والشخصيات الغرائبية مجالا لقراءة تحولات الكائن الغربي وهشاشته، ومدخلا للنظر إلى محنته الأنطولوجية، إذ بدت روايات فرانز كافكا أكثر تمثيلا لهذا التحوّل في تاريخ الرواية الحديثة، حيث ضآلة الكائن إزاء رعب صعود الرأسمال، والحرب، والكراهية، وحيث أنموذجه اللامعقول الذي يعيش اغترابه الداخلي وسط عالم مسكون بفكرة الخطيئة والذنب والخلاص، وهي ثيمات تطهيرية بدت أكثر غموضا في رواياته.
منهجية الكتاب، الصادر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر ببيروت 2018، اعتمدت المقاربة المقارنة، كسياق إجرائي للتعرّف على السردية الكافكوية من جانب، مقابل توصيف أثرها على الرواية العربية من جانب آخر، وبوصف هذه المنهجية تأطيرا لفعل القراءة، وتأكيدا لفاعليته في مقاربته الدرس المقارن، فضلا عن تقديمها فرشة واسعة عن تلاقحهما على مستوى الأثر والتأثير، وعلى مستوى إثراء الجانب الإجرائي لبيان حدود الدرس ومنهجه.
التأثر بكافكا
ضم الكتاب تمهيدا وتوصيفا عن علاقة الأدب العربي بالآداب الأجنبية، وعن مدى تأثر روائييه وقصاصيه بتلك الآداب، وقسمين حاول من خلالهما كاظم وضع الثيمة الكافكوية في سياق وصفها كتيار تاريخي في الرواية العالمية، وفي سياق إضاءة استخدامها من قبل عدد من الروائيين العرب، والذين وجدوا في “الفنتازيا الكافكوية” تمثلاتهم النفسية والسردية، على مستوى ترميز الرعب، والخوف الذاتي، أو على مستوى نقد السلطة والأدلجة والعنف في الواقع العربي، وعبر ثيماته اللامعقولة اجتماعيا ونفسيا وحتى سياسيا، فضلا عن ملحقين ضمّ الأول أسماء عدد كبير من الكتّاب العرب الذين تأثروا بنزعات كتابة اللامعقول، وضمّ الثاني أهم تلك النزعات التي استغرقت مجالات التجريب الروائي، وهوس الرواية العربية بأزمة البطل المطارد، والبطل المغترب وعبر تقانات التجريب والواقعية السحرية وغيرها.
أبطال مطاردون
وضعنا الباحث أمام عوالم كافكا، وغرائبية كتابته، تلك التي اصطنعت لـ”اللامعقول” مجالا سرديا، لمواجهة محنة الذات، ومحنة الواقع الذي تعيش اضطراباته وقلقه، والتي كان البطل الكافكوي أنموذجها المثير للجدل، حيث وجد فيه عدد من الروائيين العرب علّتهم في مقاربة البطل المطارد، واقعيا ورمزيا، أو في صورة “البطل المغترب” لا سيما وأنّ رواياته التي تُرجمت للعربية (المسخ، القضية، المحاكمة، أميركا) تحولت إلى فضاء عاصف، وإلى حوافز دافعة نحو تقانة اللامعقول، ونحو البحث عن المرجعيات النفسية والفلسفية والميتافيزيقية التي تقف وراء رواياته، لا سيما وأن صورة البطل المطارد والمغترب كانت من أكثر الصور تمثيلا لصورة البطل الإشكالي في الرواية العربية، ولمحنة علاقته الملتبسة والغامضة بالسلطة وبرموزها غير واضحي الملامح، وحتى بالتاريخ وهواجسه وشيفراته.
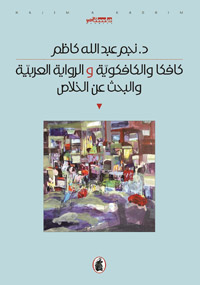
وفي هذا السياق يُحدد الباحث سمات تأثر الروائيين العرب بروايات كافكا، إذ تتبدى من خلال الاطلاع على وظائفية الفنتازيا والغرائبية واللامعقول، وعلى طبيعة العوالم المعقدة التي عاشها كافكا، وعلى طبيعة شخصيته المضطربة، والهلوسية، مقابل حساسية الروائي العربي إزاءه، وإزاء تمثلاته، بوصفه “آخر” له مرجعياته الدينية والبيئية والأيديولوجية، ومدى القدرة على توظيف هذا اللامعقول في تحبيك البنى السردية، وفي تمثيله لموضوعات الهوية والتاريخ، والخطاب والرؤية.
لقد اختار الباحث عددا من الروائيين العرب والذين وجد في تجاربهم الروائية “براديغمات” واضحة للتمثيل الكافكوي، على مستوى المعالجة السردية، أو على مستوى وظائفية الشخصية المأزومة والمطاردة، ومن أبرزهم محي الدين زنكنة، وجورج سالم، وجبرا إبراهيم جبرا، وإبراهيم نصرالله، ويوسف الصائغ، ويحيى الطاهر عبدالله، ويحيى جواد، حيث ينخرط أبطال روايات هؤلاء الكتّاب في البحث، وفي مواجهة عسف المطاردة، والعيش قلقا وخوفا وشكّا في أتون رعبها، والتي تنعكس من خلالها تبديات المحنة السياسية، ومحنة المنفى، والسجن، والاضطهاد والقهر، والضياع الوجودي، مقابل محنة كافكا الوجودية، تلك التي عاش استلاباتها في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.
توظيف النزعة الكافكوية في الرواية العربية كان أكثر اقترابا من الهاجس السياسي، فرغم أنّ الباحث قدّم لنا توصيفا منهجيا لطبيعة الأثر الكافكوي، إلّا أنّ خصوصية هذا الأثر، والتي حصرها الباحث في ثلاثية: العوالم الغريبة واللامعقولة، والسلطة والبطل المطارد، والاغتراب والإحساس بعدم الأمان، بدت واضحة في تمثيلها للجانب السياسي، ولوظيفة حركة البطل الحزبي أو الثوري، أو البطل المنفي المطارد من الاحتلال، البطل الذي يعيش محنة انكساره وهزيمته الوجودية والرمزية، وحتى استلابه الجنسي، وهي تمثلات تقارب إلى حدّ ما الملمح الأسطوري الذي أشار إليه روجيه غارودي، وهو يصف التأثير الكافكوي بأنه “نجح في صناعة عالم أسطوري لا ينفصل عن عالمنا”.
من أكثر التجليات النقدية والبحثية في هذا الكتاب المنهجي، والتي أراد الباحث تسويغها تعود إلى تعالق دراسة خصائص التأثر الكافكوي مع مرجعيات فلسفية ونفسية، وحتى دينية وثقافية متعددة، تلك التي ارتبطت بأطروحات الحداثة، وبمناهجها، وبما جعلها تُسهم في جعل الأنموذج الكافكوي مجسّا للتعرف على الكثيرٍ من الأزمات والصراعات، فضلا
عن هوية الشخصية المشغولة بثيمات تلك الصراعات، والتي هي أضحويتها أيضا، إذ تعيش هذه الشخصية المستلبة والمطاردة والخائفة، والمحاصرة مثل شخصية “ك” الكافكوية هواجس البحث عن الذات، أو حتى الهوية، وكأنه أراد أنّ يقول لنا إنّ الأثر الكافكوي لا ينفصل عن مركزيات الأثر الأنكلوسكسوني في ثقافتنا العربية، والتي أورد الباحث لنا في هذا الكتاب عددا من الترجمات الإنكليزية لأدباء وباحثين غربيين آخرين، من منطلق منهجيته في الدرس المقارن، أو في سعيه لمقاربة الأثر الكافكوي بوصفه واحدا من أكثر المؤثرات التي انعكست على القص الروائي، وعلى بنيات التحبيك السردي.