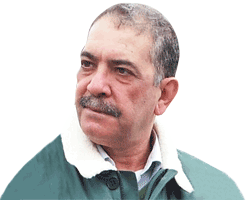ناديا صيقلي.. المحلقة بشرقها بجناحين غربيين

“ناديا صيقلي ومعاصراتها” ذلك هو عنوان المعرض الذي يُقام في مركز مرايا للفنون بالشارقة. أما معاصرات ناديا فإن بعضهن أكثر شهرة منها. لوحات المعرض تمت استعارتها من متحف بارجيل للفنون. كان لناديا الحصة الأكبر في العرض. لذلك بدا المعرض كما لو أنه استعادي لتجربة فذة في عالم التجريد.
إضافة إلى صيقلي ضم المعرض أعمالا لسلوى روضة شقير، هاغيت غالان، إيتيل عدنان وهلن الخال من لبنان، مديحة عمر من العراق، منى السعودي ومليحة أفنان من فلسطين، أسماء الفيومي من سوريا، ومنيرة القاضي من الكويت. فمَن هي ناديا صيقلي التي اجتمعت حولها فنانات من أزمنة وأماكن مختلفة؟
في مرسم بيكاسو

◄ واحدة من أهم فنانات وفناني التجريد الصافي
ما من أثر من بيكاسو في لوحاتها، غير أن شبح الرسام الإسباني يتجول في مرسمها. أهنا ولدت لوحته الشهيرة “فتيات أفنيون” عام 1907. تلك اللوحة التي غيرت وجه الرسم في القرن العشرين؟
الصدفة وحدها جمعت بين ناديا صيقلي وبيكاسو. فمنذ عام 1979 انتقلت صيقلي للإقامة في حي الفنانين الباريسي (الباتو لافوار) وكان من نصيبها المرسم الذي سبق لبيكاسو أن أقام ونفذ فيه أعماله التي تعود إلى السنوات الأولى من إقامته الباريسية.
صيقلي التي تنتمي إلى جيل الحداثة اللبنانية الثاني، شفيق عبود وإيفيت أشقر وهلن الخال وجان خليفة وأمين الباشا وسواهم، اختارت أن تتماهى مع محل إقامتها الأخير فجعلت من مستويات التجريب التجريدي الذي تميزت به مدرسة باريس في خمسينات القرن الماضي قاعدتها للانطلاق في اتجاه أسلوبها الشخصي.
عوضتها تلك المحاولة عمّا يمكن أن ينتج عن انفصالها عن الواقع من خسائر. كانت الطبيعة هي اللقية الثمينة التي عثرت عليها. لقد فتح التجريد أمامها أبوابا واسعة تطل من خلالها على الطبيعة في تحوّلاتها. فكانت تمزج في رسومها فتنة الحدث اللوني لدى كلود مونيه بكثافة الأشكال في تقاطعاتها لدى نيكولاس دو ستايل.
سيُقال إنها في ذلك إنما تنافس زميلها، الباريسي هو الآخر شفيق عبود، وهو قول يحتمل الصواب، لولا أن صيقلي كانت أكثر حرصا من عبود على سعة المساحة الجمالية التي تعمل فيها تجريبيا.
في مرحلة معينة من مراحلها كانت شبيهة بعبود. وهو ما لا يمكن إنكاره. غير أنها لم تستلم للقدر الذي يمكن أن يجعل منها المقابل الأنثوي اللبناني لعبود. فمن وجهة نظري فإن صيقلي تخطت عن طريق التنويع في مصادرها الإلهامية تلك العقدة. فلم تعد المقارنة بين الاثنين واردة.
ربما من الإنصاف القول إن تمرد صقيلي كان منصبّا في الأساس على مصادر خيالها التجريدي التي ربطتها بمدرسة باريس. كان لديها فائض من النور الذي حملته من الشرق معها وهو ما صارت تلجأ إليه في حمى ارتجالاتها التجريدية.

◄ صيقلي تنتمي إلى جيل الحداثة اللبنانية الثاني
لم تتلصص على الرموز أو الإشارات أو الخطوط أو الزخارف التي تربت عليها جماليا، بل بعث فيها ذلك النور المقيم في حواسها روح المغامرة التي دفعت بها إلى اختراق السطح بحثا عن مصادر إلهام جديدة.
ولدت ناديا صيقلي عام 1936 في بيروت. عام 1953 التحقت بالأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة (ألبا). عام 1956 تابعت دراستها الفنية في محترف هنري غونز بباريس. ما بين عامي 1963 و1974 درست الرسم في الأكاديمية اللبنانية التي تخرجت فيها. بعد ذلك انتقلت إلى باريس لتقيم فيها.
في طريق العالمية
وكما يبدو فإن إقامتها في باريس قد فتحت لها أبوابا للتعريف بفنها، فكان المعرض الذي أقامه لها مركز جورج بومبيدو عام 1978 بمثابة خطوة واثقة ألقتها صيقلي في طريق العالمية. المعرض الذي حمل عنوان “نوافذ على ما غاب عني” وضم 30 لوحة، نفذت بتقنية الحفر الطباعي كان محط اهتمام ودهشة الأوساط الفنية الفرنسية التي حملها المعرض في اتجاهين. ففي الوقت الذي كشف فيه المعرض عن عمق ومساحة الدمار الذي تسببت به الحرب الأهلية اللبنانية فإنه أهدى الفرنسيين موهبة فنية، جددت لديهم الأمل في ما يمكن أن يجلبه الأجانب معهم من حيوية فنية.
لقد أجبرت موهبة صيقلي المؤسسات الفنية الفرنسية على احتضانها، فكان انتقالها إلى حي الفنانين عام 1979 واحدا من ثمار ذلك الاحتضان. غير أن معرض بومبيدو كان في الوقت نفسه تتويجا لسلسلة من العروض التي قدمتها الفنانة في باريس بدءا من العام 1964. هناك عشر سنوات قضتها الفنانة وهي تنقل أعمالها للعرض بين بيروت وباريس في محاولة منها لاختبار مزاجها التصويري. وهو ما هداها أخيرا إلى أن تقرر الإقامة في باريس لتعود من بعدها إلى بيروت زائرة.
في بيروت فتحت صيقلي نافذة على باريس غير أنها في العاصمة الفرنسية فتحت نوافذ عديدة على بلدها.
المجهولة عربيا

في وقت مبكر من حياتها الفنية تعرفت ناديا على رسوم الفرنسي بول سيزان (1839 ــ 1906) كان ذلك اكتشاف حياتها. حدث ذلك عام 1957. عن طريق سيزان دخلت الفنانة إلى عالم التكعيبية. تأثرت بالتكعيبيين (بيكاسو، براك) ولم ترسم مثلهم. أخذتها نظرتها التأملية إلى مكان آخر. غير أنها استفادت من سيزان في التعرف على عناصر الرسم مجردة عما يمكن أن تنتجه علاقاتها من أشكال.
تقول “انجرفت وراء لذة الاكتشاف والتعبير بواسطة التجريد عن المادة والألوان والإيقاعات،” وهنا بالضبط يقع عالمها، بدءا من الخطوط العمودية التي كانت تتحرك وفق إيقاع بصري متفاوت المسافات وانتهاء بفضاء شعري، جعلت منه الرسامة ملعبا لمختلف أنواع العلاقات البصرية. وكان المغزى الذي تهدف إليه واحدا في المرحلتين، أن تخلق تأثيرا بصريا يتجاوز المتلقي من خلاله كلفة المعنى وثقل السؤال المعرفي.

الغموض الذي يكتنف لوحات صيقلي هو تعبير عن الحاجة إلى أن نرى اللوحة بمعزل عمّا نطلبه من خلالها مسبقا. تجرنا اللوحة بلغتها الجمالية إلى عالم، لن يكون حاضنة لأيّ تعريفات محتملة للجمال. لا تقدم الرسامة نموذجها الجمالي مستندة إلى ما تراه، بل إلى ما تعثر عليه مختبئا تحت سطح لوحتها. إنها في الحقيقة تستخرج ذلك النموذج لتضيف إلى الكون مساحة جديدة، هي السنتمتر الذي لم يكن موجودا من قبل.
باستثناء ما عرضته في بيروت ومعرض يتيم أقامته في الكويت عام 1984، فإن العالم العربي لم يتعرف على رسوم ناديا صيقلي. غالبا ما يقدمها نقاد الفن ومؤرخوه باعتبارها فنانة فرنسية مولودة في بيروت. وقد لا يهم في شيء ذلك التعريف. غير أن عدم التعرف عربياً على عالم هذه الفنانة الفني (هناك سواها) انعكس سلبا على الأحكام النقدية التي يتداولها نقاد الفن العرب، وهو ما يشكل ثغرة كبيرة في مجال معرفة التاريخ الفني في العالم العربي.
ناديا صيقلي هي واحدة من أهم فنانات وفناني التجريد الصافي. لا تكمن أهميتها في انتمائها إلى مدرسة باريس، بل في موهبتها التي أهلتها للتمرد على تلك المدرسة والانعتاق من أساليبها مدفوعة بتوق اكتشاف ذاتها في إطار التجربة التجريدية. وهو ما توصلت إليه حين مزجت تربيتها المدرسية الغربية بما ترسب في أعماقها من تجارب روحية، تمتد جذورها في أرض خصبة بالتأمل الشرقي.
ليست صيقلي غربية تماما غير أنها بالقوة نفسها ليست شرقية تماما. إنها الصفتان مؤتلفتان. غربية في بناء لوحتها، فهي تراعي في ذلك البناء كل ما تعلمته من قواعد وهو ما يفعله أيّ فنان آخر. شرقية حين يتعلق الأمر بما يتم استخراجه من إيقاعات، هي بمثابة مرايا للروح في علوها وهبوطها. هذه المرأة ترتجل تجليات للمادة لا حدود لها.
يتغلب التجريد لديها على سوء الفهم. هناك متعة في النظر إلى لوحاتها تسرّ الناظرين وتعوض البعض منهم عن غياب المعنى، إذا أردنا التبسيط. غير أن غنائيات صيقلي ليست من النوع الميسر. فالفنانة بالرغم من ماضيها الزخرفي لا تسمح بأي بقعة تزيينية بالتسلل إلى رسومها. ما ترتجله ليس معدا سلفا، لذلك فإنها لا تلجأ إلى الإشارات الجمالية المتاحة التي من شأن وجودها أن يشعر المتلقي بالاطمئنان.
الجمال الذي تقترحه صيقلي هو جمال لحظوي، أشبه باستدراك خطأ.