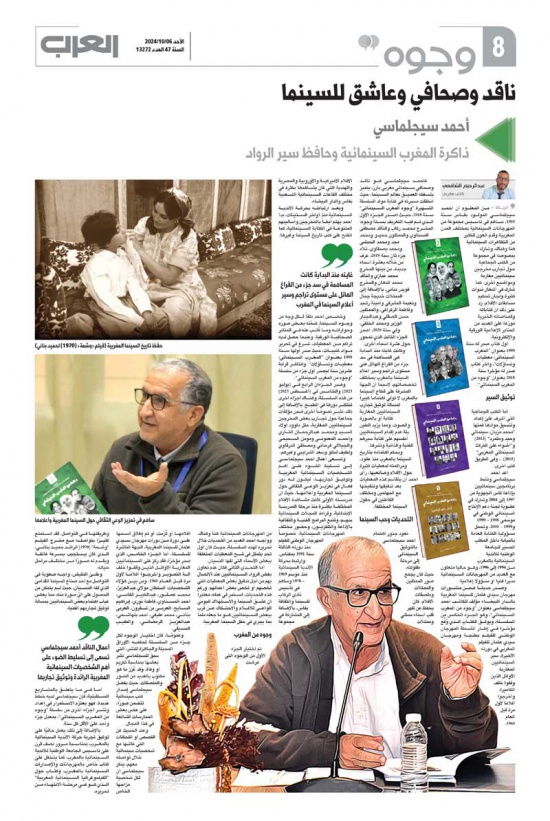محمد جبريل لـ"العرب": لديَّ عشرون كتابا مكتملا ولا أسعى إلى النشر

من الكتّاب من تمثل الكتابة عنده فعلا يشبه التنفس، لذا فهو لا يوقف قلمه البتة بل يواصل الكتابة، بينما لا يكون الهاجس عنده النشر والانتشار بقدر ما يكون المتعة وفعلا وجوديا خالصا. من هؤلاء الكاتب المصري محمد جبريل، الذي لاقته “العرب” في منزله وكان لنا معه هذا الحوار حول تجربته ورؤاه في الأدب والثقافة العربيين.
القاهرة - الكتابة حياة، يعيش من خلالها القارئ حيوات متعددة، يبحث عن نفسه في تجارب تماثل تجربته، وبالنسبة إلى الكاتب نفسه هي ليست مهنة أو صنعة أو بحثا عن كسب أو شهرة، إنما هي الهواء الذي يعيش به.
يؤمن الكاتب المصري الكبير محمد جبريل بذلك، ويعد ممن ينطبق عليهم هذا القول بأكثر من سبيل، تشهد على هذا تجربته الممتدة في الكتابة منذ عام 1970، وإنتاجه الغزير بما فاق التسعين كتابا، ما بين رواية وقصة قصيرة وسيرة ذاتية ودراسة.
أكتب طالما أتنفس
يكشف محمد جبريل في حديثه مع “العرب” النقاب عن أنه لا يزال لديه الكثير، قائلا إنه يحتفظ بحوالي عشرين كتابا مكتملا، أنهى كتابتها دون أن يفكر في كيفية أو توقيت نشرها، ولا يطلب النشر من أحد، أو يحسب كم سيأخذ من الأموال مقابلا لها.
يستوقفني الرقم، خلال الحوار الذي جرى معه داخل بيته في حي مصر الجديدة (شرق القاهرة) على أريكته المفضلة، “عشرون كتابا”، أسأله، فيجيب “ربما أبدأ في الكتاب الحادي والعشرين في الغد”، موضحا أنه يكتب لمتعته والتعبير عن رأيه، ولا يشغل باله بمسائل النشر، حتى أن البعض ظن أنه قد توقف عن الكتابة.
يقول محمد جبريل البالغ من العمر 86 عاما “إنْ لم أكتب سأموت”، كاشفا أنه يكتب بغزارة منذ أن كان شابا في سن الثامنة عشرة، ويريحه هذا، فهو لا يخرج من بيته لأسباب صحية منذ حوالي سنة، ويرى أن الكاتب الحقيقي ينبغي أن يكون هكذا، قائلا “لا يهم توقيت النشر، فهو سيحدث ولو بعد وفاتي، لكن اليوم الذي أتوقف فيه عن الكتابة سيكون يوم توقف نبضي، وطالما ظللت أتنفس فإنني أكتب، هذا ليس كلاما إنشائيا إنما حقيقة”.
الكاتب يرى أن النشر على الإنترنت يتيح القراءة بشكل أيسر، وهذا هو هدف الكاتب من كتابته أن تُقرأ
نُشرت للكاتب المصري العام الماضي ثلاثة كتب، أحدها يضم مقالات عن نجيب محفوظ، ورواية بعنوان “مدينة ليست من الدنيا” عن أخناتون ونفرتيتي، وأخرى بعنوان “سفينة الجزيري”. ولديه رواية عنوانها “بيت الرمل” عن آخر أيام الفتوات في مدينة الإسكندرية الواقعة على البحر المتوسط على خطى النشر في الهيئة العامة لقصور الثقافة بمصر.
ولا ينفصل جبريل عن العصر بالنشر الإلكتروني، لذلك قام بمنح “مكتبة هنداوي” حوالي ثمانين كتابا من كتبه تم نشر 41 منها حتى الآن، ويعتبر أن النشر على الإنترنت يتيح القراءة بشكل أيسر، وهذا هو هدف الكاتب من كتابته، أن تُقرأ، لاسيما في ظل ارتفاع أسعار الكتب الورقية، قائلا “هذه مأساة، فهل سيدفع المواطن أموالا كي يشتري طعاما لأولاده أم ليقرأ في هذه الظروف الاقتصادية البائسة؟”.
ولا يحسب المقابل المادي لذلك، فيكتب أحيانا المقالات دون مقابل، لكنه يعتز بما يحصل عليه من خلال النشر الإلكتروني في “مكتبة هنداوي” التي علم بأنه يحتل المرتبة الثانية على منصتها بعد العائد المادي لكتب الكاتب الكبير نجيب محفوظ، فهذا يسعده، وإن يكن بنسبة واحد في المئة من أديب نوبل.
حصل محمد جبريل على جائزة الدولة التقديرية في الآداب في 2020، وبدأ حياته المهنية عام 1959 صحافيا في جريدة “الجمهورية” بمصر، ثم انتقل إلى جريدة “المساء” وأشرف على باب الثقافة فيها، دون أن يسمح للصحافة بأن تشغله عن الأدب، مستفيدا ومتعلما من تجربة نجيب محفوظ في تنظيم الوقت الذي يتيح غزارة الإنتاج.
علاقة خاصة ممتدة جمعته بالأستاذ نجيب الذي لا ينطق اسمه حتى اليوم إلا بهذه الصيغة، حتى في مناقشاته العادية مع زوجته الناقدة الأكاديمية زينب العسال، بينما كان البعض من معاصريه يتعمدون مخاطبته في حياته بـ”يا نجيب”، وهناك أديب كبير يعمل طبيبا أراد الاستعراض يوما فناداه “يا أبوالنُجُب”، ليرد هو “أهلا يا أستاذ فلان” باسمه الثاني، ليشعره بأنه سخيف، كما يقول جبريل.

ويصف شعوره ناحية محفوظ بأنه كان أنانيا جدا في الاستئثار به، فكان يذهب إليه يوميا من الساعة الثانية عشرة إلى الثانية ظهرا في مقر عمله بالمؤسسة المصرية العامة للسينما، ويجد متعة كبيرة في الجلوس إليه والحديث معه.
وعندما أصدر جبريل مجموعته القصصية الأولى “تلك اللحظة” عام 1970 أخبر أستاذه بأن عنوانها كان “تلك اللحظة من حياة العالم” لكنه قرر حذف المقطع الأخير، فسأله محفوظ “لماذا حذفته؟ كان الأفضل أن تتركه”.
ونشر عنه كتابين سابقين، هما “زيارة أخيرة إلى حضرة نجيب محفوظ”، و”نجيب محفوظ.. صداقة جيلين”، وقرأ الأستاذ مادتهما في حياته، لكن محمد جبريل يعتبر أنه ارتكب جريمة يندم عليها حتى اليوم، ويتمنى ألا يفعلها أحد معه.
يقول متألما “كان الأستاذ نجيب يقرأ مقالات كتابي الثاني عنه أولا بأول، وسألني مرة عن توقيت نشر الكتاب، فقلت له: بعد عمر طويل (أي بعد وفاته)، وتقبلها مني. ولا أعرف كيف قلت ذلك”.
لفترة طويلة ظل جبريل مداوما على زيارة محفوظ حتى سافر إلى عُمان، ثم عاد بعد ثماني سنوات فالتقاه وتحدث إليه ثم سأله بعد أن ضعف سمعه “انت سامعني؟”، ليرد الأستاذ “ملك الدعابة” كما يصفه “أنا آسف، من وقت أن تركتني وسافرت وأنا لا أسمع”. ولم يحب محمد جبريل الذي اعتاد الاستئثار بلقاء محفوظ منفردا الانضمام إلى جلساته في “مقهى ريش” و”كازينو قصر النيل” وسط القاهرة، لأنه لا يميل إلى الزحام والصخب.
وردا على سؤال “العرب” يؤكد أن كُتابا كثيرين معروفين تربحوا من اسم “الأستاذ نجيب” وجلساتهم معه، وردت عليهم مؤخرا ابنته أم كلثوم، كما أن كاتبا أصدر كتابين عن صلته به، برغم أنه قال بنفسه إنه رآه مرة وهو خارج من مكان ما، دون أن يلتقيه، فما العلاقة الفكرية التي تربطه به؟
الناقدان الراحلان عبدالعظيم أنيس ومحمود أمين العالم هاجما نجيب محفوظ بعنف لأنه من وجهة نظرهما يكتب عن البرجوازية ولا يكتب عن البروليتاريا، ثم تجاهلاه تماما رغبة في التعتيم عليه، لكنه كان يؤمن في تجربته بشيء سماه “عناد الثيران”.
واختلف جبريل مع هذا التعبير وناقش الأستاذ فيه، موضحا أن الثور غبي لأنه ينطح وهو يعلم أنه سيموت في النهاية، لكنه يفضل “عناد أمواج البحر” لأن الموج يظل يضرب في الصخر على الشاطئ، ويتركه ثم يعاود الكرة، وهكذا حتى يوم القيامة لا يتوقف عن محاولة ضرب الصخور، ولمحمد جبريل رواية اسمها “عناد الأمواج” صدرت عام 2012.
القصة تكتب نفسها

تسأل “العرب” الكاتب الكبير عن أساليب الكتابة الحديثة التي تميل إلى التجريب والغرائبية، وغياب الحكاية رغم أنها الأصل في الأدب ومصدر متعة وجذب القراءة، لاسيما في ظل ميل كتاباته إلى الواقعية والجوانب الروحية في حياة البشر.
يلح محمد جبريل على فكرة يؤمن بها، هي أن “القصة تكتب نفسها”، فلا ينبغي للكاتب أن يملي شيئا على قصته، بأن يقول لنفسه مثلا إنه ينوي أن يكتب قصة واقعية أو رومانسية.
ويقول “أدخل قصتي وفي ذهني ثيمة معينة، بنفس عزم إرنست همنغواي الذي قال: عندما أجد أن الطائرة تريد أن تقلع من المطار فإنني أعطيها الفرصة كي تقلع”، وكذلك عندما تريد الهبوط، فالطائرة أو القصة هما اللتان تحددان رحلتيهما، والكاتب يساعدهما فقط على بداية الرحلة وإنهائها.
ويتذكر انزعاجه الشديد عندما قال الكاتب الراحل عبدالحليم عبدالله يوما إنه سيقضي إجازة الصيف في مدينة بورفؤاد لكتابة رواية اشتراكية، في زمن الرئيس جمال عبدالناصر على سبيل المسايرة، لأنه لا يوجد شيء اسمه رواية اشتراكية، فالرواية هي من تحدد نفسها، وقام بتذكير عبدالحليم عبدالله بعد ذلك بمقولته فضحك، كما يقول جبريل.
ويواصل ضرب الأمثلة تدليلا على صحة فكرته، “القصة تكتب نفسها”، فرواية “بداية ونهاية” بدأت في ذهن نجيب محفوظ كما قال بهدف كتابة قصة كوميدية ساخرة عن أسرة مات الأب فيها ليدخل أفرادها بعد ذلك في مواقف كوميدية، لكنه فوجئ بأنها انتهت بما انتهت إليه. وكذلك رواية “زقاق السيد البلطي” للكاتب صالح مرسي، الذي قال إنه فوجئ في يوم زواج البطل بأنه مات، فأوقف الكتابة وجلس يبكيه، وكان يمكن أن يغير نهاية البطل لكنه رأى القصة تمضي هكذا.
ويلفت جبريل النظر إلى أن محجوب عبدالدايم المتسلق الانتهازي في رواية “القاهرة الجديدة” لنجيب محفوظ لم يعاقَب في النهاية، إنما تم نقله إلى أسوان فقط، ما يعني أنه سيظل هناك فترة ثم يعود بعدها ويواصل طريقه مرة أخرى، أي أن الظاهرة موجودة. وكان يمكن للأستاذ نجيب أن يجعل نهاية الشخصية حاسمة، لكن هكذا جاءت النهاية.
“لدينا تعبير جميل في العربية هو العبقري”، يقول جبريل، موضحا أنه تم بحث معنى التعبير كثيرا حتى تم تبسيط المسألة بأنه “من يكتب على غير المألوف”، أي أنه لا يختار إلا هذا، بدليل أن ثيرفانتس ظل يكتب أعمالا فاشلة حتى أصبح عمره 73 سنة، ثم أخرج لنا “دون كيشوت”، الذي يصارع الطواحين، فنجح لأنه عمل مغاير.
إذا كان النوع الأدبي حقيقيا وأصيلا ونابعا من الوجدان ومن تجربة حقيقية فسيعيش بمجرد أن يطل برأسه
كما انعكست الأزمة النفسية والشخصية للكاتبة فرجينيا وولف عليها، فكتبت اللون الذي كتبته. والكاتبة ناتالي ساروت عندما كتبت انفعالاتها وترجمها فتحي العشري أحدثت انقلابا، فظهرت القصة الومضة، لأن الكاتبة وجدت أنها تريد كتابة هذا فقط، فالمهم أن تكون التجربة صادقة وحقيقية أيا يكن اللون الأدبي، كما يقول.
ويعتبر محمد جبريل أن محمد حافظ رجب “الأفضل أو من أفضل كُتاب جيلنا”، لأنه كتب الشكل السريالي والمضمون الواقعي، وفقا لرأي نجيب محفوظ، فكتب مثلا “أخذ أذني بصق فيها ثم أعادها”. وقيل له وقتها “ما هذا التخريف الذي تكتبه”، لكن يحيى حقى رأى أنه سابق لزمانه.
ويقول “سألت محمد حافظ رجب عمن أخذ منهم طريقته، فقال لي: هذه تجربتي. ولمن لا يعلم فإنه كان بائع تسالي أمام سينما ستراند بمحطة الرمل في الإسكندرية، فرأى الدنيا كلها عبثا وفوجئ بأنه يكتب الأدب على هذا النحو”.
وهناك مسألة مهمة للغاية يلح عليها الكاتب الكبير محمد جبريل، ترتبط بمسألة تقييم الأديب عموما، وهي أنه لا بد من مراعاة السياق الذي ظهر فيه وواقع الكتابة في عصره، ومقارنته بأبناء جيله، فهناك من يتهمون يوسف إدريس بأنه عادي، رغم أنه نقل إلينا “اللحظة التشيخوفية” وهي النهاية المفتوحة، في وقت كانت فيه النهايات في الأدب مغلقة بإحكام، لكن القصة لا بد من أن يشارك القارئ في كتابتها مع الكاتب.
ويضيف أن إدريس شجع كثيرين في جيل الستينات على المغايرة في الكتابة، وهناك تعبير للكاتب جلال العشري يصف المشهد آنذاك، هو “جرَّة وانكسرت”، فقرأنا بالفعل بعد يوسف إدريس لمحمد حافظ رجب وجمال الغيطاني ومجيد طوبيا وعبدالحكيم قاسم وغيرهم، لأنه نبهنا إلى إمكانية تقديم أدب جديد غير السائد آنذاك، فظهرت تجارب متنوعة بما لها من زخم.
خواطر وليست قصصا

يشير البعض إلى سذاجة بعض قصص محمود البدوي، لكن لا بد من وضعه عند تقييمه بجوار جيله، فما لديه من سذاجة أو عفوية كان مهما جدا في وقته، لأنه تقابله العقلانية الشديدة للغاية عند محمود كامل والعلاقات المحسوبة بين الشخصيات بشدة، وقد أكد قيمة البدوي اثنان مهمان جدا من الجيل التالي له، هما عبدالرحمن الشرقاوي وسعد مكاوي، فكتبا عنه قائلين إنه “أستاذنا الذي تعلمنا كتابة الرواية في كتاباته”.
كلمات محمد جبريل تعني أنه لا يقف ضد أي نوع أدبي أو محاولة للتجريب، فسألته قائلا إن البعض يهاجم الآن مثلا فن القصة القصيرة جدا أو الومضة. فقاطعني في الحال قائلا “لأنها تُكتب بسذاجة، كأن تكتب كاتبة ما خواطر، وعندما تسمع عن القصة الومضة فإنها تغير العنوان وتسميها مجموعة قصص بالرغم من أنها كتبتها باعتبارها خواطر، فكيف أصبحت فجأة مجموعة قصص ومضة”.
ويجزم بأنه ليس ضد أي نوع أدبي، فإذا كان النوع حقيقيا وأصيلا ونابعا من الوجدان ومن تجربة حقيقية فسيعيش بمجرد أن يطل برأسه، طالما أثبت وجوده وتنفس.
قصيدة التفعيلة مثلا، حاول عباس العقاد بعظمته أن يحاربها وأحالها إلى لجنة السرد، معتبرا أنها ليست شعرا أصلا، لكن الآن أصبحت معظم قصائدنا منها، وقصيدة النثر قيل عنها “بلاش كلام فارغ”، لكن جبريل سئل عنها مرة في ندوة فقال “طالما أنها عاشت حتى الآن ستبقى”، وبقيت بالفعل.
المسألة المهمة في تقييم الأديب هي أنه لا بد من مراعاة السياق الذي ظهر فيه وواقع الكتابة في عصره
وهناك قصيدة نثر العامية، يعتبر محمد جبريل أن أول من كتبها هو مجدي الجابري، الذي جاء يوما في الندوة التي كان يقيمها الكاتب الكبير في الجريدة لمدة 30 سنة، وقال “سوف أعرض عليكم شيئا ستسخرون منه أو توافقون عليه”. وفي الأسبوع التالي كان هناك ثلاثة كُتاب من المعروفين الآن يكتبون هذا اللون الأدبي الذي ارتاده.
ويختتم جبريل رأيه في القضية قائلا “إذًا لا تقيدني ككاتب، ولا تملي عليَّ شيئا، إلى درجة أن البعض يرفض كلمة الحبكة، لكن فلتكن هناك حبكة، لأنني مؤمن بأن العمل السردي لا بد أن تكون به ثيمة وحدوتة، حتى لو كان ومضة، وإلا فإنه لا يصبح عملا فنيا، وبشكل عام فإنني أؤمن بوحدة الفنون”.
“رباعية بحري” عمل مهم لمحمد جبريل نال اهتماما نقديا كبيرا، مؤلف من أربع روايات هي “أبوالعباس” و”ياقوت العرش” و”البوصيري” و”علي تمراز”، عن منطقة بحري في الإسكندرية والحياة الصوفية بها، واعتبرها الأكاديمي ماهر شفيق فريد ضمن قائمة الكلاسيكيات، إذ تقدم صورة بانورامية لحركة مجتمع بأكمله، وتأملا فكريا عميقا في بعض ألغاز الوجود الإنساني ونقائض السلوك البشري.