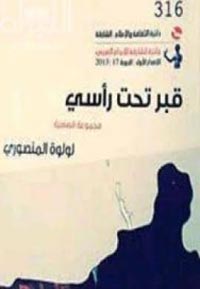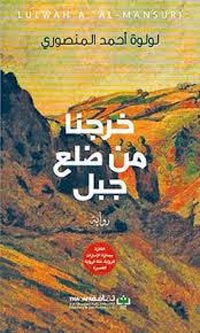لولوة المنصوري: القارئ هو المبدع الحقيقي للنص

بدأت المنصوري رحلتها مع الكتابة من خلال ما أسمته “نثر فني”، وهو أقرب إلى الخواطر الشعرية منه إلى الشعر أو السرد، واتجهت في ما بعد للكتابة السردية بعد أن ألقت بداياتها الشعرية بظلالها على أعمالها الروائية، فصارت أكثر ميلا للغة الشعرية في السرد وإلى الرموز المنفتحة على تأويلات عدة بما يمنح النص آفاقا أرحب.
الشعر والنسوية
أصدرت لولوة المنصوري كتابين من الخواطر الشعرية بعنوان “ممشى الضباب” و”الفضاءات البكر” واتجهت بعد ذلك إلى كتابة القصة والرواية. وبسؤالها عن تأثير البدايات الشعرية على الكتابة السردية ودورها في ترسيخها، تجيب المنصوري “أكتب الشعر لكني لم أنشره أبدا، ما نشر هو مجموعتان في الخواطر وتحت تصنيف ‘النثر الفني’. فقد بدأت بتسجيل خواطري في مخطوطتين أسميت الأولى ‘ممشى الضباب’ والثانية ‘الفضاءات البكر’ وكان بي حماس الشباب في نشرهما، وبالفعل احتوت وزارة الثقافة والشباب ودائرة الثقافة والإعلام في الشارقة ذلك الحماس وقامت بنشر المجموعتين تحت مصنف النثر الفني”.
وتتابع “السرد بدأ يصعد إلى عالمي ويبعثرني بهدوء، ويتغلغل في تأصيل أحداث الواقع وذاكرة الآخرين، إلى أن اقتربت منه ذات مساء ونسجت الخيوط الأولية لرواية ‘آخر نساء لنجة’ والتي نشرتها دائرة الثقافة والإعلام سنة 2013”.
وعن هيمنة اللغة الشعرية على نصوصها السردية وتأثير ذلك على الاهتمام بالمضمون ذاته تقول المنصوري “ربما كان أسلوبي سيميائيا في الرواية، وفي الحقيقة لا تريحني المباشرة والإقناع في السرد، لذا أعمد أحيانا إلى اللغة الشعرية التي تمنح النص السردي إيحاءات ودلالات متعددة. وتعدد الإيحاءات يفتح بوابة تأويلية للنص، ليصير بذلك نصا مستقبليا قابلا لتوالد التأويلات والتساؤلات وإنتاج القراءات، فالقارئ هو المبدع الحقيقي للنص، ويصل إلى منزلة السمو الإبداعي بإعادة إنتاج قراءته وتفاعله مع الأحداث بصورة مغايرة في التلقي. ولكل كاتب بصمته ونسيجه الخاص، وأنا أرى أن اللغة الشعرية تتجاوز البصريات والأجسام والمرئيات، وتتشكل في الماورائي الغامض الذي يثير التساؤل والإرباك، وتتأصل مع الزمن كمثل بقاء الروح بعد موت الجسد. بينما اللغة البصرية هي سرد عادي، يُنسى مع الزمن حاله حال الجسد. السرد يعتمد على البصريات بشكل كبير، لكن السرد المدهش هو ما يخلق هزة في الكون، يتجاوز البصري إلى الروحي، يغمس البصر في التأويل والسيميائيات، والشعرية تتيح ذلك شرط ألا يكون هناك إفراط”.
|
وتتابع “في السياق نفسه لا يمكنني أن أطلق أصابع الاتهام جزافا على الباحثين والنقاد، وأصف مصطلح ‘الرواية النسوية’ بأنه مصطلح مجحف وعنصري وينبع من نظرة دونية للمرأة. وإنما أتسامح وأختلق لنقادنا الأعذار، فربما هذا التقسيم قد فرضه لزوم البحث النقدي والمنهجية في دراسة السمات التي تميز كتابات المرأة، وما يحمله أيضا من إغراءات خاصة لجهة القراءة الدلالية، واكتشاف فوارق نادرة تكاد تكون جوهرية خاصة بالسرد النسائي، فضلا عن الحاجة الماسة إلى الإضاءة على مقدرات المرأة المبدعة، التي راحت تكسر احتكار الرجل لعوالم السرد”.
هناك من يرى أن الدور الذي يتعيّن على الرواية أن تضطلع به في ظل المطالبات الراهنة لها هو أن تكون انعكاسا للواقع. وترى المنصوري أن كاتب الرواية همّه الأول هو الواقع، الذي يتغذى عليه، لكن الأهم هو الاختلاف في طرح الواقع وطريقة عرضه بعيدا عن الجاهز والمكرر، فالكاتب المتميز في رأيها، هو من يستطيع تجاوز الأساليب المتشابهة، وتجاوز ما هو كائن، والاشتغال على النص بعمق وتحصينه معرفيا، فالنص الجيد هو الذي يحاور قيما كونية ويبحث في الأضداد.
انعكاس الواقع
تشير المنصوري إلى أن العنوان هو باب النص ومفتاحه وعلامته ودليله وفكرته الرئيسية، لذا فهي تحاول ألا يضيع هذا المفتاح بأفكار مشتتة كي لا يتوه القارئ عن الباب الصحيح، فتلك هي المرحلة القصوى في القلق، مستطردة “أنتقي عنوانا من بين العشرات من العناوين المفترضة التي أضعها على ورقة جانبية، ولا أبالغ حين أقول إن أصعب المراحل في كتابة النص هو الوصول إلى المرحلة الأخيرة أي انتقاء العنوان، ربما يكلفني ذلك شهرين أو ثلاثة أو أكثر”.
|
تعتمد ضيفتنا على الأسلوب الرمزي في السرد، وهي على ثقة تامة بأن القارئ العربي بات ذكيا ليفض اشتباك الرموز. وهذا ما يحدث الآن من خلال ما يصل إليها من تأويل وقراءات مختلفة لرواية “خرجنا من ضلع جبل”، ومن قراء كثر لهم دراية جيدة بفن الرواية ولهم وعي مكتنز بشغف فك الرموز والبحث في فكر الكاتب ومراده. وترفض ضيفتنا تقسيم القارئ العربي إلى صنف العادي والنخبوي. وتقول “لنفترض أن هناك فعلا قارئا عاديا، ألم يئن الأوان بعد ليلج هذا العادي إلى العمق ويتعلم الغوص في السادر والمكنون؟ أم أنه اعتاد على نمط قديم وجاهز وخضع وعيه لهذا النمط بصورة نهائية؟”.
وتضيف “لكل كاتب خصوصية ولون متفرد ومحبب إلى نفسه، كما أن لكل قارئ ذائقة خاصة ووعيا مختلفا في استيعاب الروايات، لذا لا ينبغي أن نفرض على كل منهما التزامات نحو الآخر، ولا يتوجب على الكاتب أن يخضع قلمه ويرضخه لذائقة القارئ. في الحقيقة أريد قارئا مفسرا ومحللا وقلقا وشغوفا باستنباط الرواية. وأثق في أنه موجود وبكثرة.. وروايتي هذه قابلة للقلق وللتأويل والتفسير على جهات وضفاف متعددة ومختلفة باختلاف القارئ لها”.