لا معارك بين النصوص الحداثية والكلاسيكية في عُمان
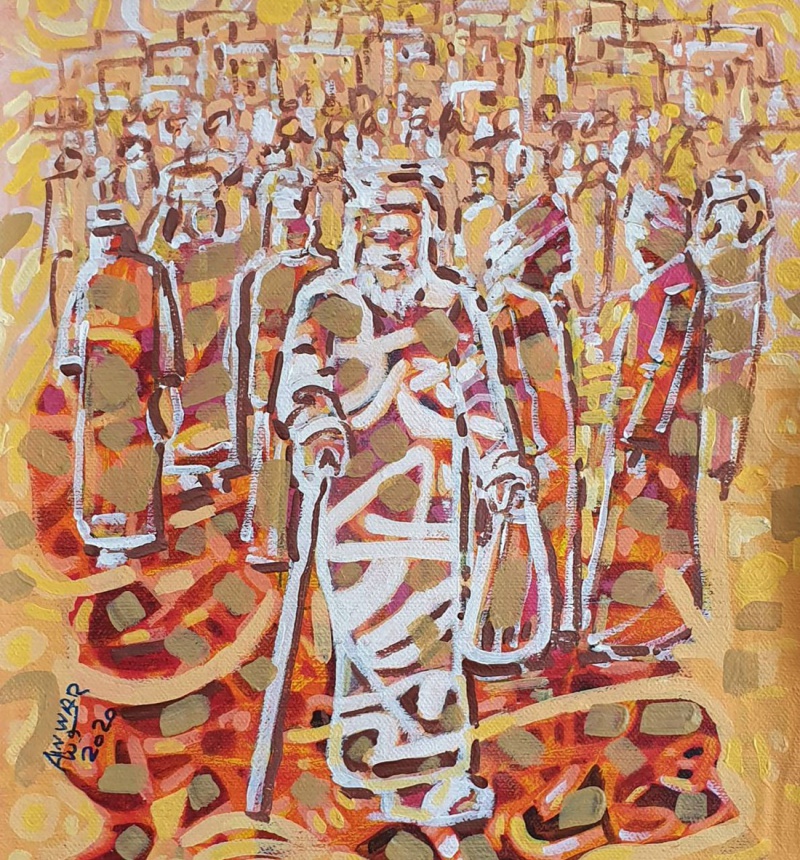
يزخر الأدب العماني بالكثير من التجارب الهامة سواء في السرد أو الشعر، لكن تبقى هذه التجارب بعيدة نسبيا عن دائرة النقد ما يجعلها غامضة عند القارئ العربي الذي لا يعرف الكثير عن خصوصيات وميزات وحركة الأدب العماني، وخاصة منه المعاصر. في ما يلي لقاء مع الشاعر والناقد المصري هشام مصطفى الذي كرس عددا هاما من أعماله للأدب العماني.
مسقط - يجد المتابع لأعمال الكاتب والشاعر المصري هشام مصطفى تتبعه للأدب العُماني والشعر على وجه الخصوص، فهناك اهتمام واضح وجلي بمقتضيات القصيدة العُمانية الحديثة ودراستها والاشتغال على ما تقدمه من رؤى، خاصة في شأن النهوض بمجرياتها وتفاعلها مع الأحداث.
وقد اقترب مصطفى كثيرًا من تجارب الشعراء سعيد الصقلاوي وسعيدة بنت خاطر الفارسية ومحمد الحارثي وهلال العبري، مرورًا بالشعر الشعبي وقراءاته المتعددة لأشعار الشاعر محفوظ الفارسي. وهنا يقربنا الشاعر هشام مصطفى من تلك التفاصيل التي يجد فيها متسعًا للتحليق نحو الكلمة.
الحداثية والكلاسيكية
يتحدث الشاعر هشام مصطفى عن تجربته مع الأدب العُماني بصورة عامة، والمحفزات في هذا الأدب من وجهة نظر نقدية، وكيفية تتبّع أثره خلال السنوات الماضية ويقول “تجربتي مع الأدب العربي في سلطنة عُمان تجربة قديمة بدأت منذ العام 1996 وإلى الآن، وإن قل النتاج الشعري والنقدي لبعض التحولات إلا أنها بدأت تحديدًا مع بعض الصحف المحلية، ونظرًا إلى اهتمامي الشديد بالتجربة الإبداعية العُمانية واعتقادي أنها تحتاج إلى تسليط الضوء عليها بالدراسات الموضوعية النقدية جعلتني أتحول في إسهاماتي إلى الجانب النقدي والذي أخرج للمكتبة العربية والعمانية من خلاله عنوانين الأول تحت مسمى ‘شاعر بحجم الألم’ دراسة تفكيكية والثاني ‘في أروقة الحداثة’ دراسات متنوعة في التجربة الشعرية العمانية”.
ويضيف “أما من حيث المحفزات فالتجربة الإبداعية العمانية ثرية بمحفزات أي ناقد يبحث عن الجودة تستحوذ عليه، وهذا الأمر لفت انتباهي ليس في الأعمال الحديثة المعاصرة بمختلف اتجاهاتها، بل منذ القدم على الأقل بالنسبة إلي على المستوى السردي ودراسة عن المقامة الشعرية أسسها وتطورها منذ نشأتها الحقيقية، ولقد شدّت انتباهي مقولة الجاحظ إن الأدب شطره في عُمان، ورغم هذا التصريح شديد الوضوح إلا أن هذا الأدب لم يلق العناية الواجبة في دراسته وتسليط الضوء عليه وهذا مبحث مهم يمكن للنقد أن يجيب عليه بالتتبع التاريخي النقدي، ولقد تتبعت أثره من خلال تجارب الشعراء سعيد الصقلاوي ومحمد الحارثي والشيخ هلال العبري والشاعرة سعيدة بنت خاطر الفارسية، وتناولت من خلال الدراسات جوانب البنية الشعرية على مستوى الجملة والصورة والمحرض الجمالي وعتبات النصوص”.

هشام مصطفى: الأدب العماني لم يلق العناية الواجبة في دراسته وتسليط الضوء عليه
ويتقصى كتاب “في أروقة الحداثة” عددًا من التجارب العُمانية في الشعر الحديث، بما فيها تجربة الشاعر هلال العامري والدكتورة سعيدة بنت خاطر الفارسية والشاعر محمد الحارثي والشاعر سعيد الصقلاوي، هنا يقترب مصطفى من هذا الإصدار ليقول “هذا الإصدار هو محاولة فك اشتباك لمعركة نقدية وهمية بين النصوص الحداثية والكلاسيكية، فمثلا كان الاهتمام بشعر الشاعرة سعيدة بنت خاطر الفارسية انطلاقا من المحرضات الجمالية للحداثة ومدى تحثثها ومواكبتها لاتجاهات الشعر في الأدب العربي لإعادة قراءة الشعر مرة أخرى بناء على الأسس الحداثية”.
ويقر بأنه ثمة إشكالية لدى النقد والناقد حينما يتناول النص من معتقدات ذاتية أو يغرق بحثا عن المعنى التعليمي المدرسي أو حينما يفرض وصايته على النص بأحكام تغلق النص ولا تجعله مشرعًا أمام المتابع والقارئ العادي، فالنقد الذي يقدم ما يعتقد أن الشاعر عبّر عنه إنما يتعدى على حقوق المتلقي العادي، فالنص متى انطلق أصبح ملكًا حصريًا للمتلقي يجد فيه مندوحة لا ما يتصوره الناقد، وعلى الناقد أن يهتم بالمعنى الفني وأسس البنية للجملة والسمات الأسلوبية ومدى توافقها مع اتجاهات النص وقضاياه، كل هذا تحت عباءة الرؤية الجمالية أو الفلسفية التي يعبّر عنها النص ومبادئ الاتجاه الذي سار من خلاله.
وأما عن دراسة محمد الحارثي فكانت محاولة لتطبيق الرؤية التي وضّحت مع الشاعرة سعيدة بنت خاطر الفارسية للكشف عن زوايا التجربة بداية من بنية العتبات ومرورًا ببنية الجملة والدلالات للرمز واتساقها مع الوجه الحداثي وترابط النصوص باعتبار الديوان نصًا واحدًا ورؤية واحدة متعددة الأبواب لها أو النصوص التي تناولها وترتيبها، فكل ما يأتي في الديوان لا يأتي مصادفة، فهو دال له مدلوله الذي يعاضد المعنى الفني العام والرؤية للعالم الذي ينتمي إليه المبدع.
وفي الدراسة الثالثة كانت هناك مقارنة بين الشاعرين هلال العبري وسعيد الصقلاوي من حيث بنية الصورة ومدى تجذر الرؤية الحداثية سواء على مستوى البنى المتتابعة للجمل أو الرمز أو الديناميكية للحركة في الصورة صعودا وهبوطا اتساقا مع ما تعبر عنه في بوتقة الحداثة الشعرية، ولقد استعان مصطفى بالرسم البياني والخرائط المعرفية للصورة الشعرية انطلاقا من فهم لمصطلح الصورة الشعرية تحديدًا ومدلولًا، فهذا الفهم هو الأساس والباب الشرعي لفهم أي دراسة واعتبارها تأسيسا للدراسة.
ويتابع “لا أخفي قولًا إن هناك إشكالية أحاول من خلال هذا الكتاب أن أضع رؤى لحلها. هذه الإشكالية أن ملامح النص لقراءة أعمق فيه يجب أن تقوم على تحديد اتجاه النص ومحددات الدراسة واتساقها مع الرؤية الفلسفية الجمالية التي تبدو المحرك الرئيسي لتشكل ملامح المعنى الفني فيها؛ فكثير من الدراسات النقدية التطبيقية وأشدد على قصدية النقد التطبيقي لا التنظيري تهمل هذه المنطلقات والتي لا يمكن اعتبارها تنظيرية، بل أعتبرها تأسيسية لأي دراسة يمكن فيها للمتلقي العادي تتبع العملية النقدية كعملية إبداعية ثانية وموازية للنص فالنقد يجب أن يكون خلقًا جديدًا للنص القديم لا غلقا له”.
الشعر الشعبي

المتتبع لمشوار الكاتب هشام مصطفى النقدي يجد حضوره في الشعر الشعبي في سلطنة عُمان ورصده لعدد من التجارب الشعرية، بما في ذلك تجربة الشاعر محفوظ بن محمد الفارسي، وغيرها من التجارب التي شكلت نمطًا مُغايرًا في الواقع الشعري الشعبي، هنا يعرّفنا بقراءاته للشعر الشعبي في سلطنة عُمان عمومًا ويفيد “يجب ألا ننظر إلى الشعر الشعبي على أنه معادٍ للغة العربية بل هو رديف لها ينطلق منها لا ضدها، فاللهجة هي تحوير للغة مع عدم التزام بقواعدها الجامدة وتمرد على قولبتها للجملة وهذا ما تفعله الحداثة الشعرية محاولة لإيجاد اللغة في إطارها من خلال المدلولات المدهشة والتحولات النصية للجملة هكذا الشعر الشعبي”.
ويضيف “تجربة الشاعر محفوظ الفارسي هي تجربة حداثية بامتياز لذا كانت تجربة صادمة للمتلقي العادي والمبدع معا، حيث لم يكن متصورا أن دور الشعر الشعبي الذي اضطلع به منذ نشأته قد تطوله التحولات الحداثية في الرؤية لا القضايا. فتجربة الفارسي ليست تجربة بعيدة عن قضايا الشعر الشعبي الذي يعالجها وإنما كان التجديد قائما على محورين الأول في بنية اللغة الجملة، والثاني إغراء المتلقي لأن يفكر معه ويرتقي به إلى مستوى الخلق للفكرة لا تلقيها والطرب بها”.
ويتابع “تجربة محفوظ ومن قبله شعراء آخرون وكذلك من سيأتي من بعدهم هي قائمة على الخروج من بوتقة التطريب إلى التفكير والخلق والتماهي مع إحساس الشاعر عقلانيًا لا قلبيًا وعاطفيًا، رؤية العالم من خلال الذات لا من خلال مفردات الوجود التي يجمعها في صورته، لهذا كانت الدراستان اللتان قدمتهما عن تجربة محفوظ الفارسي تقويما على الأسس الجمالية وتفكيك الخطاب لرصد البنى العميقة للجملة الشعرية في إطار الحداثة لفتح آفاق الرؤية لا غلقها بالشرح والتفسير. وتعمدت أن تسير بنفس الخطوات لدراسات التجربة الإبداعية وللمنجز الفني الفصيح لرد الاعتبار للشعر الشعبي فهو يستحق هذا العمل كشعر شعبي وتجربة حداثية“.

دراسة تنطلق من فهم واسع للمعنى المراد للناقد
وتوجد لمصطفى رؤية في التجارب الشعبية الشعرية العمانية وهي تشكّل حضورها الفعلي تصاعديًا، فهو يشير إلى ذلك من وجهة نظره إلى الترابط بين الشعر الشعبي في سلطنة عُمان والشعر الشعبي كما عرفناه في مصر، ويقول “التجربة الشعرية الشعبية العمانية تشكل حضورًا قويًا بتنوع أنماط الشعر الشعبي الفريد، بل يمكن اعتباره سجلًا تاريخيًا للمجتمع العماني، عاداته وتقاليده واتجاهاته وأنماط تفكيره، وهو كنز لم يفتح بعد وينتظر الكثير من العمل التوثيقي والنقدي وإعادة قراءته قراءة متأنية عميقة تبرز كل هذه الجوانب، بل يمكن أن يكون مادة لعلوم التاريخ والاجتماع والأدب والنقد”.
ويبين أن الفرد العُماني أيا كان انتماؤه محب للشعر ومقدر له، بل وعميق الفهم له، وعلى مستوى الحضور فالقصيدة الشعبية العمانية حاضرة وبقوة قديما وحديثا، والإشكالية في رأيه تكمن في تسليط الضوء عليها سواء على مستوى النافذة الإعلامية والقنوات المرئية أو على المستوى النقدي، إذ لا بد من تحفيز النقاد لهذه التجربة؛ فعملية النقد شاقة تستغرق شهورا وسنوات لكونها شاملة لإعادة إيجاد هذه التجربة من زوايا متعددة، والشعر الشعبي في عُمان يعبر عن المجتمع بقضايا واحتياجات الإنسان وهو يلتقي مع الشعر الشعبي في مصر في اتجاهات الغزل ومعالجة القضايا الاجتماعية، لكنه يختلف أو لم يدخل بعد في الحيز السياسي، ولكن في العموم يلتقي مع التجربة المصرية وخاصة الغنائية مع الفارق في الأسس التي تحكم العقلية هنا أو هناك.
وللكاتب هشام مصطفى أيضًا دراسات حول شعر الشاعر العراقي يحيى السماوي في عدد من أعماله، وهنا نقترب من مضمون هذه الدراسات وأهم ركائزها “دراسة الشاعر يحيى السماوي هي بداية لأني الآن أعد لدراسة أشمل وأوسع. دراسة ‘شاعر بحجم الألم’ للشاعر سعيد الصقلاوي تنطلق من فهم واسع للمعنى المراد للناقد والذي يجب أن يضعها نصب عينيه عن دراسة أي تجربة، أما عن دراسة لي ‘ما يبرر وحشتي هذا الصباح’ فقد قامت على أهم الأسس النقدية، كما أعتقد أن الانطلاق من الفهم الجمالي لوضع الأسس والأبعاد للمعنى المعبر عن اتجاه النص لا الشاعر، لذا ضمنتها مقدمة عن الشعر السياسي والأسس التي يراعيها وبعد ذلك الجزء التطبيقي في النص تضمن شقين، الأول مدى توافر الأسس للشعر السياسي في النص من حيث المحرض والشخوص كبنية سردية والرموز والتماس مع الأسطورة. وفي الشق الثاني اعتمدت الدراسة على منهجية الدراسات البنيوية التكوينية والثنائيات التي تحملها بداية من ثنائية الداخل والخارج وانتهاء الثنائية الأسلوبية في الخطاب لدى النص“.
التجربة الشعرية الشعبية العمانية تشكل حضورًا قويًا بتنوع أنماط الشعر الشعبي الذي يعتبر سجلًا تاريخيًا للمجتمع العماني
ويضيف “أما الدراسة التي أعدها الآن فهي في مجمل أعماله (انتقاء لأعمال تعبر عن تحولات الخطاب) وتقوم على أساسين، الأول فهم للمعنى وعلاقة المبنى به، والثاني على السمات الأسلوبية من خلال الأسلوبية الإحصائية وهي دراسة أخذت سنة كاملة في الشق الأول وقد تأخذ مثلها في الشق الثاني والذي يعمل على رصد أكثر من 17 ظاهرة من خلال بُنى الجملة لديه“.
وفي نهاية هذا التطواف يشير هشام مصطفى إلى أن الحركة النقدية في سلطنة عُمان حظيت باهتمام كبير من قبل الكتّاب والأدباء العرب منذ فترة ليست بالقصيرة، حيث اتجهت نحو الشعر والقصة القصيرة والرواية أيضًا، هنا يكشف الكاتب عن مشاهداته لمسارات تلك الحركة، والنتائج المستخلصة كونه أحد الكتّاب الذين اتجهوا ضمن نطاقها.
ويقول “الأدب العماني قديما وحديثا زاخر بالكثير من الجودة، هذا الأمر ليس من قبيل المجاملة، فالنقد الموضوعي لا يقبل المجاملة ولا ترفها أو إمكاناتها، لهذا فكل عمل ينفذ من الداخل إلى الخارج يجد ترحيبًا بل تقديرًا وهذا ما نراه أخيرًا في الأعمال التي نالت الكثير من التقدير سواء على مستوى المسابقات أو على مستوى المحافل الأدبية المعتبرة، بل أصبح واسع الانتشار لأنه يحمل لغة جديدة ومضمونا لم يتطرق له أحد وهو يعبّر عن تجربة تم صهرها من خلال تاريخ طويل لذا ليس غريبًا أن يجد الانتشار والتقدير معًا، وهذه سمة الجودة في العمل الأدبي أيا كان جنسه واتجاهه، فقط يحتاج إلى تسليط الضوء والنوافذ ليعبر من حدود المحلية إلى العالمية، ولا نريد منه تغيير لغته أو أسسها بل كلما تعمق في محليته وعبر عنها كلما وصل إلى العالمية، فقط نريد الدراسات الكثيرة والمنفتحة والنوافذ الإعلامية“.






















