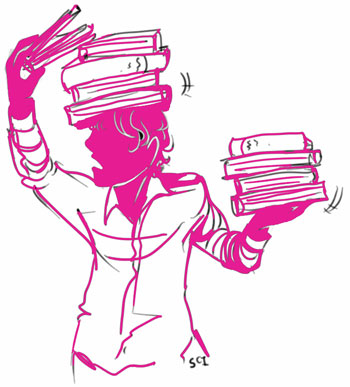عودة محاكم التفتيش، عام خرف واستعداء وتناحر وأمل
يمكن القول إنّ 2014 شهد جوانب لافتة على الصعيد الثقافيّ، بالتوازي مع بعض الخيبات التي باتت ملازمة لجوانب من الحياة في العالم العربيّ. تتمثّل جوانب من النكسات في استعادة الأنشطة من قبل فئة من مثقّفي الطغاة، بدءاً بزعم الانتصار لغزّة التي تعرّضت لأشرس عدوان إسرائيليّ -وهو دفاع حقّ- وجعلوا غزّة وسيلة للدفاع عن الأنظمة الفاسدة، وتوصيف الثوّار بالمتواطئين، أو حصر المثقّفين المعارضين للأنظمة في خانة الإرهاب والتكفير.
ظلّ الانقسام حادّا بين مثقّفي الأنظمة والمثقّفين المعارضين، حيث ازدادت الهوّة ثقافيّاً، وكانت وجهاً من وجوه السياسة التائهة، خاصّة أنّ الحرب مستعرة في أكثر من مكان، والتوتّرات متفاقمة لا تستدلّ إلى طريق للحلّ، وأمام ذلك يتمترس كلّ فريق في معسكره. كما استمرّ مسلسل نزع الأقنعة عن الوجوه اللائذة بالصمت الجبان والتواري خلف مزاعم الوقوف على مسافة واحدة من الأطراف المتناحرة.
الإنجازات الثقافيّة تبدو ضئيلة بالمقارنة مع المفترض والمنشود، وما يزال النظر إلى المثقّف على أساس التبعيّة سائدا في معظم الأماكن ولدى مختلف الأنظمة، إذ يتمّ الحديث عن الثقافة كصدى لا كفعل مؤثّر بحدّ ذاته، وبذلك ينعدم تأثير المثقّفين، ويتصدّر الخطاب التعبويّ الواجهة في ظلّ تسيّد المدّ التشدّدي للانتماءات المتباينة التي تكون على حساب الانتماء للقيم والمثل الإنسانيّة، تلك التي بات الحديث عنها مدعاة للسخرية عند أولئك الذي يسبحون في مستنقعات الطائفيّة والعصبيات الإثنية أو المذهبية أو الدينية.
|
ربّما ما يزال الحديث عن تعبير الأدب عن روح المرحلة مبكراً، ذلك أنّ المشهد ما يزال قاتماً، والثورات مستمرّة، بطريقة أو أخرى. ربّما هناك بعض المحاولات الحماسيّة التي سعت إلى تسجيل السبق في المقاربة وزعم التوثيق والتأريخ، لكنّها متحرّكة تحت وطأة اللحظة وثقلها وضغوطاتها، واتّسمت بطابع تقريريّ إخباريّ، بدت في سعيها إلى النضج مسلوقة على عجَل.
ولأنّ اللبنة الأولى للثورة، تلك المتمثّلة بتغيير النظرة للماضي والراهن والمستقبل قد بدأت وتولّدت، فهناك أمل بانبثاق أدب يواكب هذه النظرة النقدية التي تنزع عن المراحل والشخصيات هالات القداسة المتوهّمة، وتضعها تحت مجهر المراجعة والمعالجة والتشخيص، لعلّها تساهم في التهيئة لبنية متماسكة، بعيداً عن الأوبئة والسموم التي بثّها المستبدّون والطغاة في تفاصيل حياة المجتمعات التي حكموها ولوّثوها، ويأتي دور الأدب في التنقية المنشودة، عبر تعرية العلل وفضح أصحابها والمشاركين في خلقها وإدامتها، وذلك بعيداً عن ذهنيّة الثأر المدمّرة.
ما يمكن الحديث عنه هو أنّ الظروف الجديدة كشفت المخبوء، ولم تبقِ سرّاً لهذا المستكسب أو ذاك. أرجعت المستجدّات والمتغيّرات بعض زاعمي الريادة والتجديد إلى حظائرهم الضيّقة، وأوقعتهم في الهوّة التي خلقوها بأنفسهم بين القول والفعل، وقوّضت بنيان السراب الذي كان مزيجاً من تحالف لئيم بين الديكتاتورية ووجوه صنعتها ونصّبتها على أساس أنّها معارضة لها، كي تحتكر المشهد الثقافيّ بشقّيه الموالي والمعارض، وضخّمت معارضيها المفترضين لتسدّ الطريق أمام الحقيقيّين وتبقيهم معزولين عن الاحتكاك والتواصل مع الناس إلاّ في حدود ضيّقة.
لا يخفى أنّ المغيّبين استرجعوا جزءاً من سلطة الشارع النقديّة، لكن لم يتمكّنوا بعد من بلورة خطابه الثقافيّ المنشود، ذلك أنّ التفتيت الذي مارسته الديكتاتوريّات يحتاج إلى وقت ليس بالقصير للملمة التشتّت، والإعداد للانطلاق نحو ثقافة تليق باسمها.
تبدّى نوع من “الخرف” الأدبي، تجسّد بصيغة فاقعة في مقطع بائس للعراقي البريطانيّ سعدي يوسف يصف فيه كردستان بقردستان، مسيئاً إلى شعب برمّته، منطلقاً من حقد دفين لا يتوافق مع شخصية الشاعر التي يفترض بها أن تكون متسامية على الضغائن لا متسبّبة بتوليدها وتضخيمها ونشرها. والتداعيات التي أثارها بكلامه غير المسؤول، والدعوات التي تمّت لإحراق كتبه، في ردّ وصف بالعنيف أيضاً على رعونة الشاعر وتهوّره. وهو الذي عادى الثورات بحجج واهية.
وفي منحى آخر، لوحظ، بعد حضور عدد من الأنشطة الثقافيّة في بعض المدن البريطانيّة، عدم إقبال القارئ الإنكليزيّ على الرواية العربيّة المترجمة، التي – على قلّتها – لم تستطع جذب انتباهه، بل اقتصرت على بعض الأخبار عنها، وتمّ تداولها في نطاق ضيّق، وظلّت القطيعة مستمّرة في هذا المجال، ولا سيما أنّ هناك غياباً للتواصل وانقطاعاً عن سدّ الفجوات المتعاظمة، حيث يتمّ تقييد صورة الشرق والعرب في تنظيمات متطرّفة، والنظر إلى الشعوب بأنّها لم تبلغ رشدها بعد، وأنّ الأنظمة الاستبدادية ضرورة مرحليّة، وذلك مع تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا وانتشارها. وبعض الأنشطة والمهرجات لا تكفي لسدّ الهوّة المتعاظمة جرّاء سوء الفهم، ونقل صور مغلوطة.
أمّا في الحديث عن مناحٍ أخرى، ربّما تمثّلت بعض الجوانب المميّزة في الفرز الواقعيّ الذي جرى ويجري تباعاً، والثورة التي اجتاحت الثقافة العربية والتي لم تأتِ أكلها بعد ثقافيّاً وأدبيّاً كما يجب، وربّما ستحتاج سنوات لتلملم شظاياها وتبدأ بهندسة معمارها وبلورة تصوّر يؤسّس لمستقبل تتصالح فيه الثقافة مع ذاتها، مع رؤاها الإنسانية المنشودة.
سوريّاً، استمرّ التخوين من قبل المرتهنين للنظام للمناوئين له، لدرجة ظهور لوائح تشير إلى محاكم تفتيشية بائسة بحلل فنيّة أو ثقافيّة، كاللائحة الفنية التي وصفت من قبل زهير رمضان، المعيّن كنقيب/رقيب لفنّانيّ النظام، ضدّ فنانين معارضين، كما تمّت محاولات نسف القيمة الأدبية لبعض الإصدارات واتّهامها بالطائفية، وشنّ هجمة استباقيّة صحافية عليها، لا لسبب إلاّ لأنّها أشارت إلى الوباء السرطانيّ باسمه وصفته دون تورية، ويمكن التذكير في هذا السياق بما تعرّضت له رواية “السوريّون الأعداء” لفوّاز حدّاد من محاولات تشويه، واتّهام بالطائفيّة، من قبل بعض المحسوبين على النظام أو الدائرين في فلكه.
كما تجلّى نوع من التعادي والاستعداء، وإخراج بعض المخبوء والدفين، في تبادل للاتّهامات بين أدباء سوريّين من العرب والكرد ممّن يناصرون الثورة السوريّة، وحضر النظر إلى الكلّ من خلال البعض، وعكس ذلك تفجّراً لتراكم الأخطاء من بعض المتحمّسين، وأدّى الأمر إلى ردود أفعال خرجت عن سياقها، ومع دخول بعض الجهلة على الخطّ وتعكير الأجواء بتعبيرات خارج السياق، دخلت إطار النيل من الشخص والشعب من ورائه، بنوع من التجريم الجماعيّ على مواقف بعينها.
في حقل الإصدارات الأدبية، تابعت كثيراً من الإصدارات الروائية التي تتفاوت في سويّتها، ولعلّ الإسراع في طباعتها قبل انتهاء موعد الترشيح للبوكر أو “كتارا” أبرز كثيراً منها مشوباً بالقلق والتسرّع. شعريّاً اقتصرت متابعتي لنتاجات عدد من السوريين، وكان من ببين الأعمال اللافتة دواوين الشعراء السوريّين كعارف حمزة، مروان علي، حسين حبش، ومحمد المطرود، وآخرين غيرهم، وقد عبّرت عن واقع الحال بطريقة إنسانيّة وبتميّز أدبيّ، وأكّدت أنّ الشعر ما يزال ينبض بالحيوية ويحتلّ حيّزه المفترض في الحياة الثقافيّة. وفي سياق الشهادة واليوميات، يحضر كتاب محمّد ديبو “كمن يشهد موته”، وكتاب “يوميات ميكانيكية” لعلي سفر كشهادتين على اغتيال يومي يمارس بحقّ بلاد متروكة وحيدة في مواجهة تدمير ممنهج.
كاتب من سوريا مقيم في ليدز- بريطانيا