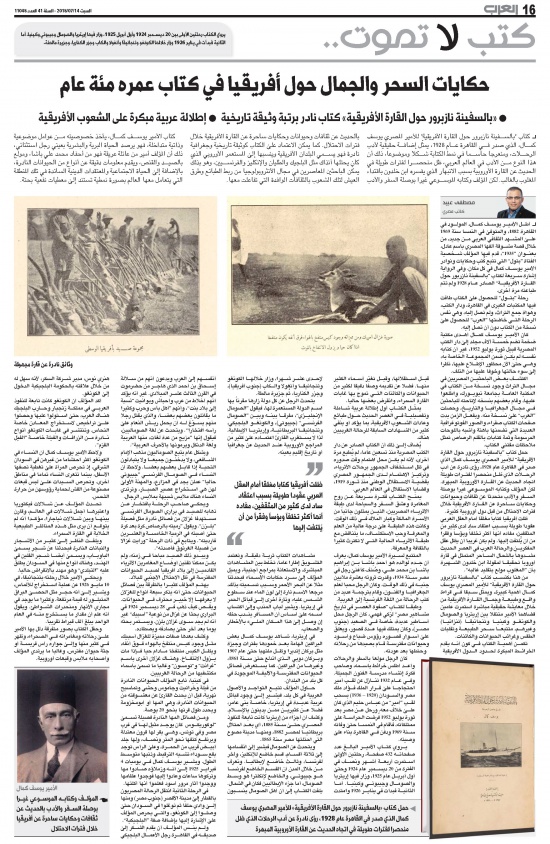عدن المدينة المرآة التي تشوه سكانها

يختار أحمد زين عبارة مفتاحية للسياسي البريطاني الراحل تشرتشل ليضيء بها عتبة العبور إلى عالم روايته الساحرة “ستيمر بوينت” مع اقتباس هجائي لمدينة عدن من الشاعر رامبو واقتباس أخير من الذاكرة الشعبية.
المدينة الكوزموبوليتانية
يقول تشرتشل “إمبراطوريتنا تبدأ من أسوار عدن“، هذه عبارة لا لبس فيها تفصح عن حقيقة النزوع الاستعماري للهيمنة وما تمثله عدن من أهمية للإمبراطورية البريطانية، ومن هذا المدخل التوثيقي البارع تبدأ أمواج الرواية المتلاطمة تنهال صورا متتابعة ومشاهد تتغير بإيقاع متسارع مكتوبة بإحساس جمالي فريد وسرد متقن تتألق فيه لغة الروائي البارعة مثلما تتسارع فيه الوقائع المشتبكة التي تشكّل متن الرواية؛ فنشهد دوامات متداخلة من التقاطعات والأهواء الخفية والمعلنة لشخصياتها القلقة، بينما يفصح توتّر السرد وتدفق إيقاعه الفاتن عن المواجهة اللاهثة بين النفس وصاحبها من جهة ومع الآخر الغريب المتعالي والآخر المستتر القابع في أغوار الشخصية المحلية المتناقضة مع ذاتها من جهة أخرى، وتتجسد التناقضات الصاخبة في انصهار بعض الشخصيات وتماهيها حد إنكار الذات مع قيم المستعمر والإقرار بفضائله كما يحدث لدى الكثير من أفراد الشعوب المحتلة، بينما تتّخذ الشخصيات الأخرى مواقف متنافرة تسوّغ العمل المُهين مع المستعمر وتعتمد مواقف ملتبسة مع ذاتها ومع المقاومة الفعالة التي تمارس رفضا قاطعا لهذا التماهي مع المستعمر وتجتهد لتفكيكه ونبذ ممارسيه.
تعيدنا أوضاع اليمن الراهنة الذي افترسته الحروب الأهلية والتناحر الطائفي والعرقي الممتد على جغرافيته- شمالها وجنوبها- إلى مشهدية عدن، المدينة العالمية التي خضعت طوال قرن وربع القرن من تأريخها لهيمنة الاستعمار البريطاني، حتى عدّها المستعمرون في مراحل متأخرة من وجودهم فيها بأنها ثالث أكبر وأهم ميناء تجاري عالمي بعد ليفربول ونيويورك، وربما هذا ما تنجح في كشفه الرواية بشكل كبير.
ينتقي الروائي أحمد زين برؤية نقدية تحليلية متقنة تأريخا مفصليا تنطلق منه وقائع روايته “ستيمر بوينت” وهو عام 1967 وبالتحديد اليوم السابق لانتهاء الاستعمار البريطاني لمدينة عدن وإعلان استقلالها، ومن هذه النقطة التأريخية يستعيد الروائي -بسرده المكثف وشخصياته العديدة المتنافرة القلقة أو تلك المتصالحة مع ذواتها- تأريخ احتلال عدن منذ 1839 مارا بسنوات التحولات الكبرى التي طرأت على المدينة وما تلا استقلالها من خيبات وانكسارات؛ فيأخذنا الكاتب وهو يروي حكاية عدن الأمس بسرده الساحر ولغته المنضبطة إلى ما يحصل اليوم في عدن من استقطابات وحروب أهلية يذكي حرائقها صراعٌ عرقي وطائفي- قبلي تغذّيه تدخلات خارجية مشبوهة، وقد أوشك هذا الصراع أن يعيد اليمن- ولربما أعادها فعلا- إلى عصر ما قبل الاستعمار.
وتقدّم الرواية صورة حية لمدينة كوزموبوليتانية تسكنها أعراق متباينة من أوروبيين وأفارقة وآسيويين، تخصّصت كل مجموعة عرقية في مهن برعت فيها وشكّلت كتلة المدينة البشرية من طبقات متعددة وضعت في مراتب لا تتخطى حدودها المرسومة: أبناء البلاد أغراب في بلادهم وهم يتوزعون بين مثقفين حالمين بالحرية والثورة وبين منتفعين من المستعمر يمثلون ضربا من الآخر المنسلخ عن هويته؛ بينما يمثل الغرباء الآخرون بهوياتهم المتعددة ذلك الآخر الراسخ في مكانته المتمسك بأدواره، ويتكشّف النظام الطبقي الاستعماري عن صراعات معلنة وأخرى مستترة بين الأعراق المختلفة تدور في معظمها حول الثروة والأعمال التي توفّرها قوات الاحتلال والتجار الأوروبيون والهنود والفرس واليهود للمواطنين المعدمين القادمين من المدن البائسة في شمال اليمن والعمال الغرباء القادمين من الصومال وإثيوبيا. وتحتضن عدن المأسورة بين البحر والجبال كل هذه التناقضات المجتمعية والسياسية والاقتصادية لتمسي مرجلا فوّارا لا تنصهر في غليانه ولا تتمازج مكوّناته بقدر ما يتجذر تنافرها وتصادمها المحتوم.
يستكثر أحد الضباط الإنكليز على عدن- وقد عدّها البريطانيون ثالث أهم ميناء عالمي- سعيها للتحرر عبر حركات مقاومة مستميتة لم تكن لتتوفر على رؤية واضحة للغد، وثمة في المقابل نزوع رافض للمقاومة لدى بعض المواطنين العاملين لدى التجّار الأجانب والمستفيدين من المصالح الاستعمارية، ويعلن بطل الرواية سمير خوفه من الاستقلال الذي سيهدد مصالح التجار الأجانب، فهو يعمل مشرفا على مستخدمي تاجر فرنسي عجوز، كما يخشى البعض الآخر على تخلخل التعددية العرقية وزوال الرفاه الاستهلاكي الظاهري المتمثل بوفرة البضائع الأجنبية وانتشار المقاهي والفنادق بعد الاستقلال ورحيل المستعمر.
العراة والمرآة
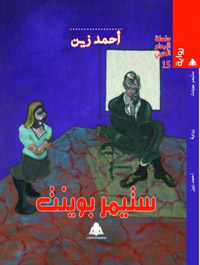
تطرح رواية “ستيمر بوينت” عبر فصولها رؤية نقدية جريئة لواقع مدينة عدن وتحوّلاتها، وتكشف عن التناقضات الحادة والصراع المحتدم بين شخصياتها وواقعها، ولا تتردد هذه الرؤية الجريئة في الاعتراف بالإيجابيات اليسيرة التي أحدثها الاستعمار في بنية المدينة الاجتماعية والاقتصادية ونسيجها الحضري المناقض للإقليم الجغرافي المجاور لها، ثم يكشف الروائي مقابل هذه الإيجابيات المحدودة حالة الاستلاب والصلف الاستعماري والنظرة الاستشراقية المتعالية نحو العرب.
ولا يكتفي بذلك بل يفضح عبر شخصية الباحثة البريطانية آيريس الأساليب والممارسات الاستعمارية إزاء الشعوب الخاضعة للبريطانيين برؤية ما بعد كولونيالية ناقدة للواقع الذي سبق الاستقلال والحال التي آل إليها بعد الاستقلال، ومن اللافت للنظر هنا أن يرى بعض البريطانيين في مناصرة آيريس للعرب “محض إعجاب رومانسي بالمتوحش النبيل” فتدافع عن نفسها بأنّ ما تفعله “ليس حبا صريحا للعرب وإنما لأنها تنتمي إلى عائلة تكسب قوتها من الدفاع عن الآخرين”.
وينعطف السرد ليقدم لنا آيريس الإنكليزية من وجهة نظر رجال محليين يخدمونها ويشتهون نيلها وفي الآن ذاته يشمئزون من شبقها وعِرقها الأجنبي، بينما كان سمير الذي يعمل لديها إضافة إلى عمله عند التاجر الفرنسي مهجوسا بسؤال لا يفتأ يؤرقه على الدوام: ما الذي سيحلّ به إذا فقد عمله بعد الاستقلال وغادر الفرنسي وهاجرت آيريس؟
تمثل المرآة شخصية محورية في الرواية؛ إذ من أعماقها تنبثق صور متلاحقة عن أغوار النفوس والأفكار السرية التي تنتاب الشخصيات وتشكّل هواجسها ونظرها إلى الآخر المختلف من جانب والآخر المتخفي في الذات البشرية نفسها من جانب آخر، وقد امتدّ حضور المرايا على امتداد فصول الرواية كاشفا عن الحقد والذل والخوف والتبجح والنكران والتشهي وعلى نحو يظهِرُ التشوهات الوحشية للنفس البشرية مثلما يظهر ضعفها المهين وتواطؤاتها.
كما استخدم الروائي شخصية آيريس الملتبسة ليعكس تناقضات الذات الأجنبية إزاء رحيل البريطانيين وتشوه الذات المحلية في تعاملها معها بين انصياع كامل واشتهاء مرضي انتقامي وبين اشمئزاز نافر من انتمائها للمستعمرين.
مرايا كثيرة استخدمها الروائي لملاحقة تناقضات الذات المحلية والذوات الأخرى للهنود المتصارعين مع بعضهم لاختلاف الدين وصراع النفوذ الفرنسي مع البريطاني والفارسي، وتناقضات المقاومة في داخلها وانقساماتها المتتالية. مرايا لا حصر لها تعكس تشوهات النفوس وجشعها واستسلامها وضياعها وهلعها؛ فكانت رواية “ستيمر بوينت” بمثابة مرآة هائلة ممتدة على جغرافيا فكرية وجغرافيا مصالح وجغرافيا تشوهات وصراعات لا تزال تتكاثر في حروب اللحظة الراهنة؛ فتحوّلت رواية أحمد زين بسرده البارع إلى انعكاسات أضواء فاضحة كشفت عري الجميع أمام حقيقتهم وحقيقة عالم يتغير كل آونة وتتحلل مكوّناته العتيقة من غير أن ينجح في تشكيل واقعه الجديد.