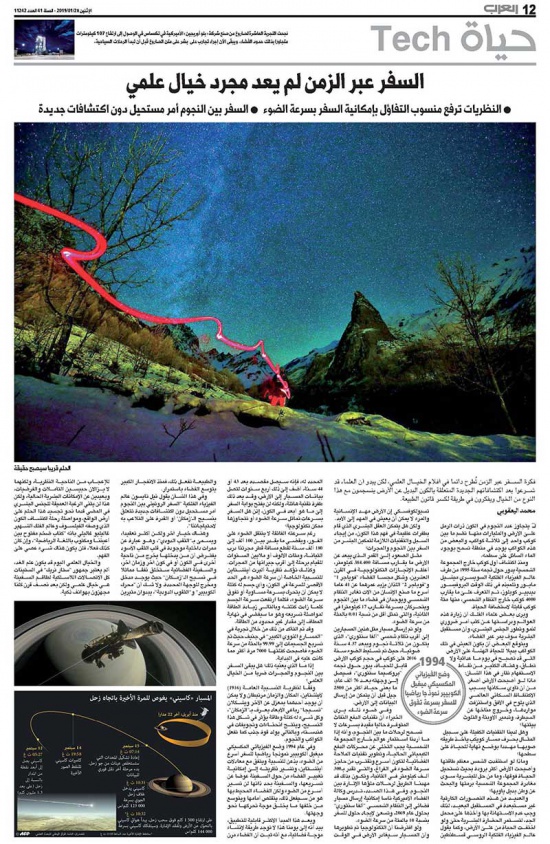عازفون حزانى يتلاعبون بالزمن والأساطير ليحكوا عن واقع المهمشين

تشكل الأسطورة رموزا وأنساقا تصنعها المخيلة الشعبية لتأويل غموض الحياة وأسرارها وتكشف عن الأحلام الجمعية للشعوب والتاريخ والدين. وغدت الأسطورة مكونا من مكونات النص سواء أكانت من الموروث أم صنعها الكاتب كما نجدها في المجموعة القصصية الأخيرة “فرقة العازفين الحزانى” للقاص العراقي زهير كريم.
أسامة الحداد
القاهرة - بين الواقع والأسطورة يتشكل تاريخ آخر من المرويات والحكايات الشعبية الممتدة من الأسلاف إلى اللحظة الآنية داخل فضاء سردي متسع يلعب مع الزمن وبه ويتوغل في الماضي، يقدم زهير كريم عبر 12 نصا في مجموعته القصصية الجديدة “فرقة العازفين الحزانى” صورة أخرى للعالم تتجاوز السرديات الكبرى إلى سرديات المهمشين وتاريخهم دون أن يحفل بالأطر المعدة سلفا ولا المقولات سابقة التجهيز.
اللغة والبناء
في قصصه الأخيرة يستخدم زهير كريم معمارا لغويا يعتمد على الجمل الطويلة الممتدة والكتل السردية المألوفة في الرواية ليصنع من خلالها قصصا قصيرة ويتجاوز الأشكال المعتادة وسطوتها عبر بنية تجمع متناقضات عديدة ومستويات مختلفة للتلقي يواجه من خلالها تاريخا طويلا من القهر دون السقوط في المباشرة.
يبدو المكان مهيمنا وساطعا داخل جسد النص الذي بدا كمشاهد متجاورة لضحايا الفقر والقهر في انحياز إلى البسطاء والمهمشين وإن بدا ذلك أقرب إلى صراع النقيضين الأبيض والأسود أو الجلاد والضحية مع اتساعه عبر البحث داخل الماضي وإعمال المخيلة عبر صناعة الأسطورة التي هي سمة من سمات هذا النص.
إن فعل السرد يعني أن شخصا ما يروي شيئا ومن هنا فتحليل الخطاب السردي هو دراسة العلاقتين الموضوع والمنطوق، وفي “فرقة العازفين الحزانى” تبدأ القصة الأولى من القصر الجمهوري وزيارة عازف فقير إلى القصر، وحين يذهب يكتشف رغبة الزعيم في تعلم العزف، ولم يغضب لفشله ويبوح إلى العازف الفقير بآلامه الشخصية وما في سريرته يكشف هشاشته وأحلامه الضائعة وتنتهي الزيارة باعتراف الرئيس بعجزه عن تعلم العزف شأنه في ذلك شأن الفنون كافة التي لم يتعلمها. ومع اكتشاف ما يراه المحيطون بالرئيس أسرارا من المحظور البوح بها، وجد “جواد” نفسه في مأزق يحمل ما لا يطاق فيبوح لزوجته بالسر ويتهامس به الأقارب والجيران ويصاب بهوس خوفا مما أذاعه ويعيش في الرعب حالة من الفوبيا أو الرهاب ذلك المرض النفسي الذي يعصف به، في تناص مع قصة تشيخوف “موت موظف عام”، إن الصراع بين الفرد والسلطة بغموضها وأسرارها وهشاشتها يقوده إلى حياة عسيرة مؤلمة ومن “زيارة القصر الجمهوري” إلى “الرجل الذي لم يعترف” أو “كومة العظام”.
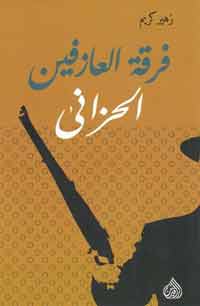
وجاء في القصة أنه “كان أثناء ذلك قد مات، ومن يومها لم يتكلم إلا عن الموتى الذين عرفهم خلال حياته، لكنه في المرات القليلة التي كان يفتح بها فمه، يفرد جسده تحت شجرة الصفصاف ويعتدل كإله على العرش”.
اللعب بالزمن
إن الذات الساردة تنتقل من الواقع -حيث العازف المرتعد الذي لا يغادر بيته بعد زيارة القصر الجمهوري و”كومة العظام” الذي خرج من السجن بلا حياة أو موت- لتدفع بنا داخل الأساطير وكأن غواية الحكي هي البديل للحياة والتاريخ، حيث تشكل بنيته أنساقا من الأساطير والمتخيلات الشعبية من مدينة البكائين إلى الهدهد وامتداد الحكي نحو الماضي بحكاياته التي يمتزج داخلها الواقع والتاريخ الرسمي والمتخيل الشعبي ليتشكل فضاء أسطوري يمتد زمنيا وعبر فعل الكتابة أيضا حيث القصة تتجاوز كتابة اللحظة أو الحدث أو الحلم لتشمل لحظات وأحداثا سابقة متوالية ليلعب بالزمن والتاريخ والشخصيات الشهيرة عبره، والتي ترتبط غالبا بالصراعات والحروب، ويكشف السارد عن لعبته بوضوح حيث يقول لنا ماذا يقدم بلا افتعال وفي سرد يقترب من الرواية ومكوناتها وتقنياتها.
تبوح الذات الساردة بعالمها المتخيل ومكوناته التي شكلتها وبخاصة في قصة “الفص” حيث ينتقل القاص من حكاية شعبية متداولة وبائع أحجار “جاسم كهرب” الذي يفرش أحجاره فوق شرشف في الميدان لينتقل إلى حكاية “فص” يبدأ من امتلاك “صدام حسين” له ليمتد إلى الجذور كأنما يصف شجرة من البراعم النابتة على فروعها وحتى جذورها ليواصل لعبته مع الأسطورة التي يشي بها أيضا ويتعامل معها كمكون ثقافي واجتماعي يواجه المتلقي كباحث أنثروبولوجي يضع الحكاية على طاولة التشريح فالفص الأحمر ما يدور حول قدرات من يمتلكه وأنه يمكنه أن يسوق الغيم بعصا ويحيي ويميت أيضا.
انتقلت القصة من الجد “الشيخ عقيقي” إلى حفيده “جاسم كهرب” والحجر الذي أتى منه الفص انتقل بين ملوك وقادة من “الإسكندر الأكبر” وحكايات “سقراط الخامس” عنه إلى “كاليغولا” وانشطار الحجر إلى فصوص صغيرة كما يقول المؤرخ وانتقال أحدها إلى ملك فرنسي هو “تشارلس السادس” واختلاس القس للفص مع موت الملك ومنه إلى “دراكولا” أحد القادة الرومانيين الذين حاربوا الدولة العثمانية والتي امتلك أحد قادتها ويدعى “خرطوم الفيل” فصا من الحجر وينتقل جغرافيا إلى الصين والشاعر الصيني “لي باي” ويذكر أنه أشار في قصيدة إلى امتلاك إمبراطور صيني لهذا الفص، وفي المقطع الثامن من القصة ينتقل زمنيا ومكانيا إلى روسيا القيصرية و”إيفان الرهيب” ومنه إلى أميركا والرئيس الأسبق “لينكولن” ويحكي أن ” بريمر” الحاكم الأميركي وصل إليه هذا الفص ومنه يعود في تلاعب بالزمن إلى “هتلر” ثم “عزت الدوري” الذي يعتقد “جاسم كهرب” الذي يحكي عن أحد الدراويش أنه اشترى منه حجرا كان لديه وأهداه إلى “عزت الدوري” وأن الحجر / الفص وصل إلى “صدام” ومنه إلى “خليفة الدولة الإسلامية” وكأن هذا الفص الأحمر مرتبط بلعنة تقضي على من يمتلكه بعد أن يمنحه القوة والسيطرة والجنون.
كذلك في قصة الخراساني يواصل اللعب مع التاريخ والأسطورة من خلال “حنون الخراساني” وتاريخ أسرته وهكذا يمتزج الواقع بالأسطوري ويقبض على اللحظة الآنية حينما يبدو وقد ذهب بعيدا في غابات الماضي، ليؤكد أن الحكاية مقطوعة زمنية تجمع بين زمن الشيء المروي وزمن الحكاية أي زمن المدلول والدال بما يؤكد أن إحدى وظائف الحكي إدماج زمن في آخر وهي سمة لا تميز الحكاية السينمائية في تناولها لزمن القصة وزمن الحكاية.