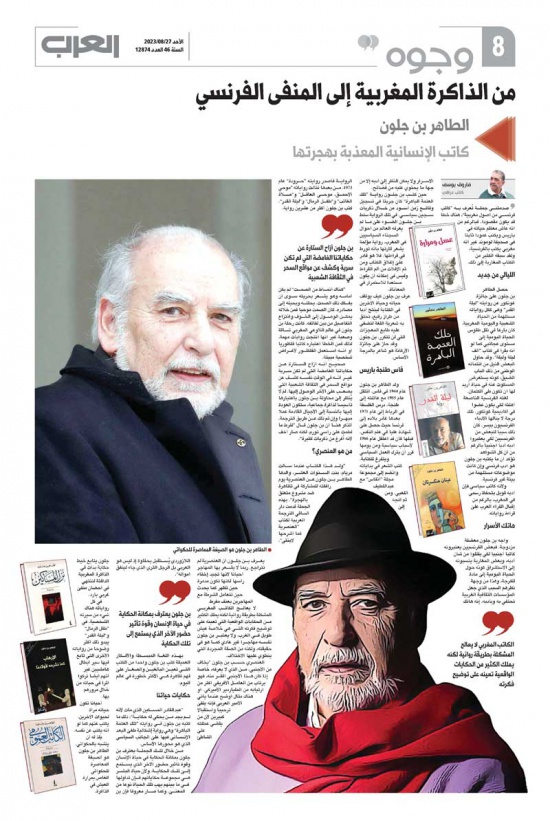"صلاة شجرة قبل أن تقطع".. قصائد تتأمل سيرا هامشية

ليست الأنا الحاضرة في الشعر المعاصر خاصة ذات الشاعر، بل هي طريق بين ذاته والذوات الأخرى، إذ يتحدث الشعراء بأكثر من “أنا” مانحين العالم والهامش والمجهول صوتا ومشاعر واسما وبالتالي وجودا. لا وجود لما لا اسم له، وكل ما هو خارج اللغة مجهول، يعي الشعراء ذاك ويذهبون أبعد منه في لعبة التسمية والاستعارة لتجديد وجود الأشياء والعوالم التي يرصدونها، وهذا ما نجده عند الشاعر والمترجم التونسي أشرف القرقني في مجموعته الجديدة.
ماذا لو كانت الكتابة هي ما يبقيك حيا، ماذا لو تعلق وجودك على ما تمنحه شكلا فيزيائيا محسوسا، وتنفخ فيه من صمتك. لا يتعلق الأمر هنا بالأثر، أو بما يعرفك به الناس، إنما هو عين وجودك الذي هو معهود إليك وحدك إبداعه، وتشير إليه وتقول “أنا”، أعتقد أن رجلا وقع على ذاته فقال: “أنا ” الرجل السعيد، لكن أليس من العجب ألا يكون طريق السعادة إلا غوصا في جحيم الحزن والألم؟ وألا تظفر بالسعادة حقا إلا بقدر ما يكون غوصك أعمق؟
هو ذاك، ولا عجب. وإن كنتَ ممن ذاق هذا السر ربما عرفت معنى ألا يكون الشعر زخرفا بلاغيا أو بهلوانيات عرفانية إنما هو وسيلة بقاء لحفظ الذات من أن تنمحي أو ينسخها الآخرون كما شاءوا.
لذلك تأتي القصائد تترى، منجمة. أعتقد أن الشاعر كلما أراد أن يقول أنا، كتب قصيدة ثم انبرى يريد ذاته.
إن كل عمل فني أصيل يجعلني أفكر في هذا وأراه بوضوح، لكني حين أقع عليه في الشعر يكون أشد وطأة وأقرب تأويلا. وهذا ما وجدت نفسي بصدده ما إن وصلتني مؤخرا نسختي من المجموعة الشعرية الثالثة للشاعر والمترجم التونسي أشرف القرقني، التي صدرت عن منشورات الجمل واختار لها عنوانا “صلاة شجرة قبل أن تقطع”، بعد أن صدرت له عن دار مومنت مجموعته الأولى بعنوان “تقريبا” (2017) وعن دار المتوسط المجموعة الثانية بعنوان “نشيد سيد السبت” (2020)، وللشاعر كتب أخرى أغلبها ترجمات لروايات من ألسنة أخرى.
الولادة والموت
قصائد المجموعة تبتعد بالشعر عن الزخرف البلاغي والبهلوانيات والعرفانية وتتخذه وسيلة بقاء لحفظ الذات من الامّحاء
جاءت “صلاة” أشرف القرقني في اثنين وأربعين نصا، إذا اعتبرنا الفاتحة التي كانت بلا عنوان على خلاف جميع النصوص الأخرى في الديوان، وهو تمييز سلبي لهذا النص يمكن قراءته (من باب التأويل) على أنه ينزل منزلة العنوان الفرعي للمجموعة، نظِم بعد عتبتيْن أخريَيْن تصدرتا الكتاب، بداية بمقولة للفيلسوف ديمتريس ليانتينيس:
لأن الفرق الفظيع أن الشعراء،/ الذين شبهوا الحقيقة جدا،/ كذبوا فحسب./أما أنا، من يبدو أشبه بكذبة، فقد عشت الحقيقة.
تتصدر هذه العتبة الكتاب لتكون بوابة برزخ تضع حد تمايز بين شعراء و”أنا” عاشت الحقيقة. ذاك هو ديمتريس ليانتينيس صاحب الكهف ورجل العودة إلى الداخل والفناء فيه وهو المتخلي عن زيف هواجس المآل بحقيقة الآن وهنا.
تجعلنا هذه الشذرة المنتقاة من قبل القرقني نتشوف/ نستشف الأفق الفلسفي الذي ربما تومئ إليه، حيث العودة إلى الداخل هي لعبة الأنقياء والجديرين بالحقيقة ولا معنى هنا للسمعة والرياء وبأن يتشبه المرء بالحقيقة، فأن يشبه المرء الحقيقة فذاك يعني أنه ليس إياها.
العتبة الثانية كانت للروائي قسطنطين جيورجيو من روايته “الساعة الخامسة والعشرون”: “هناك بعض الميتات/ التي لا تخلف وراءها جثثا”.
هل تبدو لك هذه البوابة الثانية محايدة ولا تصل التي سبقتها بطريق؟ لعلك إذن لم تقتف الأثر، أعني أثر صاحبنا ذاك ديميتريس وسيرته، حيث يكون سؤال الموت هو قلب الفن النابض، وحيث أن طريقة التعاطي مع الموت هي الدال على مأزق الإنسان الأخلاقي والجمالي، وحيث أن الموت ليس شأنا غيبيا نلفه بأسوار من التغافل والمجهول ونرنو إليه بعين طفولية فضولية ثم نستكين لهدهدة الأساطير والروايات. بل الموت -ربما- هو صنو الحياة ووجهها الأقصى وهو ما نحياه على وجه الحقيقة وإن بلا جثث.

في النص الفاتحة جاءت المفردات في أناة، ترتاح شفعا أو وترا على الأسطر القليلة، تقرأها وأنت تتنفس ببطء وتسمع صوتك (أشرف القرقني) وهو يحدث العالم، ربما كان حديثا عن الخيانة أو الخذلان لكن تجد أن أنفاسك قد هيأ مداها التوزيع البصري الذي يشي بأن المسألة ربما تتعلق بثأر ما، أو هي لحظة امتلاء تراجيدية بالألم، أم/ بل ربما أن الأمر هو ذاك جميعا.
لا يبدو الخطاب الشعري متحفزا لشيء ما بقدر ما يريد أن يمتلئ بذاته وأن يجد زخمه في الآن وهنا، حيث أن النص يقترح في إجرائه للمعنى تدفقا إيقاعيا مرتبطا بالحالة الوجدانية/ الوجودية للذات القائلة، فيرفد عناصر التشكيل اللغوي بمستوياتها المختلفة (اللسانية الإيقاعية، البصرية…) ليخلق السياق المؤسس الذي سيبني فيه ومن خلاله سردية الذات الشاعرة وسيرة مقامها ورحلتها في الكون، ألم نقل في البدء إن القصيدة في الأصل هي محاولة لقول “أنا”؟
انظر إن شئت نصا ومادة حيث أن الموت والحياة -كما وعدت العتبتان- صورتان لكنهما واحد، وهي الرحلة التي نبتدع لها اسمها -كي لا يسميها الآخرون فيمتلكونها علينا- وهي لحظة التخلق من مضغة الإمكانات اللامحدودة إلى هيئة التعين الكمي، يقول القرقني: “…/ أنتهي الآن/ إلى هذا الحضيض”.
ذلك التعين الذي لا بد من أن يكون سقوطا تراجيديا في أحسن أحواله، لم يعِدْ بجنة أو جحيم وإنما بسيرة أرضية تصنع من دوران الوقت سماءها وأفقها، يقول: “ربما أصير بعد غد شاعرا/ أو حارسا لأحلام يتيمة/ أو أي شيء آخر”.
لا يبتدع القرقني الولادة/ الموت وإنما هو ببساطة (أية بساطة) يقولها، أي أنه ينحت في اللغة جسدها الممكن ويسري في عروقها سريان النسغ الخام، ذاك النص/ الجسد / الشجرة هو الديزاين Dasien الذي يصير بدورة الزمن ضرورة لسيرة يصنعها الألم (الولادة) ويبررها الشوق (الموت).
لماذا يستعيد أشرف في مفتتح ديوانه لحظة الميلاد ليعيد تسميتها/ تأملها / تألمها؟ لماذا يصهرها في فكرة الموت؟
في النهاية هل من كائن غير الإنسان يتأمل موته ويسميه؟ على كل الشاعر هنا في “صلاة شجرة قبل أن تقطع” يفعل ذلك. ويجعل منه البداية التي تعلن عن سيرة الذات مع/ في العالم والآخرين وقبل كل شيء مع/ في ذاتها. هذه السيرة التي تبدع تفردها بالتجرد من السيَر الأخرى ومن الأسماء الأخرى، كيف ذلك؟ بأن تجعل من الأسماء و السير استعارات و كنايات عن الـ”أنا” الماضي في تحقيق ذاته فـ”الحكايات القديمة” و”قطار المحطة” و”الطريق” وغيرها إن هي إلا كنايات عن ذات تتخلق في زحمة الإمكانات اللامتناهية.
في “صلاة شجرة قبل أن تقطع” تكون رحلة القارئ بالضرورة رحلة توتر في المعنى بين مفازات وطرق ومنحدرات وتلال ووديان وجبال حزيزة، يمكن قياس المعنى بالشدة والجهد المبذوليْن في الترحل، وفي تلك الكهرباء السارية بين النصوص -تقريبا- تكمن الصلاة.
الخطاب الشعري في المجموعة لا يبدو متحفزا لشيء ما بقدر ما يريد أن يمتلئ بذاته وأن يجد زخمه في الآن وهنا
فعل الصلاة هنا، بما هي صلة وحضور، يقترح جماليا الانخراط في كينونة ذاتِ أطوار، مجال الوصل/ الفصل فيها هو أناوات متحققة في الزمن منبعها ذات تفيض على العالم فتحسب -على تناقضاته- أنها إياه، تماما كما لو كانت ألوان الطيف جميعها تتحرك بإيقاع مخصوص ليقول من أراد أن يومئ إليها “لا شيء أبيض وكثير”.
في الكتاب النص توجد أعلام وشخصيات ومعالم كثيرة محايثة لسيرة فتى وبها تنكتب. حضورها (بل هو غيابها في الواقع) يدل على الاتجاهات في الخارج، في رحلة الذات، وهو بذلك ما يقوم مقام إشارات طريق جوانية تهيأ بحضورها الطاقة الانفعالية اللازمة للمضي قدما أو إن شئنا لاستقبال النور.
يقول الشاعر: “لقد اتخذت الوقت الكافي/ لأرى جيدا./ وقد حان دورك الآن/ أيها النور”.
علـﭫْ، فيم فيندرز، سندريلا، أشرف القرقني، أبو العلاء المعري، وديع سعادة، الأب، نوح، محفوظ، التونسيون، بودلير، الله … أولئك وغيرهم أقنعة الشاعر وتعلته للقول ووسيلته في تكشف الأنطولوجيا الخفية التي تسم الذات الإنسانية ويحد خفاؤها من أن يعيش الإنسان الحقيقة (فما بالك بأن يعرفها) ويزهر فيها.
يكتب القرقني: “كلب الحداد هناك.. إني أراه بأصابعي/ التي ترتجف في لحظة/ في ليلة قد لا تشرق شمس بعدها/ على حصان من رماد أملسَ/ ينبح/ فتستيقظ طرقات خبيئة في جسدي”.
سيرة الفتى

تبدو لحظة المجموعة الشعرية الأخيرة لأشرف القرقني من الناحية الوجدانية لحظة ترسب في حداد ما، بعد أن جف نزيف الدموع -أو يكاد- وتخثرت في الفضاء الفارغ صرخة الوداع، يكون من الممكن أن تتنفس مثل هذه النصوص، فكما أسلفنا فإن الألم (الولادة) بما هو حالة قصوى من الوجود يمكن أن يجلي عن السيرة زوائدها وما يثقلها مما ليس منها، لحظة الألم هي لحظة تجرد الأنا وتحققها الأكيد في آنها، وهي اللحظة المستعادة في سبيل استجلاء الذات ذاتها.
يقول الشاعر: “مرة أخرى/ أبدأ بالحديث عن الشعر/ فأقع في الحديث عن نفسي/ لعلني أبحث عن شيء ما/ يضم الشعر والحزن والموت معا/ في عناق واحد”.
الفتى في “علـﭫ” يركض حافيا يلاحق شبح الجدة وينبح اسمها، يدرب قبضتيه لكي تمنحا الوجوه العابسة في الأزقة الخلفية للمدينة ابتسامتها اللائقة، ينتبه للحب، يخذله، مازال صغيرا على الحب وقصيدة النثر، يشرح لشعراء يشبهون الحقيقة ما ألغز عليهم من نصه العمودي، يخذلونه، ينتبه إليه الحب، يستكتبه ثم يخذله.
ما زال الفتى ينبح باسم الجدة، لكن “علـﭫ” تضيق، يكفر بالحب، فيخذله، لكن ألمه يعجب المترفين الفارهين في الصالونات الأدبية، وقد صار كلب الجدة ومخذولا في الحب وبضع معارك أخرى، والمدينة لا تحب الحقيقة بل تريد من يشبهونها لكنها على أية حال تحترم القبضات المدربة وتبتسم لها.
لطالما سمع الفتى اسمه في معارك الحي، على وقع طرق الحديد في مشغل الأب، في سكينة العائلة في الظهيرة، في السراب الباذخ لسياح سوسة، في القسم (المدرسة)، في القسم (الشرطة)، في همسات الصبايا، في صيحات الإعجاب من لدن الرفاق، لكنه لم يصدق ذلك ووعد نفسه بأن يغدو ذاك الشاعر الجدير بحياته العظيمة الأليمة، قلة صدقوه -أزعم أني كنت منهم- لكن كلب الجدة صار ينبح اسم الحداد ليس في “علـﭫ” وحدها وإنما في قصيدته وما جاورها، هو الآن يترسب في حداده وقد كتب قصيدته الأخيرة “صلاة شجرة قبل أن تقطع”.